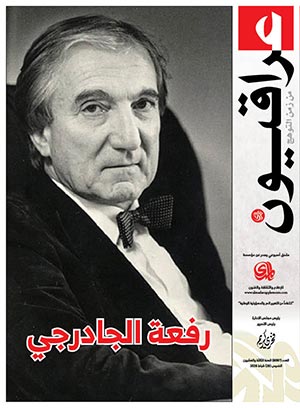فوزي كريم سأحجب ضوء الحديث عن حقول البحث العلمي في ثقافتنا العربية. وفي حقل الإنسانيات سأفرد حقل الثقافة الأدبية للإضاءة في حديثي هذا. فحقل الإنسانيات في الدراسات الاجتماعية، التاريخية، السياسية، الفكرية والفلسفية، الإسلامية، تبدو لي متعافية بصورة من الصور،
مقارنةً بحقل الثقافة الأدبية: شعر، ونقد الشعر، وكل كتابة بشأن الأدب، التي تبدو لي، للأسف غاية في الضحالة، والتردي، والنفاجة، والتعالي الفارغ، والفراغ. عناصرُ الحداثة في حقل الإنسانيات تتضح بمقدار اتضاح نفعها، وغناها. وهي واضحة ونافعة في كثير من أنشطة هذا الحقل. مع أنها لا تتكلف رفع شعاراتها، كما يُرفع السلاح، فوق رؤوس قرائها. ولنا سلسلة رائعة من أعلام هذا الحقل: من فؤاد زكريا، مروراً بنصر حامد أبو زيد، بالقمني، الجابري، جورج طرابيشي.... حقل الثقافة الأدبية وحده، الذي تكلف أمر احتكار الشعار الحداثي هذا، وجعله قبضةً أو سلاحاً. وهو يفعل ذلك بسوء نية، لأنه يُخفي وراءهما فراغاً حقيقياً. ولك أن تستقرئ ذلك بيسر عبر الكتب الصادرة، والجدل المصوّت في المؤتمرات، والروح الهتّافة في مهرجانات الشعر، وعبر هذا الغبار الخانق من نتاجات الصحافة الأدبية عامة. إن خلافات الجابري وجورج طرابيشي عبر الكتب الثمانية بشأن العقل العربي، لتملأ القارئ الجدي غبطةً، وثقة. ولها مثيلات في حقل الفكر السياسي، وعلم النفس، وعلم التاريخ، والأسطورة. حتى المسعى الأكاديمي في الدراسات الإنسانية هذه لينطوي على قدر من الرغبة الحقيقية لبلوغ هدف. ولكن خطاك ما إن تعبر الحد الفاصل بينها وبين فعاليات الأدب، حتى تجد نفسك في متاهة فاسدة، فارغة، مكابرة، سيئة الطوية، وتدميرية. السبب الكامن وراء هذه المفارقة أن مفكر الإنسانيات يسعى لاكتشاف الحياة والعالم. وهذا المسعى سيكون بالضرورة، حذراً، متوجساً وقليل الثقة. في حين يسعى الشاعر ومثقف الأدب جملة إلى تغيير الحياة والعالم. وهو مسعى سيفترض أداء رسالة خًصّ بها دون البشر، وجرأة لا تختلف كثيراً عن الحماقة، وتعالياً هو وجه بديل للجهل. وهي خصائص يتميز بها مثقف الأدب العربي بصورة ملفتة للنظر. نعم، إن مهمة تغيير الحياة والعالم فكرةٌ استُلهمت من الفكر السياسي اليساري بصورة خاصة. وهي ظاهرة وجدت أكثر من صدى في العالم. ولكن هذا الصدى سرعان ما اهترأ، بسبب هيمنة الحضارة العقلانية ضاربة الجذور. وبقي الشاعر ومثقف الأدب مؤتمناً على التساؤلات المحيرة داخل المتاهة. ولكن طبيعة العقل العربي، وطبيعة الثقافة العربية، والظرف التاريخي، شاءت أن تُبقي مثقفَ الأدب وشاعره داخل بالونة الوهم: "قادرٌ أن أغيرَ. لغمُ الحضارة هذا هو اسمي.."، على حد قول الشاعر أدونيس. حين أبدى شعراء مثل السياب وصلاح عبد الصبور عجزهم الكامل عن اجتراح حلول لمعضلاتهم الشخصية، ولمعضلات الحياة والكون، كان الاستنكار الذي ووجهوا به، على مدى الثقافة العربية، تاماً. ومات الاثنان مهمومين، مُستنكرين، غيرَ مرضيٍّ عنهما. المعضلة أن الشاعر ومثقف الأدب، بفعل وطأة الوهم في مهمة التغيير الرسولية، لم يعد يملك القدرة على رؤية نفسه إلا في مرآته السحرية. دون أن يعرف أن مرآته السحرية هذه إنما هي أداة وفّرتها له وطأة الوهم ذاته. وأن هذا الوهم لن يسمح في أن تصبح الموهبةَ، والخبرةَ، والمعرفةَ، والوعيَ قوىً ذات فاعلية حقاً. بل على العكس يعطي مزيداً من الثقل لمهمة إفراغها من كل معنى، وحشوها بالضوضاء السحرية، وإلباسها أقنعة إيهام النفس. هل يبدو ممكناً أن ينتفع حقلُ الأدب والشعر من حقل الإنسانيات، في التنازل عن مهمة التغيير والسعي إلى مهمة البحث والاكتشاف؟ لا أعتقد ذلك. فالشعر العربي، حتى لو امتلأ بحداثته الإيهامية، سيظل أسير هذا الدور المُلهم، الرائي، النبوئي، ذي الرسالة المغيرة للحياة وللعالم.
الشعر الباحث أم الشعر المكتشف؟

نشر في: 22 نوفمبر, 2009: 04:55 م