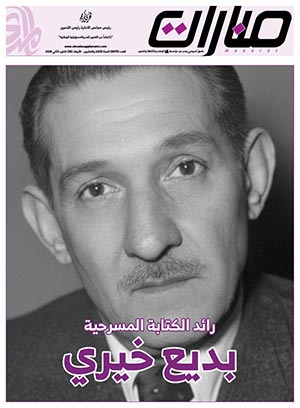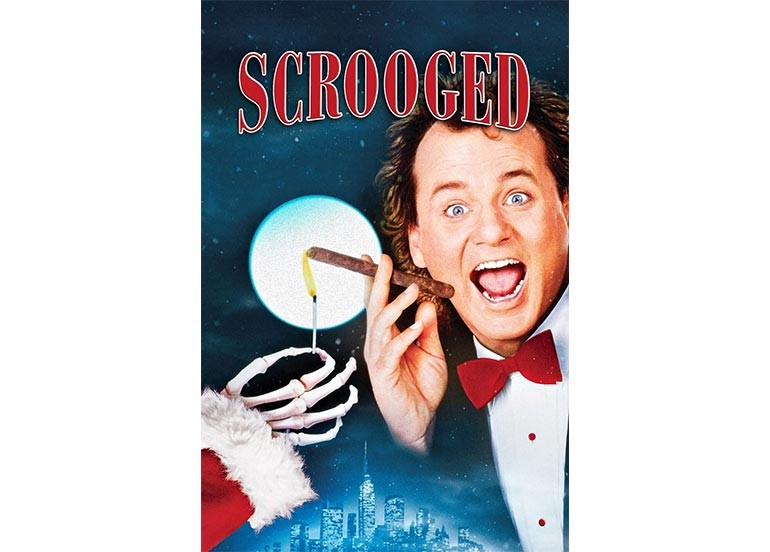لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لحملة الأنفال، سيئة الصيت، التي شنّها النظام الدكتاتوري السابق على الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق، نظم القائمون على مهرجان لندن للفيلم الكردي عرضاً عالمياً أولاً للفيلم الوثائقي "ألف تفاحة وتفاحة" للمخرج الراحل ط
لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لحملة الأنفال، سيئة الصيت، التي شنّها النظام الدكتاتوري السابق على الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق، نظم القائمون على مهرجان لندن للفيلم الكردي عرضاً عالمياً أولاً للفيلم الوثائقي "ألف تفاحة وتفاحة" للمخرج الراحل طه كريمي في الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون (بافتا) بلندن.
تتمحور قصة هذا الفليم الوثائقي المؤثر حول عشرة أشخاص كرد نجوا من المقبرة الجماعية خلال عمليات الأنفال التي ارتكبها صدام حسين ضد الكرد عام 1988 وراح ضحيتها نحو 182.000 مواطن كردي. لقد نهض "فرج"، أحد هؤلاء العشرة الناجين من بين الموتى متسلقاً جثثهم المتكدسة ليجد طريقة إلى الخلاص. وسرعان ما قامت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بنقله إلى الولايات المتحدة الأميركية ليروي قصته المفجعة للشعب الأميركي الذي لم يعرف، إلاّ قلة نادرة منه، بقضية الأنفال.
لقد قام "فرج" بتأسيس مجموعة الناجين من المقابر الجماعية للأكراد المؤنفلين، كما قام خلال عودته إلى كردستان مع أربعة أشخاص من الناجين الآخرين بشراء "ألف تفاحة وتفاحة" ووزعوها، مع أزهار القرنفل الجافة، على الأُسَر التي فقدت أحباءها كي يزينوها في إشارة واضحة إلى السلام والمصالحة.
لا يخلو الفيلم من مشاهد مؤثرة ومرعبة تصور الطريقة التي فرّ بها الناجون من عمليات الأنفال حيث هاموا على وجوههم في الصحراء الجنوبية الغربية من العراق وكان بعضهم ملطخاً بدماء الضحايا الآخرين ، الأمر الذي أثار شهية الذئاب الجائعة التي تخلصوا منها بأعجوبة ووصلوا إلى بعض البيوت المتناثرة التي أمّنت لهم الحماية ومهّدت لهم طريق العودة إلى أهلهم وذويهم المبثوثين في المدن والقرى الكردية.
لم يكن أحد يتصور بأنّ هذه الكارثة قد حدثت في العراق وكيف استطاعت العناصر الأمنية للنظام المقبور أن تسوق هذه الآلاف المؤلفة من البشر إلى حتفهم في مجاهل الصحراء ولولا هؤلاء الناجون العشرة لما صدّق أحد بحجم الكارثة وفظاعتها.
تعتمد الرؤية الإخراجية لطه كريمي على جانب رمزي، ففضلاً عن ترصيع التفاح الأحمر بأزهار القرنفل الجافة وما تنطوي عليه من رسالة واضحة إلا أن المخرج قد عمد أيضاً إلى توجيه أهالي الضحايا لأن يضعوا صور المؤنفلين ورسائلهم في قنانٍ زجاجية يلقونها على سطح الزاب الذي يفضي إلى نهر دجلة كي تصل إلى صدام حسين تحديداً دون غيره من الناس. يا تُرى، هل استمع صدام ذات يوم إلى أنين العراقيين وأوجاعهم بغض النظر عن اللغة أو الدين أو المذهب، فكلنا بالنتيجة عراقيون، لكن السؤال الأمرّ هو: لماذا يبيد الجلاد آلاف الضحايا في رمشة عين؟ ولماذا يوغل في القتل إلى حد الإبادة الجماعية من دون أن يهتز له جفن، ويقشعر له بدن؟ ولماذا تصرّ الضحية على رسائل المحبة والمصالحة والسلام؟ هذه هي الثيمة الرئيسة للفيلم أما تفرعاتها فهي لا تقل شأناً عن ثيمتها الرئيسة غير أن الأفكار برمتها تتوفر على لغة بصرية جميلة تمنح المتلقين صبراً مضافاً لمتابعة مشاهِد الفيلم التراجيدية المؤسية.
حلقة نقاشية
احتضنت إحدى صالات "البافتا" حلقة نقاشية شارك فيها خمسة سينمائيين وهم المخرجة جيمان رحيمي، والناقد السينمائي عدنان حسين أحمد، والكاتبة والمخرجة مزكين مزده أرسلان والمخرج والأكاديمي دلشاد مصطفى والأستاذ فاضل مرادي، الباحث في معهد ماكس بلانك في هاله، ألمانيا، إضافة إلى مدير الجلسة ممد آكسوي. ونظر لسعة الموضوعات التي طرحت سنكتفي بالإشارة إلى بعضها مع عرض لأبرز الوثائق التي تضمنتها ورقتي النقدية التي ركزت فيها على تعريف كلمة "جينوسايد" على اعتبار أن عنوان الحلقة النقاشية هو "دور وتجسيد الإبادة الجماعية في السينما والفن الكرديين". فالجينوسايد هي "كل إبادة جماعية منظمة تستهدف مجموعة اثنية أو عرقية أو دينية" وقد يكون هذا الاستهداف للكل أو للبعض، لكنه يقع بالنتيجة في إطار الجينوسايد. وقد ضربنا أمثلة متعددة لهذه الإبادات مثل مذبحة رواندا التي يقدّر عدد ضحاياها أكثر من نصف مليون ضحية ومجزرة سربنيتسا التي غُيّب فيها أكثر من ثمانية آلاف مسلم بوسني غالبيتهم من الرجال والصبية الذكور، أما الهولوكوست الأرميني فقد قُدر عدد ضحاياه بنحو مليون ونصف المليون مواطن أبادتهم القوات التركية عام 1915 آخذين بنظر الاعتبار أن الحكومة التركية لا تعترف بكلمة إبادة حتى الآن!
السؤال المهم في هذا الصدد هو: هل جسّد المخرجون الأكراد مفهوم الإبادة الجماعية لكارثتي حلبجة والأنفال في السينما الكردية؟ قد يكون الجواب أن بعض المخرجين الكرد قد جسّدها جزئياً ولم يستطع معظمهم، لأسباب مادية وتمويلية، أن يجسد القسم الأكبر منها. ومع ذلك يجب الإشارة إلى بعض الأفلام التي تناولت كارثة حلبجة أو مأساة الأنفال نذكر منها "كل أمهاتي" لإبراهيم سعيدي وزهاوي سنجاوي، و "باليسان" لجبرائيل أبو بكر، و "حلبجة: الأطفال المفقودون" لأكرم حيدو، و "أنا مرتزق أبيض" لطه كريمي، و "نحن" لصلاحة رش، و "الأنفال" لمانو خليل، و "رائحة التفاح" لرافين عسّاف وفيلم "ألف تفاحة وتفاحة" لطه كريمي أيضاً إضافة إلى باقة من الأفلام الروائية والوثائقية التي لا مجال لذكرها جميعا.
ربما يكون من المفيد أن نطرح التساؤل الآتي: ما الذي نحتاجه كي نجسّد كارثة حلبجة التي قُصفت بالأسلحة الكيماوية أو فاجعة الأنفال في السينما الكردية؟
للإجابة على هذا السؤال الجوهري لابد لنا من التوقف عند النقاط الخمس الآتية وهي: الحاجة الأساسية للأبحات العميقة والموثوقة عن العناصر الكيمياوية التي استعملت ضد المواطنين الأبرياء في حلبجة أو في غيرها من القرى الكردية. الحاجة إلى قصص سينمائية جيدة ومتماسكة ولا بأس من الاستعانة ببعض القصاصين والروائيين الذين يقدمون خبراتهم السردية إلى كُتاب السيناريو كي نضع حداً لمشكلة جوهرية تعاني منها السينما الكردية خاصة والعراقية بشكل عام. يتوجب على حكومة إقليم كردستان خاصة أن تقدّم الدعم المادي الكبير للمخرجين السينمائيين الكرد كي يتصدوا لموضوعات كبيرة مثل حلبجة والأنفال، فلا يمكن إنجاز أفلام عظيمة تجسد مثل هذه الكوارث الإنسانية بميزانيات متواضعة نخجل من ذكرها. كما يتوجب على الحكومة المركزية ببغداد أن تقدم دعماً مضاعفاً لمثل هذه الأفلام التي تصور جانباً من محن الشعب الكردي الذي فتكت به دكتاتورية النظام الوحشي السابق. الحاجة الماسة إلى تقنيين جيدين ومصورين سينمائيين أذكياء وموهوبين لأن المصور السينمائي المبدع يمنح الفيلم سواء أكان وثائقياً أم روائياً أم قصيراً نكهة خاصة توفر المتعة البصرية حتى للمتلقي الذي يشاهد فيلماً مأساوياً. النقطة الخامسة والأخيرة يختصرها المثل الذي يقول "إن المخرج يدفن الفيلم وأن المونتير يعيده إلى الحياة ثانية". لذلك نحن بحاجة ماسة أيضاً إلى ممنتجين إضافة إلى كافة التقنيين الذين أشرنا إليهم قبل قليل. وفي حال توفر هذه المعطيات الخمس كلها يمكننا الحديث عن إمكانية لتجسيد كارثة حلبجة أو عمليات الأنفال في السينما الكردية التي تتقدم يومياً بخطى محسوبة، رغم القصور آنف الذكر، صوب نجاحات مذهلة تؤكد بأن كردستان العراق ولاّدة للمواهب والمبدعين في الفن السابع أو في بقية الفنون الجميلة.