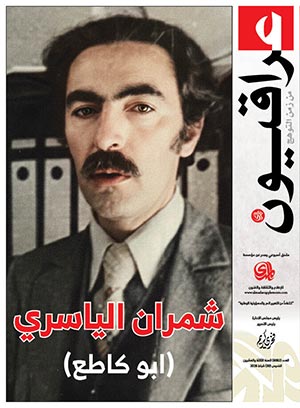كما لو اني (كسرتُ خاطرهُ) قال لي : أنتم سنّة أبي الخصيب مساكين فقراء، طيبون، أصابكم الأذى وتعرض الكثير منكم للقتل والملاحقة وحين وجدته يحاول أن يسهب في كسر خاطري أكثر عاجلته قائلاً : انا لست سنيا يا حاج، ولست شيعياً أيضاً سابقتي في الشيوعية وولعي المفرط بالحياة وعشقي لبني جنسي من العرب والمسلمين بخاصة وخوفي على أبناء وطني من الفرقة والاقتتال وأشياء أخرى بينها كتابتي للشعر وسماعي للموسيقى وحبي للفن والغناء والرقص واللوحة والطبيعة وقراءتي للأدب والفلسفة وسواها من أسباب لا سبيل لحصرها منعتني من أكون سنيا أو شيعيّا، صيرتني إنساناً عراقياً خالصاً، فلا تقلق عليَّ يا أستاذ .
أعرفهُ (الأستاذ عبد الحسين) الذي اكتملت دورة الشيب في لحيته، ولم تك كذلك أعرفه منذ ما يزيد على ربع قرن ، هو إنسانٌ طيب جداً، مهندسٌ اكمل بعضاً من دراسته في لندن أيام كان العلمُ خالصاً لم تشبه خرافة، اقرأني بعضاً من معرفته في الفلسفة وفي الدين والأصول وحب آل البيت، وعنه أخذتُ الكثير من فقه العبادات والمعاملات ولا أشك لحظة واحدة في رقة طبعه ونبل منبته وصدق نواياه. وحين وقف تحت الشمس التي انصبت محرقة على رأسينا وسط الشارع، أراد أن يتحقق من سلامتي في البدن والروح، أراد ان يطمئنَ قلبه أكثر عليَّ، وكمن يمسك شيئاً أضاعه ظل ممسكاً يدي وأنا أحدثه عن قديم معرفتي به، وعن الأمكنة التي التقينا بها وعن الأزمنة التي مرت سريعة والأيام التي أمضيناها هنا وهناك، أُثني عليه وأسأله عن صحته وكيف أصبح وأمسى اليوم، وما إذا كان يقرأ ويسافر ويحب الأرقام وغيرها. لكني أذكر انه أسرني بحديث حادث كان له ذات يوم وهو في لندن الباردة الكافرة.
يقول الأستاذ عبد الحسين بأنه ذات يوم وقد أوشكت معارفه على الكمال، أو كادت سعةُ علمه ان توصله لبغيته في الخلاص، أدركته الديكارتية فجأة، فصار شكاكاً، حتى كان يجلس في حديقة منزله بلندن عصر كل يوم، ومنضدته تغص وتضطرب بالكتب. يقرأ في هذا ويقذف بذاك، يفتش في المبحث هذا ويرجئ سواه، وهكذا كان حاله لأيام كثيرة وهو بين المعرفة ونفيها، بين الطمأنينة ونقيضها، بين ما يقرأه في الكتب والمجلدات وبين ما يقلقه في قلبه . أستحضرُ الآن صورته وهو يحدّثني عن لحظته تلك حتى قال بأنه توجّه من مجلسه في الحديقة، بلندن صوب بيت الله الحرام، مخاطباً ربّه بخطاب لم اقع على صدّقه عند أحد، وقف يعاتبه على ما غمَّ واستغلق عليه، وهو بين الحيرة والندم حتى خلُصَ إلى قوله بأنه، وفي لحظة لن تتكرر أبداً، شعر كما لو ان نصفه الأعلى لم يعد له، ارتفع فوق عشب الحديقة الأخضر، ظل سابحاً في فضاء من النور والوجد، من العشق والمعرفة والكشف، ظل ساعات وساعات خارج اللحم والدم والأخلاط، لا يعرف كم ظل وهو هناك في الأعلى لكنه حين هبط النصف العلوي على الأرض تبعثرت الكتب وتمزقت المجلدات، فقد كنست الريح التي تزوبعتْ مرعدةً ملقية بالثياب والبيت والمعارف التي استودعها الورق والأرفف .
لا أعرف كم مرَّ من الزمن، منذ أن التقيتهُ ساعة الظهيرة أمس حتى أفلتُ يدي مودعاً!! لكني عدت معه تلميذاً يسمع نصيحة استاذه الطيب، حدثني وهو يقول لي يا أخ، محاولاً تذكر اسمي، أن الحياة لم تعد تسرهُ، وما كنا يشكو ويعاني منه أيام النظام السابق أصبح يعاني ويشكو منه في الأيام هذه، وكل طموح لنا وله آنذاك يصطدم بعقبة الحكام الجدد، وكما لو انه يستلُّ يقيني مني قال: لا أثق بأحد منهم أبداً. العمامة السوداء لا تختلف عن العمامة البيضاء، فلا تأمننَّ من كان على يمينك ذات يوم، كذلك لا تأمننَّ من لا زال على شمالك هذا اليوم. كلهم سواء، وتذكر دائماً بان حجارة المسجد والمعتقل من مقلع واحد أبد الدهر يا أخ، وهو يحاول تذكر أسمي. ثم انصرف حتى لم أعد أفرق بين ثوبه الأبيض والظلال التي راحت تسقط على كتفيه وهو يغيب بين الأزقة الضيقة المتربة .