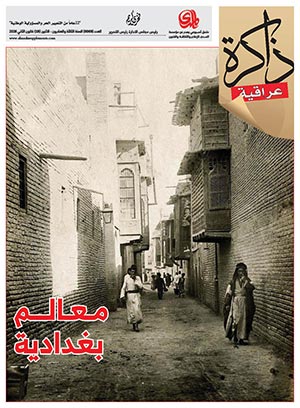أنا الآن رجل في الرابعة والسبعين. لذلك وحسب المعايير الزمنية لفن وثقافة ما بعد الحداثة, أنا الآن فنان عتيق. لكن ليس من يومي هذا. بل من قبل ذلك بأعوام لا ادري ما هو عددها. العتق بالتأكيد لم يكن مشروعا مستقبليا. فالمستقبل بات زمناً تتحكم بنبوءاته الكثي
أنا الآن رجل في الرابعة والسبعين. لذلك وحسب المعايير الزمنية لفن وثقافة ما بعد الحداثة, أنا الآن فنان عتيق. لكن ليس من يومي هذا. بل من قبل ذلك بأعوام لا ادري ما هو عددها. العتق بالتأكيد لم يكن مشروعا مستقبليا. فالمستقبل بات زمناً تتحكم بنبوءاته الكثير من الأدوات الافتراضية التي لم أكن, أو لم نكن نعهدها في بداية زمننا العتيق ذاك. لكن وفي خضم مناورات الافتراض, هل باتت أفعالي(أفعال جيلي) الفنية مشكوكاً في قيمتها. ان لم تكن فعلا بلا قيمة.
فلماذا أنشئت المتاحف وقاعات العرض الاسترجاعية التي تغص بها عواصم الثقافة والفن العالمية. لكن إن ابتكرت ما بعد الحداثة أفعالها, فهل صيرتنا هذه الأفعال فعلا أناسا عتيقين, سواء إن كنا في بلدنا الأصلي, أو خارجه, بعد ان صادرت ارثنا الفني, وبخرته بقدرة مجنزرات الاحتلال وسلطته السياسية والثقافية ألما بعد حداثية.
قبل ذلك تهنا زمنيا وسط دوامات هاجس الأصالة(العتيقة). لنلحقها بتوهان شبكة مسالك العولمة وافتراضاتها التي حولت حوادث أيامنا, صوريا, لدراما القتل والدمار العبثي(عبث فيما يخصنا فقط, ومنفعة لصناعها), حروب افتراضية لتسلية الصبيان والصبايا.
أبي كان عتيقا, هذا شأن زمنه الذي شيّأه كائنا ماضويا, كما شيّأ صحبه وصحب صحبه وصحبهم, الى ما لا نهاية. رافقت عتقه في صغري, وبقي شيء من صدأ ذلك العتق عالقا بي. والدتي هي الأخرى عتيقة كما هو حال غالبية جنسها في ذلك الزمن, الذي لم يعد ماضويا, بما تمخض مؤخرا في بلدي من محاولة جادة لاستعادته أو استنساخه من جديد. كانت الكثير من تفاصيل الزخارف البدائية تنقط من فرشاة والدي على صفحة الألواح الخشبية. وكان درسي الأول الذي لم يبق منه تفصيلا سوى مسحة الفرشاة على سطح اللوح وعبق عتق أصباغها الترابية. والدي الذي كان مزهوا بعتق تفاصيله القليلة. حولني لمجرد مؤدي دور, سرعان ما تركته على عتبة دارنا العتيق.
ما بين عتق, و جدة مفتعلة. كان معهد الفنون الجميلة البغدادي في زمني ذاك يراوح مكانه. فنان أستاذ لا يدرك من مهنته التدريسية سوى مهارة فرشاته. أستاذ فنان لا يتعب من ترديد جملته(اللازمة) باستمرار. أستاذ آخر يحاول على استحياء أن يدلنا على الأقل من القليل من ومضة الفن. أستاذ يناكد أستاذ. أستاذة لا تعرف سوى التلصص بحياء على ارث العائلة الفني, ولا تدري ماذا تفعل بنا... كان بعضنا يحرث نفسه من اجل اكتساب القليل من الخبرة الفنية, لا التصور, وعشت (عشنا) وهم الخبرة.
هل أصبح تكريسنا مؤخرا لأيقونات العتق دليل هدايتنا في مسالك الحياة, أم وصمة, علامة فارقة. إن كان وصمة. فقد استثمرت خير استثمار. وان كانت علامة فارقة. فقد كرست بأخبث ما يكون. لكن, إن كانت لعنة. فمشكلتنا تكمن في عدم استيعاب مفاصل لعنتها, من اجل أن يتم لنا تفكيكها ومحو آثار تفاصيلها المدمرة. فماذا يعني أن تكون المرأة عورة في مجال الحياة والإبداع. وماذا يعني(كمثل) ان يكون موديل رسم أنثوي لصف الرسم النسوي, وموديل رسم ذكر لصف الرسم الذكوري, في معهد للفنون الجميلة. رحم الله ماضينا على كل عتقه. فقد كان أفضل من حاضرنا الماقبل(الماضوي) هذا. يا للعجب فقد تحجب درس الفن أيضا, ورجعنا لعتق(عصملي).
لم استطع أن أكون كائنا رقميا افتراضيا. فانا رجل عتيق. لكن الكثير من فن اليوم. ومن هواة فن اليوم رقميون. ميزة الفن الرقمي كونه فن أدوات مشاعة لكل الأجناس والفئات والأعمار. هو إذا جزء تمهيدي من المشروع الأعم للإنسان الرقمي الشعبي المستقبلي. ما صادره الفن الرقمي من الفن التقليدي بمدارسه ومذاهبه المختلفة ليس كثيرا, بما انه صور ثابتة, وصور متحركة, لا يهمها سوى اختراق الدماغ. ليس الا. أما أنا, ولكوني رجل عتيق, فلا يسعني الاعتماد على دماغي فقط. من اجل ان اصنع صوري.هذا هو شأني. وان يكن أيضا شأن آخرين غيري. ربما اختلفوا بعض الشيء معي. وربما وافقوني الرأي.
هل بإمكاني أن أكون افتراضيا, بعد أن تحول الافتراض الى أفعال عالم اليوم. اعتقد, وبما أني رجل عتيق, ربما استطيع, وربما لا استطيع ذلك. فالافتراض وهم ربما كان جميلا, فنتازيا, خارقا. لكنه اليوم بات تكنولوجيا. والتكنولوجيا حمالة أوجه( بندقية افتراضية للصيد, تحولت لقنص البشر), من الخليج عبرت الصواريخ الراجمة رقميا الى جسور بغداد فهدتها على رؤوسنا. وببلاغة افتراضات اقتراحات الجيل الرابع من الحروب تفككت ودمرت بنياتنا العمرانية والاقتصادية والاجتماعية. ضمن فضاء هذه الحروب الرقمية الكونية وألعابها الصورية الغير بليغة, تحولنا الى مجرد تابعين, لا مبادرين إبداعيين.
بعد كم المدارس الفنية الإبداعية الحديثة, وما بعد حداثتها الأولى. في أوج عطائها المتقدم. هل بإمكاننا ان نشطب على كل منتجها, مادام أصبح عتيقا, و بأقل تقدير, أن نتغاضى عن النظر إليه كما هو منتج فني أنساني لأجيال بشرية متتالية. أنا العتيق, لا استطيع أن أغض بصري عن التلصص على كل هذا الكم الهائل من الإنتاج الإبداعي. فن الديجتال, وفن الكومبيوتر, أو فن الميديا. وكوسائط فن عولمية تلصيقية ودادائية, لا توفر لي سوى الوهم. وبالرغم من كوني رجل عتيق, فانا أيضا أقر بشساعة الوهم الذي توفره لي الأعمال الفنية غير الرقمية. لكني اعتقد أيضا أنها الأقرب الى نفسي لكونها تشرك اليد والدماغ والعاطفة والحالة النفسية, والكثير من تفاصيل تأثير البيئة والأحداث الخاصة والعامة, والقدرة الأدائية الفردية لالتقاط عناصر التعبير وجمالياته, و استخراج العتمة من غياهبها.
بما أننا نعيش ونعمل وسط عالم رأسمالي. فهل يعني أننا رأسماليون في استثمار قدراتنا الإبداعية, بما ينسجم وأطروحات الثقافة الرأسمالية. بعضهم وكفناني ما بعد الحداثة, يقرون ذلك بفخر. بمعنى ما, هم لا يجدوا ذواتهم إلا فيما تطرحه القنوات الرأسمالية الميديوية من نتاج نخبتها الفنية. أنا الرجل العتيق. لا أود أن أكون صامولا في الماكنة الرأسمالية الإعلامية الفنية(بما أن غالبية هذا النتاج الفني يقع ضمن خانة الإعلام الميديوي. والباقي للتسويق الشعبي العولمي). بالتأكيد هناك إغراءات كثيرة تحت يافطة الحرية الثقافية ومنها الشخصية بالذات. لكنها تبقى حريات فردية, لا تتجاوز مفاعيل فرديتها المنظومة الاقتصادية الرأسمالية الجبارة لحفنة من أصحاب الثورة العالمية التي تتحكم باقتصاديات ومصائر مليارات من سكان عالم اليوم, دون التفات الى كل الآثار الكارثية التي لحقت بالكثير من العوالم, مثل عالمنا الثالث, وبلدي العراق بات حقل تجارب لتقنية تكنولوجيا السلاح الرأسمالي, ورهط إعلاميه الميديويين. فماذا نفعل بخارطة النحر والتهديم والحراب الطائفي المسترجع تكنولوجيا. ماذا نفعل بمشاريع التقسيم والتشتيت والتهجير. أليست هذه كلها أيضا من سلوكيات سياسات معاصرة ما بعد الحداثة, وآلاتها المعولمة. هل اترك كم هذا الغث المستخرج بقدرة سلطة الانتداب والاحتساب, وكم الخراب الإنساني والبيئي الذي أصابنا, من اجل أن امجد صناعة الحدث, من قبل, ومن بعد إطلاق قوته المدمرة.
العولمة الفنية ومن احل أن تكون شمولية التواصل, خطط لها لان تنتمي لمصدر عولمي واحد , أو مصادر موحدة. أنا الرجل العتيق لا يعنيني هذا اللون الواحد. فانا لا أزال احن الى معزوفات أقوامي السابقة على سطوح أختامهم الاسطوانية.. جدران معابدهم.. معمار زقوراتهم.. وحتى نقش أوانيهم البدائية. تلك الأرواح العتيقة تنظر لي بعتب. مثل نظرات المطويات الصينية والأحجية الأفريقية. فهل يراد لي أن اصدق ما يشاع عن موت اللوحة وموات الرسم بتقنياته المختلفة, لصالح الصورة الميديوية المفهومية ووسائلها الآلية. فان كان بعض من ذلك مقبولا بنسبة ما, في حدود إنتاج أعمال تحمل عناصر جديدة لمضامين ثقافية, سياسية, وبيئية إنسانية. و بما يترشح منها أحيانا, كأعمال تمس الحدث, أو تشير إليه. لكن, ليس كما هو كم العبث المحير والطاغي, الذي تكتظ به كبريات دور العرض الفني المعولمة. فان كان إنتاج الوهم كإيهام صرف, وتكراره الى ما لا نهاية. فانا عتيق بامتياز.
ربما تجاوزني الزمن. أو هو فعلا كذلك. فانا العتيق أحب آن المس نتائجي بيدي. بينما الكومبيوتر في طريقه لأن يسرق دوري ويلمس نتاجه الفني دون أن يترك لي دورا. حسنا ليسرق ما يشاء. فالآلة محكومة بسياق تطورها الى ما لانهاية. وكما نشاهد الآن من تدخلات اصغر الوحدات الفيزيائية على الإطلاق(النانو) في بناء سلوكيات واكتشافات جديدة في طريقها الى الاستقلال التام عن كل ما هو مألوف. فهل يعني هذا ذوبان أحلامنا وانصهارها بلا عودة. لتتشيأ وحدات نانو أيضا, وما يأتي بعدها من تجاوزات لا ندرك قدرتها الآن. أم سوف يبقى هناك حد فاصل ترتع فيه أحلامنا الشخصية وأفعالها الثقافية الفنية. أنا الرجل العتيق أبقى على ريبة من كل ذلك. لا بد أن يبقى احدنا عتيقا, من اجل موازنة معادلة الثقافة الفنية كما أحزر لقطيع البشر المنتشر على أطراف الكرة الأرضية. ربما يعاد للهامش دور جديد, كما هي دورة تاريخ الفن في فصولها العديدة. ربما يكون هذا الهامش طليعيا من جديد لإعادة توازن المعادلة الإنسانية المفقودة. أو التي في طريقها للضياع. ولكي لا ابقى, وتبقوا انتم أيضا عتيقين, ولو في حدود أحياز صغيرة.
كان التطرف حاضرا في الحركة النسوية(فيمن) وشخوصها الثقافية والفنية من الجيل الثاني الستيني بتبنيها للكثير من العلامات والسلوكيات الهجومية الشاذة ضد الرجل تحت ذريعة عدم المساواة بين الجنسيين. ذريعة مقبولة بحدود عدم التجاوز على حيزها الواقعي. ثم جرى انتقاد سلوكياتها من قبل العديد من الرموز الثقافية النسوية ذاتها. في وقتنا الحاضر وضمن سلوكيات ما بعد الحداثة الفنية والثقافية, يتم الترويج للجنسية المثلية كعلامة, ماركة مهمة للعصر الرأسمالي(ولنقل العولمي). أخيرا أنا الرجل العتيق, لا تعنيني الصرعات الجنسانية, ولا غيرها. ولا يعنيني أن اصنع منها أعمال فنية كجواز مرور لقاعات ومحافل فنية بشروط مسخ جنسي. أعمال ممهورة بصك القوة الشرائية للآلة الإعلامية الميديوية لصناع منجزات, أو أحيانا ترهات ما بعد بعد المعاصرة الفنية الحالية. فهل يعني ذلك أنني شاذ عن سلوكيات عصري, وأنا أرى وسائل الميديا البصرية تغص بنماذج مختارة منهم. عتقي لا يسمح لي بالخوض في ملابسات سلوكيات يراد لها أن تكون مشاعة وكاسحة. إذا لأبقى كما آنا عتيقا, يزداد أو يزدرد عتقا. في انتظار آن يتم تجاوز هذه السلوكيات, تفكيكا من داخلها, أو إعطائها الحجم المناسب, من دون التجاوز على ارث الآخرين وسلوكياتهم. و لأجل إعادة معادلة التوازن الإنسانية, لا قهرها عنوة.