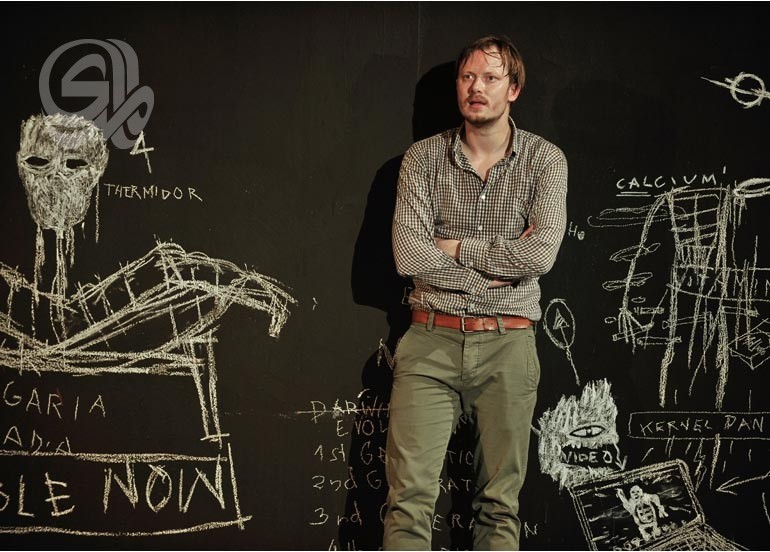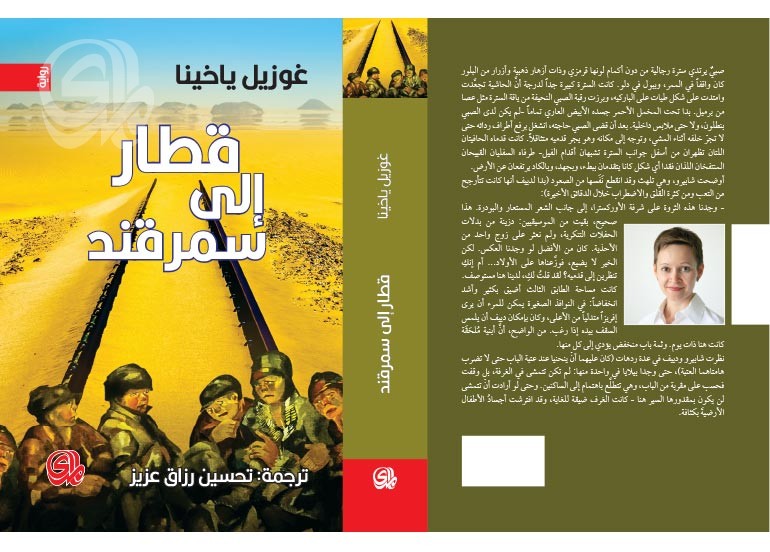ونحن نرى الحلم في إصلاح التعليم العالي في العراق، الذي بدأنا به سلسلة مقالاتنا، يتلاشى بعد أن لم نلمس ممن عوّلنا عليه تحقيقه، نعني السيد الوزير الجديد، شيئاً يُفعل من أجله، نواصل، ولكن بصعوبة ومعاناة، وقفاتنا عند ظواهر هذا التعليم السلبية المهيمنة عل
ونحن نرى الحلم في إصلاح التعليم العالي في العراق، الذي بدأنا به سلسلة مقالاتنا، يتلاشى بعد أن لم نلمس ممن عوّلنا عليه تحقيقه، نعني السيد الوزير الجديد، شيئاً يُفعل من أجله، نواصل، ولكن بصعوبة ومعاناة، وقفاتنا عند ظواهر هذا التعليم السلبية المهيمنة عليه. فكنا قد أشّرنا، في مقال سابق، بعض الأخطاء والظواهر السلبية التي تهيمن على التعليم العالي والمدمّرة له، كما هي على غالبية دوائر الدولة الأخرى، حين تسود وتشيع وتصير هي الأصل والقاعدة ويصير الخروج عنها هو الفرع والاستثناء، ذلك أن تطويقها من مسؤولين مصلحين يكون أمراً في غاية الصعوبة بدون ثورة في المسار البيروقراطي وفي الإدارة والأهم في القيادة المسؤولة عن ذلك، لأن التداعي، في هذه الحالة، يكون بشكل متسارع، وستتداعى بعده وبشكل متسارع أيضاً التجاوزات، وهو ما نظنه يتحقق فعلاً بكثرة الآن. وربما من هنا يأتي تساؤل أحد الزملاء وهو يعلق على مقال سابق من مقالاتنا، حين خاطبنا بالقول: "أنتَ وضعتَ اليد عل الجرح وأوصلتَ ما في قلوبنا، ولكن لا حياة لمن تنادي"، وإنْ اختلفنا جزئياً مع الزميل، إذ نرى أملاً، وإن كان باهتاً، في أن تكون هناك بعض آذان تسمع.
فبعد أن رأينا كيف أن المعايير غير القائمة على الأكاديمية والكفاءة والخبرة تُوصِل من هم غير مؤهلين للمناصب التي يعيَّنون فيها، إما لعدم حملهم اللقب الذي يؤهلهم لذلك، أو لعدم امتلاك الكفاءة، أو لافتقاد الخبرة، أو لافتقادهم لذلك كله، وفي جميع الأحوال يكون المسؤول، في النتيجة، معرقلاً لما يُفترض أن وظيفته يجب أن تُسيّره. وانتهينا، من جملة ما انتهينا إليه، إلى نتيجةِ أنّ الكثير من المسؤولين، رؤساء جامعات ومعاونين، أو عمداء ومعاوني عمداء، لا يعرفون الكثير من سياقات العمل كما يجب أن تكون، ومن ذلك أصول وتقاليد المؤتمرات العلمية، بل قد لا يعون أهمية هذه الممارسة الأكاديمية فتتحول عندهم إلى عمل روتيني بيروقراطي، بينما يحرص آخرون منهم على فعل ما يُرضي المافوق، فيفرضون من التعليمات للمشاركة في المؤتمرات، التي لا نظن أنهم يعرفون مبرّراً لها، ما لا يستطيع الراغبون في المشاركة تحقيقها دون المرور بطريق ملؤه المهانة والعذاب، وكما سنوضح بعضاً منه فيما يأتي، وبعد أن ندخل في معمعة هذا الطريق وما يصدر من هؤلاء المسؤولين حوله مما لا يُثبت إلا العبثية وعرقلة الراغبين في المشاركة. نقول هذا بمعزل عن قصدية ذلك أم عدم قصديته، فالنتيجة واحدة كما نرى.
وبدايةً، من المفيد أن نعرف أن ما تهيئه جامعاتنا لتتكرم به على أساتذتها من (تسهيلات) للمشاركة في أي مؤتمر، هو عبارة عن تخصيصات يومية متواضعة قد لا تسدّ، في أحسن الأحوال، أكثر من ربع ما يصرفه الموفد المشارك. والواقع أننا لنستغرب أن لا يشعر أي مسؤول بالخجل حين تُقارَن هذه المخصصات بما تقدّمه جامعات العالم لأساتذتها حين يشاركون في مؤتمرات. والأكثر مدعاةً للخجل هو ما يُقاد إليه الأكاديمي العراقي المشارك من إجراءات ومراجعات مهينة من أجل تكرّم رئيس الجامعة في نهايتها بالموافقة، وهي موافقة غير مضمونة بالطبع حتى وإن تحققت الشروط، لصرف (الخَرجية) البائسة. وهذه الشروط هي:
- المشاركة ببحث، وعليه لا ينطبق صرف المخصصات، بل ربما حتى الموافقة على حضور المؤتمر على من اقتصرت مشاركته على الحضور فقط، حتى ولو كسب من حضوره أسرارَ فلق الذرة.
- الموافقة الأمنية التي هي سابقة نعتقد أن لوزارة الأستاذ علي الأديب أن تفخر بأنها الوحيدة، في زمن الديمقراطية، التي استطاعت أن تفرضها على الجامعات.
- ولعل أغرب ما يتعلق بالشروط وباستحقاق (الخرجية) التي يتكرّم بها رئيس الجامعة، بعد سلسلة طويلة من مراجعات التعذيب والمهانة، هو أن هذا الاستحقاق لا يكون أكثر من مرة واحدة في السنة. لماذا؟ أمر تصعب الإجابة عليه، حين نفترض أن هذا الذي تستهدفه التعليمات المقيتة هو تطوير الأستاذ والكلية والجامعة والبلد، وعليه لماذا لا تكون المشاركة في أكثر عدد من المؤتمرات في العام ما دامت أية مشاركة تصب في دعم الأستاذ والكلية والجامعة والبلد؟
-وأخيراً موافقة رئيس الجامعة، وهذه لا يعلم إلا الله ما هي الشروط التي يفرضها هو شخصياً ليمنح (الخرجية)، فنحن نعرف مثلاً أن بعض رؤساء الجامعات يترددون ألف مرة في دعم التخصصات الإنسانية، بل قد لا يقتنعون بجدواها أصلاً.
ومن سخريات الواقع الأكاديمي، ونحن نستبشر خيراً بالعهد الجديد، أنْ يتواصل صدور التعليمات بشأن المشاركة في المؤتمرات، وكأن بعض المسؤولين لم يرتووا بعدُ من تعذيب الأساتذة، بينما يجد مسؤولون آخرون في المشاركة في المؤتمرات نوعاً من الترف الذي لا يحتاجه الأستاذ ولا القسم ولا الكلية ولا الجامعة ولا التعليم العالي ولا البلد. فها هو الإغراق المخجل للأستاذ بمطالب المعلومات الأمنية، التي أشرنا إليها، التي تكاد تتخطى، في تفصيلاتها، حتى ما كنا نعانيه في ظل النظام السابق.
ولا تكتفي التعليم العالي، أو على الأقل جامعة بغداد، بذلك بل تفرض على المشارك في مؤتمر أن تتم موافقة لجنة في الجامعة على البحث من حيث مطابقته مع التخصص، وهو ما لا نجد له مبرراً ما دامت المشاركة علمية، وهي كثيراً ما تتحقق فعلاً حين تكون المشاركة في تخصصات قريبة، وإلا فليوضّح من وضع هكذا شرطاً لماذا لا يُسمح أن يشارك أستاذ هندسة، مثلاً، ببحث يخصّ الجغرافية، أو أن يشارك أستاذ بايولوجي ببحث يخص النبات، أو أن يشارك أستاذ شريعة ببحث في الفلسفة، ما دامت الجهة الداعية تجد العلمية أو التميّز أو الفائدة أو الجديد في مثل هكذا بحوث؟ وحتى لو افترضنا صحة هذا الشرط، فإنه يعزّز، بالطريقة التي تفرضه بها الجامعة، الممارسة المركزية المقيتة حين تصادر اختصاصات القسم العلمي الذي يُفترض أنه هو، وهو فقط، مَن يقرر هذه المطابقة أو عدمها.
واضح أنه قد غاب عمن هم وراء هذه السلسلة غير المنتهية من العراقيل التي تُوضع أمام الراغبين في المشاركة في مؤتمرات علمية، أن مثل هكذا مشاركات يجب أن تُفتح لها الأبواب على مصاريعها بدون أية تعليمات أو شروط غير إعلام الجهة التي ينتسب إليها الأستاذ المشارك، ولا نعني بهذه الجهة هنا التعليم العالي، فلا شأن للتعليم العالي ولا للجامعة بهذا، بل الكلية والأهم القسم العلمي. هنا أتذكر أن أحد أساتذتي الذين عملوا في جامعات المغرب موفدين في سبعينات القرن الماضي أراد مرةً المشاركة في مؤتمر والتغيبّ بالتالي عن الكلية يومين أو ثلاثة، فتقدم بطلب موافقة مسبقة من قسمه وكليته، ليُفاجَأ برئيس القسم يقول له: حسناً لك هذا وإخبارك لنا يكفي، ولكن عليك أن تعلّق في لوحة الإعلانات إعلاماً للطلبة بعدم حضورك المحاضرات المعنية و(بس). والآن أتعرفون ويعرف مسؤولو اليوم (الأكاديميين) لماذا كان فعل المسؤول المغربي بهذا الشكل؟ بكل بساطة لأنه كان يتعامل مع صاحب صفة كبيرة هي (الأستاذية). أما لماذا يتصرف المسؤول العراقي إزاء حالة مشابهة، وبعد أربعين سنة من ذلك، بالشكل المناقض لتصرف المسؤول المغربي، فببساطة لأنه يريد أن يقول للأستاذ: أنت أستاذ، نعم، ولكن ليس لك أن تقوم بأي شيء إلا كما أريد أنا ومن خلالي وبكرمي وبتفضلي عليك.
وأتذكر أنني في تسعينات القرن الماضي، وحين كنت أعمل في جامعة الحسين بن طلال، وكانت أحدث جامعة أردنية حينها، فعلتُ الشيء نفسه فكتبت لرئيس القسم أطلب موافقة العميد على اشتراكي في مؤتمر، فكيف تتصورون كان رد العميد؟ حسناً، إنه خرج من مكتبه ووجّه سكرتيرته بأن تقوم بجميع المتطلبات المكتبية التي أحتاجها لأجل تسهيل مشاركتي، من طباعة وحاسوب وبريد، وهو في كل ذلك كان يجعلني أشعر بأنني متفضّل على الجامعة بمشاركتي العلمية باسمها.
والآن لنمرّ سريعاً بمقارنة بسيطة لما تهيّئه الجامعة للمشارك دعماً ومادةً، وعرقلةً بالطبع، بعد قطعه طريق المهانة والعذاب، مع ما تهيّئه جامعات بلدان أخرى منتسبيها من الأكاديميين قد يكون بعضها أكثر قدرة اقتصادية، كما هو شأن السعودية مثلاً، ويكون بعضٌ آخر مساوياً لمقدرات بلدنا، كما هو حال ليبيا، ويقلّ بعض ثالث قليلاً عنا، مثل الجزائر، بل قد يقل بعض رابع كثيراً عنا، مثل تونس والأردن. فهنا، وأزاء هذه المقارة، لا أدري مرةَ أخرى كيف لا يحس أي مسؤول بالخجل إذا ما عرف، ولعله لا يعرف، أن جامعات العرب والعالم تُحيط أساتذتها بجميع أنواع الرعاية والاهتمام والاحتضان والصرف، غير المحدّد أحياناً، إلا من ناحية التنظيم، دعماً لمشاركاتهم في المؤتمرات. فجامعات الجزائر وليبيا وتونس، مثلاً، تغطّي المشاركة السنوية سفراً أو إقامةً أو كليهما، بينما تغطي جامعات ماليزيا، لاساتذتها بمن فهيم الموفدون عراقيين وغيرهم، كلَّ تكاليف المشاركة، من رسوم وسكن ونقل وغذاء، بل للمشارك أن يسجل كل فلس يصرفه ليأخذه منها. وإذ تقوم غالبية جامعات تلك البلدان بهذا مع مشاركة واحدة في السنة الدراسية، تغطي الجامعات السعودية مشاركة الأستاذ في ثلاثة مؤتمرات سنوية تغطية كاملة.
وإذا كان هذا كله عن موقف الجامعة من المشاركة في المؤتمرات العلمية وغالبيتها عبثية كونها لا تقوم على العلمية، فإننا سندخل عملياً، في المقال القادم، في العملية الإجرائية كما ينساق في خضمّها الأستاذ الراغب في المشاركة، التي فيها سيمرّ فعلاً في طريق المهانة والعذاب.. وللحديث صلة.