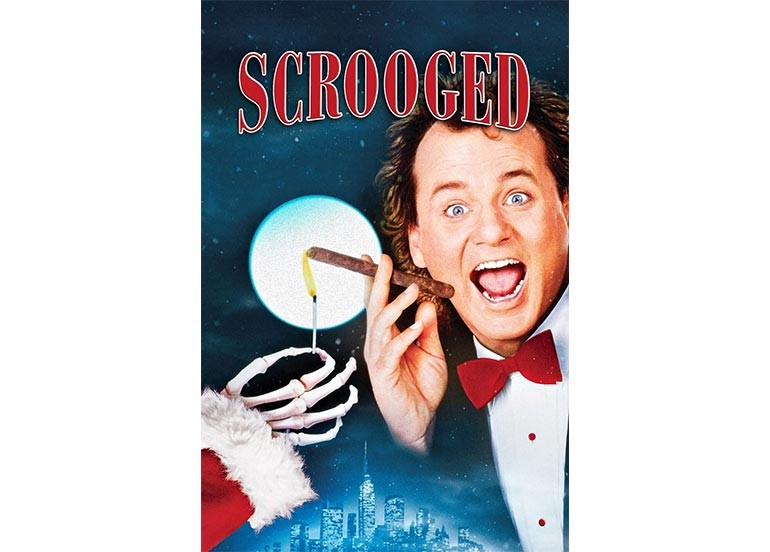لم يفكِّر الجيل الأول من المهاجرين العرب الذين يمّموا وجوههم صوب المنافي الأوروبية والأميركية بأبنائهم وأحفادهم، خصوصاً أولئك الذين اتخذوا من الخلاص الفردي حلاً لمشكلاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقطعوا حبالهم السُريّة التي كانت تربطهم بأوطان
لم يفكِّر الجيل الأول من المهاجرين العرب الذين يمّموا وجوههم صوب المنافي الأوروبية والأميركية بأبنائهم وأحفادهم، خصوصاً أولئك الذين اتخذوا من الخلاص الفردي حلاً لمشكلاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقطعوا حبالهم السُريّة التي كانت تربطهم بأوطانهم الأولى الطاردة لهم بسبب مطالبتهم بالحرية والكرامة والعيش الإنساني الرغيد.
تُرى، كيف يتعاطى الجيل الثاني أو الجيل الثالث الذي لا تربطه بالوطن الأول سوى معلومات باهتة عن الوطن سمعها في الأعم الأغلب من أهله وذويه وأصدقائه المقرّبين الذين ينتمون إلى نفس الوطن الذي انسلخوا عنه ذات يوم؟
ينضوي هذا الفيلم الوثائقي القصير تحت عنوان "عن بُعد" وهي تسمية شديدة الدلالة لأنها تُفصح عن نأي الشخصيتين الأنثويتين اللتين قررتا أن تستكشفا علاقتهما بالوطن الأصلي أولاً، وتعاينا طريقة تفكير الأهل بمصيريهما والمستقبل المجهول الذي ينتظرهما في بلدان المنافي. هاتان الشخصيتان اللتان تناصفتا دور البطولة في الفيلم هما اللتان تعاضدتا في العملية الإخراجية وأنجزتا فيلماً وثائقياً سلساً ومنساباً وخفيف الظل على الرغم من المرارة التي تنطوي عليها الكثير من الجُمل الحقيقية المُلتاعة التي تلامس المشاعر والأحساسيس الإنسانية لأنها نابعة من القلب.
لقد اعتمدت المخرجتان الدؤوبتان رانيا توفيق وليلى حطيط على تقنية "الفويس أوفر" الذي رافق اللقطات والمَشاهد المُصورة . ويستطيع المُتلقي المرهف أن يلتقط اللكنة الغريبة والمُستحبة وهما تتحدثان بلغة عربية تُحيل إلى أكثر من لهجة ومكان عربي. وما هذا بمستغرب فرانيا توفيق ولدت في لبنان وأصبحت بيروت مسقطَ رأسها وذلك بسبب هروب عائلتها من العراق وتوزعها في ثلاثة منافي عربية وأوروبية. أما المخرجة اللبنانية ليلى حطيط فقد ولدت في مدريد من أمٍ أسبانية وتوزعت هي الأخرى بين ثقافتين وحضارتين مختلفتين وإن تلاقحتا في حقبة من الحقب ذلك لأن الأمكنة المتباعدة جغرافياً لها قوانينها واشتراطاتها أيضاً.
يلامس هذا الفيلم أكثر من فكرة ولكن الفقد أو الخسارة هي الثيمة المُتسيّدة فيه خصوصاً إذا كانت المعنيتان بهذا الفقد شابتين لم تجتازا العقد الثالث بعد! تقوم هاتان الشابتان برحلة إلى البحر ليس للسباحة فيه أو السير على شواطئه الرملية أو الاستمتاع بجمالياته البصرية، وإنما لإثارة الأسئلة، وما الذي يعنيه هذا الكتاب الأزرق المفتوح لكل واحدٍ منّا على انفراد. والبحر هو البحر سواء أكان في بيروت أم في تونس أم في الدنمارك.
تشتاق ليلى، التي كانت تعيش بمدريد، إلى البحر كثيراً وتتوق لزيارته بين أوانٍ وآخر وكأنه كائن حي تمحضه حُباً من نوع خاص. وتتذكر أنّ صديقتها رانيا قد قالت لها ذات مرّة بأنها ولدت بالقرب من بحر بيروت ثم أمعنت في دقتها لتقول قرب عجلة اللونا بارك المعلقة في كبد السماء.
لا تتذكر رانيا من بلدها العراق سوى الحروب الكثيرة التي تندلع فيه بين أوانٍ وآخر، فما أن يخرج العراقيون من حرب حتى تلتهمهم حرب أخرى وتأخذهم في معمعانها سنوات طوال. تنقل لنا رانيا الأسئلة المحيّرة التي تدور في رأسي والديها، وعن طبيعة الحياة التي يمكن أن يقدِّماها لابنتهما الوحيدة التي ولدت في المنفى حتى وإن كان عربياً. وإلى أي بلدٍ يمكن أن تنتمي هذه الطفلة التي رأت النور في المنفى، وسوف تُوغل في غربتها وتتعدد عليها المنافي ولا تدري إن كانت تنتمي إلى بغداد أم بيروت، أم تونس أم كوبنهاغن؟ وعلى الرغم من هذا الاشتباك فلابد لها أن تقتنع بأنها ولدت في بيروت عام 1980 وأن لهذه المدينة التي احتضنتها حصة في ذكرياتها في الأقل.
لعل أجمل ما في الفيلم أن بيروت هي المحطة المكانية التي تتداعى في الذكريات، فليلى تتذكر أيضاً كيف أن أباها قد أخذ أمها الاسبانية في الرحلة الأولى بيروت وتركا حقائبهما في بيت ابن عم الوالد وقصدا الدسكو مسرعين، ومكثا خارج المنزل طوال الليل بينما كانت أمها حاملاً فيها وفي العام ذاته 1980 في ذلك الصيف اللبناني الذي دارت فيه عجلة اللونا بارك.
ظل العراق بعيداً بالنسبة إلى رانيا حتى لو زارته أكثر من زيارة خاطفة فإن ما يستقر في الذهن أو الحافظة البصرية لا يصمد طويلاً فلاغرابة أن تتساءل في نفسها إن كانت قلعة تلعفر، مسقط رأس أبيها، تشبه القلاع التي صادفتها في المنافي المتعددة؟ لا شك في أن المخرجة رانيا توفيق قد شاهدت العديد من المدن العربية والأوروبية ولكنها اختارت بعض ذكرياتها التونسية، ربما لأنها عاشت هناك أو اهتزت مشاعرها في تلك المضارب أو اكتشفت جانباً مخبأً من عواطفها لذلك استوقفتنا كمشاهدين واقترحت علينا أن نعاين هذه اللحظات التي عاشتها مع أسرة تونسية صديقة وجهت لهم الدعوة لزيارة منزلهم الصيفي كي يقضوا فيه بضعة أيام. ثمة صلة خفية فالأم في هذه العائلة التونسية من أصل عراقي ، الأمر الذي منح رانيا حرية التصرّف التي تُمنح في حقيقة الأمر لغالبية الفتيات اللواتي يعشن في البلدان الأوروبية لأنها جزء من الحق الشخصي الذي لا تعارضه سوى العوائل المتخلفة التي تسللت إلى هذه الفضاءات المفتوحة في غفلة من الزمن.
إذا أردنا أن نبحث عن الفكرة المهيمنة في هذا الفيلم فإن جزءاً منها يتواجد في هذه الجُمل البريئة التي قالتها رانيا في السياق البوحي الاسترجاعي الذي ذكرّتنا فيه حينما قالت بأنها كانت تركض ذات يوم بحرية حول المسبح، وكانت الأرض مبللة، وهي لم تتعلم السباحة لكنها وجدت نفسها في أعماق المسبح، وشعرت بأن الوقت يمضي بطيئاً ومملاً لكنها فجأة شاهدت جسد ولد شاب يقفز في المسبح فبدأت تتنفس هواءً نقياً من تحت إبط زياد، شقيق صديقتها الكبير الذي ميّزت رائحته وكانت خليطاً من عطر ومسبح وصيف. لقد أدخلت الراوية حاسة الشم وحرّضتنا على استعمالها إلى جانب الحاسة البصرية ونجحت رانيا في هذه المحاولة التي زاوجت فيها بين الشمّ والسمع والبصر .
لم تقدّم رانيا نفسها كثيراً فلقد سمحت لليلى أن تتحدث عنها وكأنها هي محور الفيلم وموضوعه الرئيس على الرغم من أن ليلى تستهل الفيلم وتختمه أيضاً. فمن خلالها نعرف أن رانيا لم تتعلم السباحة إلاّ في سن الثامنة والعشرين لكنها أصرت على التعلّم وأخذت دروساً في السباحة مع نساء كبيرات في السن وتعلّمت فن العوم.
تتصاعد النبرة البوحية عند رانياً فتكشف لنا عن تماهيها مع عناصر الطبيعة التي تتمثل بنسمات الهواء الرقيقة التي تداعب شعرها وبشرتها، والرمال الصفراء التي تدغدغ أصابع قدميها، وماء البحر المالح الذي يحتضن جسمها.
ربما تكون خاتمة هذا الفيلم دقيقة ومعبِّرة لأنها ذهبت بالفيلم صوب أفكار وأسئلة فلسفية مهمة قد تعتري كل واحد منّا حينما نواجه البحر ولا نعرف ما الذي ينتابنا حينما ننظر إلية في سويعات السكون أو الهيجان، أو في أيام الشحّ أو مواسم الكرم؟ إذاً، كلما تقف ليلى على ساحل البحر تسأل كل من ينظر إليه بماذا يفكر؟ غير أن إجابات الناس تتفاوت من شخص لآخر. فثمة شاب ردّ عليها بأنه يشاهد وحشاً، وأن أمها كانت ترى نفسها في البحر، بينما أجابها صديق آخر بأنه يرى الله! ثم تختم ليلى الفيلم بذات السؤال الذي توجهه إلى رانيا من دون أن نسمع أي جواب وكأنها تريد منا، نحن المتلقين، أن نتوقع هذه الإجابة ولا ننتظرها بكسل وخمول واسترخاء، فالمشاهد العضوي صانع للحدث السينمائي أو مشارك فيه في أضعف الأحوال.
وفي الختام لابد من الإشارة إلى أن المخرجة الدنماركية من أصل عراقي رانيا محمد توفيق هي خريجة مدرسة الفيلم الوطنية في الدنمارك. حصلت على شهادة الماجستير في الدراسات السينمائية من جامعة كوبنهاغن. أنجزت حتى الآن تسعة أفلام وثائقية وقصيرة نذكر منها "نوال"، "خالد"، "الليلة الأبدية"، "نسمة هوا"،" تركمان سولجه بيان الروح"، "على طول" و "تحت السماوات" الذي صُنف كفيلم وثائقي تجريبي إبداعي. حاز فيلم "الليلة الأبدية" على الجائزة الفضية في مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية عام 2006. كما فاز "نسمة هوا" بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الخليج السينمائي عام 2012. وفي العام ذاته أُختيرت كواحدة من المواهب الإخراجية العالمية الناشئة من قِبل مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية. تعمل حالياً كمدرسة زائرة في المدرسة الوطنية للسينما في كوبنهاغن.
أما المخرجة الدنماركية من أصل لبناني ليلى حطيط فقد درست السينما وكتابة السيناريو في جامعة سان فرانسيسكو. ولديها بكالوريوس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في الاتصالات السمع-بصرية. أنجزت عدداً من الأفلام الوثائقية والقصيرة أبرزها "أقلام من عسقلان"، "بسيطة" و "عن بُعد". أُختيرت عام 2011 كواحدة من المواهب الإخراجية العالمية الناشئة من قِبل مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية. عملت ليلى حطيط كمراسلة لقناة الجزيرة للأطفال. وقد سجلت حضوراً طيباً في عدد من المهرجانات العالمية أهمها الدوحة ترايبيكا ومهرجان أريزونا السينمائي الدولي.