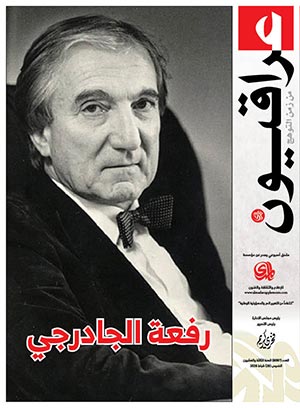فريدة النقاش
يجادل عدد من كتاب الأعمدة والسياسيين قائلين: الإخوان المسلمون هم جزء من قوى الثورة، ويرتبون على هذه المقولة الخاطئة من وجهة نظري مواقف سياسية تدعو إلى التوافق «بين كل قوى الثورة» باعتبار الجميع كانوا في الأيام الثمانية عشرة المشهودة رفاق طريق تعرضوا معا للقناصة المجهولين وإصابتهم معا قذائف ما يسمى باللهو الخفي، وسقط شهداء من كل الأطراف وبعيدا عن قول الدكتور «كمال الهلباوي»- وكان حتى وقت قريب- متحدثا باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الإخوان المسلمين هم آخر من التحق بالثورة وأول من خرج منها.. وقد خرجوا منها إلى كراسي السلطة.
أقول بعيدا عن هذه الحقيقة فإن الثورة هي بالتعريف تغيير جذري في الواقع القائم سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وبناء واقع جديد يتجاوز القائم إلى الأفضل والأرقى. فكل ثورة تلغي المجتمع القديم بتجاوزه وهي بهذا المعنى ثورة اجتماعية، وكل ثورة تلغي السلطة القديمة وهي بذلك ثورة سياسية، وكل ثورة تتجاوز نمط العلاقات الاقتصادية القديم وهي بذلك ثورة اقتصادية وإذا كان المجتمع الذي ثارت عليه الجماهير هو مجتمع إقطاعي فإن النمط الجديد الذي تنشئه الثورة هو رأسمالية، وإذا كان المجتمع الذي ثارت ضده الجماهير رأسماليا فمن الطبيعي أن يكون النمط الجديد الذي تنشئه الثورة اشتراكيا أو قائما على شكل من أشكال إعادة توزيع الثروة القومية على الأقل. فأين هي الثورة المصرية في 25 يناير من كل هذا، وأي مكان يمكن أن يحتله الإخوان المسلمون في مسيرتها التي تطلعت كما يجمع المحللون إلى بناء عالم جديد أفضل لخصه شعار العدالة الاجتماعية، لكنه لم يتحقق رغم تضحيات الثوار.
لكي نتوصل إلى إجابة علينا أن نحلل شعارات الثورة ومنطلقاتها، ونتعرف بشكل أفضل على القوة الاجتماعية الأساسية التي أطلقتها وأبقت شعلتها متقدة حتى هذه اللحظة رغم كل ما حل بالبلاد بعد انقضاء الأيام الثمانية عشرة المجيدة. وأبرز ما حل بالبلاد بعد ما يقارب العامين من اندلاع الأحداث هو الدور المحوري لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم من قوى الإسلام السياسي. فقد نجحت مبادرة الشباب في إزاحة «مبارك» وعدد من أعوانه، ولكن صعود الإسلام السياسي إلي السلطة على أنقاضه دفع بالبلاد إلى الخلف علي كل المستويات التي كان من المفترض أن تدفع بها الثورة إلى الأمام. وإذا توقفنا أمام التوجهات الثقافية التي انتشرت وسادت في ظل الإسلام السياسي سوف نجد أن القيم الحديثة والديمقراطية تتراجع وهي تصارع ضد كل ما هو قديم ومناقض للديمقراطية، وتتبنى قوى الإسلام السياسي هذه القيم باسم الدين وهي تسعي لفرض قضايا الهوية على المجتمع بديلا عن قضايا التقدم الاجتماعي الاقتصادي والتحرر الفكري وتحصين الحريات العامة. وتدلنا المواد المقترحة في صياغة الدستور على هيمنة هذا التوجه لتقييد الحريات باسم الدين وعلى نحو خاص حرية النساء، وحرية الفكر والتعبير. وهو التوجه الذي تعززه ممارسات عملية للمحسوبين على تيار الإسلام السياسي من إخوان وسلفيين ضد الفنانين والكتاب بدءا من اتهام أدب «نجيب محفوظ» بالفسق والمجون، مرورا بتحريك قضايا الحسبة ضد «عادل إمام» وجره إلى المحاكم بتهمة ازدراء الأديان في أعماله، وليس انتهاء بالهجوم الوقح علي الفنانة إلهام شاهين. هذا فضلا عن السعي لتكميم الصحافة عبر مجلس الشورى الذي تطالب القوى السياسية الرئيسية بإلغائه، ولكن الإسلام السياسي يبقي عليه حتى يظل أداته في قمع حرية الصحافة وتقييد حريات الصحفيين وذلك بادعاء أنهم ورثوه عن النظام السابق. وهو المنطق المتناقض مع توجهات الثورة وأهدافها وشعاراتها التي كانت قد أطلقت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». وهكذا فإن الثقافة التي يسعى الإسلام السياسي لنشرها هي بكل المعايير ثقافة الثورة المضادة التي يجري تأكيدها بالإبقاء على كل ترسانة القوانين المقيدة للحريات كما هي، بل والإضافة إليها. وثقافة الثورة المضادة هي التعبير عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الرأسمالي المشوه والتابع الذي ورثه الإسلام السياسي عن «مبارك» وأبقي عليه كما هو مع وضع لافته دينية متجاهلا أحد شعارات الثورة الرئيسية وهي العدالة الاجتماعية، مع توجه خاص لحل قضايا الفقر بإذلال الفقراء والتسول باسمهم من الأغنياء لكي يتصدقوا، وهي الآلية التي كانت قد لعبت الدور الرئيسي في حصولهم على ملايين الأصوات في الانتخاب باستثمارهم للفقر والمتاجرة ببؤس الناس.
إن الإسلام السياسي هو إذن العصا الغليظة للثورة المضادة وهو ما يعرفه ويقر به مواطنون بسطاء بعد تجاربهم المريرة. وعلى الذين يتحدثون عن الإخوان المسلمين باعتبارهم جزءا من الثورة أن يتوقفوا أمام كل هذه الحقائق لعلهم يراجعون أنفسهم فتصفو رؤيتهم وتتسق مواقفهم.