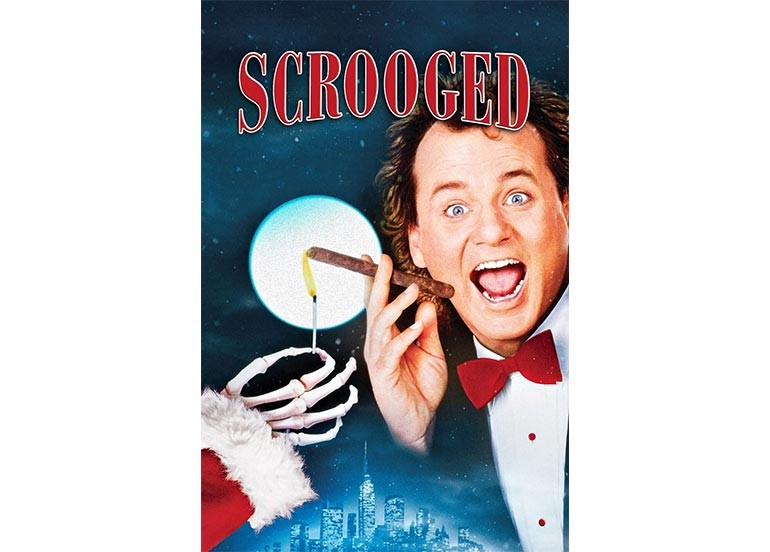كأنه يُكتشف من جديد؛ فبعد أن ظلّت أعماله لسنوات حبيسة أروقة المتاحف البريطانية العريقة، دوت في السنوات الأخيرة سيرة الرسّام الرومانسي الإنجليزي جوزيف مالورد ويليام تيرنر (1775 - 1851)، إذ أقيمت له عِدّة معارض استعادية لأشهر لوحاته وصل مداها إلى
كأنه يُكتشف من جديد؛ فبعد أن ظلّت أعماله لسنوات حبيسة أروقة المتاحف البريطانية العريقة، دوت في السنوات الأخيرة سيرة الرسّام الرومانسي الإنجليزي جوزيف مالورد ويليام تيرنر (1775 - 1851)، إذ أقيمت له عِدّة معارض استعادية لأشهر لوحاته وصل مداها إلى الصين عام 2009، حيث عرضت له نحو 200 لوحة، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها لوحات تيرنر في عموم الصين وآسيا.
وقبل أشهر، بعدما كان المخرج البريطاني المخضرم «مايك لي» قد أمضى نحو عامين في التحضير وإعداد سيناريو فيلمه الجديد، قَدّمَ أخيراً سيرة مستر تيرنر، مُسلطاً الضوء على مرحلة مفصلية في حياة فنان تشكيلي هو الأكثر شهرة في إنجلترا، حتى وإن أثارت آراؤه، وخروجه عن المدرسة الانطباعية الكلاسيكية حفيظة بعض الأوساط الفنية الارستقراطية.
في فيلم (MR. TURNER) لم يستغلْ المخرج سيرة فنان وتجربته بهدف قراءة عصره، أي النظر إلى الأشياء من خلال مقولة «الفنان في شرطه الاجتماعي»، كما فعل المخرج التشيكي«ميلوش فورمان» قبل سنوات في فيلمه الشهير (أشباح غويا - 2001)، حينما اختار أن يضع الرسّام الإسباني في سياق تحوّلات عصره سياسياً واجتماعياً، فأحاطه بحشد من الشخصيات المؤثرة التي ارتبطت درامياً بمصائر مشتركة، إن «غويا» الفنان المتمرّد الذي أنجز تخطيطات «كابريخوس» الجريئة في عصر مضطرب اتسم بالعنف والميول الثورية، لا يشبه شخصية «تيرنر» المحافظة التي يصعب للوهلة الأولى التوصل إلى معرفة مصادر إلهامها ومكامن عبقريتها وطبيعة قلقها الداخلي، لذا عمد الفيلم منذ بدايته إلى منح المشاهد إحساساً بالتشكيل الصوري الذي يمزج بين حالتي الاطمئنان والتوتر الكامن، حيث يقف الفنان في حقل فسيح، يخطط للوحته المقبلة، ثم يمضي مُتوغلاً في عالم يأسر حواسه، ويقود مخيلته.
"مايك لي" أدرك صعوبة مهمته السينمائية مع مواطنه، الرسّام البريطاني «جي ام دبليو تيرنر»، فعوالم الأخير قاسية وإبداعه مختلف، الأمر الذي اقتضى من المخرج رسم فيلمه بحس فنان تشكيلي متأنٍ، يبحث في اللقطات عما هو أبعد من اللعبة الدرامية، وهو أمر مُتوقّع من صانع محترف، أجرى تدريبات طويلة لضبط أداء ممثليه واستثمار أفضل ما لديهم، خاصة النجم تيموثي سبال، الذي قدّم شخصية الرسّام تيرنر بشكل باهر، استحق عن دوره جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي في دورة السنة الماضية.
على مدى أكثر من ساعتين، لا يلتزم المخرج بتقاليد أفلام السيرة الذاتية، فعلى سبيل المقارنة؛ لا يذكرنا الفيلم بأسلوب المخرج ميك دافيز في تصويره سيرة (مودلياني- 2004)، الذي يسرد مسار عواطف مودلياني وصداقته مع بيكاسو، وإنما عمد مايك لي إلى ولوج عالم تيرنر البصري والجمالي، بما يشبع طريقة اكتشاف جديدة.
في إحدى لوحاته، التقطت عينا تيرنر الحاذقة مشهد دخان متصاعد من قطار يشق طريقه وسط الريف الإنجليزي، كانت اللوحة مؤشراً على تمدّد عصر الآلة البخارية بكل ما مثله عصر التنوير الأوروبي والتقدُّم الصناعي من انطلاقة واعدة. تيرنر كان يعي الخيارات المتاحة وعمل بإصرار وثبات على بناء مجده الفني الذي سيقترن مستقبلاً بأرفع جائزة سنوية للفنون المعاصرة يمنحها متحف التيت بريتش بلندن منذ العام 1984. ورغم أنه ترفَّع عن الوظيفة الترفيهية للفن، مُعتبراً أن الفن يفقد بريقه حينما يكون مُتاحاً لعامة الناس، إلا أنه بقي مسكوناً بهموم الآخرين، يرصد مغزى تطلعاتهم وآمالهم من دون أن يظهر حساً حميماً بالمشاركة الوجدانية، فهو في مقابل ذلك، لم ينجذبْ للألوان البرّاقة، بل قاده إدراكه الحسي إلى النأي عن كل ما يشوّش الإحساس الطبيعي في اللوحة، ومرد ذلك عنده كون (الطبيعة) تمتلك القوة الخفية لإثارة الإعجاب لدى متذوقي الفن، فكانت أعماله تتخطى الوقوع في محاكاة المشهد الزائف أو الجامد، وهو الذي رهن فنه ببداهة حواسه التي قادته إلى مرتبة عبقري اللون دون منازع.
نرى في فيلم سيرته جانباً من الحياة اليومية، مجاله الاجتماعي المحدود، صلاته الواهية مع زوجته السابقة المتطلبة، حياته مع والده المسن، الذي كان مساعده في طحن الألوان ومزجها..ونعرف أن نخبة من الفنانين فقط تعرف طباعه الخشنة وتثمّن طبيعة نزوعه نحو المغايرة والتجديد في اللوحة التشكيلية. لم يكنْ تيرنر معنياً ببيع أعماله أو حتى تسويقها، وقد احتفظ بالعدد الأكبر من لوحاته في منزله، رافضاً العرض الذي تقدّم به أحد الأثرياء لشرائها دفعة واحدة. وقد اختار المخرج هذا الموقف ليعكس نزعة الفنان المستقلّة، وطبيعته المترفعة عن تقاليد عصره التي تحطّ من قيمة الفن بالمتاجرة الرخيصة؛ فقد ردّ مستر تيرنر على سؤال ضيفه الذي استغرب عزوفه عن بيع أعماله، أنه يُفضِّل تركها للشعب البريطاني.
رغم ذلك يخبرنا الفيلم بأن صاحب لوحات: صياد سمك، قلعة برغهام، حطام سفينة، المطر وقطار الغرب العظيم، وجر سفينة يميراير لمثواها الأخير.. فنان لا يذكره الكثيرون، عُرِفَ بطباعه القاسية وتصرفاته الغريبة وفشله الملحوظ في الحياة الاجتماعية. تجربة حياتية قاسية عاشها تيرنر، أسفرت عن انعدام الرغبة في التواصل مع بناته وأحفاده. لتبقى علاقته الودية مع والده الذي يعينه في ترتيب اللوحات وتهيئة إطاراتها ومستلزمات عرضها، وقد دفع حياته ثمناً لذلك، هي المساحة العاطفية التي يوليها الفيلم العناية الأكبر. إنها علاقة شغف وإعجاب متبادل بين رجلين ناضجين يدرك كل منهما أهمية الآخر وفرادته. تيرنر مهموم بتجديد عمل الفنان وتشرّب المشهد حسياً، ولو اقتضى منه ذلك القيام بسلوك مُتطرّف. ومثل من يبحث عن منارات هادية لتقويل اللوحة ومنحها طاقة غير مسبوقة، أصبح تيرنر معروفاً بشغفه بمناظر الطبيعة، هيجانها وسكونها، وتبدُّلاتها المستمرة.
في شتاء عام 1838 بلغ الهوس بصاحب لقب أفضل لوحة فنية لدى الشعب البريطاني في استفتاء أجراه المتحف الوطني للفنون «ناشونال غاليري»، إلى حدّ أن طلب من كابتن إحدى السفن أن يربطه على صاري السفينة، في ليلة شهدت مناخاً سيئاً، بحر هائج ومطر غزير، لحظات مريرة أتاحت لتيرنر بعد أن تخطى منتصف عمره، أن يصنع لاحقاً عمله المبهر «السفينة المقاتلة الشرسة» التي تُخَّلد أمجاد السفينة الحربية البريطانية التي استخدمها القائد العسكري الأميرال هوراتيو نيلسون ضد الأسطولين الفرنسي والإسباني في معركة طرف الغار BATTLE OF TRAFALGAR، وكانت سبباً في حسم المعركة عام 1805 على سواحل قادش جنوب غرب إسبانيا.
سيحتفظ المخرج مايك لي بأسبابه الخاصة التي دفعته لصناعة فيلم عن فنان مبدع له منزلته الخاصة في الثقافة الإنجليزية أسوة بشكسبير وديكنز واليوت ولورنس أوليفييه. لكن ما بدا جلياً هو أن المخرج حاول الاقتراب من عالم تيرنر عبر سرد سيري يُعالج مرحلة نضجه الفني ليتابع تحوّلاته العاطفية والفنية وعلاقته بالناس والأشياء، وتأثير ذلك في نشأة لوحاته، دون أن يغفل الفيلم الإطار الزمني العام الذي أعاد تذكيرنا بمناخ الفقر والبؤس في إنجلترا القرن التاسع عشر، كما بدت يوماً ما في روايات تشارلز ديكنز.