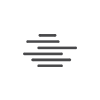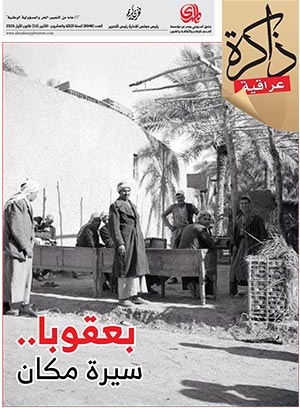من الملفت للنظر أن معظم الكتّاب المعُترف بهم، المُحتفى بهم عالمياً، كانوا مرفوضين ومحاربين في أوطانهم الأصلية: لم يُرفض البرتغالي، مؤسس الحداثة البرتغالية في الشعر، وصاحب الأنوات المنقسمة فرناندو بيسوا في مكان آخر مثلما رُفض في عاصمة بلاده، لشبونة. لم يُستغب الأسباني ومؤسس المسرح الشعري الحديث في أسبانيا، الشاعر الذي منح للغجر صوتاً، فديريكو لوركا في بلاد أخرى أكثر مما أُستغيب في بلاده إسبانيا، في نهاية الأمر قتلوه، بل الحرب الأهلية الأسبانية بدأت بجريمة قتله في غرناطة، حتى اليوم لا يُعرف القبر الذي أخفوا جثمانه فيه؛ لم تُشنع كتابات الايرلندي جيمس جويس، مثلما شُنعت في مدينته دبلن التي كان يمقتها حتى العظم، واليوم؟ يحتفون كل عام في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران بيوم "بلوم" وبطلته "الخليعة"، مولي، حتى أصبح يوماً قومياً، يطوف الايرلنديون فيه حانات دبلن يزورون كل الأماكن التي مرّ بها؛ وليست أقل من ذلك اللعنة التي حلت على روايات وقصص الإنكليزي دي. أج. لورنس في بريطانيا الملكية المحافظة، قالوا عنه أنه خليع! قائمة المغنين الذين لم يطربوا أحياءهم في الحقيقة طويلة. لا أقول ذلك عزاء أو رداً على الشتامين والإيديولوجيين في كل مكان، مهما كانت هويتهم ولون جلدهم، مهما كانت ديانتهم، أو مهما كان المرض الذي يعانون منه، والذي أغلب الأحيان هو مرض الدونية الذي يسحقهم يومياً، لأن هؤلاء في النهاية هم ناس فاشلون، حاقدون وعاطلون عن الأدب، يرددون مقولات "نقدية" مثل الببغاوات لا يفقهون منها شيئاً، بل أن ما أريد قوله أن ليس المهم للكاتب التفكير بـ "داخل" و"خارج"، إنما الأكثر أهمية هو التفكير بشرط الإبداع. ففي النهاية أن المبدع منفي حتى وهو في بلاده، وأن الكتّاب المنفيين الذين يكتبون بالعربية خصوصاً العراقيين بإمكانهم تقديم "أوطانهـم" من خلال إنجازهم الإبداعي، خاصة وإن الكتابة بحرية أصبحت في البلدان الناطقة بالعربية وبلدان الشرق الأوسط عموماً، يمكن أن تكلف المبدع حياته، منذ صدور الفتوى ضد سلمان رشدي، ومنذ طعن صاحب النوبل نجيب محفوظ في رقبته بسكين، كانت عمياء لحسن الحظ،، وإلى تهديد التركي أورهان باموك بالموت، والقائمة لا تنتهي، أما في العراق فبعد ديكتاتورية البعث أصبحت مافيات الطوائف والعنصرية هي التي تحرك بوصلة إتجاه الكاتب، بل قادت إلى صمت العديد من الكتاب الشباب الذين بدأوا بكتابات رواية أو روايتين بعد 9 نيسان 2003 ليصمتوا الآن لأسباب مختلفة، إذا لم تكن لأسباب انتهازية أو ارتزاقية. فبالتالي تظل أجمل الأوطان ليست تلك التي تفرضها أيديولوجيا سلطة ما، إنما هي تلك التي نجدها في كل رواية أو قصيدة أو لوحة جميلة. وهذا ينطبق على الإبداع في أي مكان وزمان.
وذلك ما عرفه الغجر، فهم منذ سرقتهم للمسامير التي أريد صلب المسيح بها، منذ ذلك اليوم وهم مطارَدون، يدفعون ثمن احتفاظهم بالمسامير التي لن يعطوها لأحد، يرحلون من مكان إلى آخر. ذات مرة سألت ـ في ندوة في بوخارست ـ رئيس المجلس العالمي للغجر السؤال التالي: " كل الأقليات عندما تتحدث عن حقوقها تصبو للانتماء لقومية كبيرة تتحدث لغتها في بلد مجاور، إلى ماذا يصبو الغجر؟"، نظر إلي، ابتسم، وضرب برقة على القلب: "نحن ننتمي لهذا الوطن". جواب لا يخلو من الرومانسية لكن هذا ليس بغريب لأن لا وطن ولا منفى لكلمتي "وطن" و"منفى" في لغة الغجر. ربما تُشكل هذه الرؤيا أحد مصادر الإبداع، وربما تتزود منها شرايين دم الكتابة، أليس كذلك؟
عن النفي الداخلي ومحنة الكتّاب
نشر في: 11 أغسطس, 2015: 09:01 م