"لاشيء يمنع السعادة كذكرى السعادة – اندريه جيد"
-1-ساخطا عرقلت كل ما يجعلني أصدق موت رياض غير المتوقع ، ثم تخيلت امكانات اخرى لاستمراره في الحياة . قلت لصديق إنه ما كان ليموت لو أن المستشفى كان في بلد متحضر . لقد مات بانتظار الدكتور وجهاز انعا
"لاشيء يمنع السعادة كذكرى السعادة – اندريه جيد"
-1-
ساخطا عرقلت كل ما يجعلني أصدق موت رياض غير المتوقع ، ثم تخيلت امكانات اخرى لاستمراره في الحياة . قلت لصديق إنه ما كان ليموت لو أن المستشفى كان في بلد متحضر . لقد مات بانتظار الدكتور وجهاز انعاش عاطل ، فقمت بتأبينه كواحد من ضحايا سماسرة 2003 . ردّ الصديق قائلا : لا فائدة .. لقد مات !
المطلوب إذن أن أسلّم بالأمر نهائيا ، أن لا أرفس الأبواب وأقلب الموائد والكراسي ، أن لا أبقيه حيا ولو للحظات ، ولا أذهب الى تكهنات تواصل عملها بالضد من هذا الموت الصريح المعلن .
كان صديق عمري . اتصلت به مرتين بعد سماعي خبر موته . هاتفه رنّ وتخيلته نائما لم يسمع . والآن بعد أن بات الجميع يصدق موته ، أراني ألتف على مشاعري وأضع احتمالا يعرقل التصديق السهل : لو كان رياض قاسم مشغولا بشيء يمنحه الوقت والاهتمام ، أو حتى مؤمنا بفكرة ملهية ، أو اختار أن يغادر الوطن مع المغادرين ، ما كان للموت أن يصرعه بسهولة. فالانشغال يبعدنا عن الموت ، يخفينا من أن نراه وجها لوجه ، فكأنه لا يرانا الا بالأقدار التي لارادّ لها كما في حادث خارجي عنيف.
إذن ما كانت هناك قوة قادرة على صرع رياض المشغول اليقظ ، وسألوم قوة ما أوقفته عن الشغل واليقظة . إنني أمنح رياض امكانية أخرى افترض أنه امتلكها إزاء المرض والموت ، إلا أن النتيجة المأساوية تضرب قلبي ، وتقفز أمامي ، فإذا بي أفكر بطريقة رياض اللامبالية بالحياة التي أضعفت يقظته ، وأفقدته ما يشغل نفسه به .
هل سأبدأ في لومه بعد أن لمت الآخرين؟
يخترق الموت افتراضاتنا عن الحياة . هناك سرعات متفاوتة للوصول إلى نهايات حزينة لا تقبل الشك . لعبة الحياة نفسها بكل ضجيجها تعلن عن حركة موت قادم .
والحال لا أنا ولا هو فكرنا بالحياة بجدية . كنا نخجل من روح الجد والاهتمام المبالغ فيه ، وقدمت لنا سنوات التسعينات تبريرا إضافيا . فيما عدا عمله الناجح الذي تبخر فيما بعد ، فقدنا في تلك السنوات تدريجيا أي مشروع جدي سوى أن تمضي الايام ونحن كما نحن . وبما أنها مضت تماما مثلما اعتدناها فكان هذا يكفي لكي نظن اننا نعيش . كانت لدينا ثلمة من قصيدة تي. اس. اليوت نتعزى بها : أين هي الحياة التي ضيعناها بالعيش؟
في أواخر التسعينات ، وفي بداية قرننا البائس هذا ، كان الوطن يذهب بأقدامه إلى المجهول ، وكنا نغطي مخاوفنا بالشرب اليومي والقراءات العارضة والانهماكات العائلية مع شعور باليأس واللاجدوى . فقدنا الحماس والحمية ، وكانت الحياة نفسها تجري اختزالات هائلة في كل شيء ، المسافات ، الاهتمامات ، الافكار ، المزاح ، السعادة . كان الجاد والهازل منها يتساويان . لم نعد نملك غير تشاؤم العقل الصريح والمحزن ، والبحث عن مادة تقتل الوقت وتخدّر الارادة .
وبقدر ما كنت أنا ورياض ندرك أن هذا هو طريق الموات ، وأن مجتمعا بكامله يمشي عليه متجها الى الكوارث ، كان وحده يبني أملا ومسرعا يهدّه مع الشتائم ، مواصلا المشي على نفس ذلك الطريق بأقدام ثابتة. كانت نزعته الاستهلاكية تمتص ما يتوفر من الإمكانات ، غير مبال بالتبعات والنتائج الساخرة . في هذه السنوات نفسها كتب رياض روايته الأولى ضمّنها مساخر شفوياته كلها ، مقاوما موته وموت حكاياته ، وكالعادة استهلك مجد لحظاته المنقضية لكي لا يكتب رواية تضم براهينه عن الموات الوطني الكبير . كان يقاوم بحكاياته المكانية زمنا كارثيا . كان الموات يُعاش ولا ينقضي ، عام ، كلي ، غبي ، ينتج انتظارات ثقيلة ، وضحايا اعتصرهم الحزن.
اثناء حرب 1991 وبعدها بقليل كتبت انا روايتي ، وقرأها رياض مخطوطة ليكتب عنها ملخصا وضعنا الفريد المفارق ، فبينما يكتب الاذكياء بالقطارة ، يملؤنا عديمو الموهبة بروايات لا قيمة لها . لكأنه يكتب عن مشكلته. إزاء ذلك لم يستغرب ابدا انني لم انشر روايتي الا قبل نحو شهر من الحرب الكارثية في 2003 . كنت قد قمت بتسويف هو الوجه الآخر للعدمية.
كنت أحدث رياض دائما وبخوف عن صديقنا المشترك منعم حسن ، قارئ مقاييس الكهرباء الوطنية وأكبر مستهلك لكهربائيته البشرية . استهلك منعم كل شغفه القديم ، وحيويته الضاحكة ، وخبثه ، وثقافته ، وكل اللذائذ العادية والمحرمة ، فإذا به يقف إزاء فراغ نفسي وعاطفي وجها لوجه ، عبَر عنه بالصمت والعراك مع عائلته.
في "الأحمر والأسود" لستاندال هناك لحظة يصبح فيها الشاب "جوليان سوريل" فارغا بعد أن استهلك شبابه بسرعة ، مستبدلا ماضيه وتسلقاته بحب دفع به الى المقصلة . أفضل ما فعله هو أن يكون شهيدا على دروب حرب طبقية باردة . وماذا كنا سنفعله نحن بالمقابل ؟ لسنا مثله نتسلق ، أكثر وعيا منه كي نميز بوضوح بين أكاذيبنا واضطراراتنا . كنا بالطبع نكذب وننافق ، لكن ليس على دروب الصراع الطبقي المعقد بأزمانه البطيئة المتعددة الأوجه ، وفي مجتمع متبلور الطبقات ، بل على الدروب التي احتلتها سلطة عدائية قطعت الطريق على أمانينا وحرياتنا وحطمت لنا صحتنا النفسية والعاطفية . كنا نجن خفية ، ننافق خفية ، نكذب ، نعاقب أنفسنا ، ونستهلك أرواحنا.
مبكرا جدا بات عقلي لا يستوعب الكثير مما كان الزمن يدفعه الى الخلف . كنت أنسى الأرقام والتواريخ والأسماء ، وتاريخ قراءاتي هو نفسه تاريخ نسياني لها . ما إن أفكر أثناء الكلام حتى أنسى الشيء الرئيس منه ، مثلما نسيت مرة اسم القطار فرحت أصفه بيدي ، فقبض رياض على الترجمة الصحيحة وصاح : يا الهي .. هل هذا قطار؟
كان رياض قاسم بعكسي يتذكر تفاصيل لا يحتاجها ، من مثل أسماء الأطباء والخياطين والمطاعم والمشارب والمقاهي والدرابين والأزقة والمشروبات المسكرة وباعة السمك . لعله احتاج هذا كله في عمل روائي كبير تلتقي فيه التجربة الشخصية بخطوط الأنماط والأشكال الاجتماعية ، وكنت أحدس أنه قام بتمارين مثل هذه ، إلا أنه ملول ، يتحرك جسده كثيرا على المقاعد التي يجلس عليها . كان ينتمي الى الزمن الاجتماعي مختارا ايقاعه بما يلائم تحركه الدائم ما بين احتياجاته العادية وشهياته المتجددة التي تحتاج الى التنقل على مساحة واسعة ، فضلا عن حجج التأجيل وانعدام المزاج.
بيد أن قوة ذاكرته تعود إلى أنه نمّى اهتماما ثابتا بالعالم الخارجي ، كتفاصيل غير مترابطة ، ربطها بمجاله الحسي واحتياجاته. من هنا كان يتثبّت من الأمكنة والأسماء والمذاقات كل يوم تقريبا ، مدركا تحولاتها واستقلالها مفضّلا انطباعه الأول . كانت هذه الحالة تحتاج إلى حضوره الكامل ، وتحسين وعيه بالأشياء . من هنا كان يخرج من البيت في الفجر دائرا في مدينته التي راحت تستيقظ ، داخلا إلى أحشائها الضيقة التي شهدت طفولته وصباه ، شاهدا على أن كل شيء في موقعه ، منتهياً عند عربة تقدم اللحم المشوي .
كنت على عكسه أنشغل بنفسي لا بالأشياء ، وأكتفي بالنسبة للأخيرة بمرور غير متقصد ، بلا موعد ، ولا ثبات . ما زلت لا استطيع الاخلاص لطريقة ، وتربكني قضايا السلوك والتوقعات منه . كان سلوكي باطنيا لا يُرى ، هو خليط من خجل وخوف من رفع الكلفة والجبن من التورط . هذا ما لاحظه عني الصديق عبد الرحمن طهمازي ، واصفا إياي بأنني فارغ سلوكيا ، وأظن أنه محق . كان رياض لا يعبأ بتأمل أصدقائه من الداخل ، وأحكامه عنهم تأتي إليه ولا يذهب هو إليها. كان واقعيا ساحرا يرانا – في - الخارج بأوضاعنا الحقيقية ، كأنه يقبض علينا بجرم مشهود يثير سخريته وألعابه الكلامية. وكان يحكي بالتواريخ والحيثيات عن أعمدة رأي منافقة ينتظر أصحابها المكافأة ، ويراقب المتظاهرين بالتبتل وهم يأكلون بشراهة أو تزداد نقودهم . كان ذكاؤه البراغماتي يقبض بسهولة على صحفيي الخردة من الكذابين والوشاة .
في أيام صباه ، أيام الصراع في أن يكون ذاتا ، توله رياض قاسم بالمذاقات والأطعمة التي قرأ عنها في الكتب. لم يدرك إلاّ عندما استطاع أن يختبر أساطيره ، أن كلا من اللغة والأطعمة قد يخيبان الآمال . وكان قد أصيب بخيبة أثارت الضحك من اكتشافه أن حساء كرنب ديستويفسكي مصنوع من اللهانة التي يكرهها ، وأن اللحم المقدد اللذيذ لا يفرق كثيرا عن "الكص" . وكل لذة تتبعها خيبة .
ولهه ذاك مدعوم بالفقر ، وناتج عنه ، وسّعت أفقه قراءات أحالته الى العالم الكبير الذي يصنع أطعمة لها اسماء غريبة . كانت قراءاته مفيدة ايضا في جعل شعوره بالنقص ليس مأزوما بل جزء من قواه . في ظروف العراق ليس سهلا تخطي الفقر ، لكن من السهل التحايل عليه والظهور بمظهر المتذوق ، والباحث عن التجارب . في النهاية كانت خيباته من الأطعمة والواقع والكتب تصنع موائد كلام هي أكثر حيوية من الأطعمة والمذاقات والكتب كلها.
في كل الأحوال كان رياض يتكلم أكثر مما يأكل . لقد جمعتني عشرات الموائد معه فإذا به يأكل أقل مني . كان خجلي يعذبني إذا ما أسرفت ، أما هو فكان يخفي بصخبه الطفولي فشله في بلوغ ما تخيله أو ما تمناه . حقيقة كانت شهياته مكلفة . وهذا التقدير خاص باحتراساتي ، إذ كان بعكسي مأخوذا بالمسرات وليس بتكاليفها . لم أكن مثله أسافر الى الناصرية من أجل صحن تشريب ، أو إلى البصرة من أجل وجبة صبور ، أو إلى صحن كباب في الفلوجة . لا أقصد هنا التكاليف المادية للسفر ، بل تكاليف نفسية وذهنية تتعلق بالاقتناع والصبر والاستعداد والهمة .
فيما بعد أدركت على نحو مضمر أن هذا التراكب بين الأطعمة والأمكنة شكّل جزءاً حيوياً من تقاليدنا الوطنية ، واكتشاف مجالنا الحيوي المدني ، كما أن هذا الجزء الحسّي عوّضنا عن غياب فولكلور شعبي حي. ولسوف تختلط هذه التركيبة فيما بعد بثقافة ستينية فهمت على نحو ما مقاصد "الأغذية الأرضية" لاندريه جيد بوصفها إعلاءً للحسّ والحساسية في المعركة ضد تجريدية الأفكار والمبادئ . وكان رياض قاسم قد التهم هذا الكتاب كوجبة رئيسية عدة مرات.
في أيام شبابه سحرته الأمكنة التي تشتهر بأطعمة ممتازة ، وكان يتحدث عنها كأنها أعجوبة ، كما كان يعرف أسماء المطاعم الشعبية كلها التي تقدم الباجة في بغداد ، إلى أن بات "العش الذهبي" في أرقى أماكن بغداد يقدمها بطريقة بورجوازية محافظا على نكهتها الشعبية .
لكن الزمن الاجتماعي العراقي لا يشبه أي زمن آخر ، فهو لا يديم طرازاً ولا مطبخاً ولا دروشة حسّية . لقد خضع للسياسة على نحو شاذ ، فكانت المهن الصغيرة الحاذقة تموت قبل أن تنضج وتتفرع ، والأمكنة تتغير ولا نعود نعرفها ، والموائد تنقلب على أصحابها . الأطعمة ، المذاقات ، الروائح .. كلها راحت تتبدل خلال بضع سنوات ، وكنا نتغير ونضحي أكثر حزناً ويأساً واقتناعا بالقليل . كان هناك هازم لذات أشنع من الموت يتربص بنا ويهزمنا . وبغمغمة خاسر كبير بات رياض مثلي يقنع بكباب "الاخلاص" في شارع المتنبي الذي واصل بعض الشيء على نفس المذاق ، لكن ابا عبدو في شارع ابي نواس الذي أحببنا طعامه وشخصه كان قد اختفى ، فخسرنا الى الابد افضل مخلمة وأشهى قطع سمك بزّ في الوجود .
-2-
تصنع البدايات مداخل صغيرة تشبه جملة موسيقية افتتاحية تضيع بعد لأي ، لتظهر شذرات والتماعات منها يمتصها العمل الكلي . هو اليتيم الذي ربته امرأة ظهر في صباه كأنه يستحق الدلال ويطالبنا به كحق مشروع . حسب رواية صدّقتها عنه أنه ذهب الى البصرة وطلب من سعدي يوسف أن يشتري له آلة موسيقية روسية اسمها بلالايكا . ليس هذا جنونا بل دلالا ، والشاعر حتى لو لم يكتب أروع أشعاره يمتلك أسبابا تستحق الفخر وحق طلب اللامعقول .
أنا الاخر ربتني امرأة الا أنها ملأتني خوفا من الخارج ، ولسنوات طوال لم أرغب حقا بشيء أكثر من الاختباء. إن مدخلي السري هو الانسحاب ، ومدخله السري غزو القلوب والأماكن والليالي.
عندما تعرفت عليه عام 1957 ، ربما قبل ثورة تموز ، في مقهى "اكرم" عند تقاطع شارع الامين وشارع الجمهورية المفتتح حديثا ، بدا مشروعا لشاعر ، وكان يعرف جميع الحيّل البغدادية لإثارة إعجاب أصدقائه وإرباكهم بذخيرة كبيرة من المعلومات والشعر المحفوظ ، إلا أنني نجوت من حيَله ، فأنا ولدت وأنا لا أحب الشعر العربي ، ومضى كل هذا الزمن دون أن أجد تفسيرا مقنعا، وأظن أنني قاومت الوضوح في هذا الشأن. لم احب كذلك الإلقاء الشعري الذي تتحول فيه الكلمات الى صوت مطاط ، كما نسيت حتى المحفوظات المدرسية . لم نتفاهم على مستوى التذوق الفني للشعر ، لكن أحببنا معا الرواية الامريكية . كنا صبيين يمكن أن نتخاصم من الوهلة الاولى بسبب اختلافنا في الذوق . لكن لم يحصل هذا أبدا ، ولم يحصل طيلة هذه السنوات أن تخاصمنا او اختلفنا على مبادئ . ما المبادئ؟ ههنا سر صداقتنا الطويلة والعميقة : المبادئ تتبع التجربة وليس العكس . إنها نصيحة علم يعارض الدوغما الاجتماعية – السياسية . هذه الدوغما كما عرفها العراق هي تحطيم الواقع باسم المبادئ . النزعة الإرادية للقوميين مقابل النزعة الموضوعية الاستسلامية للشيوعيين. (لم يكن لدينا في ذلك الوقت "رساليون" يتصفون باللصوصية) . الصداقة الحقة تتبع التجربة في مداها المتظافر مع قوانين الحياة . أن تحب ولا تفترض شرطا ، أن تعرف كفاياتك ، تتواضع ، تفخر أمام جماعة اهتمام مشترك وتحذر من الاعتدائيين ، لن تؤذي أحدا في نوبات الطيش ، لا تستخدم احدا أكثر من قدراته ، لا تتعالم ، لا تكن معلما ، لا تكن جادا أحمق ، تعلم فن الاشارات واللطائف : كان هذا زادا ، يزيد أو ينقص ، يتلون مع الحياة ويقوي أواصر صداقتنا .
الحقيقة لا أعرف حتى الآن سر تخليه عن كتابة الشعر . لم أسأله . خجلت ولم أرد منه توضيحا يحرجه . والحال كنا أنا وهو متحررين من أي تكريس ثقافي . أنا نفسي انقطعت عن الكتابة لسنوات طوال . كنا نكره الاحترافيين والتكريسيين ، وأعترف كنا يائسين . أخمن أنه انقطع عن الشعر لانه مبكرا استدخل نزعة نقدية عدمية وحسا بلاجدوى الثقافة . ومثلما انقطع عن الشعر لم يتحول الى كاتب صحفي جاد يبني توقعات عن نفسه . كان يعيد انتاج عقله بالقراءات بينما أضعف إرادته وعطّلها متعمدا في الكتابة . كان قارئا ذكيا يلتهم الكتب الادبية وحدها ، ومعاييره النقدية مرتبطة بالذوق والاحاديث المختلطة بين جماعة صغيرة من الأصدقاء وليس باستخدام أدوات المناهج النقدية. أستطيع القول إنه ظل يحب شعر سعدي يوسف وشعراء المهجر ، كما عشق لغة عربية سمحاء استدخلت آرامية مسيحية مدهشة عن طريق ترجمة الاناجيل . إزاء ذلك صنع أصدقاءه كما يريد ، بلا توقعات عويصة ولا تقديم أي عرض عن حياته الداخلية ، وحده الوجود اليومي المثابر ، الصاخب ، المملوء بحكايات كانت تنضب بمرور الزمن ، هو ما كان يطلبه ويبادله .
على الرغم من ذكائه العملي المختبر ، سيقترف رياض قاسم خطأ كبيرا لم أفهمه ولم أستوعبه ، بإصداره صحيفة ، هو الذي كان يخرج من مواقع صحافية مجروحا . من أوحى له بنجاح هذا المشروع؟ لا ادري . كنت بعيدا عنه ، وقد زيّن لي المشروع بمجموعة من الكتّاب الذين وعدوه بالتعاون . الحقيقة اعتاد رياض أن لا يتحدث بما يفكر به ، بل بما يفعله في التو ، كما كنت لا أعارضه مباشرة بل اكتفي بالاستماع اليه ، وكان هذا يرضيه . اعتمد رياض على سمعته كصحافي محترف ، ولست أدري كيف غابت عنه حقيقة أن صحافة 2003 الناجحة جزئيا والفاشلة لاسباب موضوعية هي مشروع قائم على توفر رأسمال كبير تموله السياسة والاوليغارشية الجديدة . تظهر هذه الحقيقة سافرة عند الانعطافات السياسية وتوزيعات المال السياسي القائم على نهب الدولة ، أو صداقة دولة ما جارة او بعيدة ، أو إعلانات سلطة منقسمة ما بين الطوائف.
ما الذي يستطيعه صحافي غير صبور ، ويريد الفوز ، غير أن يغطي تكاليف خسارته من عرق جبينه ومن خبز عائلته ومن حسّه بالمرارة والضياع؟
أبدا لم أفكر بلومه ، ولم يفتح معي هذا الموضوع ، بيد أنني عرفت أنه شعر بالخسارة والمرارة ، وخلفت التجربة عنده أوجاعاً نفسية عميقة.
في سنواته الأخيرة كان يصفي الماضي بموازاة ما كانت سياسة 2003 تغتال الماضي والمستقبل وتقطع الجسور اليهما . راح يعيش بطالة داخلية مقرونة بضياع أي هدف ، كما عانى من كآبة صريحة مليئة بالنكد والشعور باحتقار زمانه. والحياة تكفلت بالباقي ، فبناته الثلاث تزوجن ، ورحلت اثنتان منهن مع أحفاده ، فلم يبق له الا سماع وجيف قلبه وحيدا. كنت أسأله بالهاتف عن أخباره وأحواله ، فكان يجيبني بسخرية : خراء !
لم يفكر رياض بالموت ولا استعد له ، حتى أنه أهمل تناول دواء ضغط الدم والادوية الأخرى . لم يحدث أن تحدث عن الموت ، لا بحتميته ولا بمواعيده المتوقعة وغير المتوقعة ، كان يدفن أصدقاءه في النهار ليعود ويشرب نخبهم في المساء ، ساردا كل القصص والمواقف المضحكة عنهم . وكانوا يواصلون حياة الموائد في حكايات كثيرا ما يضيف اليها المزيد من النكهات والمبالغات السردية .
في الشهر الثالث من هذا العام عندما أخبرته بأنني أصبت بحالات ذعر استدعت مراجعة طبيب نفسي. شتمني وقال : منذ متى أصبحت مترفا؟
نصحني بالشنابس الدانماركي وفعلت ، بيد أنني واصلت فزعا يجعلني أفر من مكاني الى زمن نفسي مقطوع عن الزمان والمكان . رياض لم يسألني عن الظواهر والأسباب .. لعله وجدني أستطيع تشخيص حالتي وأسميها ، وبهذا أستطيع أن اتجاوزها. لو سألني لأخبرته أن الماضي راح يهاجمني . لكن سيكون هذا موضع سخريته ، لأن الماضي دائما يهاجمنا ، والآن هو يهاجمنا بقوة لأن زمرة 2003 حطمت النسيج المكاني والزماني المتبقي من ماضي الدولة العراقية الذي أطّر حياتنا . حسن ، سوف أخبره بأسباب محددة ، فأنا دائما أفكر به إذا ما نسيت اسما أو وجها ، فقد كان بمثابة ذاكرة ثانية لي : "يو اس بي" بشري بطاقة خزن هائلة يستوعب تجارب أعمارنا وأسانا وفشلنا ومرحنا بموازاة زمننا الوطني من حيث هو مكان . لكنه بعيد ولا أستطيع أن أسأله . ما كان يعرف أنني ما أن أفشل في التذكر حتى تتسارع نبضات قلبي وأشعر بصدري متخشبا، ثم يغيب الموضوع ، ولا يبقى غير الذعر ، فامشي في شوارع لا أعرف مداخلها ولا مخارجها ، مسرعاً كأنني مطارد ، وألم حاد يقسمني الى قسمين نظرا لاصابتي بالفقرات . استقل باصا ، فأشعر بالاختناق ، أنزل ، أمشي ، أصعد الى باص آخر ، ويتكرر الامر ، محاولا أن أقمع خيالي ، وصراخي ، وأمتنع عن جسارة التفكير مرة وعن العبور إلى مناطق الجنون مرة ، متعمدا السير مع حيطان حمراء لعلها تمتص فضائي الداخلي الملوّع الحزين . ومن ذا الذي يسمعني في كوبنهاجن ؟ من ذا الذي يرد لي ذاكرتي؟ وما الذي سأفعله بنفسي إذا ما تقطعت الجسور كلها؟ حتى رياض ردّني الى الاضطرار بوصفه خيارا وحيدا ، فهو أفضل من الموت البطيء في وطن يحكمه سماسرة . قال : وما الذي ستفعله في بغداد؟ ابق .. ابق .. ابق!








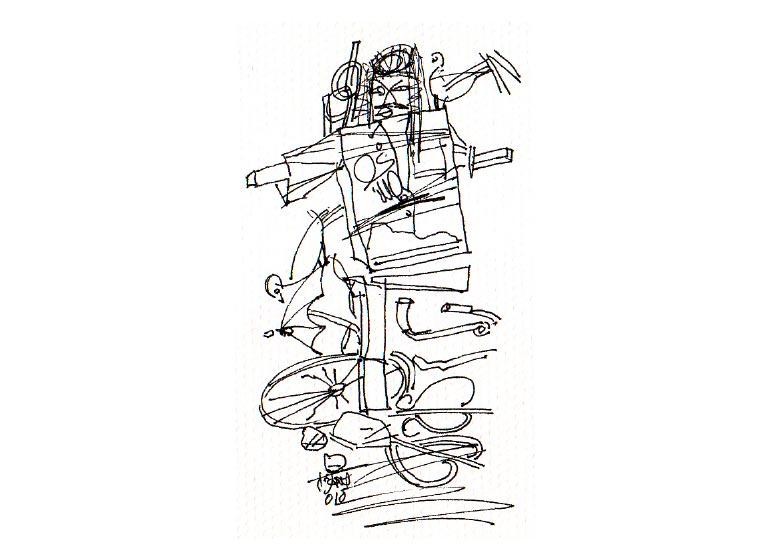


جميع التعليقات 2
حسين
حسين فلاح اني شاعر قديم لتمنه ان اعيش في بلظ لمن
حسين
حسين فلاح اني شاعر قديم لتمنه ان اعيش في بلظ لمن