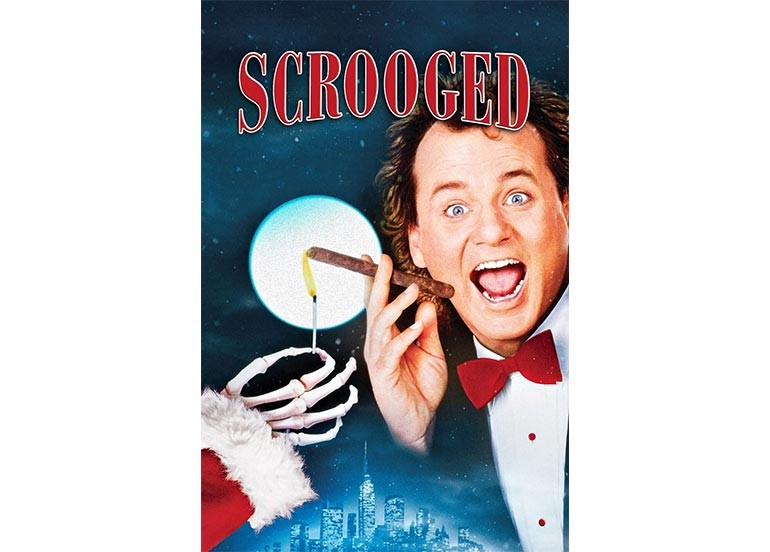في صيف 2011، كنت أحضر كل يوم جلسات محاكمات جرائم القتل في السنترال كريمنال كورت، في اولد بيلي لندن، في إطار بحث لروايتي الجديدة. في المحاكمة، امرأتان قتلتا رجلا. الثلاثة جميعهم مدمنو كحول، اجتمعوا، بعد يوم من الشراب، في شقة واحدة من الامرأتين،
في صيف 2011، كنت أحضر كل يوم جلسات محاكمات جرائم القتل في السنترال كريمنال كورت، في اولد بيلي لندن، في إطار بحث لروايتي الجديدة. في المحاكمة، امرأتان قتلتا رجلا. الثلاثة جميعهم مدمنو كحول، اجتمعوا، بعد يوم من الشراب، في شقة واحدة من الامرأتين، وفي ساعات الصباح هاجمت المرأتان الرجل بالضرب ومن ثم طعنا بالسكين حتى الموت.
في المحكمة تركت الوقائع، كما كانت مقدَّمة، قليلا من الشك حول ما حدث حقيقةً؛ عُرِضت مشاهد الجريمة في المحكمة حيث يمكن لخبير ببقع الدم أن يخبر المحلفين بأي وضع كان الضحية ممددا طبقا للمسافة التي تناثر بها دمه على الجدار. المسأله هي، هل كانت المرأتان مذنبتين بالقتل على حد سواء. كان المحلفون مدفوعين باتخاذ قرار بهذه القضية على أساس القانون؛ أي فعل، أثناء الهجوم، قاد الى موت الضحية، ومن الذي اضطلع به وهل كانت المرأتان مشتركتين بالمسؤولية؟ لكن هناك سؤال آخر قد يكون له، أو لا يكون، نفس الجواب: خطأ مَنْ كان فعلا؟ القانون هو واحد، لكن اين تكمن المسؤولية الأخلاقية؟
عبْر العصور، كانت للروائيين وكُتّاب المسرحية والسيناريو الحرية في استكشاف هذه الأسئلة الأخلاقية، وعرْض كيف أن القانون والأخلاق يصطفان احيانا ويكونان أحيانا في نزاع مباشر. شدّدت " شعريات " أرسطو على أهمية المعاناة الجسدية والخطر – السجن، أو الحكم بالإعدام في بعض البلدان – الذي يجد المتهمون أنفسهم فيه. تحدث هو أيضا عن التعاقب المنطقي، لحدث يكون نتيجة مباشرة لحدث سابق. لكن العنصر الأكثر حسما، كما يراه هو، كان الـ ’’ peripeteia ‘‘ [ التغيّر المفاجئ في الظروف أوانقلاب في الحظ ( في المسرح اليوناني القديم ) ]: انقلابات القدر.
يلخص ’’ التغيّر المفاجئ ‘‘ تعاقبا لمحاكمة جريمة قتل، مثل تلك التي شهِدتُ الحكم فيها، ربما أفضل من أية عبارة أخرى. الملخص الافتتاحي لمحامي الادعاء يفترضه الكثير من المراقبين بأنه فتح وغلق القضية. وظيفة الدفاع هي إسقاط هذا الافتراض؛ وهكذا، مع استدعاء كل شاهد وتقديم كل قطعة من الأدلّة، لمحامي النقض الحق في تحدي رؤيتنا. دراما المحكمة هي ليست انقلاب قدر لشخصية واحدة متفقة مع حكم المحلفين، سقوط مفاجئ لفرد في المعنى الأرسطي: هي مئات من انقلابات أصغر تنتشر في خط القصة مثل ملاقط على حبل غسيل.
في وصفه لفكرته عن شكل قصصي متقن، كان سيروق لأرسطو أن تكون تحت تصرّفه أمثلة من درامات محكمة عصرية. جمال هذه الدرامات، وما يجعلها واجبة القراءة أو المشاهدة، هو أن أي نظريتين عمّا حدث هما في تعارض مباشر: هناك طريحة متبوعة بنقيضة لكن لا يمكن أن يكون هناك جَميْعَة [ في الديالكتيك الهيغلي ]. هو مذنب او بريء.
" إثناعشر رجلا غاضبا " هو مثال واضح عن الشدّ بين هذه القوى المتعارضة. دراما ريجنالد روس كانت ظهرت أول مرة مسرحية تلفزيونية في عام 1954، ثم مُثِّلت على خشبة المسرح، وفي عام 1957 تحوّلت الى الفيلم الكلاسيكي الذي أخرجه سدني لوميت ومثَّل فيه هنري فوندا دور المحلّف الذي يواجه مجموعة من أقرانه المتحمسين للحكم على المتهم – شاب متهم بقتل والده في نوبة غضب – بكونه مذنبا... في خلال دقيقتين من غير زيادة أو نقصان. أثناء مسار الساعة والنصف التالية، تطرح شخصية فوندا شكّا معقولا حول الأدلة الواحد بعد الآخر، عاكسا افتراضات كل واحد من الرجال، حتى يصلوا الى قرار حكم مخالف.
" إثنا عشر رجلا غاضبا " هو دراما محكمة غير عادية لأنها تحدث تقريبا بالكامل في غرفة المداولة للمحلفين – نحن نعلم القليل عن خلفية المحلفين ولا نكتشف أبدا ما إذا كانت المهارات المقنعة للشخصية الرئيسية أفلحت في إنقاذ شاب بريء من الكرسي الكهربائي أو حررت قاتلا أثيما. أغلب الأمثلة تعطينا خلفيات أكثر: فيلم "لقتل الطائر المحاكي" غالبا ما يشار اليه باعتباره دراما محكمة، لكن في الرواية لا تبدأ محاكمة توم روبنسون قبل منتصف الرواية ولا تحتل سوى بضع صفحات. ما يحدث قبلها، ويتبع، هو تصوير هاربر لي [ نيل هاربر لي، كاتبة الرواية ] لمدينة صغيرة في الجنوب تكتنفها العنصرية المستوطنة في أميركا الثلاثينات. في قاعة المحكمة نفسها، إذ يصارع اتيكوس فينش لإثبات براءة رجل متهم ظلما، فمن الواضح أن ما هو مرهون بالنتائج بالنسبة لروبنسون ومحاميه هو رمزي لما هو مرهون بالنتائج لجماعة أوسع. الظلم نفسه خاضع للمحاكمة، وسيئ الطالع توم هو ضحيته البريئة.
بالنسبة لأي روائي أو كاتب دراما معاصر يبني دراما محكمة، هذه هي المشكلة الأولى: الباكستوري [ تاريخ أو خلفية شخصية رئيسية ]. حَصْر موقعك في قاعة محكمة وتحديد إدراك جمهورك على ما يحدث فيها هو مقيّد بما يسمعونه، شأنهم شأن المحلفين. الجمهور العصري يريد المزيد. يريدون أن يعرفوا أين يتجه تعاطفهم، يريدون الحقيقة، برغم زمجرة جاك نيكلسون الشهيرة على توم كروز في " بضعة رجال طيبون " ( 1992 )، (( أنت لا تستطيع معالجة الحقيقة! )) لدى الكاتب الاختيار. هو، أو هي ، يمكنه إمّا أن يكون له تمهيدا طويلا للمحاكمة، كما فعلت هاربر لي، أو أن يبدأ عمله في قاعة المحكمة، مع مشاهد فلاشباك لما حدث ’’ حقا ‘‘.
الإمكانية لتغيّر مفاجئ في الظروف – ناهيك عن التورية الدرامية – هي واضحة، لكنها تضع على مَشاهد الفلاشباك مسؤولية خطيرة إن كان عليها في الوقت ذاته أن توفر باكستوري كنوع من البوح الذي يقع ضمن نطاق الحدث الحاضر لدراما ما. مسلسل البي بي سي " المتهم" يتناول هذه المقاربة، فمع كل حلقة قصة تامّة بذاتها حول شخصية في قفص الاتهام – تخبرنا مشاهد الفلاشباك ما الذي أدّى به أو بها الى أن تكون هناك. بحلول وقت النطق بالحكم، يكون المشاهدون على الطريق الصحيح ليقرروا ما سيكون عليه هذا الحكم.
المشكلة التقنية يمكن التغلب عليها، لكن ثمة مشكلة أكثر ضغطا تعيّن للكُتّاب حدودهم: حل العقدة. هنا يصبح واضحا أن استخدام التغيّر المفاجئ له عواقبه: إن كانت الدراما التي تكتبها سلسلة من الانقلابات – أو الكشوفات من أي نوع – فعليك أن تقرر عند أي نقطة يجب أن تتوقف.
كل أشكال القصّ لها علامة استفهام معلّقة فوقها. في قصص الحب، السؤال هو، هل سيجتمع المحبان في النهاية أم لا؟ دعْ ذلك معلّقا وسوف لن يكون قارئك سعيدا. في دراما المحكمة، يمكن أن يكون هناك حكم واحد فقط من اثنين: مذنب أو بريء. الويل للمؤلف الذي يحاول أن يترك كتابه بنهاية مفتوحة لحظة وقوف رئيس المحلفيين للنطق بالحكم.
القدوات الكلاسيكية تتطلب بداية، وسط ونهاية – أن العدالة تتحقق وتُعاقِب الآلهة المذنب بشكل ملائم: أوديب يجب أن يُعمى، وعلى يديه هو. الجمهور العصري يعجبه انعطاف في الحكاية وحكم بالذنب أو البراءة لا يُنجَز من دون انقلاب واحد نهائي. في " الحافة المثلَّمة " ( 1985 )، يتجاذب المشاهد الشك، مثله مثل محامية الدفاع التي تؤدي دورها غلين غلوز، حول براءة جف بريدجز: هل قتل زوجته في جريمة قتل طقوسية رهيبة؟ حالما يُعلَن الحكم ببراءته تُقدَّم الينا تلميحات كثيرة جدا حول شرّه الباطني كي نشعر أن كل شيء صار واضحا. كان كاتب السيناريو جو ايشترهاس ماهرا الى حد كافٍ ليعطينا انعطافا.
في فيلمه الكلاسيكي عن الحرب الباردة، " الجاسوس القادم من البرد "، قدَّم جون لوكاريه حل عقدته الدرامية في محكمة المانية غربية حيث يعلم الجاسوس المحرر من الوهم (اليك ليماس) بحقيقة مهمته خلف جدار برلين. (( ثم فجأة، بصفاء ذهن رهيب لرجل ظل مخدوعا طويلا، فَهِمَ ليماس المكيدة المروِّعة كلها. )) تلك اللحظة سارّة للغاية لأنها ليست فقط اللحظة التي يدرك بها ليماس أنه استغِل من قبل المخابرات البريطانية لإنقاذ عدوّه الرئيسي مانت، لا لتدميره – هي أيضا اللحظة التي يدرك بها القارئ هذا.
أن يتيح المرء لنفسه أن يكون منعطفا بطريقة وبأخرى بالتغيّر المفاجئ هي واحدة من المتع العظيمة لدرامات المحكمة. لكن هناك أخرى، متعة أكثر غموضا. في مسرحية باري كولينز " حُكْم " ( 1974 )، جندي سوفييتي نجا من الحرب العالمية الثانية يقف وحيدا على المسرح، راويا قصته، المبنية على قصة حقيقية، عن كيف تم حبسه هو ورفاقه على يد الجنود الألمان في قبو دير بعيد وتُرِكوا جائعين حتى الموت. في الحياة الحقيقية، تم اكتشاف الجنود، لكن فقط بعد أن بقوا على قيد الحياة عدة أسابيع من الحجز في الظلام بإجرائهم قرعة على مَنْ الذي سيُقتَل بينهم ومن ثم يؤكل من قبل الآخرين.
أعدِم الناجون رميا بالرصاص على يد جيشهم هم، مخافة أن تُضعِف حكايتهم من معنويات الجند، لكن في المونولوج القهري لكولينز، لديه شخص واحد بقى حيا ليروي للمحكمة قصة ما حدث. إذ تمارس حكايته الرهيبة ضغطها، يدرك الجمهور أنهم القاضي والمحلفون، ويقول الجندي في النهاية: (( رفاق، أنا أنتظر حكمكم. )) دراما كولينز تجعل من المتعة المستحقة للشجب، الحقيقية والقابلة للجدل، لدراما المحكمة ظاهرة للجمهور: الحاجة الإنسانية الى أن تكون ميّالىة لإصدار الأحكام. استمتاعنا بشكل القصة المتقن يخفي متعتنا الأكثر شرّا: أن نكون متفرجين على حادثة واقفين خلف شريط الشرطة الحاجز، أو قارئين صحف الاقاويل، ننأى بأنفسنا بعيدا عن المأساة الحقيقية، هازين رؤوسنا، آمنين ومعتدين بأنفسنا معا.