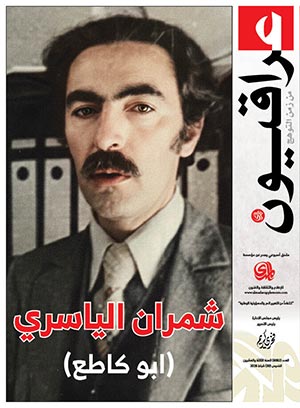حدثني جامعيّ عراقي نبيه يكتب أطروحة دكتوراه في الفن، طالباً رأيي المتواضع، أول شيء ذكّرته به هو الفارق بين (الحداثة modernty) مفهوماً و(التحديث modernisation) تجديداَ تقنياً وشكلياً, وهو تفريق أقيمه منذ بعض السنوات عبر دراسات ومقالات عديدة. خاصة وهو يمسّ الفن في العالم العربيّ. دون جدوى، إذ أن التحديث هو الذي يقوم مقام مفهوم الحداثة التي تصير إشاعة مثل بعض الظواهر والأسماء.
إذا كان (التحديث) التقنيّ في بدايات القرن العشرين العربيّ مفتتحاً مأمولاً متخيَّلاً لـ (لحداثة) مفهوماً، كأن تتحول الكتاتيب إلى مدارس وتتعبد الطرق وتُهجر أساليب الإنشاء المُسجَّع لغير المُسجَّع وتدخل الآلات الميكانيكية والبخارية بدلاً عن الحيوانات، فلقد ظل هذا (التحديث) حتى اليوم يحلّ مفهوم (الحداثة) التي تطوي وتتجاوز (التحديث). ما زال التحديث رديفاً واسع النطاق للحداثة. وهنا إشكالية حقيقية.
كان مأمولاً أن الدول العربية الطالعة مع استقلالها نهاية الأربعينات - الخمسينات وأوائل الستينات أن تُؤسِّس مشروعاً (حداثياً) ليس فقط على مستوى (تحديث) البني والهياكل والمشاريع ولكن على مستوى الوعي (وخلق) إنسان مختلف الثقافة والسلوك والمقاربات. النتيجة أن أكثر من نصف قرن من الاستقلال برهنت أن (الحداثة) التي كانت تدعو إليها تلفيقية، وأنَّ الإنسان بقي يتعاطى العالم وفق نسق ثقافي قديم بلبوس (التحديث) الشكلي، وبأول الهزات صعدت الأصوليات وصوّت الناس على نطاق واسع (للماضي): مشروع الاستقلال كان،أصلاً، مشروع (تحديث) وليس مشروع (حداثة).
جميع إصلاحات الدولة الوطنية المستقلة - ولعل مصر أهمّ نماذجها - وجميع ادعاءات الاشتراكية والعدالة الاجتماعية وإنشاء طرق المواصلات والجامعات - ولعل العراق أهمّ نماذجها ولعل إنشاءات الجنرال فرانكو تفوقها - وما يتوسط ذلك في التجربة البورقيبية المتشبثة صراحةً بالعلمانية، لم تكن لتهتمّ جوهرياً إلا (بالتحديث) وليس (بالحداثة) حيث لا يستوي، في الأقلّ، قمع الإنسان واضطهاده مع مفهوم (الحداثة). نحن ننسى غالباً أن تلك الأنظمة أنشأت السجون والمخابرات بقدر إنشائها للمدارس والمستشفيات. في الثقافة أيضاً وبشكل بارز.
أكدّ استخدام المال النفطيّ هذا الفارق الجوهريّ بين (الحداثة) مفهوماً و(التحديث) تقانةً وشكلاً. لن يتناطح عنزان حول ذلك. لا يكفي أن تشترى أجمل السيارات الأوروبية والأمريكية وتزعم أنك (حداثي) بينما تغطّي زجاجها بالأسود لكي لا نرى حريمك. لن يكفي أن تقيم أوتوستراد محمد القاسم في بغداد بينما تنهمك بـ (دعوة إيمانية) لأغراض مريبة منها تهجير وتقتيل الناس، أو تنتصب في بلدك أعظم الأبراج وناطحات السحاب والمولات بينما نعرف دون أدنى شك أنك من أعظم داعمي داعش ومبرقعي النساء بالبرقع، وأن فكرك أبعد ما يكون عن مبادئ الحداثة. من أجل حل هذه المفارقة تعالت الأصوات إلى القول أن لا وجود لمفهوم الحداثة هذا وعلينا استبعاده نهائياً، أو تمييعه قدر المستطاع.
ها هنا يقبع مأزق بعض مثقفي هذه البلدان، الخليجية اليوم خاصة: مفاهيمهم تنتمي إلى الماضي والتقليديّ، وإنْ بمحاولات "استمزاجٍ" ومصالحةٍ تلفيقية مع (الحداثة). لا يكفي أن تكتب قصيدة النثر للبرهان على خلاف ذلك.
لذلك، على المستوى الشعريّ المرهف نفسه أيضاً، ثمة جمهرة من الشعراء العرب الذين يقبعون في (التحديث) التقنيّ والشكلانيّ وليس في جوهر مفهوم (الحداثة). أليس الجميع، من رُعاة وبُداة وريفيين وقبليين وقرويين، هم من يتشبث اليوم بشكل قصيدة النثر، بينما نعرف أن مرجعيات بعضهم مشكوك بمعاني (حداثتها) على المستويات الوجودية والاجتماعية والعرفية والممارساتية كلها؟. أنا تحديثيّ على مستوى الشكل، إذنْ أنا حداثيّ؟
سيكون المرء سعيداً لو وقع إثبات خلاف ذلك.
ما الفارق بين (الحداثة) و(التحديث)؟
نشر في: 26 فبراير, 2016: 09:01 م