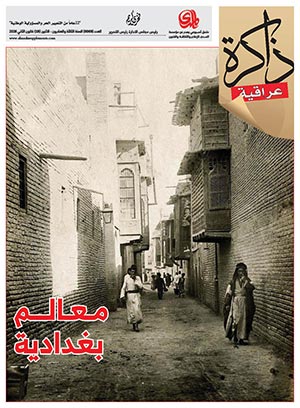لماذا الشيطان دون غيره؟ ومن ذلك الشيطان الذي يأتي مبعوثا من القرية لأجل استقباله وإكرامه وحسن ضيافته؟ فقدومه في نهاية الأمر سيوقع الفرقة بين أهل القرية في العُرف، ويؤجج الصراع العقائدي والفكري الذي شكله الحارثي بين شخصيتي رجلين متناحرين في الوجهة، بي
لماذا الشيطان دون غيره؟ ومن ذلك الشيطان الذي يأتي مبعوثا من القرية لأجل استقباله وإكرامه وحسن ضيافته؟ فقدومه في نهاية الأمر سيوقع الفرقة بين أهل القرية في العُرف، ويؤجج الصراع العقائدي والفكري الذي شكله الحارثي بين شخصيتي رجلين متناحرين في الوجهة، بينهما تقارب بحكم أنهما يدوران في نفس الدائرة ومرتبطان ببعضهما البعض منذ زمن طويل بحكم بشريتهما، كثيرا التفكير في دروب التباعد والانفصال إلا أنهما عاجزان عن فعل ذلك بحتمية المكان الذى يسعى كل واحد منهما دائماً نحو الفكاك منه.
هكذا تذهب مسرحية "ولم يك شيئا" للمؤلف السعودي الشاب إبراهيم الحارثي، إلى حكاية قرية مضطربة وقلقة لم يعرف إليها الاستقرار طريقاً.. سكانها شخصيات تكافح من أجل العيش بين مناصر لفكرة قدوم الشيطان ومعارض، تتوزع بين (شحاذ) يتسول المال من أجل حفرة من لا شيء.. و(بائع خضراوات) ميوله لا تذهب إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء و(عامل المقهى) سحقته الحياة وجعلته عبداً للعيش من أي وعاء جاء أو خرج.. يرغب سكان هذه القرية بالحياة التي يتمنون مثل حلم لا يفيقون منه صباح كل شمس إلا وقد تحول إلى كابوس يجعلهم مهيئين لاستقبال المنقذ حتى لو كان خيالياً أو منقرضاً أو يحمل أفكار الشيطان.. أو حتى الشيطان نفسه.. لتذهب بعد ذلك أحداث المسرحية إلى خاتمتها بالتراب الذي يعكس النهايات الحتمية لبؤس البشرية.
إن فرضية انتظار "الشيطان" في النص، تقربنا كثيرا من فرضية انتظار "غودو" لصامويل بيكيت في مسرحية "في انتظار غودو" إذ نحن هنا أمام نفس السؤال.. من هو هذا الشيطان أو "غودو" غير الموجود أصلا، هل هو الزمن الذي يأكل البشرية ويسرقها من وجودها دون وعي منها؟ أم هو السعادة التي سيجلبها هذا القادم إلى القرية؟ أم هو الضمير الذي اغتاله بؤس الحياة وتحول إلى شيطان يعيش داخل كل إنسان؟ أو ربما يكون قدوم الشيطان تسوية وقبولا لأي حلّ في ظل العجز الذي تواجهه القرية أمام القوى المجهولة، حيث لا أحد قادر على إنقاذ أحد.
أسس الحارثي الصراع بين شخصيتي (الرجل 1) و(الرجل 2) في هذا النص من كينونة شخصية "الشيطان" المنتظرة، والتي أنشأها اعتمادا على وجهة النظر الفكرية للشخصيتين المتنازعتين في ماهية وكينونة ذاك الشيطان، مستحضرا حكاية آدم وأسباب هبوطه إلى الأرض وإغواء التفاحة. إذ استفاد الحارثي من تلك الحكاية المعروفة موظفاً إياها في النص عبر جدل فكري وإسقاطات لها تشظياتها ودلالاتها على البعد النفسي الذي بناه لشخصياته لا بقصد الدفاع عن شيطان التفاحة، بل تهيئة المتلقي لاستقبال حدث عظيم، حيث اعتمد الحارثي في مضمون النص على وجهات نظر متعددة في مسألة قدوم الشيطان، مبينا أن ليس كل مجهول لا نعرفه أو معروف مسلّم به بالتثاقف والعرف هو غير قابل لإعادة التفكير فيه ووضعه على ميزان التفكير والتحليل.. فشخصيتا (الرجل1) و(الرجل2) متفقتان في حقيقة أن الإنسان هبط إلى الأرض، غير أنهما مختلفتان في السببية، من تلك القماشة أيضاً خاط الحارثي نهاية الحكاية، بعودة البشرية مرة أخرى إلى التراب الذي جاءت منه مع قطعة كفن بيضاء تستر عورة ما ارتكبه من فظائع في رحلته الأرضية القسرية بين التربتين في صورة بلاغية بين من خلالها البؤس والوجع الذي يعاني من جرائهما البشر على أرض لزجة متحركة قد تلتهم العالم في لحظة.
أما شخصية (الشحاذ) فقد اتخذت من الآلة عدوا.. والآلة هنا قصد بها الحارثي الزمن المادي للأشياء.. والتي يؤمن بها ذلك المتسول حتى يصل النص في نهايته إلى أن يأكل الزمن كل المنتظرين ولا يصلون إلى شيء ويبقي الباب مفتوحا لصراع طويل الأمد. وفي شخصية (الشحاذ) يظهر "بيكيت" مرة أخرى، من خلال اللعب على الزمن المادي، ذلك الشحاذ الذي يصور لنا الزمن ووجع انتظار معلومة نهايته مسبقا، وكأن المسرحية تحاكي الذات الإنسانية في البحث العابث نحو الحقيقة وانتظار مرعب ومقلق قد يطول أو لا يطول وفي كلتا الحالتين لا فائدة منه في خطاب له نفس الأسباب تقريبا وفي الظروف ذاتها التي كتب فيها صامويل بيكيت مسرحية "في انتظار غودو" في العام 1953 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ أنها شبيهة كل الشبه بما تمر به منطقتنا العربية من حيث أجواء عدم الثقة بالحاضر والخوف من المستقبل وخيبة الأمل في كل شيء والفتن السوداء المترامية على الطرقات، والقتل اليومي الذي طحن أخضر الإنسانية ويابسها. كذلك، نشاهد الوازع الوجودي حاضرا في هذا النص، من خلال أفكار الآخر التي طرحها الحارثي والتي تبنى من خلالها فكرة أن حياة الإنسان على الأرض لا جدوى منها الا من منظور ضيق باعتبارها تكفيرا عن خطيئة أزلية وانتظارا للخلاص من كل عذابات الحياة التي لا دخل له هو فيها أصلاً.
لقد حاول الحارثي في "ولم يك شيئا" أن يربط بين الحاضر وبين أقدم القديم ليبني بناء مسرحيا يهدف الى ان يتخلص من كل ما هو ليس بضروري والى ان يكون نصاً مسرحيا الى أقصى حد، غير أن اللعبة المسرحية التي صاغها فكرياً بإتقان، كانت تنقصها الحرفية لا في اختيار الشخصيات بل في بناء دراميتها، فشخصيات "ولم يك شيئا" بحاجة إلى بناء يوضح أبعادها، الأمر الذي أدى إلى انحسار الفعل عبر حوار ذهب أحيانا إلى التقريرية ونحا أحيانا أخرى للخطابية ولم يؤسس لصراع متنام يتمكن من حمل الطاقة الفكرية الكبيرة التي ألقاها المؤلف على كاهل الشخصيات. وعلى الرغم من أن نصاً مسرحياً عبثياً مثل هذا النص غالبا ما يعطي انطباعا للقارئ بأن العمل لم ينجز كاملا أو كما يقال عن حبكته بأنها "جرار غير متقنة الصنع" إلا أن هذا لا يعفيه من ضرورة وجود بناء مسرحي درامي أقوى وأكثر تماسكاً.
هذا لا يقلل من قيمة وأهمية نص مسرحية "ولم يك شيئاً".. بل إنه يؤكد على أحقية الحارثي في الفوز بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي بالمركز الأول 2015، طارحاً خطاباً إنسانياً يؤكد على أن الإنسان مخلوق عاجز، محدود القدرات، مجهول المصير، بحكم البداية التي جاء منها والنهاية التي سيؤول إليها وفقاً للزمن الذي يحفر نهاية كل كائن مع كل ولادة.