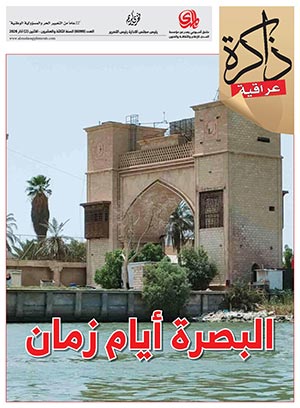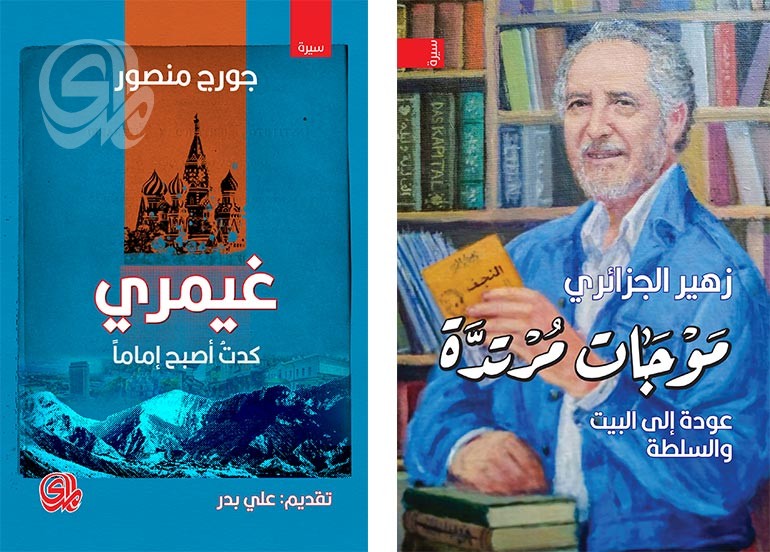هل نحن بحاجة الى التوكيد المتواصل بأن العولمة طحنت حقوق المواطن وجعلته شبيهاً بمسمار صدىء، يمكن الاغتناء عنه في أية لحظة؟ هل نحن بحاجة الى التوكيد المتواصل بأن العولمة، والأزمة الاقتصادية نزعتا سمة الإنسانية عن مؤسسات ولدت في الأساس لرعاية المواطن وح
هل نحن بحاجة الى التوكيد المتواصل بأن العولمة طحنت حقوق المواطن وجعلته شبيهاً بمسمار صدىء، يمكن الاغتناء عنه في أية لحظة؟
هل نحن بحاجة الى التوكيد المتواصل بأن العولمة، والأزمة الاقتصادية نزعتا سمة الإنسانية عن مؤسسات ولدت في الأساس لرعاية المواطن وحماية حقوقه، مثل مؤسسات الضمان الاجتماعي والصحي والعمالي؟
هل نحن بحاجة الى التوكيد المتواصل بأن لا غنى عن الآصرة ما بين البشر، أياً كان عمق الأزمة التي تضرب المجتمع؟
ليس لدى المخرج البريطاني الكبير كين لوتش أدنى شك في الحاجة الى ذلك وأكثر، لأن ما أحدثته العولمة من خراب قائم وتتفاقم تداعياته على البشر في كل مكان، يؤكد بأن الآصرة التي يمكن أن تربط ما بين البشر هي الآن أحوج ما تكون اليها المجتمعات، وهي لا يمكن أن تُقدَّر بثمن، ولا يمكن أن تُشترى وتُباع بمال أو بأسهم في البورصات، فهي، أي الآصرة، تمنح "ما لا يُمكن شراؤه بأي مال...". كما تقول في نهاية الفيلم السيّدة الثلاثينية كيتي، الأم لطفل وطفلة، والعاطلة عن العمل من دون أي أفق..
وعن الانسان يتحدّث كين لوتش في فيلمه الأخير الذي رفض في المسابقة الرسمية من مهرجان «كان» السينمائي الدولي، او بالأحرى هو ينطلق من الانسان - المواطن، ليروي كعادته، وبصحبة رفيق دربه وكاتب السيناريو بول لايرتي حكاية بشر يعيشون بيننا وقد لا نراهم او لا ننتبه الى كل ما يعانونه.
يروي كين لوتش تلك المعاناة في فيلمه «أنا، دانييل بلاك» ويقترب منها عن كثب عبر حكايا أناس بسطاء يحيون حيواتهم بشكل طبيعي حتى اللحظة التي تحلُّ عليهم لعنة البيروقراطية وانحسار القدرات المالية لمؤسسات الدعم الاجتماعي، أو حين يجد نفسه من عمل طوال حياته بدأب وشرف، مصاباً بعاهة او مرض مُعيق، كما هي حال دانييل بلاك، الذي يكتشف الاطباء، وهو في التاسعة والخمسين من عمره، خللاً في قلبه يحول دون استمراره بالعمل.
ويُقاطع لوتش حياة العامل - النجّار ونحات الخشب الفطري البارع دانييل بلاك، مع الفتاة - الأم كيتي التي تهرب بطفليها (ديزي وديلان) من لندن الى نيوكاسل بحثاً عن وسيلة للعيش ما يجمع بين دانييل وكيتي هو التعاطف الطبيعي بين البشر في لحظة العسر والصعوبة. ينتصر لها دانييل امام بيروقراطيي شركة الضمان الاجتماعي، فينال مقتهم وتعطيلهم لمطالباته بالمعونة الاجتماعية بعد أن أكّد أطبّاؤه عدم قدرة قلبه على احتمال مشاق العمل. دانييل في التاسعة والخمسين من العمر ولم يستوفِ بعدُ شروط الحصول على الراتب التقاعدي، ولأن ملفّه "ينبغي ان يُدرس من قبل الجهات العليا"، كما ترمي في وجهه الموظفة التي تتابع ملفّه، والأدهى من ذلك فإن على دانييل ان يقدّم جميع طلباته عبر الانترنيت، وهو الذي يجهل كل عالم الكومبيوتر وما يزال يكتب بالقلم الرصاص.
آصرة دانييل مع كيتي لا مصلحة فيها، من أي نوع، فهو كذلك مع زملائه في العمل ومع جيرانه، بمن فيهم الأكثر منه شباباً.
كين لوتش الذي سيبلغ الثمانين في السابع عشر من يونيو/حزيران المقبل، وهو ما يزال محتفظاً بذات الحيوية التي تميّز بها طوال انجازه الابداعي لأكثر من نصف قرن، وقد قوبلت تلك الحيوية وذلك الالتزام هذه المرة ايضاً بتصفيق طويل سواءٌ في صالة لوميير بقصر المهرجانات او في صالة المؤتمرات الصحفية.. «كين الأحمر» لم يتغيّر، فقراءته للأحداث والقضايا ما تزال على حالها، وهي هي، قراءة ملتزمة، بقيم وحقوق البشر، لكن ما تغيّر هو طبيعة تلقّي من يشاهدون افلامه بعد انهيار الايديولوجيات، ولم يَعدْ هذا المخرج يُرى عبر ذلك الموشور الايديولوجي الذي كان في الماضي يحسر عنه النظرة الايحابية لما يُنجز من قبل شرائح الوسط والبورحوازية بدعوى انها «بروباغاندا» يساريّة، فهو وبرغم بقائه على مواقفه دونما أي تغيير، لم يعدْ في نظر الكثيرين مجرّد الفنان اليساري الرافض للظلم، بل الفنان الملتزم بالقضايا الاجتماعية والسياسية التي يمكن ان تخصّ شرائح واسعة من المجتمعات، بصرف النظر عن القناعات السياسية والايديولوجية المسبّقة.
ولأن كين لوتش يتحدث عن المواطن الذي تقع عليه كل تداعيات الازمة الاقتصادية من دون ان يكون متسبّبا فيها فقد فعل مع فيلمه الأخير، بالضبط كما فعل في فيلمه الأول « كيثي تعود الى المنزل» الذي تعامل فيه قبل خمسين سنة مع قضية المشرّدين، وأطلق على الفيلم الأخير اسم وكنية الشخصية الرئيسة «دانييل بلاك»، وجعله يُعلن عن نفسه بـ «أنا»المتحدّث، كتأكيد منه بضرورة الحديث عن الفرد - المواطن.
تخمينات النقاد تشير الى احتمال عودة كين لوتش الى مدينة «كان» يوم الثاني والعشرين من مايو/أيار ، في ليلة اختتام المهرجان وتوزيع الجوائز، واذا ما حدث ذلك فإنه سيعني استحقاقاً لا غبار عليه وتأكيداً على ضرورة سينما معلم كبير مثله..