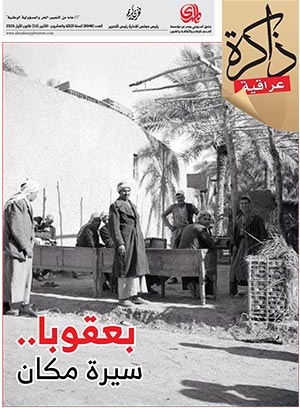3-3
الوسيلة الوحيدة لإنقاذ العالم، للبقاء على قيد الحياة، هي رواية القصص، لقد عرفت شهرزاد ذلك، لقد تعلمت ذلك منها، وإلا لما نجحت بنقل الديباجة التي تتحدث عن تأجيل خدمتي، والتي نقلتها عن دفتر خدمة عسكرية أحد الجنود المؤجلين، والذي أغريته بالحديث معه أثناء خروجه من دائرة التجنيد في محلة السراي، حيث وقفت أراقب طابور الشباب من مواليدي المراجعين لدائرة التجنيد، كنا نعرف بعضنا من بغداد، دعوته إلى الجلوس في مقهى قريب. ورحت أروي له ببساطة بعض القصص، المخترعة منها أو الحقيقية، قصص يدور بعضها عن الشارع الذي جلسنا عنده، عن المدينة، عن تغير الأحوال والناس، كل تلك القصص التي واظبت على اختراعها في ساعات الوحدة، خاصة في فترة خدمتي العسكرية التي استغرقت سنتين وتسعة أيام (تسرحت بستة أسابيع قبل اندلاع الحرب)، كل تلك القصص التي كنت أعرف أنه يتوق لسماعها لأنه لا يعرف عن المدينة شيئاً، العمارة مسجلة فقط في تاريخ ميلاده، حياته كلها قضاها في مدينة الثورة في بغداد، كنت أعرف ذلك، مثلما شعرت بتأثير قصصي عليه، كان الشاب مخدرا بالحكايات، لدرجة، أنه غادر المقهى ونسى دفتر خدمته العسكرية، تلك كانت خطتي منذ جلوسنا: أن أُنسيه دفتر خدمته العسكرية، عندما طلبت منه رؤية الدفتر، قلت له أريد مقارنته بدفتر خدمتي. بهذا الشكل نقلت الديباجة تلك عنه. وبهذا الشكل عبرت الحدود بوثائق مزورة.
أظن أن الشاب هو الآخر، شعر أنه عن طريق تلك القصص يعيش، وأن الحرب التي سيُساق إليها، ليست غير كارثة بعيدة، ذلك هو الأمر عند الروي، الراوي والمستمع متوحدان بالمصير.
نحن نلتقي بالناس ولا ندري أن وجوههم مثل لحاء شجر قديم حفر الزمن عليه القصص الكثيرة، ونحن؟ نقرأ القصة الوحيدة التي نراها أمامنا في الوجه. وهي مسألة وقت، لكي تكشف القصص الباقية لنا عن نفسها. قبل أيام وأنا جالس في القطار في طريقي من روستوك إلى برلين، صعد قرابة عشرين من الشباب، مباشرة من وجوههم، عرفت، أنهم مهاجرون. أتطلع إلى وجوههم، كانوا صامتين. ما أن أسأل أول واحد منهم، عن بلده، تاريخ وصوله إلى المانيا، حتى يلتفوا جميعهم حولي، وجوههم تنطلق، يروون لي قصة هروبهم، عبورهم البحر، مثل غريق عثر على قصة نجاة، أية سعادة أراها على وجوههم، وهم يعثرون على أحد يعيش هنا منذ سنوات، يتبادلون معه الحكايات عن بلادهم التي ابتعدت وعن البلاد الجديدة، الغامضة لهم. فجأة، يقول لي أحدهم كم هو سعيد جداً أنه عثر على الشخص الذي كان يبحث عنه طويلاً، ثم ليكمل وهو يبتسم "ألا تنشر الصحيفة التي تعمل لها قصصا وخواطر معاناة شاب، كيف خاطر في الحياة؟"، يسألني بعد أن قلت له أنني صحفي "أرجوك"، قال لي بالحاح وهو يضغط على يدي، "سأكون سعيداً لو نشرت صحيفتك قصصي". أبتسم له، وأعرف أية طاقة حملها صوته، مثل جائع أو عطشان، لم يأكل ولم يشرب الماء منذ أيام، "كم بودي أن أروي قصتي"، يقول الشاب، ويسرح بعيداً، وهو يتخيل حياة أمامه، يشعر أنه يعيش، ألا يفعل الأطفال ذلك؟ "ماما، بابا، أحكوا لي قصة"، حاجة الطفل لسماع القصص اساسية، انها تقارب حاجته للتغذية، أنه يعرضها أمامنا علناً، مثل جوع، انظروا لهم وهم يلعبون، كيف يحولون القصص إلى حيوات، أنهم يملكون القوة الخيالية، الطفل الذي يُمنع عنه الطريق الدخول إلى عالم الخيال، لن يأتي إلى نتائج في الحياة الواقعية. ومثله يحصل للشخص اليافع. بدون السرد، بدون القصص ستصبح حياته خواء. أليس ذلك هو سر الروي؟ من أين تأتي غوايته، شده إلينا، رواة ومستمعين، إذا ليس من شعورنا ذلك، أن ما نرويه أو نسمعه يتحول إلى رؤية، إلى حياة؟
من يعترض إذا قلنا: التخيل هو الوسيلة لإنقاذ العالم، للبقاء على قيد الحياة، إن لم يكن هو الحياة!
غابرييل غارسيا ماركيز يقول، "عشت لأروي"، وأنا أقول، شكراً للروي، وهو ينقذ العالم، شكراً للروي أن لنا حياة .... أننا نعيش!
شكراً للروي أن لنا حياة
نشر في: 7 يونيو, 2016: 09:01 م