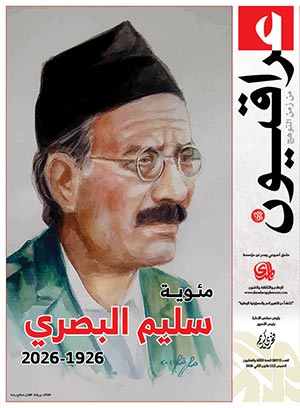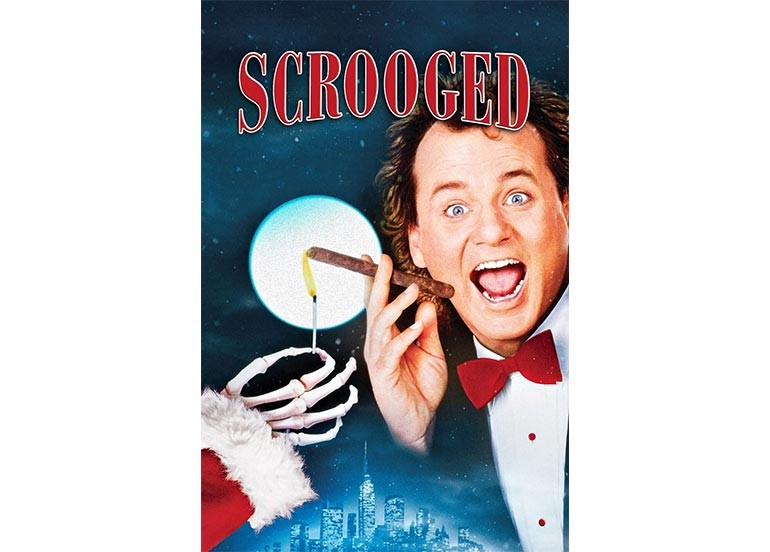يبدو أنه لولا الدراما المصرية، ما كنا سمعنا وعرفنا وحفظنا عن ظهر قلب أنواع المخدرات المتداولة في مصر، كالبانجو والحشيش والهيرووين والبودرة والترامدول والحقن التي تؤخذ بالوريد، والسكائر التي تلف على شكل مخروطي، واسمها الصاروخ، وتعمل على تحسين المزاج،
يبدو أنه لولا الدراما المصرية، ما كنا سمعنا وعرفنا وحفظنا عن ظهر قلب أنواع المخدرات المتداولة في مصر، كالبانجو والحشيش والهيرووين والبودرة والترامدول والحقن التي تؤخذ بالوريد، والسكائر التي تلف على شكل مخروطي، واسمها الصاروخ، وتعمل على تحسين المزاج، كما جاء على لسان بعض أبطال المسلسلات.. مع عبارات أخرى مشجعة على تدخينها، وتداولها حتى بين طلاب الكليات والمدارس الثانوية..
وهذا الموسم الرمضاني جاءت لنا ريمة بأفكارها القديمة نفسها، مع تعريفات جديدة بأنواع أخرى من المخدرات والمشروبات الروحية التي تتعاطاها النساء أسوة بالرجال، في البيوت والمطاعم والبارات.. وعادة فإن الخطوة التالية من التعريف بالشيء هو التطبيع معه، حيث يصبح هذا الأمر الغريب متدولاً، (بحذر في البداية)، ثم بعد ذلك تحدث الألفة بينه وبين الناس، وينكسر الحاجز النفسي السابق، ليستقر هذا المفهوم الجديد في الوجدان والأذهان، ويتداوله الجمهور بحرية، بعد أن كان مثيراً للجدل، أو ضمن الممنوعات أو المحرمات.
يبدو أن الذي حدث في هذه الفاصلة الزمنية الخاطفة التي تسبح فيها الأقمار الصناعية في هذا الفضاء الإعلامي الشاسع، هو ان المنافذ التلفزيونية على الأرض قد عملت بقوة على تفكيك هذه المحاذير بين الناس، ثم استعملت أيقونات الفن والفنانين للتلاعب بها ،ونقلها إلى مناطق جديدة غير مطروقة، وبمرور الزمن لعب هذا الإعلام دورالبطولة في تحويل المحظورات إلى مسموحات، وقد حدث ذلك في غضون سنوات قلائل تعد على أصابع اليدين.
وما شهر رمضان، كما يبدو، سوى مناسبة للتطبيع القسري مع الكثير من بلطجة المؤلفين، والتماشي مع ما يطرحونه من المفاهيم الجديدة، ليس باتجاه الثورة والتمرد الفكري على العوامل الحقيقية للجهل والتخلف، ولكن من خلال الانغماس السطحي بأمراض المجتمع، والاستجابة لآليات سوق هش فكرياً، وهشاشته أكثر خفة من آليات الانتاج الهوجاء.. عوالم الدراما المصرية، مع الأسف، أما بعيدة كل البعد عن جدليات الواقع بهدف التماهي مع تلك الآليات، وتعويض المشاهد بالأزياء والديكورات عن حالة الحرمان التي يعيشها.. أو أنها عوالم واقعية مستلة من القاع، ولكنها مرسومة بخيال مريض يقدم وسائل إيضاح وافية، لمن يعاني من شظف العيش، في كيفية الحصول على النقود بأساليب وطرق خاطئة، تكون مدانة أحياناً في نهاية العمل، أو غير مدانة كما في حالات ( ممصّرة) لفتيات عاملات يقمن علاقات مشبوهة مع الرجال (بوي فرندز) بشكل طبيعي، ووفقاً لمتطلبات العمل الأجنبي الذي يتم تمصيره بخفة شديدة، وعقلية تجارية، ودون مراعاة لكون هذه الدراما تتمتع بنسبة مشاهدة عالية بين الشابات وربات البيوت. وأسطع تجليات تلك الخفة، هو ليس حشر ولصق مشاهد العري والرقص في الملاهي والديسكوات، فهذه المشاهد العتيدة أصبحت من الأمور العادية في أغلب المسلسلات المصرية، وإنما عرض هذه الأحوال (الخواجاتية) على أنها أمر مألوف حدوثه في مجتمعاتنا..
أما حفلات التعارف مع أنواع المخدرات وطرق تعاطيها والحصول عليها، فيبررها المؤلفون وكتاب السيناريو بكونها موجودة في الشارع، وبالتالي يتمادون في عرضها على طريقتهم التي تؤدي إلى أن يكون القاع هو الذي يقود الفن، وليس العكس.. أي بدلاً من أن يتقدم الفن على المجتمع بخطوة، ولو واحدة، إلى أمام، فإنه يغطس به أكثر وأكثر إلى مستنقع الرداءة، لأنه، وبحجة التركيز على الظواهر الخاطئة، يفشل في عرضها بشكل جدلي غير استعراضي، ويعمل تدريجياً على إزالة الحواجز بينها وبين الناس، وبالتالي قيادتهم إلى شكل من أشكال التطبيع معها..
ولهذا الروتين المزعج الذي أصبحت عليه الدراما المصرية أسباب كثيرة، ومن أهمها دوران هذه الدراما في حلقة ضيقة من اسماء المؤلفين وكتاب السيناريو تعد على أصابع اليدين، وبصعوبات ليست هينة انفتحت الدراما المصرية على وجوه عربية وممثلين غير مصريين من سوريا ولبنان وتونس ضخوا دماءً جديدة للأعمال الدرامية والسينمائية، ومن المحتمل أن الأمر أقل صعوبة فيما يخص انفتاحها على الكتاب والمؤلفين والعرب من خارج مصر، كيما تُضخ بعض الأفكار الجديدة لماكنة الدراما التي أصابها الركود، وأصبحت تدور في حلقة مفرغة من ثيمات مكررة وعالقة في مناطق البلطجة والقاع المملة، وليس في رحابة الخيال المدهش، وسحر العوالم العجيبة.