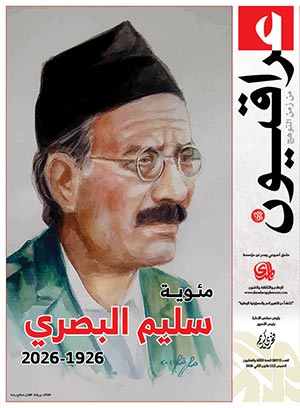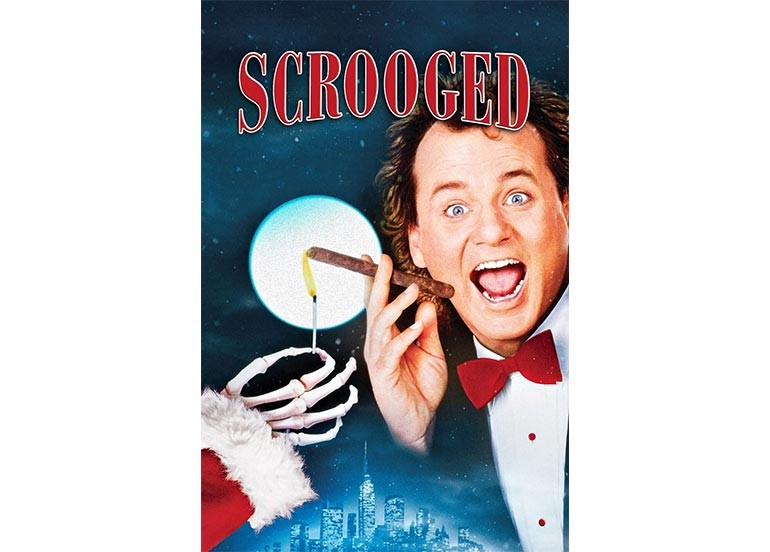ما أن ينقشع غبار الحرب، تُولد الأسئلة المقلقة. بل حتى في خضم تصاعد نيرانها، يصعب على المرء في المواقف الإنسانية الحرجة، الاستمرار بترديد مقولاتها؛ قبول مسوغاتها أو تبرير ما يرتكب باسمها من جرائم تحت ذرائع شتى، خاصة وان الحرب تضعنا دوما أمام موت مجاني
ما أن ينقشع غبار الحرب، تُولد الأسئلة المقلقة. بل حتى في خضم تصاعد نيرانها، يصعب على المرء في المواقف الإنسانية الحرجة، الاستمرار بترديد مقولاتها؛ قبول مسوغاتها أو تبرير ما يرتكب باسمها من جرائم تحت ذرائع شتى، خاصة وان الحرب تضعنا دوما أمام موت مجاني، لا يفرق بين عدو مسلح ومدني اعزل.
إذا ما كانت الحرب تماثل، بشكل من الأشكال، أصوات رواتها وموقعهم منها، فإن صور المصائر الأليمة لضحايا حربي أفغانستان والعراق-على نحو خاص- اصدق من سيل البطولات السينمائية الزائفة التي حيكت حول تلك الحربين وابلغ في توصيف حقيقتها المرّة. سرديات ضائعة لأناس من لحم ودم، ليس ثمة من يمثلهم في ماكنة هوليود العملاقة التي احتكرت-إلى حد ما- الحديث عن حروبها على الشاشة وهي كعادتها تشيح بوجهها عن حماقات ساستها. لكن تلك ليست الصورة كاملة، إذ نشهد من حين إلى آخر ظهور أفلام -أوروبية غالبا- تحاول الاقتراب بموضوعية من حقيقة ما جرى.
في الموسم السينمائي الماضي تناول المخرج البولندي "كريزستوف لوكاسزيفيتش" بمقاربة جدية واقعة الاشتباكات الدامية بين القوات البولندية والميليشيات المسلحة عشية الحرب على العراق، في فيلمه الموسوم"كربلاء"، فيما أعاد الصحفي الاسترالي "مايكل وير" في الوثائقي الجرئ الذي شارك في كتابته وإخراجه ((only the dead-2015 سرد تجربته المريرة في تغطية وقائع الحرب على العراق منذ 2003 مرورا بأحداث الاقتتال الطائفي عام 2006 وما تلاها من تداعيات أمنية خطيرة.
أما المخرج الدنماركي الشاب"توبياس ليندهوم" (مواليد-1971) والذي لفت الأنظار إليه منذ فيلمه (اختطاف-2012) الذي يدور حول اختطاف القراصنة الصوماليين لسفينة دنماركية (جائزة فيبريسي بمهرجان سالونيك) فانه يعود بفيلمه الجديد(حرب) -رشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل الأوسكار الأخير- إلى تناول قضايا جدية تهم الجمهور العالمي والأوربي على نحو خاص.
حرب واحدة
في سياق جدل سياسي وثقافي أوروبي يتخطى السينما إلى منابر أخرى، يأتي الفيلم الدنماركي (2015-A war ) للمخرج ليندهوم (وهو ثالث أفلامه الروائية) ليضاف إلى دزينة أفلام سينمائية عالجت الحرب الأفغانية بمستويات مختلفة، ربما أبرزها فيلم المخرج والممثل روبرت ريدفورد (Lions For Lambs-2007) ، معبرا عن هموم جدية وتساؤلات واقعية مضمنة في حكايته، ما الثمن الذي ينبغي للدنماركيين دفعه في فاتورة حرب أفغانستان التي كان اغلب ضحاياها من المدنيين؟
وعلى قدر جدارتها، تفتح السينما بوابة التساؤلات هاهنا: هل بوسع نيران جنودنا أن تفلت من اسر محاكمتها أخلاقيا وقانونيا إذا ما حادت عن تأدية مهمتها الأساس؟ إلى أي حد كانت حرب أفغانستان ضرورة سياسية ملحة أو واجبا وطنيا، ابعد من مجرد الاصطفاف خلف الولايات المتحدة وحلفائها؟ هل ينبغي لنا كدنماركيين التبرؤ مما اقترفه جنودنا من انتهاكات خطيرة في أفغانستان بمجرد تقديم كشف حساب بضحايا الحرب من الجانبين؟
فيلم(حرب) الذي كتبه وأخرجه ليندهوم يدفع جمهوره للتفكير فيما حصل هناك، بعيدا عن سطوة البروباغندا السياسية، حينما يعيد طرح بعض تلك التساؤلات بشكل درامي مؤثر، حيث يواجه قائد وحدة دنماركية في أفغانستان يدعى كلاوس بيدرسن (الممثل بيلو اسبيك) وضعا قانونيا شائكا يعرضه للمحاكمة عقب إصداره أمرا عسكريا بقصف قرية أفغانية انطلقت منها نيران كثيفة صوب جنوده. يعزز الفيلم الاعتقاد بان القانون الدنماركي لن يتساهل إزاء مقتل 11 مدنيا أفغانيا، بينهم نساء وأطفال، جراء ذلك القصف. مما يعني ان قائد الوحدة خرق قواعد الاشتباك المعمول بها، وعليه ان يبرر فعلته. وفقا للمنطق العسكري كانت تلك نيرانا معادية. لكن كيف ينبغي التعامل معها؟ لا يغفل الفيلم تمرير فرضية ان الجيش الدنماركي أسوة بقوات حليفة أخرى يقوم بمهمة نبيلة هدفها حماية المدنيين من بطش الجماعات المتطرفة، وإن أوحى ذلك بدعاية سياسية مباشرة.
يبدأ ليندهوم فيلمه بشكل تقليدي حيث تتحرك مجموعة من الجنود في دورية راجلة بهدف تأمين المساحات التي يشتبه بوجود عناصر طالبان فيها، وفجأة يتعرض احد الجنود إلى انفجار لغم ارضي يودي بحياته، ويتسبب الحادث بحالة من الفوضى بين صفوف المقاتلين، فيما يعاني الجندي(لاسي) من أصول مسلمة- حالة انهيار عصبي بسبب فقدانه احد زملائه. يحاول الضابط بيدرسن القريب إلى هواجس جنوده، تفهم مشاعر لاسي وتخفيف إحساسه بالذنب، ويقرر بوصفه الضابط المسؤول عن الدوريات نقله إلى مقر الوحدة لتخفيف الضغط النفسي عنه.
في الضفة المقابلة، ثمة عالم مواز لعالم الحرب، انتظار ملح لعودة الأب بيدرسن إلى أحضان العائلة التي تتكفل الزوجة ماريا(الممثلة توفا نوفوتني) بكل احتياجاتها وتكاد تفقد عزيمتها في خضم أعباء العناية بأطفاله الثلاثة. عبر اتصالات قصيرة يتلقى بيدرسن شكوى الزوجة من غيابه الطويل وافتقاد الأبناء له. لكن تلك الأزمة قد تبدو ضربا من الترف بالنسبة لما يعانيه قروي أفغاني فاقد الحيلة يأمل بعلاج ابنته الصغيرة من آثار حروق شديدة تعرضت لها. يساعده الجنود في تطبيب ابنته، لكنه يتعرض لاحقا للتهديد من قبل عناصر طالبان بحجة تعامله مع العدو، فيتوسل الرجل الأفغاني القوات الدنماركية من أجل توفير الحماية له ولعائلته.
يحاول الضابط بيدرسن الدفاع عن وجهة نظره من انه يتفهم معاناة الرجل الأفغاني، كونه هو الآخر أب لأطفال صغار، فيرد الرجل: نعم لكن أولادك يعيشون في مكان آمن الآن. في نهاية الأمر يرفض الضابط بقاء عائلة الأفغاني في المعسكر. وفي مشهد لاحق تتفجر بقية الأحداث، يعثر الجنود على جثث العائلة الأفغانية وقد قتلت بوحشية من قبل طالبان.
هناك حيث تبدو قدما الطفل الصغير عاريتين، تشيران بيأس إلى القتلة، تسود حالة من الإحساس بالاضطراب بين صفوف الجنود الدنماركيين من انهم لا يفعلون الصواب في هذا البلد العصي على الفهم، وربما لا يفعلون شيئا أكثر من التسبب بموت الآخرين.
السارد: وجهة نظر
سرديا تنتقل أحداث الفيلم بين مكانين: الدنمارك (العائلة ثم المحاكمة) وأفغانستان( وتيرة الحرب الدائرة) وكأنه يجاور بين عالمين، يبدو فيهما الضابط بيدرسن أبا مأزوما في الحالتين، بين عائلته وجنده. وما لا يحسب لصالح الفيلم انه جعلنا على مدى (115 دقيقة) نتابع سرد الأحداث بعين واحدة، يمكن لها أن تسهم في التلاعب بأحاسيسنا، ذلك اننا لا نرى طوال أحداث الفيلم التي تخللتها ثلاثة مشاهد قتالية، الجانب الأفغاني،رغم سماعنا أصوات نيرانه المصوبة نحو الجنود الدنماركيين. عدو مجهول نستشعر خطره من دون أن نتعرف على وجهة نظره في هذه الحرب. ليس ثمة مواجهة مباشرة، لكن هناك وعلى نحو مؤذ خطر العبوات الناسفة التي توقع اشد الخسائر في صفوف الدنماركيين بوصفها اثر (الأفغاني) المُغّيب.
في مشهد الاقتتال العنيف الذي ينتهي بقصف القرية الأفغانية،لا يعرض المخرج ما جرى فعليا في القرية، فكل ما نشاهده على الشاشة هو حالة الاشتباك والقذائف التي تطال الجنود عشية اكتشافهم مقتل عائلة الرجل الأفغاني الذي خذلوه. لكن المخرج في المقابل لم يلجأ إلى تنبيه الحواس أو إشباع شغفها المفرط بالمؤثرات الخاصة في مشاهد(حركة، انفجارات مهولة، عنف مفرط) وإنما اكتفى بتحريك كاميرا قريبة تتابع أفعال الشخصية وترصدها عبر لقطات منذورة لمعاينة انهياراتها الجسدية والنفسية.
بعد مشاهد طويلة لمحاكمة بيدرسن (النصف الثاني من الفيلم) تتم تبرئته بشهادة يدلي بها احد زملائه. فلا احد بوسعه التشكيك ان مهمة القائد العسكري -مهما كانت رتبته- هي أن يعود بجنوده سالمين إلى أوطانهم، مهما كلف الأمر. يقول احد شهود القضية، مخاطبا المحكمة: مهما اجتهدتم، لا يمكن لكم أن تتخيلوا ما يحصل هناك؟
ومن دون الاتكاء على استخدام الإبهار التقني لسينما هوليود، يسعى فيلم(حرب) إلى طرح قضية ملحة عبر زعزعة اليقينيات الشائعة التي مثلت فهما مخادعا لواقع الأحداث. ذلك ان أشباح الموت في أفغانستان تصطاد الأبرياء أكثر من سواهم. وهو ما على الأوروبيين تداركه، إذا ما اعتبرنا أن أوربا تعلمت الدرس الكبير منذ ان وضعت الحرب الكونية أوزارها على أنقاض النازية.
قد يبدو الوضع اشد تعقيدا اليوم مع حروب متداخلة تدار عن بعد باسم الديمقراطية، حروب أبيدت في مهالكها شعوب ودمرت بفعل قذائفها أوطان،لا تقدم سياقاتها إجابة شافية عن سؤال مدوي: لماذا يقتل أبناؤنا في أراض غريبة؟
في نهاية الفيلم يضعنا المخرج أمام مشهد ربما يحتمل أكثر من تأويل، حيث يلتفت بيدرسن إلى قدمي ابنه الناعمتين وهو يغط في نومه، يحاول تغطيتهما بحركة بطيئة كأنها تستدعي صورة طفل أفغاني بريء قتل في الحرب. وربما يلمح الفعل إلى رغبة خفية في التستر على فعل شنيع قد ارتكب، وليس مستبعدا ان تكون تلك محاولة لطي صفحة الماضي الأليم.
عالمنا في صورة
ان محاولة فهم الفيلم تقودنا حتما إلى تأمل العالم الذي جاءت منه الأفلام. انه عالمنا الملتبس، حيث تضيع التفاصيل الصغيرة التي تشكل حيواتنا وترسم مصائرنا في ركام الصورة الكبيرة التي تتلاعب بها وسائل الإعلام وإرادات المصالح الكبرى. سنرى ان أي فيلم جديد عن الحرب (أية حرب كانت) يستدعي في بناء أحداثه ومعالجته ولغته السينمائية أفلاما سابقة، فتبدو المحاولات السينمائية التي تنشغل بالجزئيات مناورة صغيرة أمام مغامرة الذهاب إلى مواجهة الأسئلة الكبرى المؤرقة التي تلخص محنة الإنسان في الحرب. يوما ما فعلها المخرج "ترنس مالك" في تحفته السينمائية (خيط احمر رفيع-1998) والتي لم يسبق لمخرج معاصر أن تناول الحرب بذات العمق والبراعة الفنية. ربما لان "مالك" أراد قول كل شيء عن الحرب بوصفها تجربة خراب شامل وشر كبير معدٍ. فيما اكتفى ليندهوم بالقول ان من عادوا بأجساد سليمة، يخفون في دواخلهم أرواحا معطوبة. في الحرب ليس ثمة رابح أبدا.