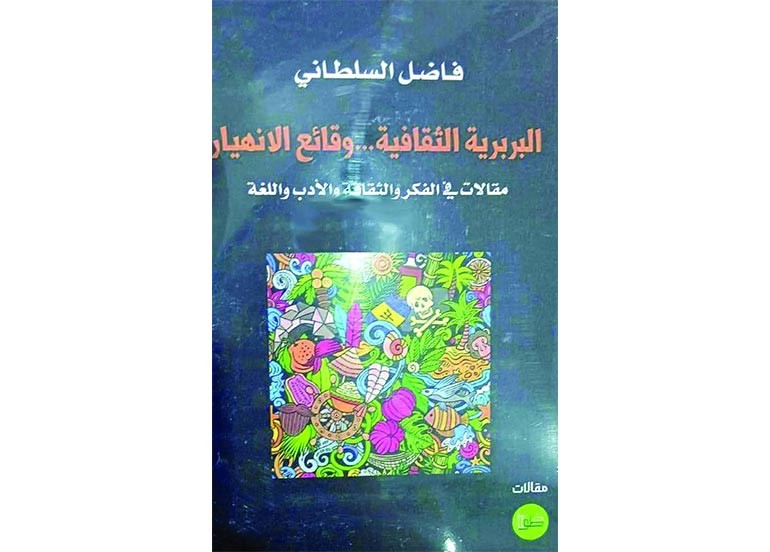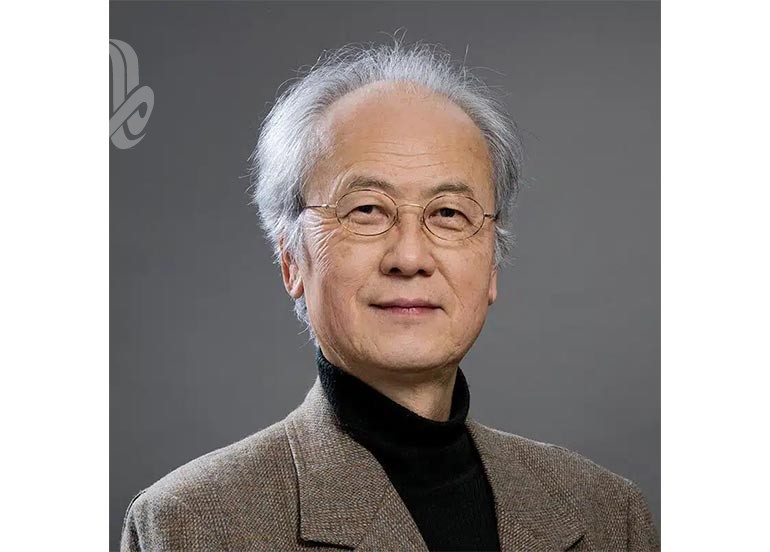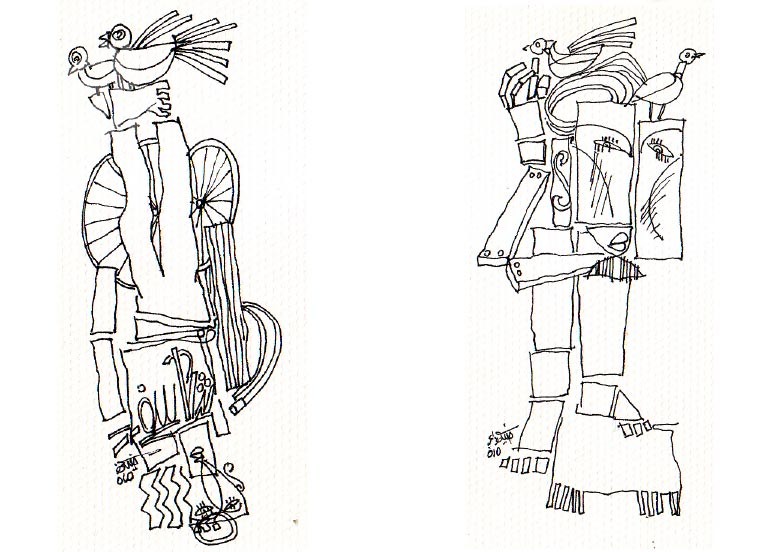متاعبنا اليوم في عموم المجتمع، وفي الوسط الثقافي بخاصة، سببها انعدام الفهم المشترك. فنحن وحدات متنافرة من الأفراد ومن طرائق التفكير ومستوياته، وإذا كان هناك قاسم مشترك فهو الاستياء من عيوب مكينه مزمنة، أو يراد لها أن تكون مزمنة.المثقفون، اعتزازاً مشر
متاعبنا اليوم في عموم المجتمع، وفي الوسط الثقافي بخاصة، سببها انعدام الفهم المشترك. فنحن وحدات متنافرة من الأفراد ومن طرائق التفكير ومستوياته، وإذا كان هناك قاسم مشترك فهو الاستياء من عيوب مكينه مزمنة، أو يراد لها أن تكون مزمنة.
المثقفون، اعتزازاً مشروعاً بوعيهم وثقافتهم، يلغون المسافة الفاصلة المطلوبة للتغيير. هم يتجاهلونها حماسة أو لعدم رغبتهم في بذل جهد مضاعف لتهذيبها من ثم زوال تلك المتاعب.
نحن أمام مسألتين، الأولى أن المتحدث عن، أو المقترِح ، أو الراغب بالصلاح، يتكلم عن مثال في ذهنه، عن تصور لأنموذج. وهذا يكون خطأً حتى مضحكاً أحيانا حين يجهل واقع الأمر، مصنعاً، مزرعة، دارَ نشر أو صحيفة. معرفة واقع حال المؤسسة أو المشروع قد يحرف التفكير، أو المقترح، من التطور والطموح، إلى البدء في معالجة أسباب الفقر أو الضمور. التذمر هنا ليس في مكانه، فهذه هي الامكانات المتاحة وإن أردنا خيراً فلنقدم من الأفكار ما يزيد من الأمكانات ويقلل من المعترضات.
ثمة عيوب وردود افعال ظاهرة ومعروفة. الانتماءات والعلاقات الشخصية مثلا حاضرة غير خافية، من التعيينات، إلى الصفقات التجارية إلى الترشيحات للموقع وحتى للاحتفاءات والجوائز، لا نستطيع نكران هذا ونعرف أيضاً أن عاملين مهرة، أصحاب علم وتخصص، قادة عسكريين ومثقفين كثرا لم يحظوا بما هم جديرون به. وهذا يجعلهم أدق نظراً للأخطاء والعيوب، فالظاهرة عموماً مبعث استياء دائم.
مبعث الاستياء الآخر هو أننا نرى بلداناً ونشاهد فضائيات، تتبع ذلك عادة المقارنة المؤلمة بين التخلف والتحضر وبين الفساد والصلاح وبين الكبت والمنع والحريات الواسعة، وهذا أمر آخر معروف.
في العودة إلى وسطنا الثقافي الملغوم أبدأ بالاستياء وعدم الرضا، نحس دائماً بكتّاب لا أهمية حقيقية لهم، أعني لأعمالهم، مكرَّمون ويشغلون مواقع كما ونرى كفاءات معزولة بعيدة عن الاهتمام. أضف لذلك، أن كل من كتب شيئاً، يرى نفسه مهماً، نداً، وهذا واقع أخلاقي معروف. فإذا أضفت لتلك المؤسفات، مرضَ كراهةِ المتفوق، نجد أنفسنا بإزاء ظواهر المجتمعات المتخلفة وقليلة الفرص، وحيث الناس الكثر هم المعوزون فيها. وهنا لا يبدو غريباً الانتقاص وتقليل الشأن والحسد ومحاولات الإزاحة، من ثم اضطراب القيم والتقويم.
أقول، نعم، صحيح أننا متعبون من مجتمع هذا مستواه الحضاري وهذه منغصات عيشه، لكنه أولاً وقبل كل شيء مجتمعنا الكبير وأنه وسطنا الثقافي الذي نحن فيه وأنها، قبل هذا وذاك، بلادنا. حسناً إذن أن نعي ما في البلاد من ظواهر ونعرف، بحكم ثقافتنا، ما وراء هذه الظواهر، جذورها وأسبابها. وهذا الوعي يوجهنا إلى النظر الهادئ والتفكير لا إلى الانفعالات والاصطراخات المنفلتة والحكم على حياتنا وناسنا كما على الموت والأعداء!
الحكمة مطلوبة في السلوك وفي الكلام. وهي مطلوبة، بل هي حاجة أولى، في الغضب والاستياء. مهمة الثقافة هي التنوير بمعنى الإفهام والتبصير لا التدمير! في الحال الثانية لن تكون ثقافة. لا أتمنى الاقتصادي انفعالياً، ولا السياسي هائجاً ولا أتمنى الكُتّاب فاقدي التوازن والنظر المتبصر، لا بحجة الرفض الشديد ولا بحجة الثورة. نمتلك لغة عاقلة للتعبير عن القرف أو الاستياء أو لإدانة الخطأ. بلادنا هي بلادنا، الإدانة والرفض لسيئاتها دائماً مع المحبة لها والحرص على سلامتها ونحدد السبب المنطقي لكراهة السيئ فيها.
ما نقوله في الحقل السياسي، نقوله أيضاً في الحقل الثقافي وفي عالمنا اليوم، سواء في الصحيفة أو في المصنع أو الدائرة الرسمية او في السوق والبرلمان.
للظواهر أسبابها. وشرط علاجها أن يكون عملياً وعلمياً، بالتخصص لا بالثقافة العامة بعيداً عن الميدان. أن تطفح الرغبات في المعالجة من هذا وذاك، أمر كريم محمود، لكنه غير مجد وقد يكون مربكاً إن لم يكن من متخصص عليم. للاقتصاد ناسه وللصناعة ناسها ولتطوير المدن والشؤون المدنية ناسهما. كلام غير المتخصص غير مضمون الفائدة وغالباً ما يكون عن سطح الظاهرة أو الأزمة .. لابد من أن نعوِّد أنفسنا على الحديث فيما نعرفه جيداً و لنا فيه تجربة أو لنا تخصص في شأن منه. هذا الهوس في الكلام بكل شؤون الحياة يبقينا بين الاستياء والأمنية. وإلا فغير معقول أن يتحدث السائق والبقال وربة البيت وطالب المدرسة والجزار وسواهم في تطوير الصناعة وفي الري والنقل والسياسة الدولية والاقتصاد وبرامج التعليم والخطط العسكرية هذه وإن كانت في باب الحرص وتمني الأفضل، مربكة وسبب للفوضى.
نعم، أنا أعرف بأنا لسنا راضين، بل نحن في غاية الاستياء من تردي الإدارة والاقتصاد والشؤون البلدية والخراب الثقافي وهبوط مستويات الانجاز في كل شيء، لكن الروية مطلوبة والحكمة والتشخيص العلمي مطلوبان وعلينا أن نضع في الحسبان أن الفلاح أعلم بأشجاره وأن النتائج الطيبة تأتي بعد وضع الخبرات في مكانها الصحيح والثمرة لا تنضج في يوم وليلة. لا شك بأن بلادنا خليقة بأن تكون أفضل وثقافتنا خليقة بأن تكون أفضل وكذلك مؤسساتنا الطبية وأكاديمياتنا وكل مرفق في البلاد، لكن أولاً دعوا المتخصص يتول الأمر، هو دور العلم تحديدا، لا أحد يتقبل الهوس واللابصيرة، وعلينا أن نعلم بأن زمناً مطلوباً و للنضج ولكي نرى الحقيقة، وإذا فاتنا العلم والتخصص فلا يفُتنا التريث وإعمال البصيرة ومعرفة طبيعة اكتمال أي شيء.
تذكرت ما ورد في رواية "ارسكين كالدويل" "هكذا خُلِقَتْ جيني" التي ترجمتها سلمى الخضراء الجيوسي ويمكن أن تكون هذه السطور المختارة منها خاتمة طيبة لكلامنا :
"..وانحنى القاضي وربّتَ على ذراعها وقال : والآن يا جيني لا أريدك أن تنفعلي وتستائي من شيء كهذا الشيء، فليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في "ساليسو" ولن تكون هي المرة الأخيرة، مهما كانت مشاعرك، فإن هناك أموراً لا يمكن تغييرها بفعل الإرادة وحدها وليس بإمكانك أن تزيلي التعصب من عقول أشخاص مثل "ريدوماك" بحركة من أصبعك".
-" لكن لي الحق مثله في أن تكون لي آرائي ومشاعري الخاصة".
-" قد تملكين هذا الحق يا جيني ولكنك لا تملكين القوة لممارسة آرائك كما يمتلكها هو".
-" أنك تتكلم يا ميلو كما لو أنك متحيز معه."
-".. لا، لست متحيزاً معه، ولكنني أحاول أن أتبع الطريق الذي تمليه الحكمة في هذه الظروف وأن انصحك بموجبه. إن التسامح الذي تتكلمين عنه، بالنسبة للتمييز العنصري، سيعم يوماً ولكن هذا اليوم لن يكون غداً يا جيني!.
لن يكون غدا، نعم، لكن لكي يتحقق لنا بعد غد، يحتاج ذلك إلى :
رغبتنا الأكيدة في التغيير أو التطوير وإلى فهم الأمور فهما علمياً، كما يراها المتخصصون بها، ثم العمل بدأب شديد من أجلها ولكن بحكمة وتبصر. هي ثلاثة شروط مطلوبة دائما لننجز مهماتنا بوعي ولكي لا نخطئ ..