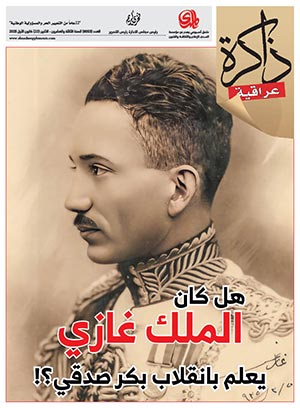... القصيدة فن شأن اللوحة، والعمل الموسيقى، والمنحوتة، فرضتها رغبة في محاولة محاكاة الطبيعة، عبر الصوت الذي تطور إلى موسيقى، وعبر اللغة فصارت ترغب بأن تتولد من ذاتها. هاجس الرغبة في التعبير عن المشاعر والأفكار، وهاجس المتعة بالشكل الذي يولده التعبير، اندفعا مع الأيام الى هواجس أكثر تعقيداً. لعل الغموض، التواصل مع غير المرئي، مع غير الأرضي، أو اعتماد الايحاء السحري في الكلمات...الخ، ليس إلا عدداً من مظاهر تطلعاتها. ولكن القصيدة في كل تحولاتها المتولدة من تراكم الخبرة الإنسانية، لم تفقد الأنْوية الأولية والجوهرية، التي تجعل منها قصيدة، لا لوحة، أو إعلان سوق، أو رواية.
من هنا أرى الحديث عن معايير عامة وثابتة لها وجودها الخاص والمجرد خارج النصوص، أو الحديث الذي يرى أن المعايير هلامية لا وجود لها، عبارة خالية من الدلالة، إذ ما من معايير عامة وثابتة خارج النصوص! وما من أحد قال ذلك في تاريخ النقد، وتاريخ الذائقة الشعرية. كما أنه ما من معايير هلامية. ولكن هذه الأحكام القاطعة إنما هي صياغات اعتدنا عليها، مع مئات مثلها، ولدتها صحافة التسلية.
شيوع انعدام الدلالة تسرب داخل لغتنا النقدية المتأخرة، على هيئة محاججة ذات قناعة حتى تبلورت في الاستنتاج الغريب التالي: " ربما كان عدم إتقان بحور الشعر الذي يعتبره البعض ضعفاً في العُدَّة الشعرية عنصراً إيجابياً يفتح الشاعر على مُمْكِنات موسيقية وإيقاعية جديدة؟". أي ممكنات موسيقية وإيقاعية جديدة تتولد من الجهل بأدوات التقنية الأولية؟ ولِمَ يصحُّ هذا في الدائرة (العربية) للأدب والشعر وحدها، لا في دائرة الشعر العالمية، ولا في دوائر الفنون، والعلوم، والحِرف، بصورة عامة.
إنني لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يكون الجهل داخل اختصاصي عنصراً إيجابياً. إنني لم أدرس الرسم في معهد أو أكاديمية، ولكنني أمارسه منذ الصغر، وفي أوقات الفراغ من القراءة والكتابة والموسيقى. الرسام رافع الناصري أجاب شكواي له مرة من مشكلة صعوبة تعاملي مع الألوان، بسبب عدم دراستها أكاديمياً، بأن هذا الضعف قد يكون فضيلة. من الواضح أنه لم يقصد أن على الرسام أن لا يدرس الألوان، وأن يحرص على جهله بعالمها الثري. لو كان حظ الرسم مثل حظ الشعر، أي أن "ثقافة الاعلام" طوته تحت عباءتها داخل الصحافة والنشر والجوائز والمهرجان، لولد مثله تيّاها بتحطيم الحدود، وحرق المراحل، وتبني فضيلة الجهل الاستنكاري. ولكن الأدب، والشعر خاصة، فعل ذلك منفرداً.
"الغياب المطلق للحساسية الموسيقية" لا يمكن أن يولّد حساسيةً من نوع خاص. الحساسية الموسيقية لا يُغيّبها حتى الطرشُ ذاته، ولقد حدث ذلك مع بيتهوڤن كما هو معروف. ولكن انعدامها لا يولّد حساسيةً خاصة حتى مع عشرة آذان. ثقافة الصحافة الناشطة، مع غياب حياة ثقافية في الواقع المعاش، جعلت قدرة التوليد الذهنية في الكلمات تقوم مقام قدرة التوليد الغائبة في الفعل الثقافي. ولذلك يبدو توليد المعرفة من الجهل ممكناً.
الموسيقى الشعرية، مثل موسيقى الآلات أو موسيقى الحنجرة، تحتاج الى خبرة ومران، الى جانب حاجتها الى الموهبة. أما "إتقان بحور الشعر"، فلا ينتسب الى المران والخبرة، ولا الى الموهبة. أنا لم أعد أذكر من بحور الشعر إلا القليل. وأكاد لا أذكر من الزحافات والعلل شيئاً. الفارق بين "إتقان بحور الشعر" وبين الحساسية الموسيقية كالفارق بين امرئ القيس وبين الخليل بن أحمد الفراهيدي. الأول شاعر والثاني عروضي. المؤسف أن كاتب "النص" هذه الأيام لا شاعر ولا عروضي.
الشاعر الذي ينفتح على ممكنات موسيقية وإيقاعية جديدة، إنما هو الشاعر الذي خَبَر ممكناتِ البحور، وممكناتِ الكلام المتدفق على لسان الناس، وممكناتِ العلاقة الخفية بين العاطفة ودرجة الصوت، وممكناتِ الغرائز البدائية الدفينة في توليد طاقة الرقص في الكلمات، وعشرات أخرى من الممكنات، دعك عن ممكنات الموسيقى المجردة أو موسيقى الحنجرة. من هنا ينفتح الشاعر على "الممكنات"، لا من جهله بهن جميعاً، وخاصة أنظمة الإيقاع الكلامي!.
من رسالة إلى متسائل
نشر في: 26 مارس, 2017: 09:01 م