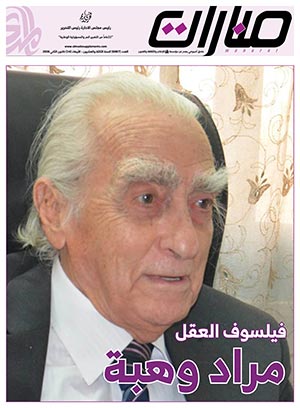يتناول الناقد والشاعر عبد الخالق كيطان في دراسته النقدية المطوّلة المنشورة في هذه الصفحة القضايا التي تهمّ المسرح العراقي خلال السنوات الماضية، وأزمة هذا المسرح، كما يسلط الضوء على مفهوم المسرحية الشعبية ، ويطرح فيها اسئلة مهمة عن الأزمة التي ي
يتناول الناقد والشاعر عبد الخالق كيطان في دراسته النقدية المطوّلة المنشورة في هذه الصفحة القضايا التي تهمّ المسرح العراقي خلال السنوات الماضية، وأزمة هذا المسرح، كما يسلط الضوء على مفهوم المسرحية الشعبية ، ويطرح فيها اسئلة مهمة عن الأزمة التي يعانيها المسرح العراقي، ولأجل إغناء هذه الورقة النقدية، فإن صفحة مسرح ستفتح باب النقاش والرد، متمنية من جميع المعنيين بالمسرح العراقي أساتذة ونقاداً وفنانين، المساهمة في إغناء هذه الورقة بتصوراتهم التي تساعد في النهوض بالمسرح العراقي الذي ظلَّ لسنوات طويلة في طليعة المسارح العربية.
المدى الثقافي
أسوأ عادات المسرح في العراق هو في غياب المراجعات. غياب المراجعات قاد الى غياب آخر، أشد خطورة، هو غياب التقاليد. هكذا يصل المسرح العراقي في أواخر العقد الثاني من الألفية الثانية إلى مصير لا يسرّ. التراكم الكمي لم يفرز شيئاً على مستوى النوع نستطيع أن نعلّق عليه الآمال. يمكنك أن تسهب في جمل انشائية عن مهرجانات المسرح هذه الأيام، وكيف أنها تتحدى الارهاب، وما إليه، ولكنك لن تصمد أمام حركة تاريخية عنيفة ومتسارعة تطالب أهل المسرح، قبل غيرهم، أن يكونوا، في أقل تقدير، امتداداً لمن سبقهم.
وأنا اكتب هذه الكلمات، التي لا تخلو من غضب عاطفي، ادرك أن ثمة شباباً ساخطين على الدوام، لن يجدوا امامهم غير الشتيمة وهم يقرأون ما لا يسرهم. لم لا. لقد اصبحت الشتيمة جزءاً من ثقافتنا. مسرحنا هو الآخر يقدم شتيمة مستمرة لجمهور يطلب عروضاً مغايرة، مختلفة، تثير الحماسة في التلقي. ولكن... ذلك اصبح من الأمور العصيّة. هكذا يلجأ منتجو عروض اليوم إلى الشتيمة مرتين، مرة من خلال عرض مملوء بالسذاجة، ومرة ثانية من خلال تعاملهم الفوقي مع ردود فعل الجمهور.
لقد مرَّ المسرح في العراق بأطوار غريبة، ولكنها غرابة لا تنفصل عن غرابة الواقع الذي يعيشه الإنسان العراقي في العقود الأربعة الأخيرة. مسائل الديكتاتورية والطغيان، الحصار والموت المجاني، ثم الاحتلال والسلطات التي ترى الفنون عامة مجرد تمظهرات لفكر المجتمع، كل ذلك دفع المسرحيين إلى انتهاج أنماط من التفكير المتناقض. فبالرغم من تشبث أغلبهم بمصطلحات الحداثة والمغايرة إلا أن حضور تلك المصطلحات في العروض المسرحية يظل على الدوام مشكوكاً فيه.
على أن ذلك ليس هو وجه الصورة الوحيد. لنعد إلى الثمانينيات. لقد كانت تقام مهرجانات عديدة تحمل الشعار ذاته الذي ترفعه مهرجانات اليوم. كل شيء من أجل النصر. معاً لدحر الارهاب. جنودنا يقاتلون ونحن نقدم الفن... إلخ. ولكن أي منصف يستطيع أن يجد فروقاً هائلة بين أنواع العروض التي كانت تقدم في تلك المهرجانات التي كانت تعقد برعاية "الديكتاتورية" وتلك التي تقدم برعاية "الديمقراطية". لا أريد أن اقع في فخ التطبيل للديكتاتورية ولا شيطنة الزمن الديمقراطي، ولكن لنحتكم إلى العروض، العروض فقط.
لقد أفضى غياب التقاليد إلى غياب جديد وأكثر إيلاماً هو غياب المعايير. وغياب المعايير هو الذي أوصل حال المسرح العراقي إلى ما هو عليه اليوم.
كان قسم المسارح في دائرة السينما والمسرح، على سبيل المثال، يخضع لمعايير عمل معينة. هنالك المخرجون، الممثلون، التقنيون. ولكل اختصاص من هذه الاختصاصات فضاء. المخرجون مثلاً، كانت غرفهم في الدائرة معلومة. يستقبلون فيها الممثلين والصحافيين على حد سواء. هؤلاء هم مخرجو دائرة السينما والمسرح المعتمدون رسمياً. كانت الدائرة تستطيع تضييف مخرجين من خارج أسوارها. وهؤلاء يعاملون بذات الاحترام الذي يعامل فيه مخرجوها المعتمدون. الأمر ينسحب على باقي الاختصاصات. الموسم المسرحي الواحد كان يشهد عدداً معقولاً من نتاجات الفرقة القومية للتمثيل. كان في هذه الفرقة بعض الممثلين والممثلات المترهلين. ولكنهم لم يكونوا بالمئات. لماذا؟ لأن معايير الانضمام إلى الفرقة لم تكن اعتباطية. ربما كانت قاسية من وجهة نظر بعض الموهوبين، ولكنها يمكن أن تقود إلى الفرقة إذا ما لفت هؤلاء الانتباه إلى تجاربهم. في كل هذا الكلام تحضرني عشرات الأمثلة، ومن المؤكد أنكم تمتلكون أمثلتكم أيضاً.
لقد شاع في الثمانينيات ما اصطلح عليه بالمسرح التجاري. والآن، لنعد إلى تلك العروض ونلقي نظرة نقدية سريعة عليها. لن نحتكم إلى الذاكرة، على أهميتها، بل نحتكم إلى فيديوهات تلك العروض الموجودة على اليوتيوب. سأحيلكم إلى العروض الآتية كعينة بحث فقط:
1.مسرحية حوتة يا منحوتة: تأليف كريم العراقي. إخراج سليم الجزائري. تمثيل: فوزية حسن، هناء محمد، عدنان شلاش، سامي الحصناوي، فاضل جاسم، زاهر الفهد، عبد علي اللامي، نصير أحمد وعماد بدن. الحان الأغاني: عبد الحسين السماوي.
2.مسرحية: المحطة: تأليف صباح عطوان. إخراج: فتحي زين العابدين. تمثيل: طالب الفراتي، عبد الجبار كاظم، ليلى محمد، هناء محمد وعماد بدن.
3.مسرحية: الناس اجناس: تأليف: عدنان شلاش. إخراج: مقداد مسلم. تمثيل: سعدية الزيدي، غازي التكريتي، ليلى كوركيس، فوزية حسن، غازي الكناني ومحمود أبو العباس.
4. مسرحية: الخيط والعصفور. تأليف واخراج مقداد مسلم. تمثيل: خليل الرفاعي، أمل طه، محمد حسين عبد الرحيم، زاهر الفهد، أفراح عباس، عزيز كريم، مطشر السوداني وكاظم فارس. وهذه المسرحية من انتاج فرقة مسرح بغداد، فيما المسرحيات السابقة من انتاج الفرقة القومية للتمثيل.
هذه أربعة نماذج لما كان يطلق عليه بـ"المسرح التجاري". أن أيّ مقارنة بين هذه المسرحيات والمسرحيات التي أنتجت في أواخر التسعينيات، وما بعد 2003، من النوع أو الجنس ذاته، ليست مقارنة ظالمة وغير منصفة فقط، وإنما مستحيلة. ومستحيلة جداً. هكذا يصح مقارنة تلك العروض بالعروض الجادة التي قدمت في هذه المرحلة. لأكن أكثر وضوحاً، وهي دعوة للنقاد والمشتغلين في المسرح بأن يقارنوا بين النماذج المسرحية الأربعة السابقة، وهي نماذج من المسرح التجاري، وبين العروض الجادة التي قدمت في الفترة من 2003 وإلى اليوم. والنقد المقارن لا ينقص من قيمة أي عرض، كما هو معلوم لأهل النظرية، بل العكس هو الصحيح. بمعنى: أن المقارنة بين جيلين من المسرح، بين نوعين منه، بين تجربتين بكل ما تتضمنه من فعاليات انتاجية تبدأ من المؤلف ولا تنتهي بالجمهور والنقد.
وفي عجالة هنا أستطيع تأشير جملة من المعايير التي كانت سائدة آنذاك والتي أدت إلى هذه النتاجات، التجارية، والتي بالرغم من تجاريتها يمكن عدها عروضاً مسرحية متكاملة لجهة الانتاج المسرحي، ولا نقصد بالطبع أنها عروض متكاملة بلا ثغرة أو أنها وصلت للمنتهى الجمالي.
أن تلك العروض تعتمد بشكل واضح على نصّ درامي فيه حبكة، شخصيات وأفعال وتوتر درامي . هذه مبادئ العمل المسرحي التي أطيح بها لاحقاً بدون أيّ وجه حق. كيف يمكن تقديم مسرحية بلا شخصيات ولا حبكة ولا أفعال ولا توتر درامي؟ وإذا كان هذا الكلام تقليدياً وساذجاً جداً بالنسبة للشباب الساخطين، فلا أدري ما تعليق اولئك الذين يعدون أنفسهم أكاديميين في فن المسرح؟ لقد تجاوز مسرح ما بعد 2003 اي معايير ممكنة في انتاج المسرحية، وحجتهم النهائية تتمثل في الحداثة. جميل جداً، ولكن غير الجميل، بل والقبيح جداً، أن تيارات ما بعد الحداثة نفسها لا تسقط معايير صناعة المسرحية بل تقوم بترويضها لصالح مشهدية عالية. مشهدية يمكن لها أن تعلق في ذاكرة المشاهد إلى ما لا نهاية. انني أفهم كثيراً مسألة التجاوز، أي تجاوز النمط والذهاب إلى الحداثة، وأفهم جيداً تجاوز الحداثة نفسها في مدارس ما بعد الحداثية، ولكن ذلك كله لم يكن عائقاً أمامي في تلقي عرض مسرحي يحتمل اشتراطات أدائية – مشهدية تبرر هذا التجاوز، وتضعه في مصاف الفن الرفيع، ذلك الذي يصعب التندر عليه، أو وضعه في سردية تحيل إلى ضبابية فكرية أنتجته.
العروض – العينة لم تكن تدّعي شيئاً من كلام النظريات الخطير هذا. بالرغم من ذلك فهي اتكأت على أبرز مدرستين في تقديم المسرح على مر التاريخ، وهما مدرسة ستانسلافسكي ومدرسة بريخت. وما بين المدرستين ثمة استفادة من المسرح الاحتفالي في توزيع المجاميع، وحركتها، وفي اعتماد الموسيقى المؤلفة خصيصاً للعمل وما إليه.
لقد اجتهد مخرجو العروض – العينة في التعامل مع النصوص التي قدموها، ويمكن تلمس مواضع الاجتهاد في خلق الشخصيات وصناعتها. وبلغة أهل المسرح الكاريكترز:
characters
فكاريكترات تلك العروض كانت متناسقة، ومنهجية جداً وخاضعة لمعايير فن الممثل. في كل تلك العروض تجد مسافات فارغة يردمها الكاريكتر، وبين شخصية وأخرى في العرض تلاحظ فروقات أدائية كبيرة تسمح للمتفرج بالتعامل معها كلٌ على حدة. تسهم أزياء الشخصيات، ورسم جغرافية المسرح، والتوزيع اللوني في الإضاءة وكذلك الموسيقى في صنع مشهدية ملائمة للشغل التمثيلي. لم يكن الممثل على الخشبة يشبه أيّ ممثل آخر عليها. المساحات الممنوحة لكل ممثل محسوبة بدقة إخراجية. حتى الممثل الجوكر، الذي يعتمد عليه المخرج تجارياً، لم يكن ليحيد عن الخطة، خطة الإخراج. قد يقدم بهلوانيات فجّة، وقد يسترسل في نكاته التي تداعب جمهوره، ولكنه بالنتيجة ممثل منضبط في سياق عرض منضبط. عرض ترفع الستارة فيه بعد ثلاث ضربات مسموعة وفي زمن معلوم، لينتهي مثلما ابتدأ في زمن معلوم أيضاً.
وفي تلك العروض – العينة كان يقدم أبن الجنوب دون الإساءة إليه. لقد كانت أحداث مسرحية "المحطة" تدور في الجنوب، ومع ذلك لم يظهر الممثل الراحل طالب الفراتي، على سبيل المثال، وكأنه ينتقص من لهجة أبن الجنوب، بل زادها احتراماً من خلال الشخصية التي لعبها، والتي أجزم أنها مكثت في ذهن المتلقي إلى اليوم. الآن قم بنظرة سريعة إلى المسرحيات التي تتعامل مع لهجة أبن الجنوب. ماذا تجد؟
وفي تلك العروض استخدام مؤثر لراقصات وراقصي الفرقة القومية للفنون الشعبية. هؤلاء فناون محترفون يتدربون على يد مدربين محترفين. ولهذا لا يمكن أن تجد الاشارات المبتذلة في عروض اليوم الرقيعة التي تستدعي راقصات الملاهي بملابسهن الخليعة من أجل إثارة الغرائز. أضف إلى ذلك، فإن عناصر الفرقة القومية للفنون الشعبية كانوا يقدمون جزءاً من موروث البلاد الفني والحضاري. في مسرحية "حوتة يا منحوتة"، على سبيل المثال، ثمة توظيف كبير في هذا المجال، بل أن بطل المسرحية نفسه هو أحد راقصي الفرقة البارزين، ويدعم الفرقة بألحان موضوعة خصيصاً للعمل، وفيها الكثير من روح التراث العراقي. كل ذلك يدفع القارئ إلى القول بعلمية العمل المسرحي. وخضوعه لضبط إخراجي واضح ومستند إلى فكر واضح أيضاً.
ويمكن الحديث بشيء من التفصيل أيضاً عن ديكورات تلك العروض، الإكسسوارات، الموسيقى والمؤثرات الصوتية، الإضاءة، الأزياء... كل تلك العناصر كانت تنتظم في معايير عمل ابتدأت من غرفة المخرج التي تحدثنا عنها، تلك الغرفة التي يجد فيها المخرج نفسه فيها متأملاً، قارئاً ومحاوراً ومستمعاً.
يمكن القول في ختام هذه الفقرة أن جهود الفنانين مقداد مسلم، فتحي زين العابدين، فخري العقيدي، محسن العلي، محسن العزاوي، سليم الجزائري، وغيرهم من المشتغلين في المسرح الجماهيري كانت محاولات جادة، في وجه من وجوهها، على طريق تقديم مسرح جماهيري خاضع لمعايير الانتاج الفني بشكل عام.
والآن، فإن تلك العروض كانت تقدم في زمن، سامي عبد الحميد ويوسف العاني وجعفر السعدي وبدري حسون فريد وصلاح القصب وفاضل خليل وقاسم محمد وعقيل مهدي وعوني كرومي وعادل كريم وعزيز خيون وسعدون العبيدي ... وكان هؤلاء يقدمون عروضهم التي تختلف كلياً عن العروض - العينة لجهة الفكر الاخراجي، ومع ذلك، فإن عروضهم تلتقي مع بعض في منطقة واحدة، هي منطقة معايير صناعة العرض المسرحي. لكل مخرج من هؤلاء، وأولئك، منهج عمل واضح وعلمي في التعامل مع النص، الممثل، الديكور، الموسيقى، الأزياء، الإضاءة والجمهور. كانت عروض الجميع تجتهد من أجل خلق متعة المتفرج. التفكير في تطوير منهجيات الإخراج المسرحي هو ذاته التفكير الذي يحسب ألف حساب للمتلقي، حتى الشاب الساخط. في كثير من المرات، وكنت من هؤلاء الساخطين، يفاجأني واحد من هؤلاء الأساتذة بسؤالي عن عرضه المسرحي، أو عرض مسرحي لمخرج آخر. كنت أقول رأيي بمنتهى الحرية أمامهم. وكانوا يستمعون بمنتهى الاحترام. لم أكن بالنسبة لهم الصانع الأمهر، ولكنني كنت الشاب الساخط الذي يحترم رأيه الأستاذ أيضاً. لقد وصلنا إلى اليوم الذي يشتم فيه هذا الأستاذ علناً وصراحة وأمام الملأ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد أنه قال كلمة، مجرد كلمة، في نقد عمل التلميذ!
ولكن كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ أن تغيب المعايير وأن يصبح المشهد المسرحي عبارة عن مشهد مكرر وممل، حتى وإن تشدق صانعوه بأنهم اجترحوا ما لم يصله الأولون؟ المشكلة بدأت في غياب همزة الوصل بين جيلين.
لقد كان جيل ما بين الجيلين نادراً. هذا الجيل يمثله بصدق الفنان ناجي عبد الأمير. انقطاع ناجي عن المسرح العراقي كان يمثل انقطاع ابناء جيله أيضاً. ناجي عبد الأمير كان وفياً للمعايير المسرحية بالرغم من أنه اشتغل في مناطق خارج سرب التوقع الشائع آنذاك. لقد كانت عروضه مناسبة للتفكير من قبل المشتغلين معه وكذلك من كان يتلقى أعماله. وبالرغم من أنه قدم ستة عروض مسرحية فقط في بغداد إلا أنها كانت كافية تماماً لكي تضعه جنباً إلى جنب مع مخرجين كبار عايشهم عبد الأمير، عمل معهم، وصار تجربة لا يمكن اغفالها، مثلهم تماماً. كانت ميزة عبد الأمير الأساس في قلقه النابع من رغبة في قول شيء مختلف، ولكنه واضح جداً. اشتغل على النص الأجنبي مثلما اشتغل على المحلي، وفي كلا الحالين كان لا يغفل أي شرط من شروط الانتاج المسرحي. وبرغم الكفاف الذي كان يعانيه، وبرغم شح الإمكانات على الصعد كافة، إلا أنه لم يكن يستسلم للضغوط، كان ينشغل اليوم كله، والليل كله، من أجل صياغة بصرية، أو مشهدية، يمكن أن تضيف، أو تبني عليه، أو تفاجئ المراقب. كان ناجي عبد الأمير يحترم المتفرج.
لقد ظهر قبل - مع – بعد ناجي عبد الأمير عدد من المخرجين، لا أريد تسميتهم حتى لا يبدو كلامي جارحاً، كما أتوقع، بالنسبة لبعضهم الساخط على أقل تقدير! والآن ماذا قدم هؤلاء؟ أو لنقل بعبارة أخرى: هل استمرت تجاربهم بذات الوتيرة التي انطلقت بها؟ كيف ينظرون هم، قبل غيرهم، إلى الوراء؟ لقد انشغل بعضهم بالإدارة، وهي مجلبة للوجاهة والمال، فتوقف أو شبه توقف عن العمل المسرحي. آخرون استثمروا في الكوميديا، ولكنهم سرعان ما استسلموا لشروطها التجارية. ثمة من استمر في الاخراج المسرحي، فهو يقدم عرضاً في كل موسم تقريباً، ولكن العروض التي يقدمها تسجل تراجعاً مريعاً في كفاءته الاخراجية. ثمة من أصبح نادراً في اشتغاله المسرحي لسبب أو آخر. المشكلة الأعظم، أن أغلب هؤلاء لم يستطيعوا أن يكونوا امتداداً لجيل المعايير الواضحة الذي تحدثنا عنه. كما أنهم لم يتجاوزوهم. لم يستطيعوا أن يقدموا عروضاً تطيح بأساتذتهم، بل ظلت أعمالهم تتراجع حتى ظهر بعدهم مخرجون جدد استطاعوا في عروض نادرة أن يقدموا فناً جديداً، يمكن التوقف عنده، وأبرز هؤلاء هو المخرج مهند هادي.
لقد فهم مهند هادي موقعه في خريطة المسرح العراقي، وأراد أن يسجل حضوره، ففعل في ثلاثة عروض هي من أبرز عروض ما بعد 2003 المسرحية. اللافت هنا أن مهند هادي لم يستطع البقاء في بغداد لأسباب تتعلق بعضها بالمنافسة!
مشكلة الكثير من المخرجين الذين نتحدث عنهم، والذين تواصلوا بعد العام 2003، هو أنهم لم يستطيعوا الوفاء لمعايير صناعة العرض المسرحي. كانت عروضهم، خاصة التي شاركوا فيها بمهرجانات عربية، خطابية على الأغلب. الشكل المسرحي ظل فقيراً، ولا عناية بالممثل. لا يمكن أن نتحدث عن عرض مسرحي يغفل أهم شروطه: النص المسرحي. نصوص معدّة اعداداً سريعاً، أما النقطة الثانية، والقاصمة حقاً فهي عمل الممثل. انك تستطيع أن ترى بوضوح هؤلاء الممثلين بكروشهم المتدلية والممثلات اللواتي يمكنهن أن يصنعن أجود الأطعمة بعيداً عن المسرح بوضوح في عروض هذه الأيام. الحركة اعتباطية وبلا معنى. والصراخ هو سيد الموقف. الممثل يكتفي بعدّة تقليدية لم تعد تناسب هذا العصر السريع، والمخرج سعيد جداً بجمل المديح التي يكيلها له المحيطون به. لا يوجد أسهل من تقديم عرض مسرحي بهذه المواصفات. عرض يشتم متلقيه ذلك أنه يعتبره أقل شأناً منه. عرض بلا تعب. مجرد تمارين روتينية. تمارين لا صلة لها بتلك التمرينات القاسية والطويلة والمثيرة التي دأب عليها سابقوهم. من المعيب، كما أظن، أن تقدم عرضاً لا يحتمل شيئاً من الاجتهاد ولو على سبيل تقديم الشكر والعرفان للمتلقي، دعك من وظيفتك الجمالية والفكرية في سياق تاريخي معين!
لا ننكر، كما أسلفت، وجود تجارب جديدة تحاول أن تجتهد في ظل قتامة الواقع، ولكن السؤال الذي ألحُّ في طرحه، وأتمنى ألا أكون فظّاً في ذلك، يتمثل بغياب المعايير التي لولاها لما تحدثنا عن فن المسرح. كما أن غياب أساتذة المسرح عن المشهد مكّن، بشكل أو بآخر، ما نتحدث عنه من غياب للمعايير.
المسرح العراقي اليوم في مرحلة حرجة جداً في تاريخه. لقد بدأ يضغط، زحف الظلام عليه بقسوة، وإذا ما أراد المشتغلون في المسرح أن يفعلوا شيئاً فلا توجد وصفة أبلغ من الاستماع إلى شيوخه الكبار والشباب الساخطين على حد سواء.