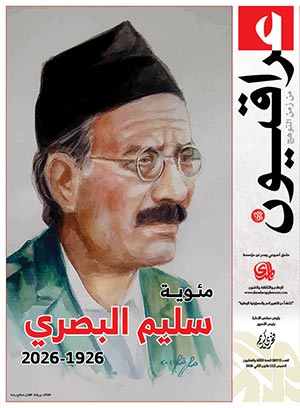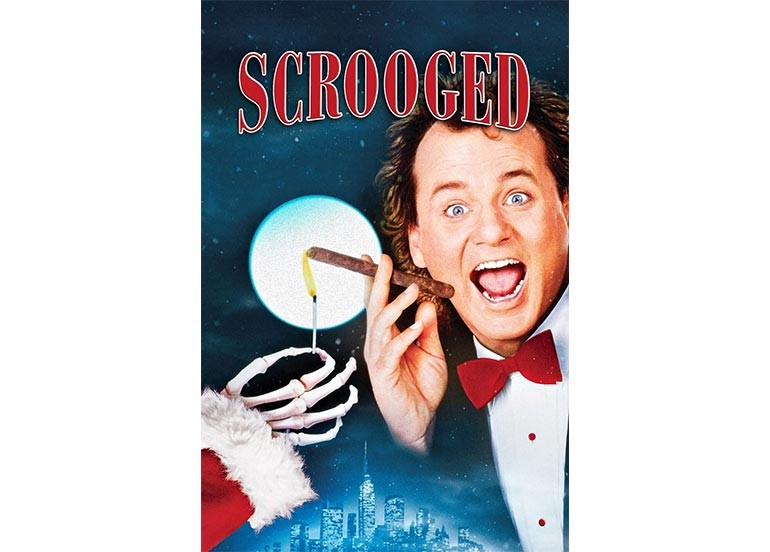كم مرة تذهبون، في هذه الأيام، إلى السينما؟ وهل ما زال يغمركم الاحساس بالمناسبة المشتركة و تصيبكم الرعشة لمنظر الشاشة العملاقة في الظلمة المثيرة الدافئة؟ أم أنكم أصبحتم متحررين من الوهم مع ذلك السيل المستمر من الأفلام المعززة بالواقع التي تُبرز الأبطا
كم مرة تذهبون، في هذه الأيام، إلى السينما؟ وهل ما زال يغمركم الاحساس بالمناسبة المشتركة و تصيبكم الرعشة لمنظر الشاشة العملاقة في الظلمة المثيرة الدافئة؟ أم أنكم أصبحتم متحررين من الوهم مع ذلك السيل المستمر من الأفلام المعززة بالواقع التي تُبرز الأبطال الخارقين، والقطع السابقة من ألعاب الكومبيوتر، أو الممثلين الرائعين غير المصحوبين الآن بالأكسسوار العصري الأساسي وضمان الحضور، المسدس؟
إن مجرد طرح السؤال، يقول تشارلس نيفين في مقاله هذا، قد يفرزني واحداً من الجيل القديم يصعب عليه جداً استساغة ما هو جديد، وصاخب، وسريع. و حتى والأمر هكذا، لا يزال من المدهش أن الأفلام قد صمدت جيداً، بوجهٍ خاص في البلدان الأكثر تطوراً، في وجه الخيار الأعظم و المدخل الأسهل التي توفرهما شاشات محمولة، شخصية، أصغر. و الميول، مع ذلك، غير مشجعة لدور الشاشات الفضية ، خاصةً بين الشباب: إذ ذهب المراهقون في أميركا إلى السينما عام 2012 بنسبة 20 % أقل من عام 2009.
عندئذٍ يمكن أن يكون مستقبلها في الماضي، وهو يخدم سوقاً محدودة لماهو حنيني و تهكمي. و في غضون هذا، وكواحد تخلّى قبل بعض الوقت لمتعة التلفزيون الأكثر كسلاً، فإني استخدم تجهيزات العصر الرقمي digital-age للتفرج على أفلام قديمة في البيت ــ الأفلام القديمة التي سمعتُ عنها كثيراً ولم أشاهدها أبداً، موشّاة بالأفلام التي كنت أريد رؤيتها مرة أخرى، بقدر ما يود المرء رؤية أصدقاء قدماء.
بالنسبة لمتبنّي التكنولوجيا الكبير في السن، كان عليها أن تكون عند الطرف الأقل تحدياً: أقراص الـ DVD المستأجرة بواسطة البريد، لا تزال تقدماً معتبراً على تلك المنتخبات المتجرية القديمة المتخصصة في الأغلب في جاكي تشان (ممثل ومغنٍ من هونغ كونغ) أو مراهقين يتصرفون بجنون، مع مناشير جنزير في الغالب. وينبغي أن أشدد، أيضاً، على أن شروط الاختبار كانت تتّسم بالتحدي تماماً: رؤية التلفزيون المشتركة (في الدقائق الافتتاحية، في الأقل) مع طفلين بالغين مغرَّضين prejudiced ضد أي شيء أحادي اللون، وشريك غير مستعبد كثيراً لإغراء الماضي، وتحريم ثابت منهم جميعاً على أفلام الغرب (أفلام رعاة البقر والهنود الحمر الأميركية).
ولقد بدأتُ اختيار كلاسيكياتي المنزلية برائعة مارسيل كارني، " أطفال الجنة Les Enfants du Paradis ". واتذكر قول أحدهم لي عام 1987 بأن عليَّ أن أرى قصة 1945 هذه عن دلّوعة باريسية من القرن التاسع عشر وعشاقها و المعجبين بها، و منهم رجل غني، وممثل، و فنان محاكاة، ولص. و أنا الآن أفعل ذلك. وهو فيلم طويل طويل جداً (ثلاث ساعات وعشر دقائق) و آرليتي، التي تقوم بدور الدلّوعة، عجوز جداً؛ و كما هي الحال في أفلام قديمة كثيرة، فإن طب الأسنان قضية بالنسبة للحساسيات الحديثة المبتذلة. لكن كارني أنجز شيئاً ما نادراً جداً في الأفلام، لحظة سحرٍ آسرة تقلب القلب رأساً على عقب، في مشاهد حشود لافتة للنظر ــ مرسومة في باريس أيام الحرب من المقاومين و المتعاونين ــ حين يقدّم بابتيست، فنان المحاكاة الذي يمثل دوره جان ــ لويس بارول، عيّنة ساحرة خارجاً في الشارع مما يقدمه داخل المسرح. ولا يمكنني أن أفكر هنا إلا بمشهد آخر واحد يباريه، حيث يستدير لوريل وهاردي في فيلم "Flying Deuces" (1939) نحو الكاميرا ويرقصان بأسلوب معين، ويمكن أن يكون ذلك خياراً مخصصاً لذلك.
وانتقلتُ، متشجعاً لكن باحتراس أكثر، إلى " لصوص الدراجات " للمخرج الإيطالي فيتوريو دي سيكا (1945)، الذي يبرز بشكل ثابت في قوائم الأفلام العظيمة. وكان الجهل، زائداً ذكرى باهتة عن دي سيكا أنيق مبتسم في المسلسل التلفزيوني الخفيف في الخمسينيات، "الرجال العادلون الأربعة"، قد تركاني غير مستعد لحكايته الأخلاقية القاسية عن الرجل الفقير المدفوع لسرقة دراجة لأن شخصاً ما سرق دراجته هو. وكان فيلماً واقعياً neo-realistic جداً بالنسبة لي، من دون أيّ تنشيط للدعابة التي يبدو أن المشاهدين بحاجة إليها الآن سواء كانت مناسبة أم غير مناسبة (ولقد سمعتُ مؤخراً أن أحدهم وجد شيئاً ما يضحك منه في المشهد الأخير من الفيلم المأساوي "عُطيل "!).
لقد فسحت الواقعية الجديدة منذ ذلك الحين المجال لموجة عاطفية من الأفلام الإيطالية، و منها " سينما براديسو " (1988)، "إيل بوستينو" (1994)، و "الحياة حلوة" (1997)، باعثةً الدفء في الترفيه المنزلي، وقد جعلت سابقاتها تبدو أكثر صرامةً حتى.
و كان " النمر The Leopard " لفيسكونتي (1963) أفضل مثال على فيلم تبدأ مشاهدته بكل روعته الفخمة على الشاشة الكبيرة. وكنت أتعرف، متأخراً مرة أخرى، على الثغرة التي يمكن أن تقوم ما بين مزاج وعادات زمن صنعِ الفيلم وزمن مشاهدته. فقد تمتعت تماماً في حينه بفيلم الفكاهة المتعدد الإخراج و المتعدد الشخصيات الرئيسة و هو "كازينو رويال" (1967)، فيلم بوند الذي انطلق من بروكولي و سالتزمان؛ وهو الآن ساذج جداً إلى درجة أنه غير قابل للمشاهدة.
بمثل هذه الرؤى النقدية والتحفظات في ذهني، توصلتُ لما يمكن أن يكون توصيتي الأكثر إثارةً للجدل، بالنسبة لي بالتأكيد: لا تشاهد أبداً مرة أخرى الأفلام التي أحببتَها في شبابك، إذ أن الشباب يُعير تعجباً وتسامحاً يُبطلهما ويترفع عنهما التقدم في السن. وهو ما ينطبق على مسلسل الهزليات البريطاني "Carry On" وتأمل بيرغمان المتعلق بالقرون الوسطى (1957).
وهناك أفلام لم تفشل، على نحوٍ غامض، أبداً، بالرغم أو ربما بسبب كونها أخف من الأفلام الكلاسيكية :" فتيان و دمى "Guys and Dolls (1955)، حتى مع سوء إسناد الدور لمارلون براندو؛ "فطور في فيتاني" (1961)، "الرجل الثالث" (1940)؛ و "كازابلانكا" (1942) لكتابته التي لا تُضاهى، كما في تذكر ريك المختصر المثلوم لعلاقته الغرامية مع أيلس في باريس قائلاً "إني اتذكر كل تفصيل. فالألمان كانوا يرتدون الرمادي. وأنت كنت ترتدين الأزرق".
وكانت هناك بعض الاكتشافات المتأخرة الرائعة، مثل ملحمة شكسبير المعاد ترتيبها "أجراس في منتصف الليل Chimes at Midnight " لأورسون ويلز (1965)، بمشهده القتالي الذي لم أرَ مثل حيويته الفريدة، و "نساء على حافة الانهيار العصبي " لألمودوفار(1988)، وهو مباراة رائعة للوقار الأسباني مع الاستهتار الأسباني، وغيرهما من الأفلام الكبيرة.
عن: INTELLIGENT LIFE