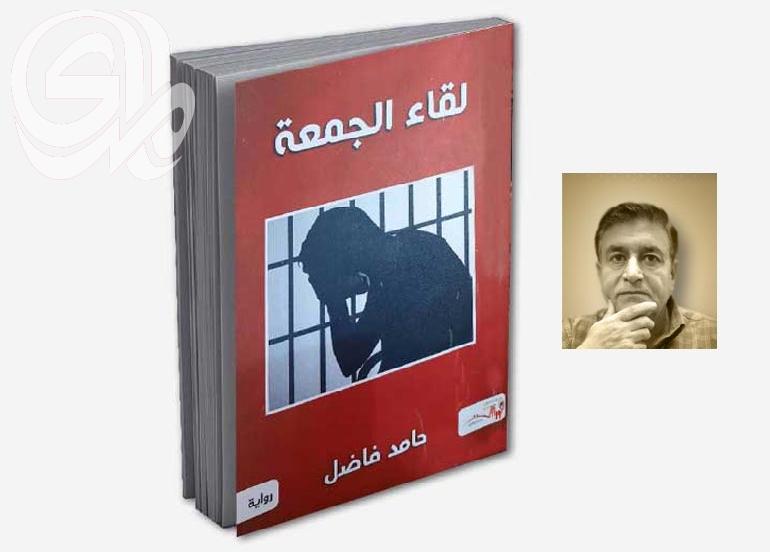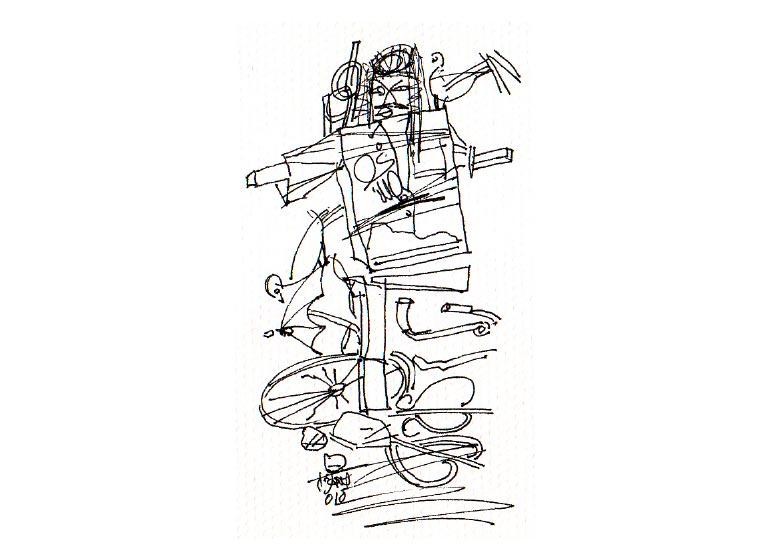ياسين النصيِّر
- 1 -
دأب الروائي حامد فاضل على أن يبني بيت قصصه ورواياته في بادية السماوة، ويؤسس لمروياته ولمدوناته فيها أرضية راسخة على ثقافة وعمق تاريخيين،
فقد اكتشف فيها بقعته الخلاّقة، فنهل منها جدلية أزمنتها وأمكنتها المشتركة مع حياة الناس وأفعالهم، ومع تراث البادية وعمقها المثيولوجي، الأمرالذي جعل ثيمة البادية ومن ثم مدينة السماوة مكاناً كونياً أو اللامكان المحدد بأشخاص أو حدث معين، بل هي فضاء لا مكاني لكل التواريخ القديمة فيها والحديثة، وما سوف ينفتح أفقها فيها على الأزمنة. إن عالمه الفني الذي شكله في هذه البادية؛ لم يتخذ شكلًا فنيًا لمسروده فقط، بل جعله يرافق التنوع بين السرد ،والحوار، والوثيقة، والمدونة، مما جعله هوالآخر لا شكلاً محدداً لمسوردة.
وهذا ما وجدناه، كما سنرى في فنية رواية "لقاء الجمعة"، حيث جمع فيه كل صنوف السرد الصحفي، واليومي، والقصصي، والحكائي، فأصبح اللقاء لازمنياً محدداً بنوع محدد من المسرود. فالمجاورة والمحاورة ما هي إلا أحدى صور البادية الخطابية؛ أسس من خلالها خطاباً يجمع بين قديم البادية وحديثها: الحكاية والحداثة، الحدث المحلي الشعبي، بجوار الحدث الكوني المثيولوجي التراثي، فأسس له طريقة وأسلوباً للسرد تحمل خصوصية هذا الفضاء البيئي مختلفاً به عن المسرود في قصص الريف أوالمدينة. كما وجد في البادية الأبعاد الأسلوبية المضمرة للمخفي من التاريخ الشعبي غير المدون، الأغاني والأمثال والتقاليد والأعراف، كصيغ للتاريخ الشفاهي الذي يتداوله رواة البادية، ثم يضيفون إليها ما يستجد، فالذاكرة كتب الأمكنة الحكاءة، وكما يقول تودوروف" الكتاب الذي لايروي أية حكاية يقتل" ولذلك بقيت البادية حية في نماذج من المرويات، لوجود "حائك كلام" يلازم تحولاتها. وهذا هوالسبب الذي جعل حامد فاضل يعود إليها لاكتشافه "بصيّات" تحكي ، فتمثلت عودته كأحدى صورالرحالين الكبار الذين يجدون بيوتهم مجرد نافذة على مرجعياتها، هذا ما سرده السندباد في رحلته الثامنة وهو يعيش في بيته ببغداد مستعيداً فيه رحلاته السبع كلها، ثم يترك الرحلة الثامنة لحمال المدينة أن يصوغها في سفراته اليومية في أزقتها وهو يحمل حاجات الناس ليوصلها إلى بيوتهم، فالمحايثة للأحداث المعاصرة في لقاء الجمعة تتم بين ما هو معاصر(السجناء الشيوعيين"، التي تمتد بجواره مثيولوجيا أمكنة البادية، وما هوميثيولوجي قديم وجد صورته المتجددة في حياة هؤلاء السجناء. وتجد أن الرحلتين في المثيولوجيا وفي المدينة المعاصرة تتم عبر سيارة تكتك وسيارة قديمة ولابتوب حديث. هذا العالم الفني المابيني (بين البادية والمدينة)، جعله يعتمد على أفعال المدينة والبادية، هو من صلب جدلية العلاقة التبادلية، أي علاقة الأمكنة المتناقضة في وحدتها مع حاجات الناس وتفكيرهم الاجتماعي لها. حتى لو كانت الأفعال حديثة وبتقنية الكومبيوتر الخوازمية. ثمة عالم خفي في الحياة اليومية والمألوفة اكتشفه الروائي ليغذي به هذه التداخلات ، فعالم الروائي المقروء، هو العالم الواقعي والفني الذي أسس له المؤلف خصوصية أسلوبية تميزه عن العوالم الأخرى المختفية في الرمال، لقد أرسى سفنه البحثية على فنارات الصحراء وواحاتها وآبارها ورمالها، بجوار حكايات رجالها القدامى والادلاء المختلفين، وجعل من تقاطعاتها مراسي لأقدام تبتعد كثيراً عن الأمكنة المدينية المعاشة بالرغم من أنها منطلقة منها. وهذه ثيمة لامكانية حيث لا ترتبط الرواية بأية بقعة أو حيز ذاتي. لذلك لم يجد القارئ فارقاً كبيراً بين بدوي يتكلم لهجة البادية، ويحمل في الوقت نفسه لابتوباً حديثًاً يسجل فيه تحولات حكاية عن مجموعة سياسية كانت هنا وما تزال جزءًا من ذاكرة مدينة اليوم. فما بين عالمي البادية وتقنية اللاب توب: الواقعي والمتخيل، بني حامد فاضل نصه الروائي وفق الصيغة الحداثية لرواية العوالم المتداخلة التي تتشكل في اللا- المكانية المعينة، مستعينا بتقنيات التداخل الزماني والمكاني بين تقنية اللابتوب المعاصرة، وحوارات شخوص سياسيين واجتماعيين عاشوا وتنقلوا في أمكنة مختلفة ينتمون لفكر جدلي هو الآخر لايرتبط بزمان ولا مكان محددين، فالفكر الماركسي، أممي في أزمنته وأمكنة ،ولم تكن غير البادية نموذجاً لاحتواء هذه الكونية له التي تتوافق مع أممية الشخوص والأفكار. وكأن دائرة الزمكان تتبع خطواتهم حتى أدخلتهم في تقنية الحداثة الكونية للكتابة "اللابتوب" ثم ضاع كل شيء في وهم هذه التقنية، ولم يبق منها إلا إعادتها شفاهياً أو عبر مرويات أشخاص تداخلوا في الاسم والوظيفة مع أمكنة وأزمنة البادية (نجم السماوي، سهيل السماوي، سارة السماوي)، ثم في الانتماءات وفي التحولات. فاللابتوب بنية فضائية كونية ومرآوية، وليس مجرد جهازللحفظ، سنجده يرتبط بثيمة المجال، الفضاء الذي تختلط فيه كل الاتجاهات، وفي صورة أخرى له نجده الفضاء السرمدي الذي يمثله، وقد تحول إلى رموز وإشارات ورياضيات خوارزمية، فثيمة الفضاء التقني في الأدب، يعني ثمة فضاء آخر بجوار فضاء الأمكنة، لأن " فلسفة الفضاءات هي تصورٌ نظريٌ مجرّد للفضاء، أي مجموعة التصورات والتفسيرات والمعاني التي تشغل الفضاء. وفي أمكنة في فضاءات "بادية السماوة"، تتوالد العوالم المختلطة بين السماء والأرض، كتوالد الرمال أي التكاثر عبر التكرار.وهي عوالم الحكاية نفسها وهي تنشطر، عندما لا تغيّر ثوبها الخارجي واستهلالها وخاتمتها، فالحكاية عند حامد فاضل بنيت بطريقة تستوعب طرائق فنية حديثة للمسرود،وهي التنامي بين الأمكنة القديمة المثيولوجية، وحياة المدينة المعاصرة. لذلك لا يتم عمران المدن الصحراوية، أو مدن البادية إلا في باطنها، وليس على سطحها، والناس عندما تتشبث بالماضي فيها هو اتصال بهذا التطورالباطني من العمران، لتؤكد سياقاً صيانياً لايرى فيه إلا كلية الحكاية وهي تتلبس ثوب المعاصرة. لذلك انصب الحديث على ما كان، فنجد الأمكنة القديمة تتحكم بأية حركة جديدة للأمكنة المعاصرة، وأن أية حركة اجتماعية حديثة لايمكنها أن تنهض دون أن يصاحبها الماضي. هذه الثيمة مُضمرة في أمكنة الرواية وحكاياتها، والروائي استثمرها من خلال الرحلة في شعابها، التي رسمت معالمها الأبار والكثبان والمنمنات التراثية والمرويات، ولذلك لا نجد في مثل هذه الأمكنة أية عوالم معاصرة قائمة لذاتها، أوعوالم يمكن تطويرها، كل عوالمه مختلطة. فالتراث يسحب المدنينة إلى مكامنه القديمة، ويبقيها هناك تستحم في حمأة التكرار، هذا ما يفعله القاص محمد خضير في حفرياته أيضاً، وإذا كان ثمة تطور لهذه الثيمة الكونية تصبح معادية للحداثة، لانها ثيمية صيانية كما يبدو مآلها سجون الأعماق والرحلة المكررة للتاريخ السياسي القديم، أو الارتباط بتلك الأثريات المدفونة في الحكايات . البلاغة التي تنشأ في مثل هذه الأمكنة بلاغة الإعادة والتكرار، والمؤلف أجهد نفسه كي يجد نوافذ مضيئة في نوافذها كي يستوعب بعض مدن الحداثة، إلا أن حامد فاضل يفاجئونا دائماً أن حركة التحديث تكون في باطن البادية، فالتراث في حين يمتلك أدوات بحث معاصرة كالنزول إلى الأعماق، أي زيادة الارتباط بالقديم، تمكنه هذه الأسلوبية من إكتشاف هوية الإنسان المعاصر، الذي يسير وعينه على تراثه. وربما وجدنا الصورة الهامشية لهذه العودة، صورة المطعم الفلسطيني في شارع مترب ومغبّر ومهمل، سيكون هو المكان الذي سيجد الروائي فيه اللابتوب المسروق أي الزمن المقبل لفلسطين، فالإنسان لايشعر بحريته إلا من خلال قيوده، هذه مفارقة أملتها وضعية الأمكنة القديمة المهيمنة، تلك التي أسندت بالتقاليد والأعراف وحكايات البادية والنصوص الدينية، ولذلك ما أن فكر الروائي بالتغيير من خلال سرد ما يحدث على سطح البادية ضاع اللابتوب، وضاعت خيوط الحكاية الأولى، ليصبح البحث عن الاثنين بحثاً عن الحقيقة الهاربة في الأعماق، أن تعود دائماً إلى الجذور، يعني أن تتمكن من الحاضر،هكذا شكّلت رحلة السجناء في البادية باتجاه نقرة السلمان؛ عودة لاستنهاض قيم البادية وتقاليدها، وتخلت البادية عن مروياتها لتستبدلها بمرويات الشيوعيين، وهم يقطعون مسافات معلَّمة بالكيلومترات فيها، فالبادية ما زالت تتحكم ليس بالسجناء وحدهم، بل في عموم تشكيلة السلطة. فاضطر الروائي الى الدوران المتعب للبحث عن تقنية الاستبطان الذاتي لذاكرة الشخصية المحورية"سهيل السماوي" حين تشظي إلى شخصيتين، أو ثلاث بقصتين وروايتين،لاستكمال بناء نص رحلته في البادية. دائماً ترافق رحلة البحث عن مصائر بشرية رحلة في تشظي الشخصيات المهيمنة، ومن هنا يأتي جديد هذه الرواية لأنه من الصعب عليها أن تلحق بركب التقدم وهي تسكن تراث الماضي المسحوب إلى الجذور وحده، ستصطدم أدواتها الفنية بعقبات كثيرة تمنعها من التطور، لأن شخصيات الرواية دائماً تبحث عن مصائرها وهي مختفية، إما في السجون أو في اللابتوب، أو في الذاكرة العامة. إذ لا يمكنها مواجهة العالم العلوي للمدينة ما دامت أرجلها مقيدة. ولذلك غابت حياة المدينة من الرواية، وحضرت حياة البادية، كما غابت القضايا التي سجن الناس من أجلها وحضرت فلسطين كمقهى شعبي في شارع مترب، لأنها مازالت مداراً لصيقة بحديث الناس اليومي.
في بنية المسرود الفني نجد عين المؤلف دائماً على الأرض أو في حركة سير بطيئة ، ستوتة أو مشياً على الاقدام، هذا الغياب لعناصرالمدينة لايجعل من اللابتوب السريع التقنية تعويضًا عن حال مدينة رأسها مدفون في الرمال، فالسماوة لوحة مرسومة بريشة مستشرق ملأ مساحاتها باللون الأصفر الترابي، أما سماؤها فلا تختلف عن أرضها، كلتاهما يشكل عامل تقييد لحركة الشخوص، فاستعانوا بالسيارة الخشبية، وبدليل بدوي خبير، هو حائك كلام الرحلة، يرشدهم الطريق. فالبادية التي يسكن في أعماقها دليلها، تحتاج إلى حكواتي متمرس، يكون مؤلفاً وراوياً ودليلاً وعالماً وقارئ المخبوءات في أمكنتها، إنه عالم مكاني كلي وسجل مدون لتاريخ اللا أمكنة. بينما اختفى الروائي وراء مقود السيارة، مجرد عين ثالثة ترى الطريق، لبناء نص الطريق الصحراوي، شخصياته مقيدة بالحديد، ومنقادة بسيارة خشبية محروسة بالشرطة،ومسارها مرسوم في خارطة تحددها علامات البادية وكأنها تقاطعات اللامكان الشمولي. أما شخصيات المدينة النامية فهم أصحاب دكاكين وتجار صغار ممارسون، أي هم من فئة " الممارسون؛ مشاة أو راجلون كشكل أولي... حيث تخضع أجسادهم إلى فيضان النص الحضري وطلاقته، يكتبونه دون أن يتمكنوا من قراءته، ينتفع هؤلاء الممارسون من الأمكنة المتوارية، ولهم فيها معرفة عمياء على غرار التلاحم الجسدي الغرامي . الدروب التي تتشابك (قصائد مجهولة حيث كل جسد توقعه فيها أجساد أخرى) ... ". وهي الشكل المتواري للقصة اللامكتوبة، في اللاب توب قصة العمام والأنساب والاقارب وقصة سارة السماوي ، وقصة الحياة المختفية قصة الحكائون الأقدمون الذين بنوا مدينة البادية من الكلمات مشكلة حكاياتهم الظل الموازي لقصة اللابتوب المفقود، لقد أصبحت الحكايات الثانوية هي "ما يستوهمه السكان الأصليون، هو عالم مغلق وموَّسس بشكل نهائي، وبالمعنى الدقيق للكلمة، ليس عليه أن يكون معروفًا. إننا نعرف عنه أصلًا كلَّ ما يجب أن يعرف: الحقول، الغابات، والينابيع، والمواضع المميزة، وأماكن العبادة، والنباتات الطبية، من دون أن ننكر الأبعاد الزمانية المرتبطة بمسح كامل للواقع الراهن الذي تؤكد صحته وتدعم استقراره السرديات الاصلية والتقويم الشعائري، وفي هذه الحال يجب أن نجد ذواتنا فيه. كل حدث غير متوقع يقتضي التفسيرَ ولو كان متكررًا، ويمكن استشعاره تماماً، من وجهة نظر طقوسية، في حالات الولادة والأمراض والوفيات،لا لكي يُعْرَفَ حصراً، بل لكي يتم الاعتراف به، أي لكي يخضع لمتطلبات خطاب وتشخيص يعبر عنهما بكلمات منتقاة لا تصدمُ حراسَ الصراطية الثقافية أو التركيبة الاجتماعية" ( )
1 - العين والإبرة عبد الفتاح كليطيو ترجمة مصطفى النحال شرقيات، ط1، 1995، ص49، الهامش 15. -
2 - سوسيولوجيا الفن، ناتالي إينيك، ترجمة حسن جواد قبيسي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت- لبنان، الطبعة الاولى، 2011، ص 32-
3 - ابتكار الحياة اليومية، ميشيل دي سارتو، ترجمة محد الزين ، ص 183-
4 - مايكل أوجيه، اللا أمكنة ص 49