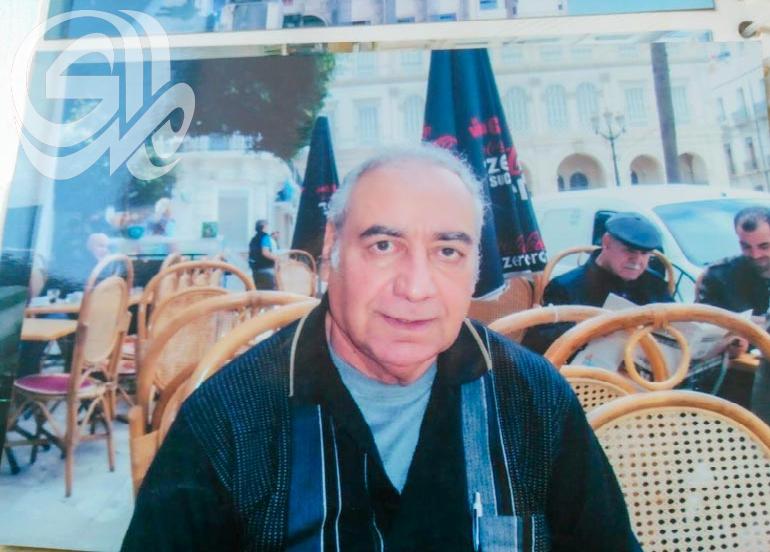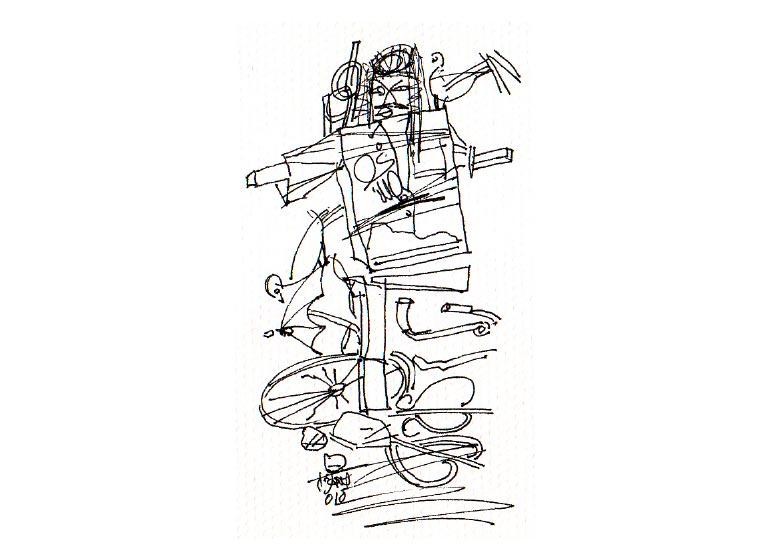يرى أنه لابد من رؤية متكاملة للتعامل مع الموروث ورؤية طرق توظيفه
حاوره: علاء المفرجي
القسم الثاني
جهاد مجيد المولود عام 1947 يعد من جيل الستينيات، فقد بدأ النشر منتصف هذه الحقبة في مجال القصة القصيرة فأصدر عام 1972 أولى مطبوعاته هي (الشمس في الجهة اليسرى) وهي مجموعة مشتركة مع كتاب آخرين.. ثم أصدر عام 1988 مجموعة اخرى حملت عنوان (الشركاء) . وكانت اخر مجموعة قصصية له هي (الرغبة السامية) التي صدرت عام 1989. تقول الناقدة نادية هناوي عنه: جملة جهاد مجيد رصينة قوية تدل على ثراء الكاتب اللغوي وخزينه المعرفي في ما يكتب. مشددة على ضرورة دراسة اعمال جهاد مجيد الروائية من قبل النقاد."
فجهاد مجيد لأعماله خصوصية جهاد مجيد في السردية العراقية، فقد اتجه الى الرواية وأصدر اولى رواياته ( رواية الهشيم)، عام 1974. ثم (رواية (حكايات دومة الجندل)، عام 2001 ، و (رواية تحت سماء داكنة)عام 2010. ثم رواته الحديثة الاصدار (أزمنة الدم) عام 2016، منازع التجريب السردي في روايات جهاد مجيد، للباحثة الدكتورة نادية هناوي ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت، طبعة أولى، 20116.
*في رواية (دومة الجندل) اعتمدت لغة تراثية تضمنت أيات واحاديث قدسية وحتى الشعر العمودي هل كان ذلك بسبب طبيعة الأشخاص والأحداث؟
ليس الذهاب إلى الموروث غاية في حد ذاته ولا هو مجرد إجراء شكلي، لابد من رؤية متكاملة للتعامل معه رؤية له كمادة خام, ورؤية إلى طرق توظيفه ، الموروث بالنسبة لي مادة ماثلة للعيان ، ماثلة في الواقع الذي اعيشه، مختلطة بحيثياته. وسبل تعاملي مع الموروث هي ذات السبل التي اتعامل بها مع الواقع القائم ، المنطلقات ذاتها، وثمة رؤية واحدة للتعامل مع (الواقعين) لاني أحسب الموروث واقعاً حياً ، والنهل منه ومن الواقع الراهن بنفس الدرجة ولنفس الغاية والتي هي تخليق واقع نصي قوامه الالفاظ، الواقع النصي واقع ملفوظات، ومقتضيات التعامل مع الموروث كواقع حي البحث في موضوعاته المختلفة أي ملفوظاته واستقدامها وامعان النظر في تشكلها واستثمارها في التشكيل.
ولابد من الإشارة الى أن دومة الجندل استحضرت كل الملفوظات التراثية وغير التراثية وكل ضروب الأشعار العمودية والحداثية وحتى الشعبية .
*في روايتك(تحت سماء داكنة)كان موضوعها هجرة المثقفين والأدباء والتي شملت الحديث عن ذلك من خلال الدلالة الرمزية ابتداء من عنوان الرواية والذي هو البنية الاستهلالية, ماالذي تقوله عن هذه الرواية؟
-موضوع هجرة المثقفين هو ناتج عرضي في هذه الرواية وقف عنده باحث من جامعة اسطنبول هو الدكتور عبد الجبار محمد الغريري في بحث قدمه إلى مؤتمر عن أدب اللجوء والهجرة عقد في اسطنبول عام 2019 الموضوع الرئيس للرواية هو تسجيل الهجمة القمعية الشرسة التي شنتها الأجهزة الأمنية الصدامية نهاية السبعينيات على الشيوعيين واليساريين والتقدميين بغرض التصفية الجسدية أو التسقيط السياسي أو التشريد خارج الوطن. وقد التقط الباحث الغريري الأمر الأخير وتتبعه كباعث من بواعث الهجرة عن الوطن واللجوء الى المنافي . لقد كنتُ في آتون هذه التجربة واكتويت بنارها وعشت معاناتها مع رفاقي واصدقائي ومعارفي ، واجهنا شتى صنوف القمع والأساليب الوحشية , ودرأنا مخاطرها بكل ما نستطيع, ولم نستسلم لمشيئة الدكتاتور ولم نمكنه من فرض إرادته التعسفية التي حسبها يسيرة.
فتركنا وظائفنا وهجرنا منازلنا وتشردنا في المدن والقصبات والقرى سعيا إلى ملاذات آمنة من بطش النظام البوليسي وزمره المجرمة التي مارست أقسى صنوف التعذيب لمن سقط بيدها من المناضلين، كانت هجمة افظع واشنع من الهجمات الفاشية والنازية. وسط هذه الأجواء كتبتُ روايتي (تحت سماء داكنة) في ميدان أحداثها في عام 1979 أشرس أعوام الحملة حيث اشتداد ضراوة ماكنة القمع الديكتاتورية في القتل والتعذيب والملاحقة واشتدت معاناة المناضلين الذين أخذت تضيق بهم السبل ، وتنفد وسائل المواجهة ،هاموا على وجوههم إلى كل الملاذات المفترضة، ناموا في عراء الاماكن العامة.. في القطارات الليلية، في البنايات المهجورة لكن عصابات القمع الصدامية كانت توقع بهم واحدا تلو الآخر وتفتك بهم بلا رحمة حتى وجدت الشخصيتان الرئيستان في الرواية ـ أنا وزوجتي ـ وجدا نفسيهما وحيدين, مقطوعي الصلة بالرفاق وبالأهل, مختفيين في مكان يكتمان فيه حتى أنفاسهما؛ فشرعتُ حينئذ بكتابة الرواية، إنها رواية في الميدان، فاخترت لها التسجيلية منهجاً فنياً وهو ما يناسب مادة هذه المعاناة ، وعملت منها نسختين .تمكنت من تهريب أحداهما والاحتفاظ بالأخرى في مخبئي. وبعد سقوط الديكتاتور ونظامه البوليسي اخرجت نسختي المخبأة ونشرتها كما هي ضمن أعمالي الروائية التي صدرت في دمشق عام 2010وبعد ذلك باعوام وأنا في تركيا اتصل بي ولدي ليقول لي :أن شخصاً اتصل بي واخبرني بأنه يحتفظ بأمانة لي أودعها لديه أحد معارفه, ولما ذهب إليه ولدي سلمه نسخة رواية (تحت سماء داكنة ) التي هربتها فور كتابتها . وهذه الرواية مع رواية (العناكب) لشقيقي الكاتب الراحل نعمان مجيد هما الروايتان الوحيدتان اللتان سجلتا أحداث تلك الهجمة الوحشية نهاية السبعينيات في اتون وقوعها. وأطلقتُ عليهما (الأدب السري) فقد ظلتا في مخبئيهما ولم تُنشرا إلا بعد زوال النظام الديكتاتوري, وقد عملتُ على طبع رواية (العناكب ) ضمن منشورات اتحاد الأدباء وأخرت طبع (تحت سماء داكنة) حتى تمكنت من طبعها على نفقتي الخاصة.
*-دافعت مرة في إحدى مقالاتك عن الرواية التسجيلية وأشرت الى إغفال النقد فحصها, ولا حتى الإشارة اليها ..هذه الرواية كان لها حضورعربي و عالمي جدير بالمتابعة ابتداء من جون دوس باسوس الذي وضع اسسا رئيسة للكتابة التسجيلية وخاصة في ثلاثيته الشهيرة(الولايات المتحدة الامريكية)لكنك لم تدخل عالمها بعد ..هل حدثتنا عن السبب؟
-دخلت عالم الرواية التسجيلية من خلال كتابة روايتي(تحت سماء داكنة) واكتشفت أن كتابتها ليس أمراً سهلاً كما يبدو لأول وهلة. وهذا ما يتصوره الكثير من الكتاب وبعض النقاد ظنا منهم أن هذا اللون من الكتابة لا يساعد على استخدام تقانات سردية متطورة وأن مداراته تنصب على العملية التسجيلية الحرفية البحتة وانه لا يحقق مستويات فنية ودلالية راقية. لذا تشكلت نظرة استعلائية نحو الكتابة التسجيلية ليس لدينا فقط بل غربيا فباسوس الذي أشرت إليه في معرض سؤالك لم ينل ما ناله اقرانه الكتاب الذين لا يقل عنهم موهبة وتاريخا وتجربة ، حياتياً ومعرفياً، لم يحظ بالشهرة والاهتمام عالمياً مع أنه توأمهم الذي خرج من مركب هرمان ملفل -مو بيدك-.
ومن أسباب مجافاة الكتابة التسجيلية الحذر من السقوط في مهوى المباشرة بالتسجيل الحرفي للوقائع فتختلط التسجيلية بالوثائقية؛التسجيلية تجسيدية,والوثائقية تجميدية ،ولكن الكاتب الماهر قادر على الانجاز الفني فيهما كما هو شأن الكاتب المصري صلاح عيسى الذي مارس اللونين من الكتابة وصنع الله ابراهيم في رواياته التسجيلية وبالتاكيد مالرو وباسوس.
*في العقود الثلاثة الأخيرة ازدهرت الرواية اعني من حيث شيوعها كتابة ونشراً..هل ترى ظروفا بعينها اسهمت بذلك، بحيث ازاحت الشعرعن عرشه كما يقال ؟
-وأزاحت القصة القصيرة أيضاً فهي الأخرى كانت أكثر حضوراً وأوفر حظاً نشراً ونقداً وبالتاكيد لا يمكن حصر الأمر بسبب واحد محدد ولا يمكن القطع بأي تفسير مهما بدا مقبولا لان الحالة تخالف تماما ما كان راسخاً عملياً ونقدياً بأن ازدهار الرواية في أي مجتمع يتطلب قاعدة مستقرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وظاهر أحوالنا في هذه العقود الثلاثة الأخيرة لايوحي لنا بذلك ,لكني سأغامر بطرح رأي مفاده أن بنى مجتمعنا المتراصة والمتداخلة في بعضها لم تكن تسمح الا برؤية مجتزأة من كثافتها وهو أمر تنفع للتعامل معه القصيدة والقصة القصيرة.
بعد 2003حصلت تطورات دراماتيكية في الواقع ، ففككت بناه وعزلتها بعضها عن بعض ،وتفضفضت كثافتها، واتسعت طولا وعرضا ، وتباعدت الحدود بينها وصار الإلمام بكل بنية يتطلب جهداً كبيراً ولم يعد النظر الاجمالي كافيا للاحاطة بها اجمالاً؛ مما تطلب حركة أوسع زماناً ومكاناً وهذا ما توفره الرواية لاستيعاب دراماتكيةالواقع بخصائصها الدراماتيكية؛ تعدد الشخصيات، تعدد الامكنة ,الامتدادات الزمانية وتنوع الموضوعات الشخصية والعامة : بقايا الديكتاتورية،الاحتلال ، الطائفية، الكيانات الجديدة، وكل من هذه تتفرع وتتناسل وتتصارع مما لا تحيط به الاشكال والاجناس المكثفة فكان دور الرواية محتما ولو توفرت الامكانيات التقنية ربما لازدهرت الأفلام الروائية لكن هذه تتطلب جهداً جماعياً لا فردياً كالرواية .
يمكن إضافة دور السخاء المغري الذي قدمته جوائز الرواية لمنتجيها كتّاباً وناشرين في تحفيز الكثيرين على دخول ميدانها هواة ومحترفين متخصصين فيها أو غير متخصصين وفُسح المجال لهم فهب فيها من هب ودب فيه من دب واذكر هنا شرحاً موفقاً للكاتب المصري المجيد إبراهيم عبدالمجيد يشير فيه للانتقال الى الرواية من حقول شتى (انتقل إليها النقاد وكثير من الشعراء والصحفيين والسياسيين والمحامين ... ورجال دين قالوا سنكتب روايات والحمدلله لم يفعلوا .. فعلها واحد منهم فقط برواية لا معنى لها ولا قيمة) ويمكن أن نضيف الى قائمته مراهقات على مقاعد الدراسة الأولية وأيضاً متقاعدين او متقاعدات عن مهن لا تمت للكتابة الأدبية بصلة ؛ ولم لا يجربون فقد تحصل ضربة الحظ ويفوزون بقيمة الجائزة المغرية . فهؤلاء الذين هبوا ودبوا الآن وتوا في (الإبداع الروائي ) لم لا يغامرون ؟ وماذا سيخسرون ؟ فلا شيء يخشون على فقده ولا هم يحزنون ، خصوصاً مع وجود ناشرين جشعين يسيل لعابهم على مغانم الجوائز فيشترطون على كَتبتها مشاركتهم الغنيمة لكي يطبع لهم مئة أو مئتي نسخة ولا يكتفى بالاتفاق اللفظي فيتم النص عليه تحريرياً بالعقد الذي يمضيه الطرفان؛ الأول المغلوب على أمره المؤلف والثاني الناشر التاجر على أن يعود اليه كل مايتعلق بالمردودات المادية للمنشور إلا محتواه فهذا يبتلي به كاتبه بالتأكيد. لا ننفي وجود روائيين حقيقيين ومبدعين يواصلون مشاريعهم الروائية التي تشكل المستويات الرفيعة للرواية العربية وبعضهم فازوا بهذه الجوائز فلا بد ( من الطاقة باقة ) كما يقول المثل الشعبي . هناك كلام كثير في شأن الجوائز الروائية قيل بعضه ولم يقل معظمه.
* أنت بدأت في كتابة القصة القصيرة التي واجهت الانحسار مقارنة بالرواية على مستوى الادب العالمي لكن (نوبل ) أعادت الاعتبار للقصة القصيرة عندما منحت أليس ووكر جائزتها ، فهل عدد القراء سيزداد بسبب هذا التتويج العالمي لكاتبة لم تكتب إلا رواية واحدة وتفرغت للقصة القصيرة وراهنت عليها ، أجنبياً مكنها في النهاية من انتزاع لقب سيدة القصة القصيرة في العالم.
- قد يسهم هذا التتويج كما تفضلت بزيادة رقعة الاهتمام بالقصة القصيرة ولكنه ليس بالامر الحاسم في كثرة قراء القصة القصيرة أو انحسارها ؛ فالقصة القصيرة لها مكوناتها وخصائصها الجاذبة لنوع من القراء ، منها قصرها الذي لا يتطلب وقتاً طويلاً من قارئها وهذا مايناسب قارئاً معاصراً اتسمت حياته وتفصيلاتها المختلفة بالسرعة وضيق الوقت فيسعى الى فرصة عاجلة توفر له معرفة مكثفة لاتوفرها له الرواية بحجمها وطول الزمن الذي تستغرقه قراءتها .
الرواية تمتع قراءها بأتساع شبكة علاقتها وامتداد جوانب الحياة فيها لكن محصلة الكثافة في الحمولة الفكرية التي توصلها القصة القصيرة اسرع من الرواية مما يزيد من انشداد قرائها اليها ويوسع رقعة الاهتمام بها .
وخلال اكثر من قرن ضلت جائزة نوبل تمنح للروائيين والشعراء ولكن ذلك لم يؤثر على تطور فن القصة القصيرة ولم يحجمها ؛ فحتى أليس ووكر لها رصيد ادبي لا يستهان به من الشعر ولها رواية اخرى غير روايتها الشهيرة ( اللون الارجواني ) وهي ايضا معروفة بكونها من الناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة وبالاخص حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة . لعل كل ذلك كان متمما لجهودها في مجال القصة القصيرة التي لن تفقد ضرورة استمرارها وشرعية وجودها لأسباب استهلاكية او ترويجية دعائية ، فعلى الرغم من ضيق سبل نشرها وقلة حركة ترجمتها من لغة الى أخرى نجد التطورات الفنية في المتن القصصي القصير اسرع منه في المتن الروائي فالأخير يستقي من الأول مستجداته.
القصة القصيرة هي المختبر لمعظم وسائل التجديد والتجويد والابتكار في الرواية والتي بمرور الوقت أخذت تتخلى عن كثير من سماتها مستعيرة من القصة القصيرة سمات لم تكن تتصف بها وأولها كثافة السرد وكثافة لغته والتخلي عن الطول المفرط لمتونها والاقتراب من القصر كلما وجد الروائي ذلك ممكنا . لذا ظهر ما أطلق عليه (نوفيلا ) وانتشر والأمثلة الساطعة عليه مثل : صمت البحر لفيركور والمسخ لكافكا وليس للكولونيل من يكاتبه او حكاية بحار غريق أو موت معلن لماركيز وعربياً نذكر : خاتم الرمل وبصقة في وجه الحياة للتكرلي ولكنفاني ماتبقى لكم وعائد من حيفا وسوى ذلك الكثير.
* السنوات الأخيرة اقمت في تركيا ..هل تطلعنا على السبب في هذه الهجرة الطوعية وهل كان لها أثر كبير فيما تبدع؟
فعلاً إن هجرتي طوعية, وأسبابها شخصية محضة, أما تأثيرها إبداعياً فهو ملموس كمياً ونوعياً.