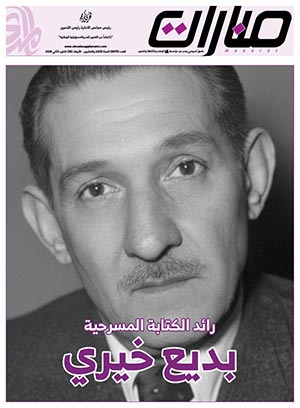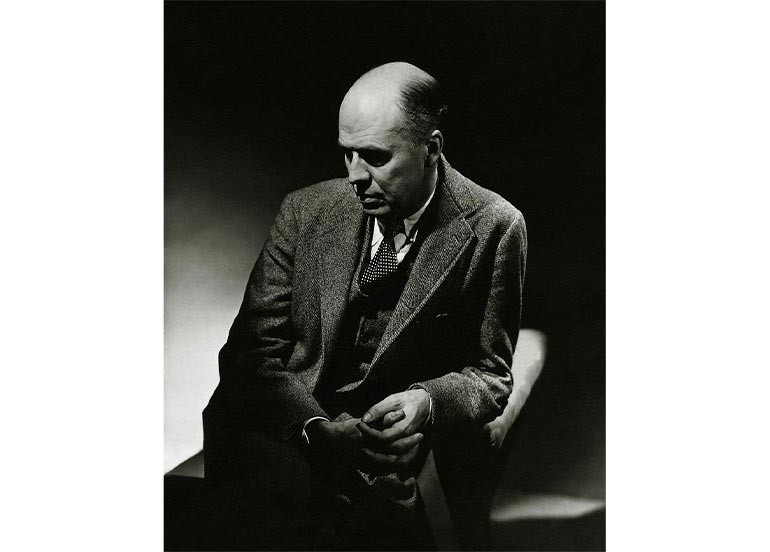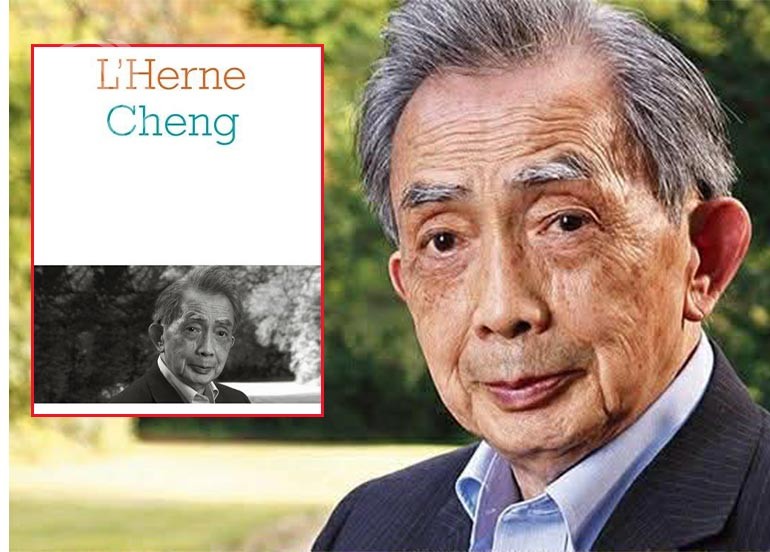شاكر الأنباري
اتجهت الرواية العربية، في العقود الأخيرة، إلى تناول إشكاليات الفرد ضمن مجتمع محدد زمانياً ومكانياً، مبتعدة بوضوح عن الشعارات الكبرى، والبلاغة الإنشائية، والافتعال، روايات الألفية الجديدة،
والقرن الحادي والعشرين، انفجرت مثل بركان في أغلب الدول العربية، قل جاءت على هيئة موجة غير مسبوقة تجاوزت كل ما كتب سابقاً في هذا الفن، طبعاً سبب ذلك يعود إلى الانفتاح الثقافي للبلدان العربية، وتطور التكنولوجيا الرقمية، والترجمة من مختلف اللغات الحية، وتحطم القناعات الراسخة، الميتة، في وعي الشعوب العربية التي خرجت من شرنقة التابو الاجتماعي، والديني، والسياسي، بهذا المعنى استطاعت أن ترفع ما يجري في الواقع اليومي من حوارات، وهموم، وآلام، وكوارث حتى، إلى برزخ اللغة غير المتعالية، بل والمرتبكة بعض الأحيان.
مما انعكس إيجاباً على توسّع الآفاق المعرفية، والاجتماعية، والسياسية، في النص المكتوب روائياً. بهذا تجذّرت البيئة المحلية، والوعي الفردي، وانعكاسات الأحداث الكبيرة، في آلية تواشج الأفراد مع ما يجري حولهم ضمن المساحة الزمانية الممنوحة لهم.
روايات سوريّة، ومصرية، وعراقية، وسعودية، ومغربية، وجزائرية، ولبنانية، وبلدان عربية أخرى، قرأت أحداث واقعها بهوس غير مسبوق، مستفيدة من روافد الروايات العالمية التي صارت تصب في اللغة العربية، إذ فتحت سبلا روائية مبتكرة، ومقاربات تتواءم مع الحدث المحلي، تأسست هذه النقلة الأسلوبية في النثر الروائي المنقطع عن قرون من البلاغة العربية على يد نجيب محفوظ المصري، في مجمل رواياته وعلى رأسها الثلاثية، وعبد الرحمن منيف السعودي في ملحمته الروائية مدن الملح. وعدد آخر من الروائيين العرب مثل غائب طعمة فرمان، وفؤاد التكرلي، وحنا مينة، والطاهر وطار، وإبراهيم الكوني، والطيب صالح، للمثال لا الحصر. هم الذين شكلوا قاعدة انطلاق لبركان الرواية في الألفية الثالثة، وقد كتبوا عن مجتمعات تملك ملامح واضحة وشبه مستقرة، عكس ما يمر به الواقع العربي اليوم، كون التجارب المؤسسة تلك نجحت في ربط هموم الشخصيات، وأنماطهم، بالحدث العام، أي التاريخ وكيف يظهر في سلوك الأفراد، وأفكارهم، وحركتهم ضمن حيز مكاني محدد.
شاهدنا اليوم موجة روائية عارمة، بأساليب ومضامين هائلة التنوع. حملت معها ما يرزح تحته الفرد، أو الشخصية المتخيلة، من تأثيرات الحروب والنزاعات الأهلية والأزمات الاجتماعية من تنافر ديني، ومذهبي، وعنف موجّه مقصود ومبرمج، وهجرات نحو قارات أخرى أكثر هدوءاً، وتصورات مغايرة لما تخططه الجهات الحاكمة أو المهيمنة دينياً، وسياسياً، وثقافياً، أي أن الروايات الخارجة من رحم المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة، راحت تسجّل تاريخاً حقيقياً للأحداث، تاريخاً تفصيلياً تهمله، أو تتغافله المدونات الرسمية للمرويات الحديثة.
والتاريخ الرسمي عادة ما يغفل، أو يزوّغ، اضطهاد المرأة المعتّق، الفج، والتطرّف الأصولي المتوحش، وعذابات السجون والزنازين وكان القصد منها تحويل الكائن البشري إلى حيوان، وطرق الهجرات القاتلة عبر الجبال والبحار والحدود. وكانت مغامرات غير مسبوقة في الوعي البشري.
نحن أمام رواية وقائع لا رواية أفكار إذن. وقائع اشتغلت عليها الصنعة المحترفة لفن يعتبر جديداً نسبياً على الذائقة القارئة. رواية الأفكار والانشاء السردي سادت منذ ولادة هذا الجنس في الثقافة العربية بدايات القرن العشرين، رواية الألفية الثالثة مرتبكة، قلقة، وكأن التاريخ بتقلباته المفاجئة، والحادة، يرسل إليها ذبذباته عالية الرنين. وهنا بان القاع المجتمعي، المسكوت عنه سابقاً، في المتن الروائي، وأسفر عن تلافيف خشنة فاقعة، ساخنة وصادمة أغلب الأحيان. وهذا ما يعتبر تطوراً هائلاً في نمط الكتابة الروائية في العالم العربي، الابتعاد عن القضايا الكبرى ذات "المانشيتات" العريضة المتصدّرة في المدونات التاريخية، والبحث عن قصص وحكايات الضحايا والمهمشين، صنّاع التاريخ الحقيقيين، جعل للرواية العربية نكهة وهوية، ووظيفة معرفية هائلة.
لقد غادر الكتّاب معطف الكائن الفرد، وهنا هو التاريخ الخطّي، وتغلغلوا في اللحم الحي، فعن طريق قراءة تلك اللوحات الشاملة من شخوص وأحداث وتداعيات جوّانية وأحلام محبطة، يستطيع أي ناقد، أو باحث اجتماعي، أو مبرمج لمستقبل بلد ما، الوقوع بسهولة على حقيقة ما يمور، ويتفاعل، خارج تلك المانشيتات البرّاقة. ربما لهذه الأسباب نادراً ما تقرأ الفئات الحاكمة في العالم العربي الرواية الجديدة، لأنها تعكس، مثل مرآة، الصورة القبيحة للحاكم، القروسطي الوعي، وبشاعة مؤسسات القمع، ومستعمرات العذاب المنصوبة في أغلب مجتمعاتنا بدوافع دينية ومذهبية، ونهب مبرمج يقوم به المتنفذون، وسرقات للمال والأحلام والمستقبل. وبالتالي فكل ذلك يصنع تاريخاً حقيقياً لمرحلة ما، قرئ زورا من آخر بعيد، أو من سلطة مهيمنة محلية بأنواعها.
إن معظم الروايات الخالدة في الوعي البشري، تغذت على هذه الرؤية في الكتابة.
تولستوي على سبيل المثال في روايته الحرب والسلام. كان مدركاً لربط التاريخ بالشخصيات، فقد قارب الحرب التي شنها نابليون على شمالي أوروبا، وروسيا لاحقاً، عن طريق شخصيات روسية شاركت في تلك الحرب. ولاحق تلك الشخصيات حتى في المدن الكبرى والبلدات الصغيرة. عرض الهزائم والانتصارات، والبؤس البشري، والشجاعة والظلم، ومعادن البشر وهم يعيشون أزمة وجودية ماحقة وضعتهم الحرب في أتونها.
إن ضغط ما هو ملموس وواقعي في الحياة اليومية، وتنامي العقلية العلمية المنافية للأساطير والغيبيات والمسلّمات العتيقة، هو ما دفع بالكتّاب الحقيقيين، والمبدعين الجادين، إلى تجاهل التاريخ الرسمي السلطوي ومروياته المهيمنة لتدوين تاريخ الفرد البسيط، والحالم. الفرد الساعي إلى شروط حياتية عادلة وجميلة، حضارية لا تغفل الجانب الإنساني في أي حياة. جرى الأمر في تناغم جليّ مع ما وصلته البشرية من تطور في العلوم، والبحوث الاجتماعية، والفلسفية والجمالية، وحقوق الانسان. إلا أن هذه المسيرة في تحولات الكتابة، لا يمكن لها أن ترسّخ أقدامها في البيئة الكتابية العربية دون تلك الموهبة الخلاقة للمبدع. ذلك الخيال المحلّق باحثاً عن فسحة الجمال المتمثلة بالنص الروائي الناجح، والمؤثر على القارئ، الملامس لوجدانه بعمق.
إن الصدق هو وحده ما ينقذ السرد الروائي من الواقعية الفجة، بالتالي فالعرض المجاني للأحداث دون تسجيل رؤية عما يجري، سيفرغ النص من قوة الموقف، حيث من البديهي أن الرؤية تتطلب الانحياز، سواء من الكاتب أو شخصياته.