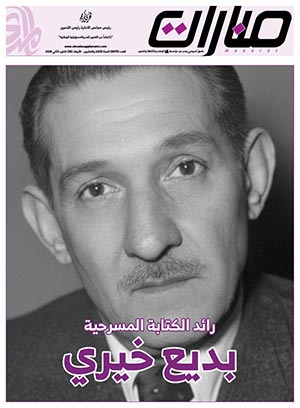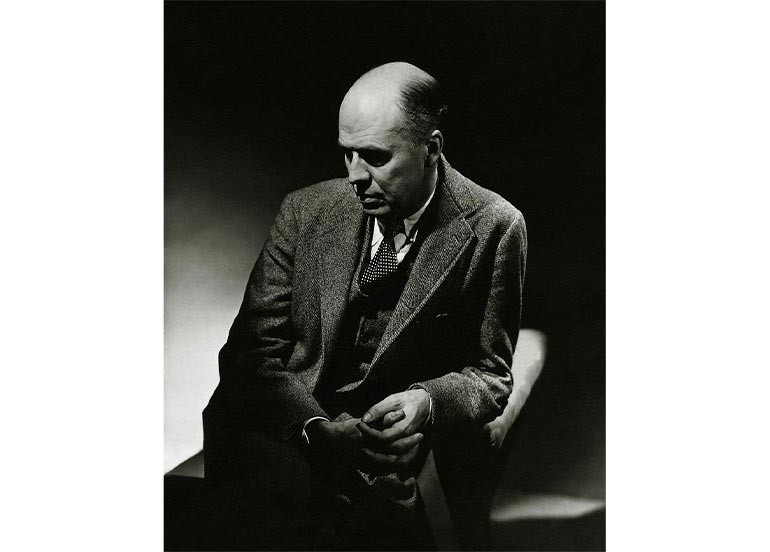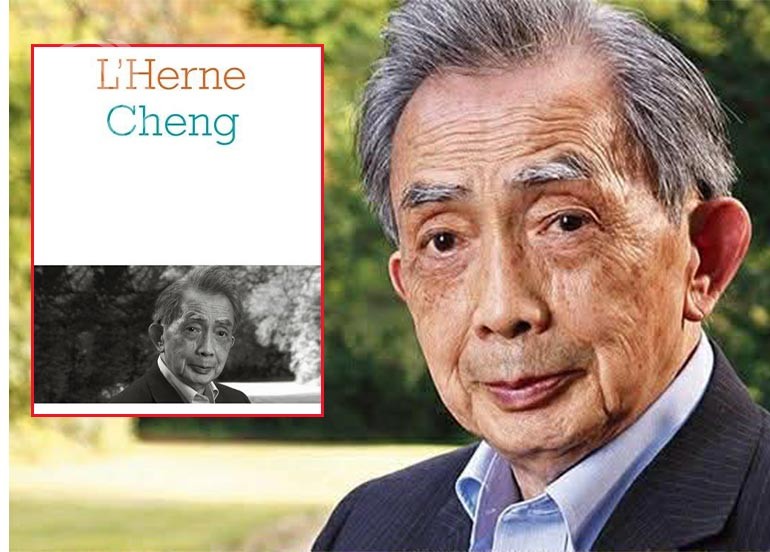أجرى الحوار: يحيى جابر ويوسف بزي
هذا الحوار
يكفيك أن تقرا هذا الحوار الذي نشر عام 1993 مع الشاعر الراحل سعدي يوسف ، لتقف عند السيرة المكثفة، لكن المكتفية بذاتها، عند شاعر تقلب به الزمان للاسف ..
فمنذ ديوانه الاول " القرصان" ، ظل يرسم صورا، للحياة ، للوطن، لمدن النفي، لحيواة مرّت به، ومرّ بها.. ومنذ إعدام القادة الشيوعيين، حيث خطوته الاولى في طريق اليسار، وحتى الشيوعي الاخير ، كان سعدي يرسم قدره بنفسه... كان يتمنى أن يفتح الوطن ذراعيه له يوم الانعتاق، شاعرا ومنافحا من أجله ، لكن ندوب الكراهية التي لازمته في سنواته الاخيرة، وراح بسببها يكيل السباب لمن يعرف ولا يعرف، ويصرح بمواقف تتناقض مع ما كان عليه ، مما جعل القراء يحصون شتائمه، بدلا أن يفاجأوا بقصيدة جديدة يضيف بها جمالا لما قاله في قصائده التي سطّرها عبر ستين عاما.
كنا ننتظر، من شاعر ملأ الدنيا يوما أن يفي بنذوره عند مذبح الوطن لحظة الانعتاق، فنفتح اذرعنا لاستقباله وتحيته، لا أن نسعى الى اللجوء الى مراجعنا السيكلوجية لنتبين مصدر هذا الانحراف.
لكننا على يقين مطلق انه بعد سنوات سيقوم الزمن بواجبه فيشذب من شخصيته ندوب الكراهية التي لازمته سنواته الاخيرة ..هذا الحوار تعيد المدى نشره لاهميته ولانه يسلط الضوء على شخصية سعدي يوسف الحقيقية .. الشاعر الذي احبه الناس .. وليس الشاعر الذي تحول الى شتام يبث الكراهية في كتاباته
بيروت
الزمان: آذار 1993
المشهد: سعدي يوسف
في مقهى بحري
سعدي يوسف قبل العام 2003 هو غيره ما بعده. تروما سقوط بغداد والغزو الأميركي للعراق، ضربت وعيه ضربة قاصمة. هذا ما أتحاشاه عندما أتذكره، كما عرفته وعاشرته. لقاؤنا الأخير كان في مسقط، العام 1998. كان جميلاً غارقاً في الحب، طباخاً ماهراً وذواقة يعرف كيف يدوّخ إدارة فندق من أجل ابتداع مائدة على رمال شاطئ. شاعر شديد الحب للشعراء، سخي ومنصت وصارم بانحيازاته. وأكثر ما أحببت فيه مشاركتي إياه الشغف الفائق بمتع الحياة.. المتع كلها.
اليوم، أستعيد ما قد يكون أشمل وأهم حوار أجري معه. وثيقة تاريخية بكل معنى الكلمة. يحيى جابر وأنا، ظللنا برفقته ثلاثة أيام، نهاراً وليلاً، نسأله ونساجله وندوّن كل شيء. حوار حذفنا منه وجودنا وكلامنا وتركنا فقط بوحه الكامل، ليُنشر في مجلة “الناقد” بتموز 1993. هنا نصه الكامل.
بين قهوة البحر وفودكا الحانة كان حوارنا. وكان ثمة وجع بين الكلام. لحظات الإعدام، لحظات الحصار. زمن التشرد بين مدن أنيقة وأمكنة الخراب. زمن الفنادق وزمن السجون.
اختار سعدي الجلوس بمواجهة البحر كمن يود النظر إلى “شط العرب” أو يتذكر فيه أقارب مقيمين هناك، ومنزل الأهل، المطاردين والثوار. إلى البحر ينظر ويتكلم. بدا لنا كحقيبة شعرية مشبوهة. شاعر جوال وعاشق حانات، حيث القصائد تحضر بحدس عتيق ومكبوت. قصائد لكلام أقل عن ناس وزوار وغائبين.
وبين نهارين ومكانين سعينا مع سعدي، بهدوئه ومسالمته، نحو تذكارات وحياة لا مقر لها، ضائعة بين مغامرة “جلجامش” وعشبة خلوده، وبين “أنكيدو” وبريته المفقودة.
هنا، في البرد، أمام شاطئ بيروت، وعراق الشعر حاضر معنا. كانت شهادة سعدي يوسف.
سيرة
- أنا من جنوب البصرة، من منطقة “أبو الخصيب”. وهي منطقة ملاكين صغار ومعروفة منذ القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بأنها مركز للاجتهاد الديني السنّي. وهي من الأماكن القليلة التي زارها جمال الدين الأفغاني.
وذلك الاجتهاد الديني كان مصحوباً بعلمانية ما. والمنطقة واحدة من مراكز النشاط السياسي لكافة الأحزاب اليسارية. والسيّاب تربى في المنطقة نفسها. وهي من أغنى المناطق العراقية بغابات النخل وكروم العنب. بالإضافة إلى كونها منطقة تجمّع للناس والأسواق والدكاكين الهندية والإيرانية، واللغات والبحّارة. وكان يسيطر عليها مناخ حب المغامرة.
- توفي أبي وأنا في الخامسة من عمري. لا أتذكره إلا بصورة غائمة. وأخي الأكبر هو الذي تولى رعايتي. أمي كانت امرأة أمّية لكنها كانت تتابع اهتماماتي. وحين أنشر قصيدة تطلب من أختي أن تقرأها لها..
عندي رغبة أن أدفن بجوار أبي، ولكني لا أعرف أين قبره. أمي توفيت ولم أعلم بموتها إلا بعد سنوات خمس. كنت في باريس. وصلني الخبر عبر قادم من بغداد، وكان وقع النبأ مؤلماً جداً.
- أتذكر كيف دخل الإنكليز قريتنا في استعراض عسكري، وكانت أمامهم عنزة بيضاء وموسيقى تصدح من خلفهم. وكنت مبهوراً بهذا الاستعراض. وأتذكر أيضاً كيف كان الأميركان يقومون بإنشاء خط الإمداد من العراق عبر إيران إلى الاتحاد السوفياتي. وأذكر جندياً روسياً أهداني زراً من بدلته رسم عليه منجل ومطرقة.
- كنت فقيراً لا أستطيع شراء الكتب. لذلك كنت أستعيرها من الأصدقاء، ومكتبة المدرسة، وأحياناً أنسخ القصائد على ورق الأكياس، كما ألجأ إلى نسخ كتب بأكملها، ثم أجمع الأوراق وأحولها إلى دفتر.
- قراءاتي العامة كانت مبكرة، وذلك في آخر سنة من المرحلة الابتدائية، ومعظمها قراءات في البوليسيات والمغامرات، ثم تطور الأمر عندي إلى قراءة كتب سرّية مثل كتاب عن تيتو. ثم اختلف الوضع عند انتقالي إلى الجامعة، فزاد اهتمامي بالأدب والشعر والسياسة. وكان الشعر موضوع اهتمامي الأول. في تلك الفترة طرأ عنصر جديد إذ بدأت أقرأ باللغة الإنكليزية، فطالعت روايات شتاينبك كاملة، وهمنغواي، والروايات الروسية. ولكنني انجذبت إلى الروايات الأميركية والإنكليزية. وتلك الفترة كانت من أغزر فترات القراءة بالنسبة لي.
- دخلت إلى دار المعلمين لأنها كانت كلية لأبناء الفقراء، وكنت في القسم الداخلي. وفي تلك الدار كنا على علاقة بمن سبقونا، وشكلوا ملامح جديدة في الشعر العراقي، كالسياب وحسين مردان وبلند الحيدري، حيث كنا نلتقي بهم ونعرض عليهم قصائدنا، ونستمع إلى آرائهم. وكان مقهى البرازيلية في بغداد هو المقهى الوحيد الذي يقدم القهوة. ومن خلف زجاجه كنا نشاهد البياتي والسياب والحيدري، لكننا كنا نتردد في الدخول إليهم. ومع ذلك كانوا جميعهم دقيقي الاستماع، وذوي اتجاهات يسارية، على درجات مختلفة بالطبع، وكان بعضهم منتسباً إلى الحزب الوطني الديموقراطي، أو الشيوعي أو كان مستقلاً كبلندر الحيدري.
- إن دخولي إلى كلية التربية في بغداد، نمّى في داخلي الإحساس السياسي. وأول احتكاك مباشر لي بالسياسة كان عام 1949، وفي ذلك الوقت جرى إعدام قادة الحزب الشيوعي وبينهم الأمين العام. ووجهت ضربة قوية للحزب. لكن بعدها بوقت قصير بدأت محاولة إعادة بنائه، فأُجري اتصال بي من قبل أحد الأصدقاء لكي أعيد علاقتي من جديد بالحزب، وحدد لي موعد مع شخص آخر يتم في الطريق العام. والشخص الذي أتى كان بدر شاكر السياب. فبدأت العلاقة معه هكذا.. لم نجلس، واستمرينا بالمشي والحوار حول إعادة تنظيم الحزب وكيفية إعداد نشراته وتوزيعها. كانت الجريدة متوقفة والمطبعة مصادرة. لذا، كان لكل منطقة جريدتها، التي تصدر بشكل مختلف لكن باسم واحد هو “القاعدة”. وكانت مهمتي أن أرسل عدداً من النسخ وأوزعها، لا أن أكتب فيها. وكنت أخبّئ الجرائد والمنشورات خارج البيت..
- ربما لو كنت حزبياً بشكل رسمي لما استطعت تقبّل الآخر، لأنني طالما تصرفت خارج قواعد التربية الحزبية التي تنطوي عادة على نوع من التشدد. ولما استطعت الانفتاح على الآخرين. كنت مسالماً دائماً، أنظر إلى الأصدقاء والمثقفين من حيث كونهم أشخاصاً فقط، وليس من منظور ثقافي أو حزبي، ومن دون عقد مسبقة.
- تزوجت عام 1961 من امرأة عراقية. لم أعرف التدخين وشرب الخمرة إلا بعد تخرّجي من الثانوية. أما علاقتي بأولادي فهي علاقة رعاية أكثر مما هي علاقة حميمية.
- عملت بشكل دائم كصحافي حقيقي في مجلة “الحرية”، وفي وكالة “وفا”، ثم في مجلة “البديل” كرئيس تحرير، والآن أصدر مجلة “المدى».
- أتعرض لكوابيس سلبية، أكون الضحية فيها دائماً.
- لا أخشى الموت. ولحظة حصار بيروت وجدت نفسي إزاء حالة ينبغي أن أخوضها كنوع من التحدي الشخصي. وصرت أبيت في قواعد المقاتلين، وأذهب إلى خطوط القتال الأمامية وأكتب يومياً في جريدة “النداء».
- كنت مرة مع فخري كريم نتمشى قرب فندق البريستول، وفجأة تعرّض لمحاولة اغتيال فأصيب، وأخذناه إلى مستشفى الجامعة الأميركية، وكنت أساعد في دفع النقالة إلى غرفة العمليات. وبينما كنت في صالة الانتظار، حيث تم إدخال قتلى عديدين، حصلت حادثة لا يمكن أن أنساها: سقط مخ أحد القتلى على الأرض. ولأن الناس كانوا في عجلة من أمرهم، أخذوا يدوسون على المخ المتناثر. وبعد ربع ساعة لم يبق منه شيء.
سجن
- سُجنت عام 1963 لمدة سنة ونصف السنة بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي، وفوجئت بالسجن، لأنني كنت أتصوره، كما في القراءات، مثل سجن نهرو، حيث هناك حديقة صغيرة لزراعة الزهور. لكني وضعت في زنزانة إفرادية معزولة ومنع الاتصال بي. ثم نقلت إلى سجن على أطراف الصحراء، إلى حصن “نقرة السلمان” الذي يقع بين العراق والسعودية (وهذا الحصن بالمناسبة، هو أول مكان دخل إليه الفرنسيون في حرب الخليج الأخيرة). وكنا لا نستطيع الهرب، لأن كل هروب يعني أن تصبح فريسة للذئاب. كان معي في ذلك السجن، كما أذكر، الفرد سمعان الذي توفي قبل وقت قصير. وكان هناك أيضاً شاعر شاب يدعى خالد الخشاب. وهو لم يعد يكتب منذ زمن بعيد. ومظفر النواب كان هناك، ولم أصادفه لأنه كان يتنقل بين سجون عديدة.
- عام 1964، أتذكر عندما نقلنا من سجن إلى آخر، أننا وصلنا ليلاً. وبعد التفتيش، كان نصيبي مع ثلاثة أشخاص أن نبيت في غرفة المشنقة. وكانت مشنقة متقنة. وهذا المشهد لا أستطيع نسيانه.
وفي ذلك السجن، كانت الكتب ممنوعة. أذكر عندما بدأوا تفتيشنا قبل الدخول أنهم عثروا معي على قرآن صغير، كنت أحتفظ به دائماً، وبسبب تلك اللقيا تلقيت ضرباً أليماً.
- في السجن عام 1963 حدث لي شيء يسمى الإعدام الوهمي، حيث أوثقوا ذراعي إلى كرسي، وعصبوا عيني ثم أطلقوا الرصاص حواليّ.
- السجن يقمع الكتابة، فالقراءة محرمة، والاستماع إلى الراديو كان سرياً، والماء يصل بالصهاريج. وكنا نخاف الموت عطشاً عندما تتأخر الصهاريج.
- السجن يعني لي مكاناً للإبادة سواء جسدياً أو نفسياً.
- علمني السجن الصمت والهدوء واحتمال الأشخاص المزعجين. وعلمني الاكتفاء بالقليل وأن أجد معنى حقيقياً للتصرف الحرّ.
- شعرياً، السجن لم يساعدني في الكتابة على الإطلاق، لأن القهر وحجمه داخل السجن يخنق أي تأمل حرّ. لكن المشاهد واللقطات الشعرية المستوحاة من السجن ترد في نصوصي بشكل دائم.
ذاكرة الحقائب
- أول مرة غادرت العراق فيها كانت عام 1957، إلى موسكو. ثم بعد التدريس سنتين في العراق، غادرت إلى الكويت، ثم عدت وغادرت إلى لبنان عام 1964 بعد سجني وفصلي من العمل. في لبنان أقمت في أرخص منطقة، بجوار مستشفى بحنس (للمجانين). كان الناس لا يسكنون هناك خوفاً من العدوى. ومن لبنان غادرت إلى الجزائر، وبقيت هناك حتى أواخر عام 1971، ثم رجعت إلى العراق بعد إقامة المصالحة الوطنية، ثم غادرت العراق عام 1979، بعد تشديد الخناق على الديموقراطية، إلى بيروت. وبعد ذلك.. إلى أماكن كثيرة.
- السفر هو ضرورة لي، سواء كنت مقيماً أم راحلاً. وقد ساعدني في الكتابة بسبب تنوع المشاهد، وتجنب الموضوع الواحد. وكذلك في التعرّف على منابع أخرى للثقافة. وهذا الترحال أنقذني من استخدام التجريد كأداة أولية.
- كانت تجذبني منذ الصغر فكرة الأبطال والسفر. ولا تزال باقية في ذهني صور مناضلين ومطاردين كانوا يمرون في بيتنا ويرحلون إلى أماكن أخرى. وكانت قريتنا بعيدة عن المركز الإداري، ومن هناك، كنا نذهب إلى إيران عبر شط العرب أو إلى الكويت عبر الصحراء. وأذكر من أولئك المطاردين رساماً يدعى ناصر الخرجي وهو من الأسرة النجدية.
- الحقيبة لم تصل معي إلى درجة الرمز، واعتبرها شيئاً عادياً. ومنتهى سعادتي العيش في فندق، حيث يحررك الفندق من الجري وراء تسيير الشؤون البسيطة، لأن متابعتها تأخذ وقتاً وأعصاباً. وأنا أكتب كثيراً في الفنادق.
ثمة فندق في الجزائر اسمه “مازفران” يشعرك باستمرار بدوار البحر. والعجيب أن الأرقام العليا في المصعد تهبط بك، والأرقام الدنيا تصعد بك، ومن الصعب أن تهتدي إلى غرفتك. ومرة ظل سليم بركات يطوف يوماً كاملاً من دون الاهتداء إلى غرفته، فاضطر للنوم على كنبة البهو، وصار يعتقد بأنه سيبقى في الفندق إلى الأبد من دون الاهتداء إلى غرفته!
حانات ومقاه
- الحانة تعني لي أكثر من المقهى، لأن الحانة هي من الأماكن القليلة التي تجد فيها الناس مصرين مسبقاً على الاستماع.
- أصر على شراب الفودكا أولاً، وهو لا يرتبط عندي مع فكرة الانتماء الثوري.
- الحانة الأساسية التي تلقي بظلها علي وعلى نظرتي إلى العالم والتي أقدسها، هي حانة البحر في ملحمة جلجامش التي استقبلته بعد عودته من رحلته.
- في باريس أقمت حانة صغيرة في منزلي بثلاثة مقاعد.
- مقهى أم نبيل في بيروت، هو أول ما يخطر على بالي من حي الفاكهاني الشهير. لم يعد الآن من أثر للمقهى. وهذا المقهى كان يشرف على مدخل الحيّ، حيث تستطيع أن ترى منه حركة الناس والقادمين الجدد الذين يوزعون منشورات الأحزاب والتنظيمات.. وأتذكر هناك دائماً رسمي أبو علي مع كل الفانتازيا التي يحملها.
- كنا نخاف ارتياد مقاهي شارع الحمرا بسبب تعرض اثنين منا للاغتيال: عادل وصفي وعبد الجبار الذي قتل وقطعت رأسه. وكنا نخاف الخروج من الفاكهاني الذي أسميه “بهجة الغيتو”، حيث كنا معزولين، ونادراً ما كان لبناني أصيل يغامر في الإقامة الدائمة فيه. وفي الفاكهاني كانت الحياة حرة ومعقدة في آن معاً.
شعر
- أول اتصال لي بالشعر كان عبر طريقة تعلم العروض في السنة الثانية المتوسطة. وبدأت قراءة المعلقات وتطبيق العروض عليها. وفي الوقت نفسه قرأت لبدر شاكر السياب قصائده المبكرة، وبعدها بسنتين اطلعت على ديوان محمود حسن اسماعيل “أين المفر”، ثم في الفترة نفسها تعرفت على نتاج الياس أبو شبكة. كان تأثيره في الشعر العراقي أكبر بكثير من تأثيره في الشعر اللبناني. و”أفاعي الفردوس” بالنسبة للشعراء العراقيين كتاب مقدس.
- أذكر في تلك الفترة ترجمات علي سعد للوركا وناظم حكمت.
- أول مرة جربت الكتابة الشعرية عام 1950. كانت محاولة تطبيق وتلمسات أولية. عشت في هذه الفترة وحدي في مسعاي وبحثي. كتبت كثيراً ولم أنشر.
- لم يكن هناك من امرأة تحفزني على الكتابة، ولم يكن لمسائل المرأة والجنس من آثار في نصي.
- تعلمت الخطوات الجادة الأولى في الشعر عن طريق كتاب نقدي في القصة القصيرة. قرأته منذ أكثر من أربعين عاماً.
- بدأت من الشعر ووصلت إلى السياسة وليس العكس. تعلمت منذ الخطوة الأولى أن الشعر مغامرة الحياة الكاملة. أي أن أكون حراً فعلياً وقادراً على تخطي الحواجز باستمرار.
- لا أكتب عما لا أراه. الفكرة البسيطة التي راودتني في وقت مبكر هي الاهتمام بالفرد. شعرت بالهول عندما كنت أفكر بإيجاد مسلك خاص في القصيدة العربية منذ امرئ القيس. الفكرة هي أن الشعر العربي لم يكن يهتم بالفرد كفرد، وأمسكتها.. وأول قصيدة نشرتها كانت عن شاب في تظاهرة.
- أول ما نشر لي كان في جريدة محلية في بغداد “صوت الكرخ».
- في الخمسينات كتبت أشياء كثيرة، أعتقد أنه لا يمكن أن يطلع عليها الآخرون.
- ليس لدي يوم نموذجي. أكتب في النهار ولا أكتب في الليل، أكتب في أي مكان. أحتمل الضجة في الخارج لا في البيت. عادة أكتب بالحبر، وأفضّل ورق الصحافة.
- الكتابة في الصحافة جزء من بنيتي.
- عندما أترجم لا أكتب الشعر. أنظم عملي في الترجمة.. أعتبرها عملاً ممتعاً وألتزم به.
- أفضل ترجمة لي هي “المفسرون” لوول سوينكا.
- أحب ترجمتي في الشعر لكفافي وويتمان.
- القصيدة والفن يمنحاني التوازن أكثر من أي حزب أو دولة.
- أجد نفسي الآن في القصيدة المتقشفة. وأعتقد أنني توصلت إلى وعورة هذا المسعى عبر أربعين سنة من الكتابة. وأعني بالقصيدة المتقشفة أن تزيح كماً هائلاً من الزيادات. الزيادات في البيان العربي، في الهالة المضافة على الكلمة، العلاقات الإرغامية في الشعر، النعت والتشبيه على سبيل المثال، والمصدر الذي أتحاشى استعماله. وهذا كله عسير جداً في التطبيق.
- أشعر الآن أنني بحاجة إلى تدريب وتجريب في آن معاً. أن أكيّف حواسي لتصبح أكثر قدرة على الالتقاط.
- عندي رغبة قبل موتي بإلغاء أكثر من خمسة أسداس ما كتبت في مختلف مراحلي. لدي رغبة فعلية في أن أكتب رواية عن سيرتي بأكبر قدر من الصراحة.
نقد
- أعتقد الآن أن طريقتنا في تلقي الشعر لم تعد فعالة. نحن بحاجة فعلية إلى أن تدخل القصيدة من خلال التقنية البصرية والسمعية. أن تُمسرح وتشخَّص، أن يتبلور تعدد الأصوات للوصول إلى الناس. هناك ضرورة لاعتماد وسائل أخرى.
- النقد عندي لا يشكل هاجساً على الإطلاق.
- لست مسروراً بالمشهد الشعري العربي حالياً.
- بعد محمد مندور وإحسان عباس وميخائيل نعيمة، أظن أن الجهد النقدي لا يزال محدوداً، وأن حركة الرواد حظيت باهتمام نقدي من حيث تقريب القصيدة من القارئ، وهذا لا نجده الآن، لا من حيث المتابعة النقدية ولا من حيث الدقة والاهتمام.
- من الطبيعي أن تنكسر موجة التحديث ويأتي غيرها. وهذه حركة مبدئية. ولكن مشكلتنا تكمن في الثقافة العربية التي هي بطبيعتها ناقصة وانتقائية وغير معنية بمراقبة تفتّح الجديد.
- ثمة نقص ثقافي في تكويننا.
- المبدع دائماً في المنفى.
- إن صورة وعضوية المثقف العربي في أواخر القرن العشرين تراجعتا عما كانت عليه منذ خمسين سنة مثلاً.
- الكاميرا مسلطة الآن على المثقف الوسيط، القابل للاستخدام، الذي يمكن استعماله، ببساطة، كبرغي. المثقف الوسيط العملي هو المطلوب الآن من قبل السلطات في العمل الثقافي الشامل. المثقف الوسيط الذي يعمل في الصحيفة، الذي يكتب السيناريوهات، الذي يذيع في الإذاعات، الذي يدبج الخطابات للمسؤولين الحكوميين. ومركز الاهتمام الفعلي في النشاط الثقافي الجماهيري هو هذا المثقف الوسيط. إنه العمود الفقري للثقافة المنتشرة.
- أحب الرسم وتحديداً جبر علوان المقيم في إيطاليا، ونعمان هادي المقيم في باريس.
- أفضّل الآن أن تمنح جائزة سلطان العويس لمجموعة من الشعراء الشبان.
- أرشّح أدونيس لنيل جائزة نوبل.
- لا أعرف من هو أفضل روائي. ومن الصعب أن توافق على روائي عربي بكامل نتاجه.
- التأصيل عندنا لم يتم.