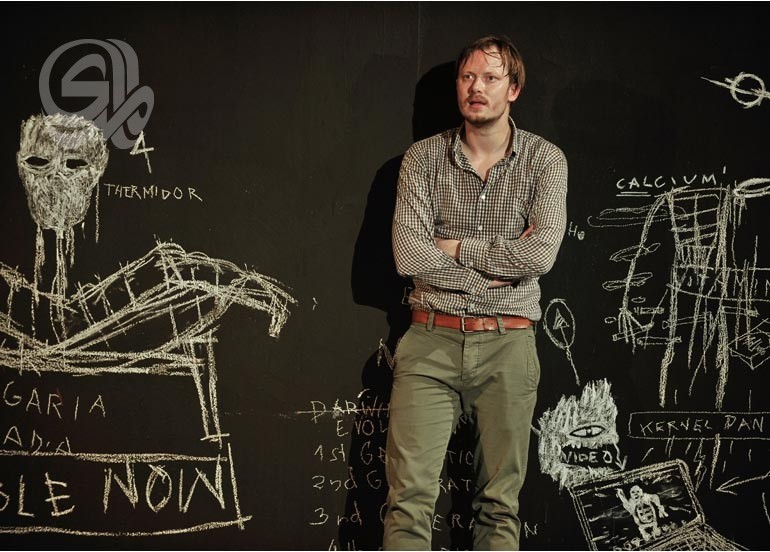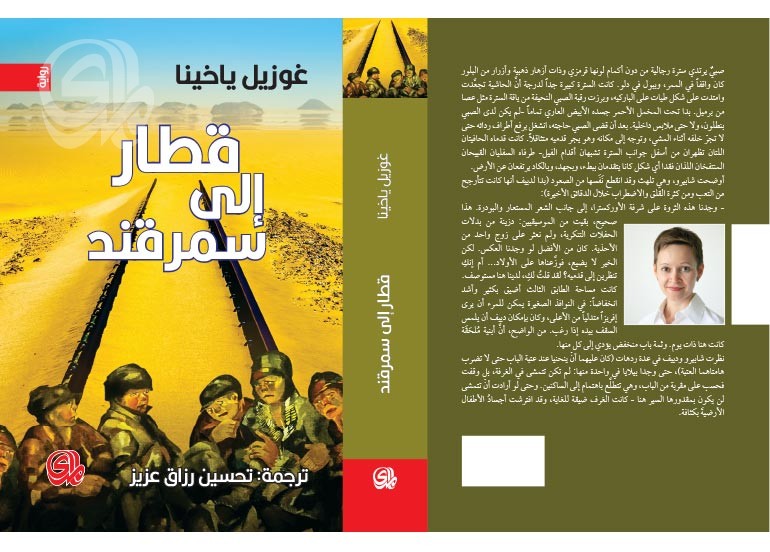علي النجار
في نهاية الستينات بعد قضاء يومي عطلة في بغداد وأنا قادم فجرا لمدينة كركوك في طريقي لناحية(الدبس) حيث مكان عملي.
كنت التقط أوقاتا صباحية رائقة في بعض شوارعها الرئيسية قبل مغادرتها. أحيانا ما كنت أقضي بعض الليالي فيها ويبهرني أفقها المحمر المشع بلونه الغريب. ربما أجده انا القادم الجديد ساحرا، ربما يجده غيري مؤذيا بصريا وبيئيا. لكن ما أعرفه أن أطناناً من غاز استخراج البترول تذهب هباء، بالوقت الذي اغتنت به ماليا لحد التخمة بعض الدول الصغيرة المجاورة لنا. فيا للهبة التي لم نعرف كيف نستثمرها كما بقية أنظمة شعوب العالم.
بعد كل هذه الحقب الزمنية الضائعة، يعيد الفنان(ديلان عابدين أمين) محنة ضياعنا، أو تيهنا المؤسساتي والبيئي للأبصار من جديد. بالتحديد بيئة مدينته البترولية(كركوك) المخترقة سمائها بسحب الغاز السامة. في وسط بات لا يفقه شيئا مما يحدث له. أو هو بات يتلمسه. وبما أن هكذا أفعال فنية بيئية لا يستوعبها سطح ورقة أو قماشة. فإنه ولضرورة الحاح الموضوع اقترح عمله التركيبي بمواده الصلبة، التي رغم صلابتها تضمر هشاشة عاطفية، لم نعدمها في عموم التشكيل لمجمل القوميات القاطنة في المنطقة المدارية المتوسطية. ربما لكون الموضوعة(التركيب والإنشاء) تحمل رسالتها الإنسانية، الاعتراضية، التواصلية. ربما لأن الموروث الفني ومعظمه شعبي متجذر في نفس الفنان، لونا وتفاصيل لعب عليها بحرية يتطلبها موضوعه الفني.
العمل هنا وكما يبدو من حجمه نصبيا. والأنصاب باتت تشكل هاجس النحات العراقي. ربما للإرث نصيبا في ذلك. لكنها تبقى أحلام، غالبا للشهرة، على حساب القيمة الفنية، أو الولع في الإتيان باشتغالات نحتية تحمل غرابتها، أو تغريبها. ويبدو أن الانفتاح على آفاق النحت المعاصر، أدى الى المزيد من الاهتمام من قبل نحاتين عراقيين من أجيال جديدة ومن جميع القوميات بالأداءات المتنوعة الأخرى، منها منحوتات الخامات المختلفة. سواء كانت نفايات صناعية، أو بيئية. لكن يبقى المهم كيف يتم التوظيف، هل لمجرد التجريب، أو العبث، أو لبناء وتنفيذ فكرة مستجدة. وأعتقد أن الأهم من كل ذلك هو طريقة المعالجة للفكرة بما يناسبها من مواد أولية، ان كان العمل نحت تجميعي أو تركيبي.
الفنان ديلان يضعنا في بؤرة الحدث(الفكرة) بيئيا بدلالات سياسية مضمرة. فان كانت أداته التنفيذية الفنية(المادة الأولية) انتقاها بفطنة من محيط بيئته، ليست البيئة الخضراء كما يتوارد للذهن. بل المواد الصناعية الدخيلة، والضرورية للصناعة التي تنهك موارد الطبيعة. فالبراميل، وهي مجرد أدوات معدنية تستعمل لنقل البترول ومشتقاته وغيره. هي في نفس الوقت هياكل(فورمات)، ربما للوهلة الأولى لا تصلح للإنشاءات المعمارية. لكن استطاع (كرستو كلود) تركيبها كمنشآت معمارية، بالرغم من افراغها من وظيفتها المعروفة، هو استطاع ان يشكلها وينصبها بما يوازي معمار البيئة التي أخذت مكانها وسطها. كما مسطبته في بحيرة(سربتنين) في حديقة الهايد بارك من لندن ببراميلها الحمراء، أو في الصحراء العربية. والتي حملت وظائف مختلفة في كلا المكانين. رغم اعتراض البعض، واستساغة البعض من السكان المعنيين ببيئتهم. هو وحده الفنان من حاول توظيفها كشيء مألوف، كما اللعب الصغيرة بألوانها المختلفة البسيطة والساحرة الشكل. على كل، هي مجرد انشاءات كبيرة شبه هرمية من مادة مصنعة غريبة، هدفها إضافة لمسة مغايرة لمواقعها البيئية.
بعيدا عن فلسفة أهرام براميل كرستو التي أوردتها كمثل لاستغلال هذه الخامة فنيا، كما استغلها العديد من الفنانين للتعبير غالبا عن نواياهم السياسية الاعتراضية أو البيئية، سواء كأعمال تجميعية أو تحويرات بيئية أو بوسترات أو غيرها. يضعنا ديلان وسط دوامة أسئلة مغايرة. فعمله لم يعتمد على مفردة(الخامة) فقط. بل هو أجرى عليها تحويرات، وأضاف لها اشتغالات فنية مارسها في أعمال تشكيلية أخرى، كالصباغة واضافات نحتية(خرق ولصق) ليمنحها خفة فضائية تخفف من حدة تشكيلتها وصلادتها، ولتدمجها بالملونة المحلية التي عمرت غالبية أعماله. هي، وبشكلها هذا تعيدني لأنصاب حضارة الهنود الحمر (الأستك)، ليس بتفاصيلها الداخلية المتمثلة برموزها ومنحوتاتها الميثولوجية، بل بشبح الشكل الخارجي، حيث الأعمدة النصبية واجنحتها المشهورة، وحتى مقاربة ملونتها لذات الطيف المتوهج. مما يؤهل هذا العمل النصبي الموقت لأن يحتل مكانة وسط موروث ملونة أثرية مقاربة. من جهة أخرى أنا أرى أن هذه النقاط والخطوط التي اضافها الفنان على سطح براميله وحتى بعض مفاصل مساحاتها الملونة تحيلنا لمبدأ العزل، عزل المحتوى كمادة وفورم عن طبيعتها الفيزيائية الوظيفية الصرفة، وعزل مفهومي، تأثيرات الخارج، وربما هي آثار اطلاقات نارية وأكفان بيضاء، ما دام الوضع السياسي المحيطي لا يخلو من عنف سياسي. أو انزياح بيئي. بما أن بيئتنا العراقية عموما ملغومة بمخلفات الأسلحة المحرمة والمحللة. وربما أيضا تحيلنا(هذه الملونة) لفولكلور الملابس الشعبية العراقية شمالا وجنوبا. فنحن بلاد الشمس ونزيز البترول.
أعتقد أن كل منشآت الفن البيئي من تركيبات وغيرها من اشتغالات فنية ومنها العضوية زائلة. وما يديم زخمها الا الولادات التعويضية. لذلك على الفنان ان يتذكر هذا الدرس، لا كما وهم الأنصاب الخالدة باقية أبد الدهر. حالة الزوال هذه لا بد أن تعمر ذهن الفنان وهو بصدد انجاز عمله. ما يساعد على ذلك هو هشاشة المادة، حتى ولو كانت تحمل بعضا من صلابتها. أو هشاشة الزمن المرصود لاستهلاكها، ان كانت مواد نفاية أو بطريقها لتصبح نفاية. لذلك فهي لا تمر في الأفران لتعاد مصنعة من جديد. فهوس إعادة التصنيع يكمن هنا في مجرد اللصق والتراكم أو البعثرة والربط وبعض العمليات الإجرائية البسيطة. بما أن أصل العمل الفني هنا يكمن في الفكرة المستوحاة من هذه المواد نفسها، لا من خارجها كما النحت التقليدي.
هل حاول ديلان في هذا العمل النصبي أن يستخلص من صلابة مادته الأولية هشاشته ما، (رسالة افتراضية عاطفية). ربما هو تمثلها كما إشارة أو ومضة وسعى لتنفيذها. هذه المادة المستهلكة والمألوفة، لا بكونها ناقلة تجارية تواصلية فقط. بل لكون لا يخلو أي بيت عراقي
منها كحافظة للنفط الأبيض المستعمل لاستهلاك الاسر، ربما انحسر استعمالها بعض الشيء بفضل التقدم التكنولوجي في مجال التدفئة والاستعمالات المنزلية الأخرى. لكنه يبقى في الذاكرة العراقية تذكار لأيام الحصار والمحن والوضع الاقتصادي. ولكل أثر تاريخه العاطفي وحتى في خفايا الذهن. فكيف وسط مدينة تحيطها آبار النفط وأنابيبه الناقلة وبقية منشآته. اليس هيكل مدفأة النفط المألوفة يشبه هذه الأسطوانات، كما تشبه غيرها من الاستعمالات التي باتت في يومنا غير مألوفة. وهل الذكرى لوحدها تكفي.
أعتقد أن اختيار ديلان لموضوعه الانشائي ثلاثة أنصاب(جدل القامات) موفقا. كما الثلاثية الذهبية في الفن التشكيلي الكلاسيكي(ثلاثية النعمة والسحر والجمال)، بالذات في الرسم. فالتوازن الثلاثي لا يعادله توازن آخر. فإن نصبت عمودين متوازيين، فسوف يكون هاجس ميلان أحدهما على الآخر واردا، حتى بمجرد الأبصار لوحده. لكن أن نصبتها ثلاثة متوازية كما فعلها ديلان، فلا ورود لهكذا ظنون، وكأن النصب الأوسط هو الراعي لتوازن بقية التفاصيل، مما يعزز هيمنته على فضاء المكان، وليحقق أهم أهداف الأعمال النصبية. ومن هنا يعلن اختلافه النسبي وما قرص(غطاء البرميل) الذي يعلو أوسطها، الا اعلاء من شأنها، بما أنه يشير للشمس كما نصب نذري. رغم أن هذه الثلاثية تعلن نذر طيرانها شكليا. لتدخلنا في جدل الأعلى والأسفل. أو معراج الأرواح المفقودة، بيقينية لحدها أو فنائها أرضيا، هي أيضا تعوم هنا في سماء لا تزال ملغومة. ما يعزز هذا الضن، هو الأمكنة نفسها التي نصب فيها. فليس اعتباطا أن تستقر هذه الجثامين المعدنية الثلاثة على حافة نهر)الخاصة صو( وسط ساحة لمنطقة شعبية وزعتها السلطة المحلية لأهالي الأسرى والمفقودين في حرب الثمانية أعوام بين العراق وإيران. فان كان العمل يحمل اسمه الجدلي، فقامات الشهداء لا تزال منتصبة فوقه صعدا.
لنذهب في افتراضاتنا الى مداها. ما دام العمل النصبي هنا يحمل افتراضاته الجدلية. فهل هو يمثل انهار كركوك الثلاثة(نهر الماء الخاصة صو.. نهر النفط، ونهر الجثث الطافية). وهل بيئة العراق تخلو من هكذا افتراضات. بما أن النصب التركيبي هذا أنشأه الفنان بنية اعتراضية. إذا، ذلك وارد. فالأرض التي يستقر عليها هي أصلا وريثة هذه الأجداث التي خطفتها الحروب العبثية، ومنها حروب هذه البراميل(البترول) الافتراضية والواقعية. فهل فكر الفنان فعلا بإعادة ربط أناسها بأرضها، أم بقصص الأرض نفسها. وإن لم يفكر، فالعمل يشير الى ذلك. من هنا تأتي الأهمية البيئية لهكذا أفعال فنية تغيب عن غالبية العاملين في الوسط الفني المحلي ومؤسساته غالبا أهدافها. بل تذهب بهم الى حد منع خروجها لواقع حال التشكيل العراقي، بحجة مواصفات العمل الفني، التي في غالبيتها تقليدية مكررة ومسفهة لأية فكرة مبتكرة لا تألفها ذائقتهم التي عفي زمنها منذ عدة عقود من زمننا الحاضر. وهذا ما يعاني منه الفنان ديلان وغيره من مبتكري الأفكار المجددة في واقع حال التشكيل المعاصر الذي أتردد في أن أطلق عليه معاصرا.
يذكرني ديلان وهو يحاول أن ينتقل بعمله هذا من مكان الى آخر بالعروض المسرحية الشعبية المتنقلة. أو بشاحنة الشاعر والمطرب الأمريكي المشهور صاحب جائزة آداب نوبل(بوب ديلون) وهو يبتكر خطابه والحانه بما يوازي زمنه الثقافي السياسي. فهل وجب على ديلان أن يحمل صليبه ويتجول في متاهات العراق التشكيلية، وقامة من عمله تقارب صليبا يشير الى جهات مجهولة. وهي دعوة للمؤسسات التشكيلية التدريسية والمؤسساتية لأن تعيد النظر بأحكام معايرها الفنية التقليدية. فكيف تتطور الوسائل التواصلية التشكيلية في حال أن تبقى النظرة قاصرة على أساليب التشكيل التقليدية فقط. كما يذكرني هذا الأمر بمقترحي في عام ذروة العنف العراقي(2005) بإقامة نصب من هياكل السيارات المفخخة أمام وزارة الثقافة. وهي دعوة لأن يصبح الجمهور فاعلا ومؤثرا من خلال ربطه بفن الحدث والبيئة والدخول في مساحة العمل وملامسة فضاءاته وليتحول العمل الفني من مجرد مواد خام محورة الى عمل تفاعلي يساهم في زيادة واستقطاب الناس للمجال الفني الذي لا يزال محصورا بين الجدران الأربعة.
ديلان في عمله هذا يقرب الجمهور منه بشكل مؤثر، ربما لمجرد الفرجة، ربما للتفاعل بإيحاءات أو مدلولات خرساء(كامنة في الذهن أو اللاشعور الجمعي المحلي)، ربما بإثارة الأسئلة، ربما لإيصال رسالة ما. في كل هذا الحالات يكون الفنان قد حقق هدفه الذي رسمه ذهنيا، أو ربما تجاوزه. مع اعتقادي بأن الأمر غالبا ما يؤول للتجاوز. قدرة التغيير هنا هي الحصيلة الأهم. بما تمنحه من إمكانية الانتقال من حالة الجمهور السلبي(تجاه الفن التشكيلي)، الى حالة التجاوب، أو ما يصطلح عليه بالتواصل. لا تهم المغامرة، بقدر النتائج. مثلما أخذتني صورة العمل نفسه المنصوب في فضاء أخر، وهي مجرد صورة فوتوغرافية. الفضاء البيئي الجديد والملغز(حيث منشآت النفط وشعلة الغاز الأبدية) تلوح قريبة من مكان نصبه المختلف جذريا عن المكان الأول. والذي يبدو هنا كأنه جزء مكمل لا يتجزأ من طبيعة المكان بتواشج تفاصيله المادية المعدنية ذات العلاقة الحميمة بهذه المنشأة. وكما قصدها الفنان كمناورة بيئية.
مع اطلاعي على العديد من أعمال ديلان، الا أنني آثرت أن أحصر معاينتي بهذا العمل فقط. فهو برأي يشكل مفتاح الدخول لبقية أعماله، سواء كانت محاولات تركيبية، أو رسوم، أو دفاتر فنية. بما أنه وفي كل أعماله مفتون بملونته البيئية، وفي اخراج أفكاره التلسيقية غالبا غير بعيد عن هذا الإرث اجتماعيا وسياسيا. كما أنني أعتبر هذا العمل بمادة انشاءه المألوفة، الفقيرة والمتداولة والمبتذلة أحيانا، شكل دعوة لغيره من التشكيليين ليحذوا حذوه. وأنا أعرف ان العديد من تشكيليينا في وقتنا هذا انتبهوا لهكذا اشتغالات متريالية مهملة. هي أيضا دعوة للخروج من فضاء صالات العرض الى فضاء المدن. ربما بمناسبة، أو حتى بغير مناسبة. ولو من أجل إشاعة ذائقة فنية جديدة تكتسب أهميتها من كونها جزء من فضاءات محيط وبيئة المدينة والفضاءات البيئية الأخرى.