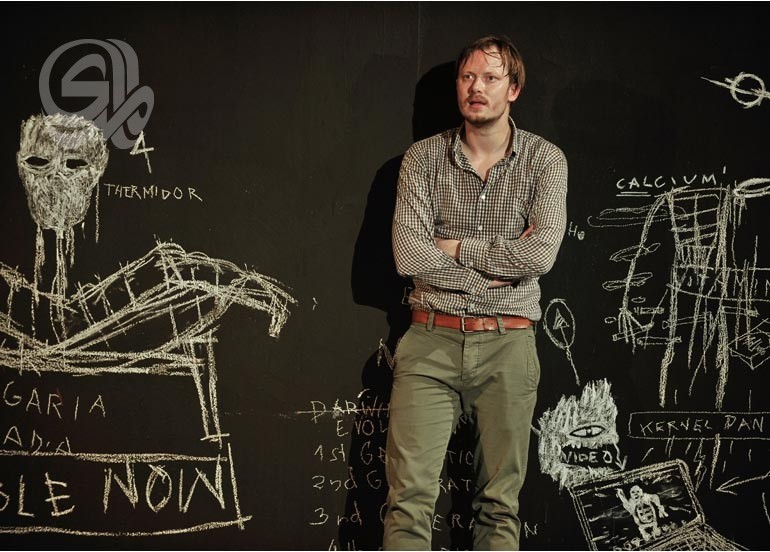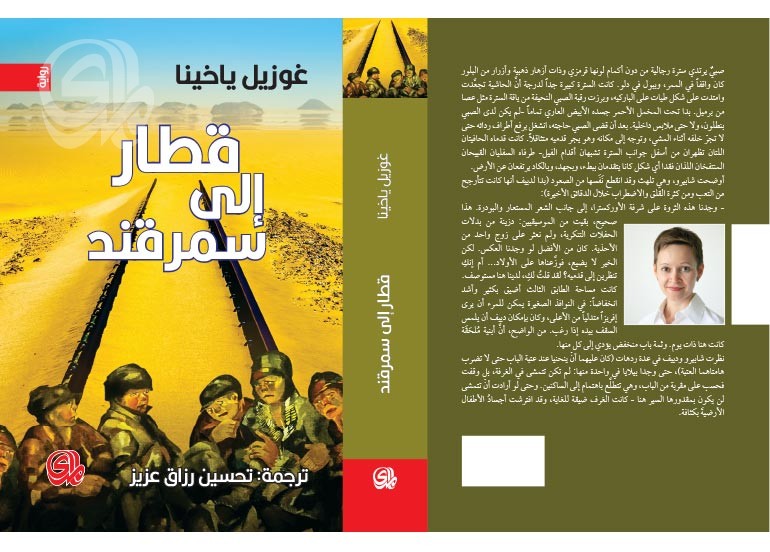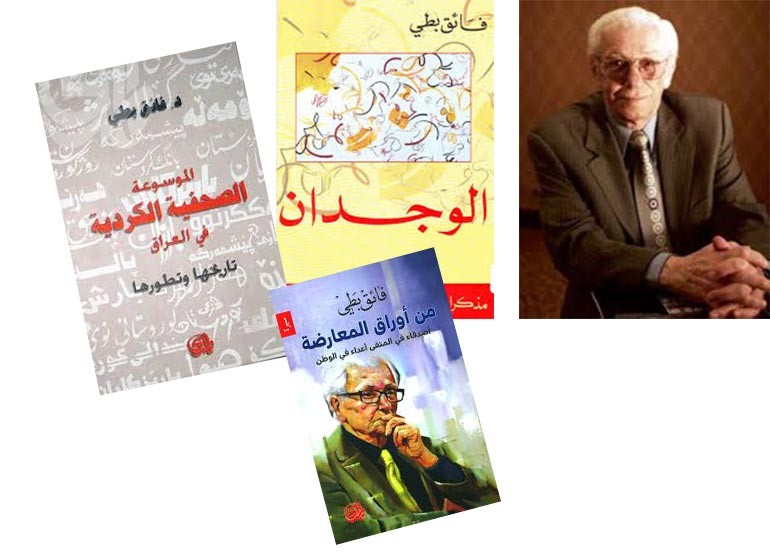دُنى غالي
جدتي لم تفهم غربتها. ماتت وفي حوزتها هاتف نقّال كانت تضعه على الدوام تحت وسادتها. لم أتصل بها ولو لمرة واحدة. حالة شبه مرضية، هي من اتصل! الأموات أذكى.
كانت المكالمات الهاتفية في الماضي تتطلب المرور بعاملة البدالة التي تستلم الرقم لكي تحاول الحصول لي على خطّ. كنت طوال المكالمات هذه منصتة لأصوات عاملات البدالة، ولا أتفاجأ، في الغالب حين تدخل علينا إحداهن لتقول كلماتها المعهودة بإهمال وعمومية: سلّمي، انتهى الوقت! لا تمهل في الغالب الطرفين ليودّعان بعضهما، وقد تظلّ جدتي بسمعها الضعيف تصيح من جهتها، من دون أن تفقه ما جرى. فوبيا الاتصال بأهلي الأحياء لم يلتفت إليها أحدهم. تفاقمَ الأمر بتقدّم السنين، البعيدين منهم على الأخص. عجزتُ عن توضيح الأمر لأمي وأبي، ولم يعجزا عن إقناعي بضرورة تكرار المحاولة، لربما أفلح وأُشفى. كلاهما يؤمن لازال بضرورة التواصل. ولازلنا نرهق كلمات مثل التواصل والمنفى بشكل لا رحمة فيه. ولا أحد من الأطباء يفهم مثولي أمامهم. حضوري الكامل غير ممكن، قلت له، ما يعمّق الفهم الخاطيء لما يدور في بال بعضهم. وبلغ الطبيب حدّا من العته لينعتني بالاستعلاء. قبلتُ به وغادرت العيادة تخفيا خلف ما هو أشدّ مرارة. بمرور الوقت تتأصّل الحالة، ولا يعد الأمر واضحا تماما، جسدي كتلة صلدة ترفض أن تتفكك باللحظة التي يستوجب عليّ فيها مخاطبة أحدهم؟ الكلام ليس شيء بالمتناول على السطح. اللغة مُكفّنة، مقيدة بسلسلة انفعالات ومرمية في قاع بئر عميق، لا أفعل إلا المسك بحبله القصير. اللحظة تكون أكثر من كونه زمنا أخشى ألا أطلع منه بسهولة. طفولة غائمة، توجس، رضوض، التباسات وخوف.
الهاتف لازال يرنّ. عليّ أن أفتح الكاميرا، هي تجيد استخدامها، رغم إنها لا تعتشب غير الذكرى تلك الجدة. لم تتغير تسريحة شعرها المجعد، ولا يمكن أن تتغير. تنسدل جديلتان مموَّجتان الآن على الشاشة أمامي، تكسّرات مدهونة، ابتداءً من الفرق حتى الذيل بلونها الأشيب المُحنى. اليدان مخضبتان بزيت المشط الخشبي والعينان بفعل عتمة الماضي تكادان لا تنظران إلى الهنا والهناك، شيءٌ من غير الممكن في اللحظة. رغم انه كان كذلك على الدوام. كانت لها نظرة لا نعرف وجهتها. لا «نكسر كوداتها» فنقول انه القلق، وهي تؤكد السرّ حين لا تبوح بشيء. النظرة ذاتها ثاقبة تفضح الغرائز لدى الآخرين. إشارةُ الرنين على الشاشة ترتجف. تصعد، وتظلّ تكرر الصعود. ما لها يدي ترتجف. كلُّ شيء مرّ بشكل خاطف، رغم طقسها الذي كان يفرض البطء على المدينة. لم تتمكن عجلة عصرنا من كسره، وسمعها كان ثقيلا فلم تأبه للضجيج. ولكن ما المعنى، ما قيمته، ها هي قد نزلت تحت السطح رغم كل هذا الهدي والتراخي. وهذا البئر كم أؤثر أن أرمي بنفسي في عتمته: كافية لتجعلني أهبط مثل مظلّي إلى قاعه. لا تعرف جدتي عن هذا الهراء شيئا، من الأرستقراطية أن نتحدث عن العتمة والضوء. عن ذكورة وأنوثة، طوّعتْ كلا منها لصالح الموقف. وإن فتحتُ خطّ الاتصال لن تباشر حديثها معي بكلمات حب واشتياق. قريبة جدا من الأرض، في حياتها ومماتها. إنها على السطح وتحته بأقل من قليل، في كل أوقاتها، معنا وهناك دائما. مكان بعيد لم تبذخ في وصفه ليسهل علينا الاقتراب من صورته. لكنها حوّلت الحوش في بيتها إلى بحيرة. ولم يغبْ عنها إن الوشمَ وسنّ الذهب والاسم ليسوا هي.
لديها من الطاقة بعد ما يُبقي جهازها مشحونا. لا شيء واضح على شاشة هاتفها المفطورة عرضا. الصوت ”صامت”. تشير بابتسامة إلى سنّ الذهب، القاطع الناعم في فكّها العلوي، تشير عاليا إلى السماء ولا أفهم ما الذي تريده مني، هل عادت طفلةً في هواء طلِق!
هل كنتِ سعيدة يا جدتي؟ السعادة تُعدّ بعدد اللقمات الطيبة.
مثل ماذا؟ الطيور، أشتهيها، أشتمّ رائحة كل ما يطوف حينها، والعوم طولا وعرضا.
ماذا عنكِ يا ابنتي، هل تزوجتِ؟ لا يا جدتي. أعرف انها فضيحة.
الفضيحة أن تبحثي عن شيء، غير عضلاتِه أو جيبه، أعرفكِ، بلاها أيتها الخائبة.
هي أقرب إلى المرأة الندّ، النظرة التي تعكس الخيبة، المسافة التي تجذّر ليس غربتها عن المكان فحسب ولكن غربتنا عن بعض.
ماذا عن أحلامك أنتِ جدتي؟ البيت، نعم، وأن أضيع بين الأسماك والقصب، أن أرقبَ أمي، تفتح العجين وهي تسمع صوتا ريفيا يتكسّر في الفضاء ناعيا. أحبّ أن أعوم بثوبي، لذة النزول إلى الماء الحلو، زحامٌ عذب، يلتصق جسمي بالأجساد الأخرى، مع أختي، هي الوحيدة لي، وحيدتان في الكون والغروب يرمي بالصوت بعيدا، والماء ثقيل زيتي ساكن، نطفوا جميعنا في سعادةٍ لا يعرفها العالم، أنا وهي والحيوان.
لم يدرك أحدٌ أن قدم الطفلة كانت تطأ القاع وتقفز دفعة واحدة إلى أعلى لتأخذ نفسا عميقا آخر وتعود لتغوص. كان جذر الطفلة مائيا، وطيبها من طين قاع الهور. لم يكن منا مَنْ أدرك ذلك.
* من ضمن كتاب يصدر قريبا.