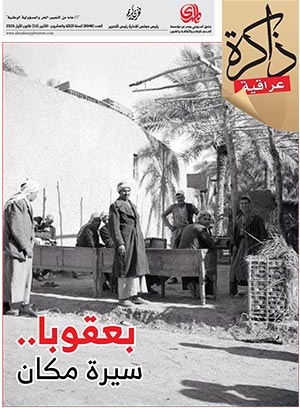لطفية الدليمي
قرأتّ مرّة أنّ النشيد الوطني الكندي كان يضمُّ بين مفرداته واحدةً لها إشارة صريحة إلى المسيحية. لم يرُقْ هذا الأمر لبعض أعضاء البرلمان الكندي ذوي الأصول المهاجرة من خلفيات إسلامية ؛ فاعترضوا على هذا الأمر وطالبوا بتغييره.
عندما وصلت القضية إلى المحكمة العليا الكندية قضت بشرعية مطالب هؤلاء لأنّ النشيد الوطني ينبغي – بحسب القانون والأعراف الرفيعة - أن يمثّل كلّ الأطياف الكندية من غير إشارة تمييزية – حتى لو كانت غير مقصودة – إلى طيف بعينه، وهو ماحصل لاحقاً: تمّت مراجعة شاملة لكلمات النشيد الوطني، وحُذِفت كلّ الأشارات المرجعية الموحية بتحيزات دينية أو جندرية أو مناطقية، واستبدِلت بأخرى وافق عليها البرلمان الكندي ممثّلاً بكلّ تلاوينه العرقية المتعدّدة. كم كان عدد المسلمين حينها في كندا ؟ لاأحسبهم تجاوزوا 5 % من السكان في أقصى الحدود ؛ لكنّ المحكمة العليا الكندية إستمعت لرأيهم ولم تتعامل معهم بمنطق (أهل الذمة) الأقلية التي ينبغي أن تخضع للأغلبية، وأنّ حقوقها ليست سوى مايجود به عليها الخيّرون من الاكثرية. لاوجود لفقه (أهل الذمة) في المجتمعات المتحضّرة ؛ بل يسود حكم القانون من غير حذلقات لفظية أو تبجحات عاطفية أو مشهديات فلكلورية. ثمة حقوق محميّة بالقانون ولاأحد يستطيع الالتفاف عليها.
هذا ماحصل في كندا ؛ أما في العراق فيحصل العكس تماماً عندما تتغوّل الهجمة النكوصية على البعض القليل الباقي من تراث العدالة القانونية والأخلاقية المشرّعة في قوانين معروفة. هناك ترتيبات منسّقة لقضم هذه التشريعات وتقزيمها في أوقات الأزمات، ومايدعو للأسف والأسى أن تُسْتَخْدم المحكمة العليا وسيلةً لهذا القضم القانوني المُصمّم بقصدية مسبّقة.
« تجد المحكمة من تحليل المادة موضع الطعن أنها نصّت على حق التأديب في الحدود المقررة شرعاًأو قانوناًأو عرفاً... «: هذا بعضُ ماجاء في ديباجة قانون المحكمة الاتحادية العليا، وهو مايستوجبُ بعض التساؤلات. وأنا أقرأ هذه الكلمات حضرت أمامي صورة بعض المسؤولين أو رؤساء الشركات في اليابان أو كوريا الجنوبية وهم معلّقون بحبل في غرفة بعد أن اقترفوا خطأ صغيراً عقوبته القانونية قد لاتستوجب أكثر من بعض التوبيخ أو بضعة أيام أو شهور في السجن ؛ لكنهم يرون مافعلوا خطيئة تثقلُ ضمائرهم، يطلبون السلوى فلايجدونها سوى في مغادرة هذه الحياة. ماذا نفهمُ من هذه الفِعْلة ؟ نفهمُ أنّ الأخلاقيات الرفيعة لاعلاقة حتمية لها بدين، بل هي صناعة شخصية وأعراف مجتمعية رصينة ترتبطُ بتقدّم المجموع البشري وارتقائه الاقتصادي والحضاري والثقافي ولاشأن لها بفلكلوريات بالية.
أخطرُ مافي قرار المحكمة الاتحادية أنه يتركُ الباب مفتوحاً أمام حدود فعل وتأثير مفردات مثل الشرع والقانون والعُرْف، ويتركها معوّمة غائمة ومتداخلة لكي لايترتب على الفعل عقوبة قانونية واضحة، وهذه مثلبة في صناعة القانون، وكلّ خبراء فقه القانون يعرفون هذا الأمر. لنتفكّرْ كثيراً أمام مفردة (التأديب): ماهو التأديب ؟ نعرفُ جميعاً أنّ فقه التأديب إرتبط مع عصر العبيد ؛ إذ أن السيّد مسموحٌ له أن يؤدّب عبده. هل نسينا مقولة المتنبي التي صارت أحد أعمدة الحكمة التراثية (لاتشترِ العبد إلا والعصا معه.......) ؟ العصا صارت قرينة التأديب ؛ فكيف نتوقّعُ بعد هذا أن يكون التأديب رقيقاً خفيفاً ؟ ومامعنى الرقّة والكياسة في التأديب ؟ هذه أخاديع يرادُ منها الالتفاف على روح القانون وجعله منقاداً للحدود التي توصف بأنها (حدود شرعية). لن تنفع هذه الملاعبات والتداخلات في تكريس سيادة القانون واحترامه. إنّ مفردة (التأديب) توحي بعبودية صريحة أو مقنّعة، وقد يجد البعضُ تخريجة لها بأنّ الشيوخ المريدين كانوا يؤدبون تلامذتهم ؛ بل حتى نقرأ في بعض منقولاتنا التراثية أنّ بعض الخلفاء كانوا يطلبون إلى ناصحيهم أن يؤدبوهم بالكلام الذي يثقل صدورهم وضمائرهم (وأنّ الخليفة فلاناً أسمعه فلانٌ كلاماً جعل عيونه تفيضُ بدمع إخضلّت منه لحيته.....). هذه كلها فلكلوريات تراثية لاتجدي شيئاً. هل ستحضرُ هذه التراثيات أمام رجلٍ غاضب لم يَعُدْ يسعى لشيء سوى إنزال أقسى أشكال الضرب بزوجته أو أخته أو أولاده أو حتى أمه ؟ هل سيحسبُ عقلُهُ حينذاك الحدود الشرعية الفاصلة بين تأديب مقبول وإيذاء يعاقب عليه القانون ؟ الغضبُ يُذهِبُ العقل، والعراقيون عندما يغضبون يستحيلون كائنات عنفية إنفرط لجامُ العقل منها ؛ فكيف لو تعاضد هذا الغضب اللحظي مع تسويغ قانوني أكّدته أعلى محكمة في العراق ؟
الموضوعة الأخرى بشأن التباس الحدود هي الأعراف. لنتناولْ مثالاً على الأعراف. نتذكّرُ جميعاً تلك الأمثولة البائسة عندما كان بعضُ الآباء يخبرون معلّمي أولادهم قائلين: هؤلاء أولادنا، خذوا منهم اللحم وابقوا لنا العظم !! هم يريدون القول أدّبوهم كما شئتم، ولاتتردّدوا في استخدام ماشئتم من فنون القسوة والضرب، والغريب أنّ بعض الكبار يستذكرون (الراشديات) التي تلقوها على أيدي معلميهم باعتبارها البرَكَة التي قوّمت اعوجاجهم ووضعتهم على السكّة المستقيمة. لايدري هؤلاء أنّ تلك القسوة جعلتهم كائنات سيكوباثية معطوبة،وبعد كلّ هذا نتساءلُ عن جذور العنف في المجتمع العراقي ؟!
أتساءلُ: ماالذي أضافه قرار المحكمة الاتحادية ؟ مَنُ اعتاد ضرب زوجته لن ينتظر هذا القرار لكي يضربها، ومن كانت لديه هذه العادة المرذولة المحتقرة فلن يجد في هذا القرار دافعاً لكي يمارسها. واضحٌ أنّ القرار يُرادُ منه التمهيد لفرض قوانين أخرى لاحقة على المجتمع العراقي. لم يفعل قرار المحكمة الاتحادية أكثر من محاولة إيجاد مقاربة توفيقية بين متطلبات القانون المتحضر وحماية حقوق الانسان من جهة، والحدود الشرعية والاعراف المجتمعية السائدة (وهي عشائرية في مجملها) من جهة أخرى. كم سيستمرُّ هذا الامر ؟ لن تنجح هذه المقاربة التوفيقية، ولن تسلم الجرّة كلّ مرّة من الكسر. لابديل عن الوضوح وتأشير الحدود الفاصلة بين القانون والأعراف والاعتبارات الشرعية. لاينبغي في كلّ الأحوال أن تنقلب المحكمة الاتحادية محكمة فقهية أو عشائرية، ولو فعلت فإنّ العراق سيطمسُ في جبّ مظلم يقوده إلى الفناء.
كانت المرأة العراقية في عقود سابقة مثالاً على الاناقة والكياسة والجدارة العلمية والتفوق المهني، وكان كلامها هادئاً بعيداً عن السفاهة والمجادلات وينمّ عن ثقة تدعو للاحترام ؛ أما اليوم فقد انحسر المشهد إلا من ثنائية قبيحة: نسوة برلمانيات جاءت بهنّ (الكوتا) البرلمانية ولانكاد نعرف عنهنّ شيئاً وهنّ المفترضات فيهنّ تمثيل الصوت النسائي، ومن جانب آخر نرى هذا التغوّل في في تشريع قوانين تثلم حقوق المرأة باعتبارها كائناً بشرياً قبل أن تكون إمرأة.
ستكون الأعراف مقبولة عندما تثقلُ ضمير المسؤول الفاسد وتدفعه لشنق نفسه قبل أن تمسك به قبضة القانون وتضعه وراء القضبان لسنوات طويلة وربما لبقية عمره ؛ أما أعرافنا العشائرية وبعضُ الحيل الشرعية التي تجوّزُ سرقة المال العام واعتبار الدولة كياناً مصطنعاً فليست سوى مسالك إلتفافية لمراكمة مزيد من الثروة والسلطة لدى البعض، وتكريس تجهيل الشعب بحقوقه المسلوبة.
أحسبُ أنّ عِظام مؤسسي الدولة العراقية وفقهاء القانون الدستوري الكبار وصُنّاع الليبرالية العراقية الوليدة ستنتفضُ في قبورها إذا ماعرفت أنّ المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتت تعتمدُ الأعراف وتأويلات مجتزأة لبعض التفاصيل الشرعية غير المتفق عليها حجّة قانونية لديها.
حريٌّ بكلّ واحد فينا أن يفتح فمه لأجل الأخرس، ولاأحسبُ أنّ المرأة العراقية كانت خرساء من قبلُ، ولايجبُ أن تكون خرساء في يومنا هذا.