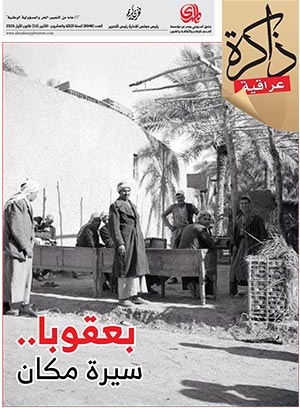لطفية الدليمي
هل الانسان كائن آيديولوجي بالضرورة ؟ سيجيبُ البعضُ بِـ ( نعم ) كبيرة من غير كثير تفكّر، مثلما سينفي آخرون الضرورة الآيديولوجية في الوجود البشري. الخطل في هذا الخيار يكمنُ في مساواة الموقف الآيديولوجي بالمحتوى الأخلاقي والموقف المسؤول تجاه غيرنا في هذه الحياة؛ أي بمعنى آخر:
خطلُ القناعة السائدة في أنّ من لايتخذ موقفاً آيديولوجياً واضحاً هو كمن يتملّصُ من واجب أخلاقي تفرضه ضرورة ملزمة تمنحُ الحياة معنى .مضت الحركات اليسارية بعيداً في هذا الشأن حتى صارت اللافتات الانسانية العريضة - على شاكلة ( الإخاء الإنساني، وحدة قوى الشعب العامل،،،،) –، والمقترنة بنبرة مثالية مطلقة، قرينة اليسار؛ في حين صار اليمينُ مقروناً بكلّ الموبقات الأخلاقية التي هي بعضُ إفرازات التغوّل الرأسمالي.
يتوقُ الإنسانُ إلى الآيديولوجيا عندما تفتقدُ حياته مايدفعها إلى العمل والمثابرة والإنجاز. تلك حاجة نفسية متأصلة في البشر. الأمر ليس مجرد حاجة وجودية بل هناك دافع براغماتي أيضاً: تمنحك الآيديولوجيا محرّضاً للإنتظام في كتل أو أحزاب أو تجمّعات تسعى للإمساك بالسلطة السياسية.
لندعْ جانباً هؤلاء الآيديولوجيين السياسيين. لندقق في حال الفرد ذي الضمير المنزّه عن الصغائر، الذي يسعى إلى أن تكون له بصمة أخلاقية مشرّفة في هذه الحياة.
تابعتُ قبل بضعة أيام منشوراً فيسبوكياً لأحد الأصدقاء الذين يتوفرون على مستوى ثقافي مرموق تشي به منشوراته ومداخلاته (هو لم يتجاوز الاربعين )، يمتدُّ اهتمامه الثقافي على مجالات معرفية متعددة . بدأ هذا الصديق قبل بضعة شهور يلِجُ إنعطافة فكرية واضحة؛ فبعدما كان ذا توجهاته ( يسارية) مفرطة في المثالية صار يميلُ إلى نمط من اليمينية المتشدّدة، وبات مثل سائق سيارة يفرملُ على دواسة الكابح في سيارته ليوقفها ثم يشرعُ في الرجوع بعكس إتجاهه! .بدا الأمرُ وكأنه ثورة على الماضي ورغبة ثأرية في الانتقام من متبنيات فكرية صار صاحبنا يراها ( طفولة يسارية ) بحسب المعجم اللينيني.
دققوا كثيراً في هذه العبارة التي كتبها هذا الصديق على حسابه الفيسبوكي :
« لم أشعر بتشتت فكري من قبل مثلما أشعر به اليوم. أشعر أنني أكثر إدراكاً؛ ولكن ماأدركه يناقض كثيراً من مبادئي الأساسية التي كنت أؤمن بها بإخلاص وأنشرها ليل نهار. لم أتوقع أن أمرّ بمثل هذا التشتت وأشكّ فيما كنت أراه من المُسلّمات التي تبنيتها طوال عمري «
إعترافٌ مثير، أحسبُ أنّ كثيرين منّا عانوه وتلظّوا بناره في مفصل من مفاصل حياتهم عندما دفعتهم حقائق الحياة للتعامل الحسي المباشر مع الوقائع ولم يكتفوا بملامستها في الأقاصي الفكرية، والفكرُ غير التعامل الحسي المباشر: هناك، على أرض الواقع الحي ،تُكتَشَفُ الحقائق المجرّدة من مثاليتها الموهومة التي صنعناها نحنُ وليس سوانا.
الموضوع بالغ الأهمية ويتطلّبُ أطروحات معمّقة؛ لكن تظلّ بعض التفاصيل ضرورية في مثل هذه المراجعات الفكرية الفردية:
أولاً : من الأفضل أن لانسلك في مراجعتنا الفكرية لليمين أو اليسار مسالك ثأرية نبدو فيها كمحبّ يسعى للإنتقام من محبوبه، ويبالغُ في الإنتقام تعويضاً عن الأيام التي صار يراها ( غفلة فكرية) ضائعة.
ثانياً: فك الارتباط القسري بين الحكومات والتوجهات الآيديولوجية. الحكومات تكوينات مؤسساتية تحكمها قوانين بيروقراطية تسعى لتحقيق مصالح مؤكدة ولاشأن لها بالأخلاقيات الانسانية. لنعتمدْ سلوك الافراد بدلاً من الحكومات.
ثالثاً :الشعوب – مثلما الحكومات – لايصح التعويل عليها في صناعة الخطاب الآيديولوجي المعاصر. الشعوب كتل كبيرة يسهل التلاعب بها في عصر مابعد الحقيقة والأخبار الزائفة.
رابعاً: اللسان الطويل والحناجر المبحوحة ماكانت يوماً معياراً للموقف الأخلاقي. أعظمُ مفكّري الغرب كانوا ذوي توجهات يسارية ( بالمعنى الأخلاقي ). برتراند رسل، مثلاً، كان أحد أعضاء الجمعية الفابية البريطانية التي نادت بإشتراكية معقلنة، ودخل السجن مرتين لمناهضته الحرب، وفعل مثله كثيرون.
الأفضلُ في عصرنا هذا، ولمن كان ذا مروءة وضمير حي مثل صاحبنا، أن يحافظ – قدر المستطاع - على بوصلته الأخلاقية لتؤشر صوب الحس الانساني بدلاً من يمين أو يسار. المهمة شاقة ، وقد تعاكسنا الوقائع المستجدة؛ لكنّ نزاهة الفعل تبقى متقدمة على خطابات الآيديولوجيا وبلبلة الألسنة.