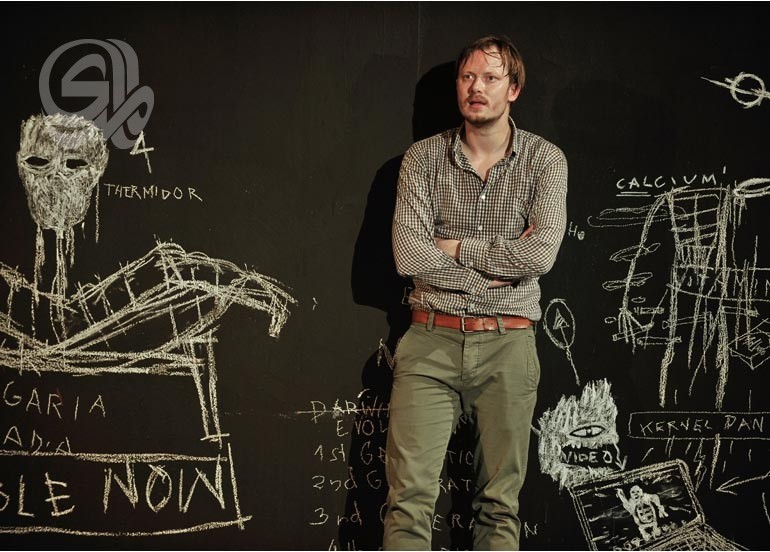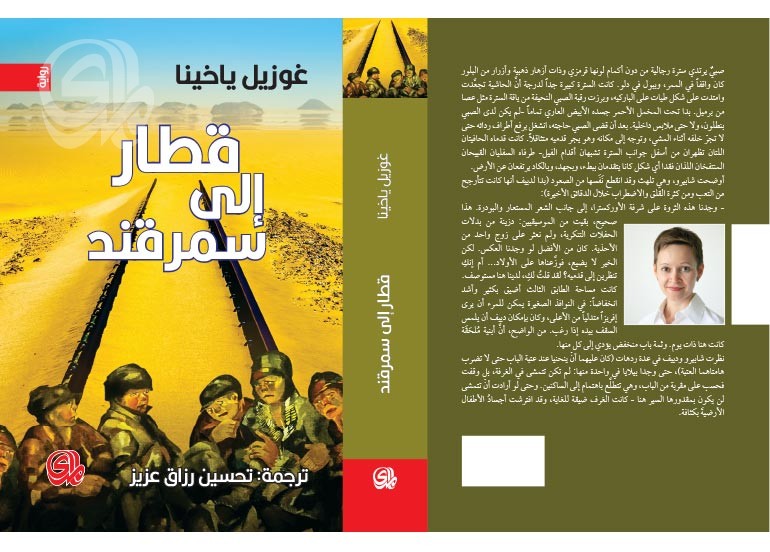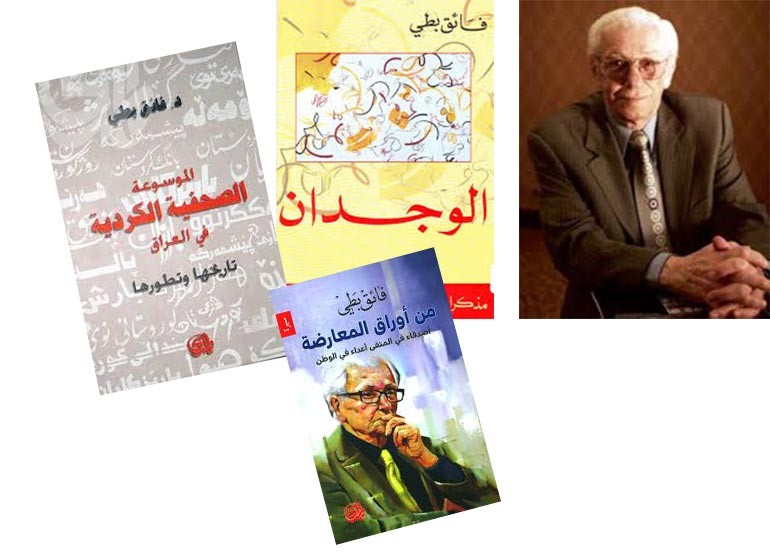اوستاش دولوري(*)
ترجمة د. حسين الهنداوي
(1-3)
في اللوحات والاشكال الفنية التي قدمها بيكاسو، جرى التعرف منذ زمن طويل، على تأثيرات قيل مرة انها جاءت من المنحوتات الزنجية،
او من منسوجات البيرو او من جداريات بومبيوس الايطالية مرة، فيما اعتقد آخرون ان مبادئ التكعيبية ذاتها ليست نتاج ابتكار جديد تماما، انما بالامكان العثور على بدايات لها عند كبار الفنانين الرومان والقوطيين واليونانيين القدامى بل حتى في ضربات غيرهم كسيزان مثلا.
بيد ان الشرق والشرق الاسلامي خاصة، هو مصدر التماثلات الاقوى التي تشترك بها التكعيبية مع عوالم بيكاسو في عدد من المجالات.
فنحن قد لا نعرف الحدود الدقيقة التي ينبغي وضعها لمعرفة وجود الاستلهام او التأثير الواعي او حتى المحاكاة عندما نسعى لتفسير ظاهرة وجود تلك التماثلات المدهشة. لكنّ من المستحيل اهمال الرأي الذي تؤكده النظرة البسيط ويخطف من الرسم الحديث بعض غرائبه المثيرة، وهو ما يلاحظ غالباً من وجود قدر مهم من السطوة للاشكال التجريدية لدى بيكاسو. هذا الحال لا يمكن ان يكون مجرد صدفة، انما يوحي بأن نوعاً من ولع موروث لديه جعل طبيعيا ومباشر اللذة تقريباً ذلك التناسق الجلي بين الموضوعات عنده والذي لم يفسره البعض الا كنتيجة لمنطلقات نظرية.
والحال اذا كانت التكعيبية ليست الا مرحلة في عمله، فمن الممكن التصور بانها وصلت او تبلورت اليه بفعل ملكة ما فطرية لديه مثلما قد تكون وصلت بفعل عامل آخر الى سواه من الفنانين.
فهذا الفن المجرد من الهيئات البشرية والخالي من اية مظاهر حسية احيانا، بل غير المحافظ حتى على الجماليات الملموسة في الاشياء وعلى اشكالها الحية، هو “فن مفهومي” بكل معنى الكلمة.
ويبدو بالفعل ان فناناً ما اسبانياً، ومن صلب عربي حصراً، وحده من يستطيع ان يجعل ذلك ابتكاراً. وعليه، وكما لاحظ غيّوم ابولينير من قبل، من غير الممكن استبعاد فتراض وجود مسلم ما شرقي بين اجداد بيكاسو، هو الذي يقوده تلقائيا نحو “شيطان التجريد”. وهكذا، وبعد مرور اكثر من عشرة قرون، يكون بيكاسو قد بدأ مغامرة شبيهة بمغامرة الاسلام في تجريد الرسم من كل بعد تصويري.
اننا نعرف نفور المسلمين من التصوير الواقعي. فلقد ابتعدوا شيئا فشيئا عن الاشكال الحسية وعن فن المحاكاة الذي يستبدل الطبيعة بمشهد منها له ظاهر الواقع او الحياة، مختارين كعنصر اساسي ما هو اقل حسية، ونقصد به لعبة الخطوط التي صارت هي ذاتها مثالها الخاص. فهم لم يكتفوا بتجنب تصوير الهيئات الانسانية وبمطالبة الفنان بالامتناع عن تقليد العالم الفعلي عبر صور عاجزة وحسب، انما ابتكروا فناً شبه لامادي متخلص من ثقل الموضوعات الى اقصى حد، لكنه مدرك من العين والروح في ذات الوقت. ففي بعض الزخارف الاسلامية، وحيث يجري اقصاء اي عنصر طبيعي، تتولّد عن التواءات وتعرجات الارابسك لذة ابداع مطلق للعين. وهكذا، ورغم ان النظام فيها يظل غير ممكن التحديد الا عبر الحساب، فان اعمالا لها كثافة محض ذهنية كهذه، هي على وجه التحديد، ما زعم كثير من التكعيبيين تحقيقه.
وكما نعرف، ان هذا الطابع العام في الفن الاسلامي يفسر نفسه جزئياً بالقيم الدينية. فمن الصحيح ان القرآن لا يمنع تصوير الاشياء، الا ان الاحاديث النبوية تحمل بشكل شديد على صانعي الصور والنحوت موحية بان الله يلقي عليهم يوم القيامة مهمة مستحيلة تتمثل باضفاء الحياة على تلك الهيئات التي اقتبسوا شكلها مما صنع الخالق. اي ان كل الاشكال الحسية التي قام الرسام بتقليدها عبر فنه ستخرج من قبورها عندئذ لتطالبه بمنحها الروحٍ بدلاً عن مظهر الحياة الخارجي الذي خصها به، وبالتالي سيجد نفسه مطارداً بحشد طويل من كل اولئك الذين استدعاهم بفنه الى الوجود. وبما انه سيكون عاجزا عن تصحيح فعلته المكابرة تلك، الرسام بالاكتواء بنار جهنم الخالدة.
نفهم اذن سبب تخلي الفنانين المسلمين عن الانموذج التصويري في الرسم نظرا الى تعلق الامر بارادة النجاة من ذلك المصير الرهيب. لكنهم مع ذلك لم يتخلوا عن الطبيعة تماماً، بل لم يحرموا انفسهم ابدا من ينابيع فن المحاكاة في عدد من المجالات. فما صار يشغلهم هو كيفية طمس ما يستعيرنه من الطبيعة، كي لا يجد الله في يوم القيامة اشكال مخلوقاته في رسومهم، ومن هنا سعيهم الى تجريد الطبيعة الى ابعد الحدود الممكنة من ملامحها المباشرة والى تقديمها خفية مقنعة بالتالي.
وهذا يفسر اهتمامهم بالاساليب التي ذهبوا في تبسيطها الى حدود بعيدة حتى صار من الصعب جدا علينا التعرف على انموذجها الاصلي احيانا، فهي لم تعد اسوداً او فيلة او طواويس، كما لم تعد اوثانا لتعبد، انما اصبحت محض عالم جديد مستلهم عن الطبيعة، عالم لا يتذكر اصله ولا يمكن ان نتعرف فيه الا على دقة فتنة الاشكال الهندسية. فالشجرة المقدسة، رمز الحياة والخلود، التي جرى تصويرها غالباً وعبر شتى الازمنة في الرسوم الاسلامية، لم تكن في الفترات الاولى قد تخلصت من كل واقعيتها، كما هو الحال في منبر القيروان المصنوع في نهاية القرن التاسع، والذي يقدم لنا شجرة واقعية بجذعها واغصانها واوراقها وثمارها، برغم ان المفاهيم الجمالية والضرورات الهندسية انطوت سلفاً على جوانب لاواقعية، الا ان الشجرة راحت تتبسط اكثر فأكثر مع مرور الزمن. ولئن ظلت توحي عبر بعض تعرجاتها بما كانت عليه في الاصل فانها لم تعد تمثله.
ونستطيع القول ان الجهد الزخرفي في الشجرة المقدسة المرسومة على حوض الوضوء الموجود في متحف الاثار بمدريد، والعائد الى القرن العاشر، ابتعد حتى عن مجرد الاستلهام الرمزي للطبيعة، ليصبح الانسلاخ في الاخير كاملا في فترة لاحقة، كما في الضريح المقام في دمشق الذي يعود الى القرن الحادي عشر. فالتكوين الذي فيه تحول الى مجرد لعبة خطوط رائعة، كما لو ان شبكة وهمية هي ما يؤلف بين التعرجات الغصنية والالتواءات الحلزونية، في حركة حرة ومقيدة في الوقت نفسه.
وقد يبدو مثيرا، لأسباب ليست مختلفة الا ظاهرياً، اننا نستطيع تقديم ملاحظات مماثلة حول موضوع التكعيبية. لكنها في سعيها للوصول الى فن مفهومي، تبدو بالفعل كما لو انها مرت في تلك المراحل نفسها، اي ان اللوحات التي يسودها الاسلوب التجريدي لا تتخلى الا نادرا عن ملامح الاشكال المقلدة حيث نتعرف فيها على قيثارة او غليون او قارورة او شبح انسان، وكل ما يشير الى عالم لم تستطع تجاوزه برغم كل شيء. كما ان المشهد الواقعي الذي خططت لتجاوزه يترك اثارا لا تقاوم تقريبا في العمل الابداعي الذي لا يبدو، حتى في تعبيراته الاكثر غموضا، الا طبيعة مجردة وتجريدية تماما، كما ان اعلى درجات التجريد الغصنية في الارابسك تظل توحي بصورة الشجرة الواقعية المرسومة في الزخارف الهيلينية على الرغم من كونها اصبحت جليلة ومتحررة، ومنقولة مع كل تلك الحرية الى عالم المخيلة. ويتجلى هذا بشكل اكبر في اعمال بيكاسو، فهو يلعب مع الطبيعة مقلدا ومبدعا منها ما ينتجه من اشكال.
*منشور في مجلة الفنون الجميلة – باريس 1932