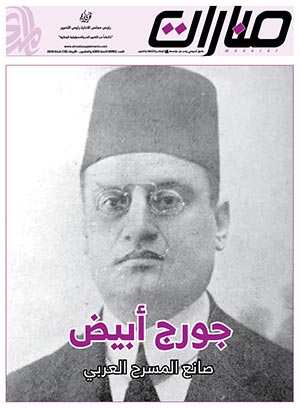عدنان حسين أحمد
يستلهم المخرج الفرنسي روبن ديميه بنية فيلمه الوثائقي الجديد “أوديسة سامي” من كتاب “التحوّلات” للشاعر الإيطالي أوفيد لكنه لم يرتقِ إلى عبقريته الفذّة التي تركت أثرها على الثقافة الغربية بمجملها.
ولكي لا نغمط ديميه حقّهُ التوثيقي في الأقل لابد لنا أن نتوقف عند القصة السينمائية التي اجترحها بنفسه وشيّد هيكلها المعماري اعتمادًا على كتاب أوفيد الذي يتضمن 15 فصلاً ويشتمل على 250 قصة خرافية تروي تاريخ العالم منذ نشأة الخليقة حتى تأليه الإمبراطور يوليوس قيصر.
ليس بالضرورة أن يكون البطل وسيمًا أو نابغة أو شخصا ملحميًا قادمًا من أعماق الأساطير والخرافات الشعبية. بل يكفي أن يكون إنسانًا عاديًا يلتقطه المُخرج من عامة الناس كما هو الحال مع سامي، الإنسان المُشرّد، والضائع، والمِعوَز ماديًا لكنه، بالمقابل، شغوف بالأدب، والمسرح، والفن التشكيلي. وقد اكتشف منذ يفاعته أهمية كتاب “التحوّلات” وقرأ الترجمات العديدة المتوفرة في اللغة الإنكليزية التي يفهمها ولا يتحدث بها بطلاقة وتدفّق، وقرّر أن يترجمها إلى لغته الوطنية الأمهرية، ويتمنى أن يقرأها الأطفال، ويفيد من حكمتها الكبار مُعتقدًا أنها تنفع المجتمع الأثيوبي وتنير بصيرته.
يعيش سامي، البالغ من العمر خمسين عامًا، في غرفة متواضعة في متاهة العاصمة الأثيوپية أديس أبابا. ولم نرَه مُواظبًا على مهنة مُحددة يكسب منها قوت يومه، وإنما كان يعتاش على مساعدة الأصدقاء والمعارف الذين يمحضونه حُبًا من نوع خاص يعكس اهتمام الأثيوبيين بالإنسان المتعلِّم حتى وإن كانت ثقافته محدودة. فالمخرج لم يُحطْنا علمًا بالمستوى الدراسي أو العلمي لبطله ولكنه أظهرَ لنا ولعه بالقراءة والكتابة والترجمة. ولعل الأهم من ذلك هو جهده الكبير الذي بذله في ترجمة الأساطير الأغريقية واليونانية على مدى تسعة عشر عامًا لكي يرفدَ بها المَشهد الثقافي الأثيوپي المتنوع الذي يتألف من 80 جنسية ويتحدثون بـ 80 لغة مختلفة. يعتقد سامي أنّ هذه الأساطير مجهولة في بلاده المترامية الأطراف لذلك تحمّس إلى ترجمتها رغم ظروفه الشخصية المعقدة، فهو ينتقل من غرفة متهالكة إلى أخرى، ويتناول باستمرار المشروبات الروحية، ويفقد أعصابه أحيانًا إلى الدرجة التي يحطّم فيها ممتلكاته الخاصة المتواضعة، ويحطّم حاسوبه المحمول القديم، ويهشِّم زجاج نافذة غرفته ثم يستعين بالآخرين لترميمها بحجة انهياره العصبي بين آونة وأخرى.
يركز المخرج كثيرًا على أسطورةالصياد أكتّايون والإلهة ديانا ويمضي في الاستطراد والتنويع على دلالاتها المتعددة، فهو يبدأ بالحديث عن أكتايّون، “الصيّاد الذي كان يمشي في الغابة فرأى الربّة أرتميس تسبح في بركة ماء كبيرة، وعندما رأينهُ حورياتها أحطْنَها كي يحجبْنَ جسدها العاري لكنه رأى عريها الباذخ فغضبت عليه وحوّلته إلى وعلٍ تُطارده كلابه التي أمسكت به ومزّقته إلى اشلاء متناثرة”. لم يجسّد المخرج هذه الأسطورة بالشكل المطلوب وإنما قدّم نُتفًا ضبابية تُشتت انتباه المُتلقي.
يؤثث ديميه نصه البصري بين أسطورة وأخرى ليحيطنا علمًا بأن كتابه المترجم يتألف من 234 صفحة مكتوبة على اللاپتوپ وأن عدد الصفحات سيزداد إلى 400 أو 500 صفحة عند النشر. وأنّ كلفته تصل إلى 70 ألف بِر Birr وكان يفكِّر باختصاره لكنه عكف عن هذه الفكرة التي تضرّ بفحوى الكتاب.
يُطعِّم المخرج فيلمه بزيارة البطل لمعرض تشكيلي للفنان الأثيوپي تادسيّ مسفين وإعجاب سامي بلوحته المعنونة “موت شاعر” لكنه لم يتوقف عند لوحات أخرى جميلة تستحق الاهتمام كونها تستثمر “الأقنعة الأثيوپية” التي ابتكرها مسفين بنفسه متأثرًا بتقاليد غرب أفريقيا، خاصة وجوه البائعات الصغيرات ذوات الذقون المُدببة والأعين الطويلة المسحوبة. يلفت المخرج انتباهنا إلى لوحة “أبيتشو” Abichu التي يجسّد فيها الفنان صورة شاب وطني أثيوپي حقق انتصارات رائعة في سوح المعارك ضد الغزاة الفاشيين الإيطاليين سنة 1935، ووقّع بالدم مع ثوارٍ آخرين عهدًا يقضي بالدفاع عن وحدة أثيوپيا بأي ثمن.
يركز المخرج على ديانا، إلهة الصيد التي كانت تقصد وادي كاركافي الذي يحتضن في أعماقه كهفًا نحتتهُ يد الطبيعة وفجّرت فيه ينبوعًا يصبُ ماءه في بحيرة محاطة بالعشب تستحم فيه ديانا مع حورياتها كلما تعبت من مشقة الصيد. وفي الوقفة الأسطورية الثالثة يكرر المخرجُ عملية الاستحمام بينما يغامر أكتايّون في الولوج إلى الغابة المجهولة متتبعًا مصيره في الوصول إلى النبع المقدّس.
على الرغم من الجهد الملحمي الذي بذله سامي في الترجمة إلاّ أنّ البعض من أصدقائه الذين قرؤوا الكتاب تكوّنت لديهم ملحوظات جوهرية مثل تفادي الأخطاء الإملائية، وضرورة مراجعة المضمون، والإفادة من المحكية الأثيوپية التي تجدها لدى عامة الناس. كما أن المخطوطة المترجمَة تفتقر إلى التمهيد إلى الكتاب، والأسباب التي دفعته للترجمة، ومفاجأة القارئ بصلب الموضوع، والخوض المباشر في الأساطير اليونانية والرومانية من دون التفكير بتوريط القارئ.
يسلّط المخرج ضوءًا شحيحًا على طفولة سامي وسنعرف بأن أمه ماتت وهو في سن السابعة. ولم يعش مع أبيه بسبب الصراع الطبقي الذي كان مُحتدمًا بين الأبوين، فالأم تنتمي إلى أسرة فقيرة، بينما يُعدّ الأب غنيا بعض الشيء. وحينما توفيت أمه اضطر للعيش مع جده. لا ينكر سامي الارتباط العاطفي بالمدينة التي عاش فيها ولعب في أزقتها وهو طفل صغير، وصبي يافع قبل أن ينغمس في عالمه الثقافي الذي خفّف عنه وطأة المشكلات العائلية التي كانت تتفاقم يومًا بعد يوم.
يتميّز هذا الفيلم بتنوع أجوائه التي تمنع المتلقي من السقوط في فخ الرتابة والملل، فمثلما شاهدنا المعرض التشكيلي وولجنا في بعض ثيماته هناك عرض مسرحي لا يخلو من روح الطرافة وخفّة الظل لألازار الأمر الذي يوضّح أهمية الثقافة القولية وغير القولية.
يكرر المخرج تركيزه تقنية اللعب على أسطورة الصياد والإلهة، وفي كل محاولة ثمة إضافة سردية. فالحوريات اللواتي يحطنَ ديانا رأينَ هذه المرة أكتايّون في فم الكهف وحاولنَ أن يسترنها بأجسادهنَّ لكن رأسها كان أطول من الحوريات ولم يستطعن أن يخبئنها تمامًا فاحمرّت من الخجل مثل شمس غاربة. وبما أنها في قلب البِركة فقد رشقت وجهه بالماء، ولخبطت شعره، وهددتهُ إن كان في مقدوره أن يقول بأنه راى ديانا عارية حتى من ورقة التوت.
يتمنى سامي أن تُوضع صورته التي رسمها مسفين على ظهر الغلاف وأن يعززه بآراء بعض النقاد. يخرج الكتاب من المطبعة بعد قرابة عقدين من الزمان، ويُجرى له حفل توقيع متواضع لا يُحدد فيه سعر الكتاب الذي ترك تقديره للمُقتنين الذين أنتقده بعضهم لأنه لم يتحدث عن طبيعة الكتاب وظروف ترجمته. وبما أن النسخ المتبقية كثيرة جدًا فإنه يفكر بتوزيعها مجانًا. يتمنى سامي أن يقرأ ابنه الكتاب حتى يعرف السبب الحقيقي لإهماله كل هذه الفترة الزمنية الطويلة لأنه كان مُنهمكًا في هذه الأوديسة اللغوية المعقدة.
جدير ذكره أنّ روبن ديميه قد درس السينما في جامعة باريس الثامنة قبل التحاقه بالمعهد الوطني للتصوير السينمائي VGIKفي روسيا. وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية من بينها “أصوات الروح” و “محطة القطار الليلي”.