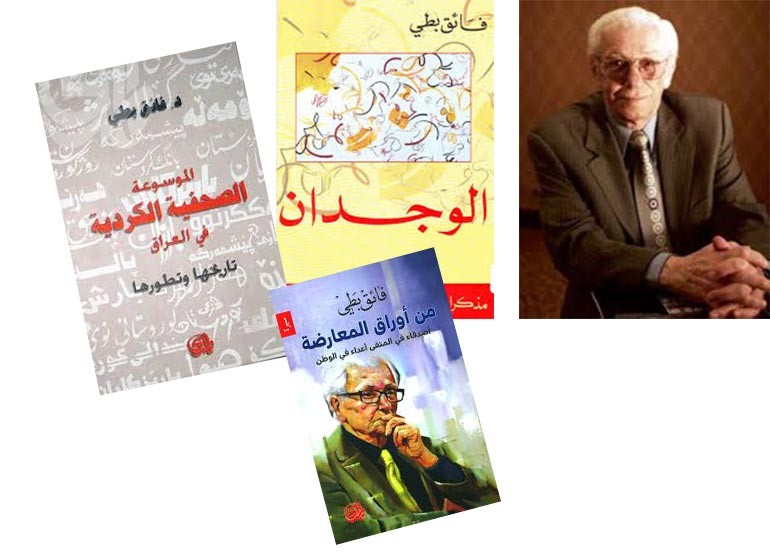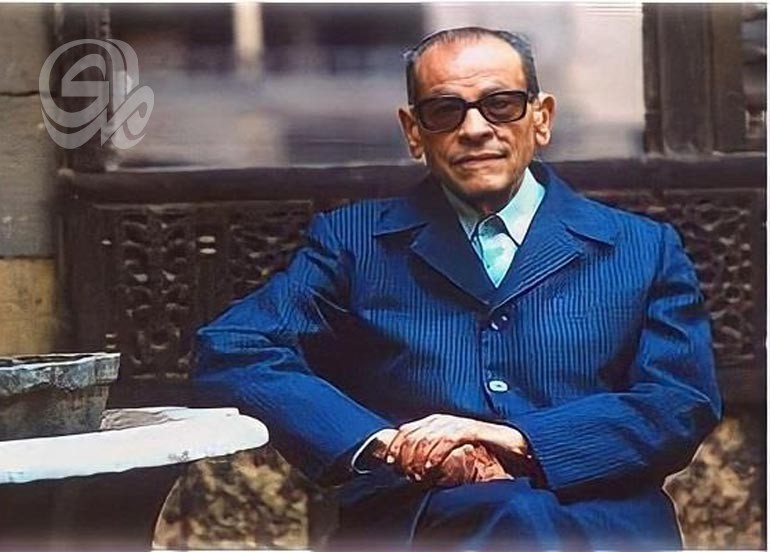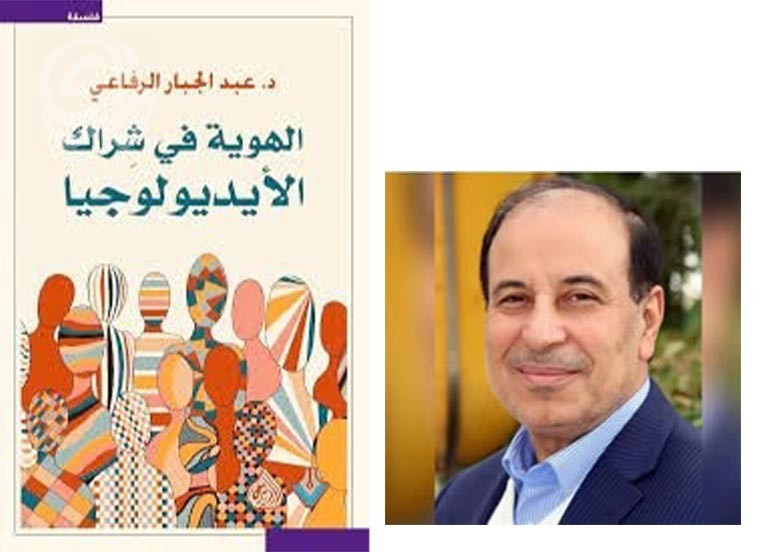زهير الجزائري
(2-2 )
طالب مكي لا يكتب ولا يقرأ عالمه هو الصور. بعين حادة يلتقط الصور من الحياة حوله. يترسم وجود الأشياء في نقاط استقرارها، كما فعل جواد سليم في بغدادياته،
ويترسّم تعابير الوجوه وحركات الأجسام ويحفظها في ذاكرة متوهجة حيث كل ما يستدعيه يحدث الآن. كنت جالساً في مقهى البرلمان حين دخل (ابراهيم زاير) و معه طالب. صداقتي مع طالب ما زالت في بداياتها لا تحتمل المزاح، لكن مزاجه الكوميدي غلبه فجلس إلى جانبي ووضع كوعه على المنضدة وذقنه في راحة يده مبرطماً شفتيه مثلي وقد مللت الانتظار.
سرعته خارقة في الانتقال من الصورة الى المجاز وبينهما قدرة تخيلية تخطف الإثنين وتمزجها في لحظة. كنت في مواجهته وهو يصغي لصديق عصبي لم يتح لنا لحظة صمت. الكلام أسرع من الصور، لأن الأسماء تختزل صور الموجودات وهي في الغالب قيد التشكل او في حركة. يصغي طالب إليه و رأسه يرتد الى الخلف متحاشيأ رصاص الكلمات. تنسد جفونه وتفتح على وقع الأصوات. خرجنا نحن الثلاثة، هو وابراهيم وأنا، دائخين الى شارع، وفي الحال بدأ طالب يقلّد بحركات أصابعه ويديه تدفق الكلمات السريع. الأصابع تعزف سيل الكلمات الدفّاق واليدان تدفعان تراب الكلمات الى الأرض. في النهاية أخرج طالب من فمه مسدساً وهمياً وأطلق على كل واحد منّا رصاصة والثالثة في رأسه هو، ثم وضع المسدس في جيبه.
تحويل الكلمات الى رصاص يرينا كيف يتحول العجز الى نرفزة حين تفقد الكلمات الملفوظة معانيها وتتحول الى محض أصوات. يتراكم العجز كلما تسارعت الكلمات.…فجأة أفزّ وأنا أتحدث مع طالب على حقيقة أني تيّهت الرجل وأنا أحدثه. عليّ أن أبطئ و أحرك يدي لأعين الكلمات على الوصول إليه. حين يتعب طالب من تدفق الأصوات حوله في المقاهي يلجأ الى الصور بديلاً. الحياة تهديه حين ينعزل عنّا حشداً من الصور مندمجة أو مقطوعة عن سياقها الحركي. مامن أحد مثله يجيد تقليد أفندي يدخل المقهى ويجلس في مكانه المعهود ويفتح الجريدة ليكشف هويته كمثقف، أو ريفي في وليمة يغرف الرز باصابع يده ويسيل الدهن من كوعه، طريقة جلوس المعزّين في فاتحة وهم يردون التحية بالجملة ويحركون فنجان القهوة.. هذه اللغة الإشارية هي موهبة طالب ووسيلته للمعرفة. أحيانًا يجسّد التخييل الى واقع توشك أن تصدقه فيقلّد استاذه فايق حسن وهو على دراجته. يدير غليونه الى طارف فمه قبل أن يستدير بدراجته. التخيل عنده طريقة للفهم.
الصور مبثوثة في الحياة يلتقطها حيثما يلتفت. نحن الكتاب نحولها إلى كلمات، بينما يبقيها طالب في خامتها كصوّر. حين تشحّ الصور في الحياة يذهب طالب الى المجلات.” ثقافته، كما يقول أديب، من نوع خاص جداً، مرئية و تحليلية من خلال ذكاء وقّاد يكشف و يحلل و يقرّر بطريقة فذّة جداً. يهوى جمع المجلات الامريكية مثل: مجلة لوك Look و مجلة لايف Life الامريكيتان. يقضى وقتاً بالتفرج على صورها، و يسال من يشترى منه عن مختارات ما يجذبه من صور و اخبار: يحلل الصور الفوتوغرافية و يحدثني عنها لساعات».
بهمهمته وكلماته المبتورة وتعبيراته الجسدية يعطينا طالب علامات وإشارات لفهم لغته الخاصة. من الجيم المضغوطة وفتحة الفم الواسعة عرفت منه اسم جواد، و هو واحد عنده، لا حاجة لإضافة اسم الأب.هذا ما ينبغي أن يكون معلوماً لدينا. استبدلت ذاتي بذاته فنطقت (ج واااد) على طريقته ثم وضعت أصبعي على قلبه. فهم طالب بسرعة سؤالي عن تأثير (جواد) عليه. حرك رأسه بنصف دائرة محدقاً بعينيه بالحياة حوله، ثم نقر على صدغه علامة التفكير العميق ليريني كيف يتبحر جواد في الواقع ثم يعيه، وبعد ذلك يرسم.
مثل جيل أساتذته الرواد وجيله الستيني كان طالب أمام السؤال البسيط المحيّر: الحداثة أم المحلية؟ الرسامون البولونيون الذين قدموا للعراق مع الجيش الإنكليزي قالوا للرسامين العراقيين: لن تصيروا فنانين إذا لم تفهموا بيئتكم المحلية.. هكذا كتب بلند الحيدري عن لقاء كان شاهداً عليه. بين المحلية والحداثة لم تكن فجوة قطيعة. فالدولة نفسها تتقدم نحو الحداثة بخطوات متمهلة منذ نهايات العهد العثماني. ومن جانبها تزحف الحداثة على إيقاع العسكر. الأرياف البعيدة وجدت نفسها تندمج في السوق العالمي وقد شقّها(الريل) والبواخر النهرية. ومن مواطن الحداثة في الغرب دخلت أسواقنا بضائع غيرت حياتنا وأزيائنا. تظهر هذه البضائع( ماكنة سنجر وساعة نيفادا وراديو فليبس وباصات الطابقين كمفردات أصيلة ومحلية في رسوم فيصل لعيبي).التيارات الفنية الحديثة في الغرب صارت جزءاً من برامج التدريس في العراق وانقسمت وفقها جماعات الفن العراقية.
كنت اتنقل حاملا نضدة الكتب في يميني، من مقهى الكتّاب (البلدية) إلى (مقهى أم كلثوم) حيث الرسامين. المقاهي كانت لنا أبناء المحافظات بيوتاً ومطاعم و أماكن عمل وجدال. أخترق غيمة من روائح الشاي ودخان الأراكيل، فأجد الرسامين الستينيين فيصل لعيبي، صلاح جياد، قاسم الساعدي وابراهيم زاير. صف من عيون تتحرك بين الورق والمشهد. كل منهم منكب على أوراقه يرسم من حوله في المقهى أو ما يجري حوله في الشارع كما يفعل الانطباعيون الفرنسيون. هذه الممارسة التي تعلموها من اساتذتهم العائدين من الخارج. الضوء الأفقي يدخل عمق المقهى ممزوجاً، بالغبار والأدخنة، متدرجاً ومتغيراً بمرور الوقت.الموضوع أليف، ولكنه يغادر استقراره حسب زاوية النظر. أتيه وأنا أراقبهم بين المؤثرات.أيهما أوقع المشهد المرئي أم ضربات الانطباعيين في باريس؟ لم يكن الأمر مفارقاً، بل يختار الرسام المشهد الأكثر محلية والأقرب إلى القاع، الكاسب المرتدي (جراوية بغدادية) والجالس قريباً من عربة الكسب. سيراوح الموضوع بين الأصالة والحداثة.أدوات الانطباع والفهم لتي تعلمناها من الغرب صارت جزءاً منّا و علمتنا كيف ننتقي مفردات محليّتنا و نكيّفها لحداثة متأصلة. استعير من (سهيل سامي نادر) وصفه للتداخل بين الثقافتين الغربية والمحلية”الثقافة الأولى (الغربية) كانت في المقاييس العراقية آنذاك شبه معزولة، لكنها كانت تتصيَّر بوضوح مع بناء الدولة الوطنية واحتياجاتها، وفي ارتباط السوق المحلي عضويًا بالسوق العالمي، وولادة حاجات جديدة. و من جهة المثقفين لم تكن تجسيدات هذه الثقافة واضحة إلا في كونها أفكارًا وحالة من الإعداد والتدريب وأملا في التجديد».
الحداثة كانت هاجس طالب الدائم، كما هو هاجس من حوله من أبناء جيله. “حين انتقلنا من الأعظمية الى الشواكة- يقول شقيقه أديب مكي- افردت لطالب غرفة محاطة بالأسرار والغموض. حين يدخلها طالب يغلق الباب و يقفلها على نفسه، و يقفله حين يخرج”. في هذه الغرفة يدخل طالب مختبر التجريب مراوحاً بين التجريد والتشخيص. لكن الحداثة، والمزيد منها كانت طريقه إلى المزيد من الحرية. بعد تخرجه عيّن مدرساً في (معهد الأمل) للصم والبكم. هنا تذهب لغته الإشارية لقومه بلا وساطات لغوية. فى نهاية العام الدراسي اقام المعهد حفلاً ختامياً و معرضاً.شقيقه الفنان أديب كان معه وهو في عمر السادسة عشر “ …كان المعهد ينبض بالفرح. الأولاد يركضون نحو معلمهم و يحتضنوه، مما اثار استغرابي ثم تقديري لطالب. أعمال الطلبة كانت من أجمل ما رأيت.مدهشة. مؤلفة من خامات غريبة: قطع خشبية، ليف، قطع حديد مقتطعة من أجهزة، ، أشياء متروكة تحولت تحت إشراف طالب إلى معان رمزية. من خلالها استطاع ان يلهم طلبته بالخروج عن المألوف و التعامل مع الغير متداول والغريب بشكل مبدع. الطلبة عشقوا هذه الحرية في العمل الفني».
عام 1965 أسس طالب مكي مع مجموعة من زملائه ما أسموه (جماعة المجددين} التي ضمت كلّا من (نداء كاظم، وسالم الدباغ، وصالح الجميعي، وعامر العبيدي، وفايق حسين، وإبراهيم زاير، وسلمان عباس). حين أعلنوا عن معرضهم الأول كنا ننتظر منهم المدهش و الصادم الذي نتحدث عنه ولم نصل إليه. المعرض، كما رأيته بدايات ثورة على الأساتذة. الحصان الذي أدمن رسمه فايق حسن ووضعه جواد سليم في قلب النصب مازال حاضراً. جموح الحصان كان تعبيراً عن جيل وجد نفسه وحيداً في الساحة بدون آباء. الجموح هو التمرد الذي لازم هذا الجيل. لكن الفنان الشاب (فايق حسين) حوّله إلى ليفة محروقة الأطراف تكررت في سلسلة لوحات تحت اسم(صهيل الحصان المحترق)، (حامد العبيدي) جرّد الحصان وصلّب أطرافه، بينما وضع طالب الحصان بمواجهة جدار. ما الجدار، هل هو العجز عن النطق أم عجز أوسع؟ مبدعاً رسمه (علي المندلاوي) يجرّ هذا الحصان الحارن في مكانه مكبلاًً في مانع منه ومن خارجه.
الجهود التي بذلها الأساتذة لتأصيل الحداثة وجعلها محلية لم تشغل المجددين. كنت واحداً من المندهشين بمعرض المجددين حين اعتقدوا، وهم يبدأون خطوة نحو المزيد من التجريد. لا حاجة للمحلية! ذهبوا مباشرة الى المنبع العالمي للحداثة. العالم باحداثه الصاخبة في الستينات كان حاضراً هنا في مقاهينا. وصفه (فاضل العزّاوي) في كتابه (الروح الحية) عن جيل الستينات في العراق “الروح التي اطلقتها الستينات داخل المجتمع العراقي متخذة شكل الانتفاضة الثقافية، كانت ظاهرة عراقية بالتأكيد، لكنها لم تكن بمعزل عن الروح الجديدة التي تعصف بالعالم حينذاك، فقد اتفقت الظروف الداخلية مع الشروط الخارجية ضمن لحظة تاريخية نادرة المثال بطريقة يصعب الفصل بينهما. في تلك الأيام بدا العالم وكأنه يسجل مصيراً جديداً للبشرية كلها. انتفض الجيل الجديد في أوربا وأمريكا ضد كل بؤس الرأسمالية ودعاواها الفكرية والأخلاقية، ولكنه رفض في الوقت نفسه الجمود المرتبط بفكر اليسار التقليدي، مانحاً الثورة معنى جديداً، تحرير العقل والجسد من تابوات الماضي».
خرجت من المعرض برفقة (جان دمو). الكولاج كان لي صدمة غير مقنعة. والأكثر هو التكرار. سألت جان دمّو عن المعنى.المعنى كان دائماً مفتاح تقبلي للجديد. جواب جان كان مختصراً مثل قصائده :
-تجربة مكثّفة!
قالها وبصق على الأرض.
القناع كان أيقونة طالب المكررة، وهو موضوع صلته بالحداثة الأوربية. في الغرب الكولونيالي دخل القناع الأفريقي كأيقونة منزلية لجامعي الغرائب وجزءاً من تراث التحديث في أعمال موديلياني وبيكاسو. تأثراً به أو ابتكاراً أصبح القناع موضوعاً ملازما للنحات طالب مكي. رسماً أو نحتاً يتشكل قناعه من صفيحة مربعة صارمة وحادة الحواف تعلوها عينان جاحظتان تجمعان الرعب والدهشة. يقطع القناع إلى نصفين متساويين أنف طويل يشبه السهم يدلّ إلى فم مزموم تعبيراً عن صمت أبدي. لم تكن الكلمات جاهزة، بل هي حبيسة آنذاك.القيود الاجتماعية التي تطوق جيلنا( المعقد) المعزول عن محيطه أضيف لها عند طالب قيد مضاعف، قيد من جسده العاجز عن الكلام.
آخر مرة رأيت طالب مكي واقفاً على المسرح ينظر الى الواقفين إلى جانبيه بحيرة. مامن أحد بجانبه من ذاك الجيل الذي يفهم إشارته؟ مرتدياً بدلة كلاسيكية أنيقة شابكاً يديه تحت بطنه، منصاعاً تماماً لبروتوكول لا يفهمه. يسمع من يتحدث عن سيرته الفنية يبتسم بأدب دون أن يعرف الكلمات، كما هو هاملت في بلاط والده. حين منحه الوزير وسام التكريم تاه بين وجوه الحاضرين ومنهم أنا، تائه حتى عن نفسه، هل هذا أنا؟