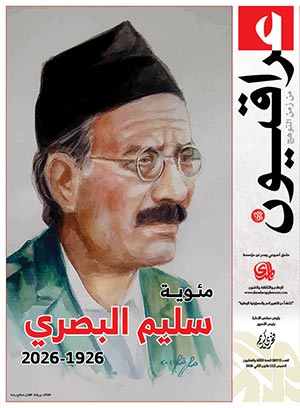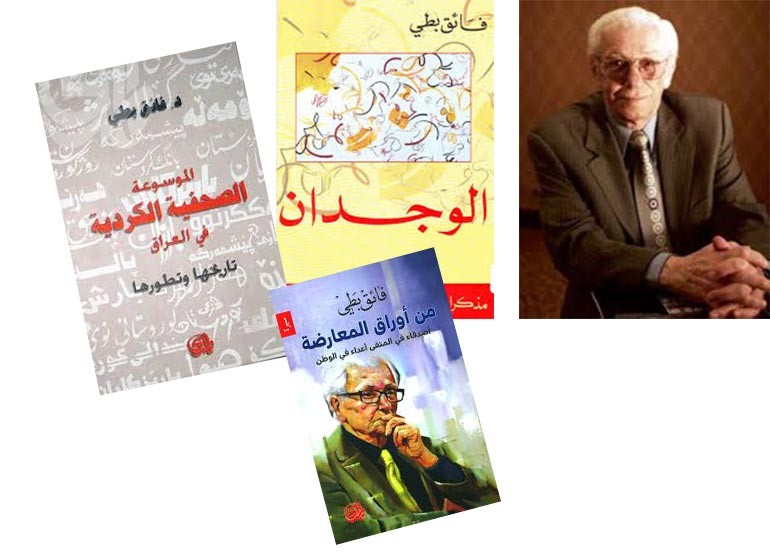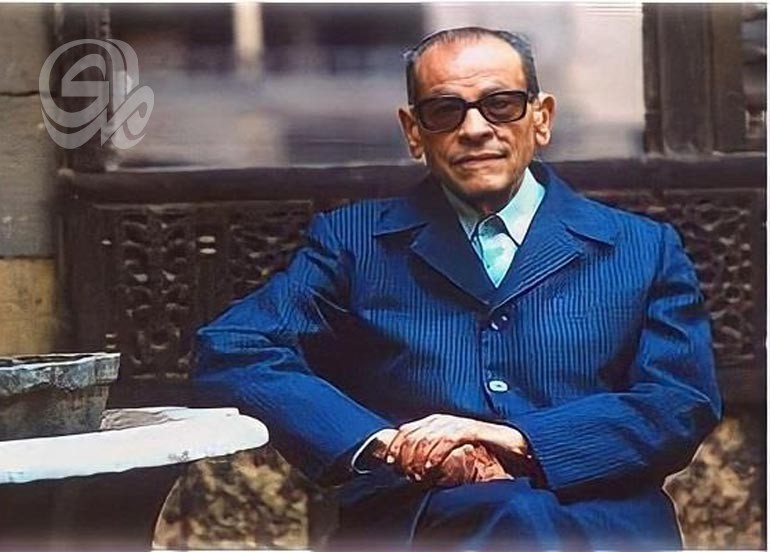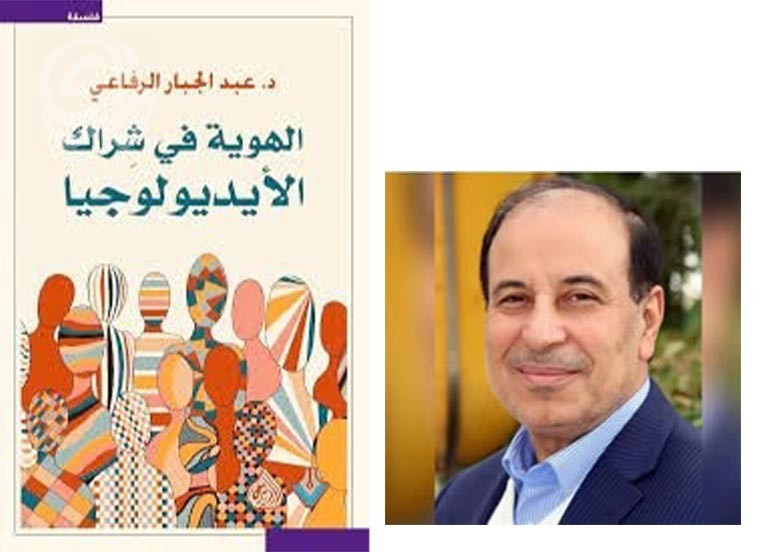فيلمه (أوربا) أول فيلم عراقي تختاره (كان) في برنامجها الرسمي
حاوره: علاء المفرجي
ينتمي المخرج حيدر رشيد (22 عامًا)، إلى جيل عراقي صاغت الغربة ملامح تكوينه. يقف حائرًا أمام أسئلة الهوية والوجود والوطن المُفتقد. الأب عراقي والأم إيطالية.
وجد في الكاميرا نوعًا من حلّ، يجوب بها مدن الغربة (روما، نيويورك، لندن)، لعلّه يرسم شكل محنته.
والده الصحفي المعروف والناقد السينمائي المقيم في إيطاليا منذ اكثر من أربعين عاما عرفان رشيد.. وفسر حيدر حضور العراق في أفلامه السابقة، رغم أنه يعيش خارجه، قائلاً: «أنا نصف عراقي وآخر إيطالي، وطوال حياتي أسعى لتعلم الكثير عن العراق، فقد تربيت على شغف عميق حول حقوق الإنسان، وكلما تابعت الأخبار وجدت شيئاً مخالفاً، وكنت أسعى دوماً لطرح وجهة نظري».
وأضاف أن «الاغتراب انتهى منذ أجيال عديدة، فوالدي رحل عن العراق منذ 40 عاماً، وبشكل ما رغم ذلك استمر الإحساس بأن العراق داخلي وجزء من حياتي ومشاعري، ولهذا السبب أشعر بأنه لدي مسؤولية شخصية تجاه هذه الدولة، لأتكلم عنها وعن الهجرة أيضاً، وأحكي قصصاً لم أمر بها، لأني لم أنشأ ولم أولد فيها، فولدت في بيئة آمنة ومكان مريح، ولكني دائماً أفكر إذا حدث وولدت في مكان آخر أو حدث أمر ما لعائلتي، إنه إحساس صعب على الصعيد الشخصي».
ولد 23 مايو عام 1985 في مدينة فلورنسا الإيطالية وقام بإخراج أفلام قصيرة وكليبات موسيقية وافلام وثائقية ويعيش رشيد الآن ويعمل في لندن، حيث يدير شركته الخاصة للإنتاج السينمائي "بلوسان فيلمزفاز "" بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة المهر العربي للأفلام القصيرة في الدورة العاشرة من مهرجان دبي السينمائي الدولي. وحاز فيلمه الأول "المحنة" على الجائزة الثانية في مهرجان الخليج السينمائي 2010. من أفلامه أيضاً: "صمتاً: كل الدروب تؤدي إلى الموسيقا" 2011، و"مطرٌ وشيك" الذي فاز بالجائزة الثانية في مهرجان الخليج السينمائي 2012، وكان فيلمه الأهم هو فيلك (اوربا) الذي حصد العديد من الجوائز ورشح لتمثيل العراق قي جائزة الاوسكار العام الماضي.
التقته المدى في الحوار:
حدثنا عن الالهام السينمائي الذي تلبسك منذ الطفولة، واثر النشأة الأولى في ذلك؟
- "عندما كنت طفلاً، ما بين التاسعة والعاشرة من العمر؛ عندما كان والدي الصحفي والمخرج عرفان رشيد، يُنجز برنامجاً تلفزيونياً عن تاريخ العرب والمسلمين في صقليّة واختارني أن أمثل معه، فأمضيت شهوراً منغمساً في أجواء كانت بالطبع غريبة ومذهلة لطفل. وكنت قد اعتدْتُ على قضاء الإجازات الصيفية في سنوات المراهقة في مرافقة والدي إلى مهرجانات السينما والفعاليات الثقافية، حتى صرتُ مصوّره الخاص في العديد من المقابلات التي كان يُنجزها للعديد من القنوات التلفزيونية حول العالم، ما زاد من اهتمامي بالوقوف خلف الكاميرا. وبدأت بكتابة بعض النصوص والتجارب، ثم صنعت فيلماً قصيراً مع أصدقائي في المدرسة الثانوية بعنوان «كما الماء» حاولت التعلّم من خلاله على عمل كل شيء، شيئًا فشيئًا. ثم انتقلت بعد ذلك إلى لندن لدراسة السينما، لكن سرعان ما تركت الجامعة لأن الكليّة التي كنت قد اخترتها كانت تُدرّس الإعلام وليس السينما، ثم مارست العديد من الاختصاصات ذات العلاقة بالفيلم كالمونتاج والتصوير وترجمة الحوارات، ومن ثمّ بدأت في كتابة أول فيلم لي، أخرجته وأنتجته في سن الثالثة والعشرين. كانت أحداث الحكاية تدور في لندن والفيلم بعنوان «المحنة» ويروي عن ابن كاتب عراقي معروف يتعامل مع حادث فقدان والده إثر عملية اغتيال في بغداد.
حدثنا عن فيلمك الأول (المحنة) الذي شكل الملامح الأسلوبية للمخرج حيدر رشيد؟
- أنجز شريطه الروائي الأول «المحنة» والذي تناول محنة شاب عراقي بريطاني ولد من أبٍ عراقي (مثقّف مهاجر يُغتال في بغداد بعد عودته اليها غداة سقوط التظلم الديكتاتوري) وام بريطانية، وتشكّل الآصرة المتشابكة والملتبسة ما بينه والأب والام اللُحمة الاساسيّة في الفيلم. الفيلم فيلمه الأول بعنوان «المحنة»، يحكي عن لندن وفوضى الزحام والحركة، وعن ابن كاتب وأكاديمي عراقي يواجه محنةً تتعلق بنشر كتابه الأول عن مذكرات ومأساة والده الذي اغتيل في بغداد بعد عودته إليها عام 2003.
وبغداد في «المحنة» موجودة في مذكرات والد البطل، وسوى ذلك هو صدى بعيد في خضمّ المعاناة الوجودية للبطل لكن حيرة البطل وقلقه انعكاس طبيعي لأزمته وهو يحمل مخطوطة كتابه متنقلاً بها بين دور النشر. فشله في إيجاد توصيف لعلاقته مع صديقته بعد 4 أعوام على علاقتهما، هذا كلّه نتاج طبيعي لأزمة أكبر تغلّفها الأسئلة. بالنسبة إليّ، يتحدّث الفيلم بشكل حقيقي عن العراقيّ، وأيضًا عن معاناة الإنسان مُمزّق الهوية.
لكنك أولت وعالجت الفيلم بغير ما كتب فيه؟
- بعد عرض الفيلم، أشار حيدر إلى مواجهته صعوبة في إنتاجه، الذي استغرق 3 أعوام. فهل لازمته الفكرة نفسها هذه الفترة كلّها؟ يقول: «في البداية، كان الفيلم عن علاقة رجل بامرأة. هو مُقتبس عن مسرحية قصيرة للكاتب براد بويسن تمّ التصرف بها لتأخذ منحى شخصيًا فتكون التجربة العراقية ثيمته. ربما هو الإحساس بعراقيتي، بنصفي الآخر، بوصفي من الجيل الثاني من المهاجرين العراقيين. هذا موضوع تناولته سابقًا في فيلمٍ وثائقي، وقد واجه مع فريق عمله في هذا الفيلم الجديد صعوبات مادية وروحية، كنتُ أسعى إلى خلق توتر. لا أريد مُجاملة المُشاهد، لذا عليّ إحداث توتر لديه. لا أريد إثارة عاطفته، بل وضعه أمام أسئلة شائكة. كارثة العراق خلفية للحدث، والدمار موجودٌ في الفيلم.
من ناحية أخرى، تبدو شخصية الشهيد المفكّر كامل شياع حاضرة في ذهن المخرج حيدر رشيد، وهذا يؤكده إهداء الفيلم له؟
- ليس هذا بالضبط، وإنْ أعترف أن لاغتياله تأثيرًا كبيرًا عليّ، لعلاقته الوطيدة بي وبوالدي. ربما كان نموذجًا لتفكيري، لكني هنا لا أسعى إلى شخصنة الموضوع، وهو أشمل من ذلك، فهو عن العلاقة بين أب وابن، وأيضًا عمًا يعانيه البطل في أزمته»، رغم الاستعانة بوالدي، الذي له أثر كبير في تفاصيل عديدة متعلّقة بهذا الموضوع، أحمل وجهة نظر خاصة عن موضوع العراق، عالجتها برؤيتي الموجودة في الفيلم. أنا لستُ معنيًا بأية قراءة أخرى. أنا معنيٌّ فقط بطرح رؤيتي للموضوع.
ومرة أخرى يعود موضوع الهوية والانتماء من جديد الى عمل حيدر رشيد حين انجز فيلمه الروائي الثاني «مطرٌ وشيك»؟ ما تعليقك؟
- تناولت فيها حياة وحالة من يُسمّون في ايطاليا واوروبا بأبناء «الجيل الثاني»، وهم ابناء المهاجرين المقيمين في ايطاليا (بشكل قانوني) لكن دون ان يتمتّعوا بالمواطنة الايطالية، وعلى الكثير منهم مغادرة البلاد الى بلادهم الاصلية في حال انتفاء المسببات القانونية لبقاء ذويهم في ايطاليا، وهي في الغالب مسببات اقتصادية تُحبر ابناء هذا الجيل الى واحدٍ من خيارين:
إما البقاء في ايطاليا بشكلٍ غير قانوني والتعرّض الى كلّ التبعات القانونية والقضائية لهذا الوضع، او «العودة» الى بلاد ابائهم والتي لا يعرفونها إلا عبر ذكريات وحكايا ذويهم وربما لم يتعلّموا حتى لغتها.
يروي الفيلم حكاية «سعيد مهران» - وهذه تحية مشتركة من المخرج الى نجيب محفوظ وكمال الشيخ لرواية وفيلم «اللص والكلاب»، الذي ادى بطولته الراحل شكري سرحان-.
بعد «مطرٌ وشيك» عاد حيدر رشيد في فيلمه الوثائقي الموسيقي الثاني وكان بعنوان «ستريت أوپرا».. ما موضوعه؟
- موضوعه تجربة خمسة من موسيقيّي الهيب هول الإيطاليّين، والذين قدّموا عبر عمله صورة وقراءة للمجتمع الايطالي المتنوع من شماله الى جنوبه، وهما، الصورة والقراءة، التي يُفترض بأيّ سياسي ايطالي (وغير إيطالي) ان يقرأها ويشاهده ليتعرّف على المتغيّرات الحاصلة في المجتمع الايطالي (وغيره) بالذات في عالم الشبيبة الذي فقدت السياسة وشائجها معه ونأى الشباب عن السياسة لعجز السياسيّين عن التعامل معه وادراك المتغيّرات الحاصلة في ذلك العالم الذي يمثّل الغد، وهي متغيّرات ليست شكليّةً فحسب، بل فكرية، سوسيولوجيا وسيكولوجية ايضا.
حدثنا عن فيلمك القصير الذي كان بعنوان « No Borders" الذي تبع فيلمك «صمتاً، كل الطرق تؤدي الى الموسيقى»؟
- وهو الفيلم الايطالي الأول الذي يُنحز بالواقع الافتراضي وحاز، بعد عرضه في مهرجان فينيسيا، على جائزة «ميغرارتي» الممنوحة من قبل وزارة الثقافة الايطالية، كما حاز على جائزتين من ضمن جوائز «الشريط الفضّي» الذي تمنحه «نقاد نفّاد وكتاب السينما الايطاليين».
وشكّل ذلك الفيلم المُنجز بتقنيات الواقع الافتراضي، الخطوة الأولى من مراحل انجاز شريط «أوروبا»، كما يقول المخرج حيدر رشيد «إذْ أردت ان انقل حالة الشعور بالغرق التي يستشعرها المشاهد وهو منغمسٌ في الواقع الافتراضي حواليه، الى الواقع الحقيقي الذي يستشعره انسانٌ وحيد تُلقي به الأحداث في مجاهل غابة عدائية لا نهاية لهافكما المشاهد في « No Borders» يعيش كلّ زاوية من زوايا مأساة المهاجرين المكدّسين عند نقطة الحدود الإيطالية الفرنسية في مدينة فينتيميليا الايطالية دون اي افق للخلاص، اردت للمشاهد ان يُعايش الساعات الاثنتين والسبعين التي يعيشها بطلي «كمال» وتحيله الى حالة الانسان الاول على الارض الذي عليه ان يواصل السعي والهرب للخلاص من خطر محدق والوصول الى هدف ما، لكن دون ان يكون ذلك الهدف، اذا ما بلغه بالفعل، هو الخلاص بعينه.
نعود الى فيلمك (أوربا) الذي يعد أهم افلامك بما حصل عليه من جوائز وتقدير من قبل النقاد والجمهور إضافة الى شرف اختياره تمثيل العراق في جائزة الاوسكار العام الماضي.. ما الذي يرويه هذا الفيلم؟
- يروي الفيلم اثنتين وسبعين ساعة من حياة الشاب العراقي العشريني «كمال» الذي يحاول اجتياز الحدود التركية الى أوروبا عبر بلغاريا، برفقة مجموعة من المهاجرين غير القانونيّين الذين يسلّمون قيادهم الى مهرّبي البشر ليقعوا فرائس بين يدي شرطة الحدود البلغارية، ومن بعدهم «صائدو المهاجرين» وهم مجاميع مدنية ذات ميول واتجاهات فاشيّة مناهضة للغريب، تعمل على الاثراء عبر اصطياد المهاجرين وسرقتهم من كلّ ما بحوزتهم من مالٍ ووثائق وادوات. وفيما يصبغ هؤلاء سلوكهم بأرديةٍ أيديولوجية وفكرية عنصرية، فإنّ واقع الحال، وتحقيقات صحفية وقضائية كثيرة، أثبتت بأن عمل هؤلاء ليس إلاّ المرحلة الثانية من عمليات تهريب البشر وإثراء المنظومات والجماعات الإجرامية المنظّمة التي تقف وراءها مافيويّات عديدة، سواءٌ أكانت عبر البحر من شمال أفريقيا، أو عبر ما يُسمى ب «طريق البلقان» الذي تدور في مجاهيله أحداث الفيلم والساعات الاثنتان والسبعون التي يعيشها الشاب كمال، والذي يؤدّيه، بحضور متميّز، الممثل الليبي البريطاني الشاب آدم علي.
تنتهي الساعات الاثنتان والسبعون التي نشاهدها من حياة «كمال» بنهاية مفتوحة، لن نعلم إلى مَ ستنتهي، لكنّ النغمة الموسيقيّة الوحيدة في الفيلم، والمأخوذة من «Tender Breeze" للموسيقي العراقي الكبير نصير شمّة ستوحي الى المشاهد ما قد يؤول اليه مصير هذا الشاب.
فيلم «أوروبا» هو العمل الطويل الخامس الذي يُنجزه المخرج العراقي الايطالي حيدر رشيد، والذي شكّلت مسألة الهوية والانتماء والتعايش ما بين الثقافات.
هل يعزف فيلمك الجديد «أوروبا» على الوتر نفسه لأفلامك السابقة، حيث المعاناة والمشاكل التي يعانيها أبناء الجيل الثاني من المنفيين العراقيين؟
- لا، ليس الأمر هكذا. الموضوع مُختلف، لأنّ الشخصية التي يروي الفيلم حكايتها ليست من أبناء الجيل الثاني من المهاجرين، بل شاباً يبحث عن حياةٍ جديدة في مكانٍ آخر. لذا، موضوعُ الهوية والانتماء مركزيان بالنسبة إليه، ويبرزان بوضوحٍ في الأيام القليلة التي تُروى فيها الحكاية. الفيلم مُختلف عن أفلامي السابقة، لكنّه، رغم هذا، يتّبع مساراً مُشتركاً، يرتبط بأعمالي السابقة. إنّه، على أيّ حال، أكثر ارتباطاً بفيلمي القصير «لا حدود»، أكثر من ارتباطه بـ»مطرٌ وشِيكْ».
كما في أفلامك السابقة، استعنت هذه المرّة أيضاً بممثلين أجانب، رغم أنّ الموضوع عراقيّ، والشخصية عراقية.؟
ـ الممثلون يتكيّفون ويتأقلمون مع ما يؤدّونه، فيكون التماهي أكبر وأعمق، إذا كانت أدوات الممثل مكتملةً. بالنسبة إلى «أوروبا»، مُهمٌّ لي أنْ يكون الممثل من أصل عربي، وأنْ يستوعب مغزى الفيلم ومضمونه من وجهة نظر عاطفية، وأيضاً من وجهة نظر الانتماء والهوية. لم يكن ضروريّاً مطلقاً أنْ يكون عراقياً، فالجذور العربية للممثل آدم علي ساهمت في توضيح الأمور لديه. علي ليبيٌ، ولد في ليبيا وسافر منها، في سنٍّ باكرة، إلى إنكلترا، رفقة عائلته. تمكّن من استيعاب المستوى العاطفي لمعنى مغادرة البيت ومسقط الرأس، والرحيل إلى مكان جديد. ربما أَشْعَرهُ هذا بالخوف نفسه الذي شعرَ به كمال، الشخصية الرئيسية في «أوروبا».
هلا حدّثنا عن تمويل الفيلم وإنتاجه؟
- في البدء، أردتُ صنع فيلم بمالٍ قليل. هكذا، بكلّ بساطة: عملٌ يُنجَز بالتعاون بين أصدقاء عديدين. انتبهتُ لاحقاً إلى أنّ من المنطقي أنْ أحاول جعله أكثر تنظيماً. «لجنة توسكاني للأفلام» أول من اقتنع بالمشروع، فمنحتني جزءاً من الميزانية. استوعبَتْ قيمته رغم اطّلاعها على مُعالجة أوليّة فقط. النص جزءٌ واحدٌ وبسيطٌ من المشروع، بينما الأهمّ كامن في ما سيُنجِز في موقع التصوير. فيما بعد، حصلتُ على دعمٍ من وزارة الثقافة الإيطالية، ما منح المشروع علامةً رائعة.
باختصار، تمكّني من صوغ مشروع إنتاجي، يضمّ إيطاليا والعراق والكويت، خطوة مهمّة، أكثر انسجاماً مع مشروع كهذا. إنّه فيلم إيطالي عراقي كويتي، لكنْ من دون أنْ يعني ذلك بأنّ هوّيته منغلقة في هذه الحدود. غياب الحوار ساعد على منحه هويّة عالمية، إذْ يُمكنه حينها أنْ يكون فيلماً ألمانياً أو بوسنياً أو إسبانياً أو لبنانياً. إنّه، حقاً، فيلمٌ غير مُحدّد بأيّ خطابٍ إقليمي أو أوروبي، لأنّ ما يرويه حدثَ ويحدث على الحدود، في مناطق كثيرة من العالم بأسره.
لكنْ، هل يُمكن تفسير اختياره في مسابقة «نصف شهر المخرجين» في مهرجان «كانّ 2021» وهو اول فيلم عراقي يفعل ذلك، مؤشّراً على كونه يُخاطب الجمهور الأوروبي بعقلية أوروبية؟
- أعتقدُ أنّ «أوروبا» يخاطب أيّ جمهور، ومن ضمن ذلك الجمهور الأوروبي. إلاّ أنّ هذا لا يعني أنّه فيلمٌ صنعه عربي للجمهور الأوروبي. «أوروبا» صُنع ليروي هذه الحكاية: حكاية الشاب كمال، الباحث عن حياةٍ أفضل في مكانٍ آخر. استشعرت هذا عندما كنتُ في القاهرة، حيث عرضتُ جزءاً منه في «ملتقى القاهرة السينمائي» في دورة عام 2019. فاز المشروع بجائزة OSN TV. كان يجلس إلى جواري مخرجٌ عربي، قال لي: "أنتَ تروي بفيلمك حكايتنا. نحن، جميعاً، نرغب في الهروب من بلادنا".
وكيف جاءت فكرة الفيلم؟
- "حين انتهيت من إنجاز فيلمي الوثائقي الموسيقي "ستريت أوبرا» في عام 2015، كانت تقنيات «الواقع الافتراضي» في طريقها إلى البروز وبدا لي بأن هذا التقنيّة وجدت لتبقى. لم تكن، بالنسبة لي في تلك اللحظة مجرّد تلاعب بالتكنولوجي، بل وسيلة لتوسيع مديات الرؤية بالتصوير بزاوية 360 درجة واستخدام الصوت الغامر. لم تكن التكنولوجيا كافيةً بعد لجعل الواقع الافتراضي يعمل كما هو الحال اليوم، وكان الجزء الأكثر متعةً خلال تلك الفترة هو ابتكار حلول لمواجهة التحديات التقنية. كنت محظوظًا جداً للعمل مع شخصين أساسيين في هذه العملية: زميلي دانييلي برنابي، الذي عملت معه لسنوات، وكان قد انتقل للعمل الآن في لندن في Foundry، أحد أهم شركات برامج المؤثرات البصرية في العالم، وعلى وجه التحديد على أدوات VR لـ Nuke، ومجموعة VFX الخاصة بهم ؛ أمّا الشخص الثاني فقد كان زميلي غابرييلي فازانو، مصمم الصوت الخاص بي الذي كان يعمل ويبحث عن الصوت المكاني لسنوات ودرسنا الوسائل لمعرفة كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة المذهلة. ومع ذلك فقد كنت متأكّداً من شئ واحد، وهو، أنّه، على الرغم من التأثير المبهر لهذه التقنية، فإنّ تقنيّة الواقع الافتراضي، لم تكن بالنسبة لي إلاّ وسيلة للتحريض في السرد الجيد، لأنّ ذلك كان سيمنحه الفعالية والضرورة، وإلاّ فإنّ سيبقى مجرّد تقنية عالية. عندها خطرت لي فكرة فيلم " No Borders - لا حدود!"،،أردت بأن أغمر به الجمهور في مراكز إيواءٍ للاجئين مدارة ذاتياً في روما وفنتيميليا - على الحدود مع فرنساوالقريبة جداً من جدًا مدينة كان -. كان الفيلم محاولة لإظهار الأشخاص من داخل النضالات التي يواجهها هؤلاء الشبان والشابات في السفر عبر البلاد، بعد وصولهم إلى سواحل جنوب إيطاليا، للوصول إلى شمال أوروبا.
ما هي نظرتك إلى السينما العراقية؟
- واضح أن هناك نموًا مُتصاعدًا للسينما العراقية. هناك حركة في إنجاز أفلام في العراق ذات جودة عالية. أعتقد أن مهرجانات السينما تمثّل فرصة جيدة لتقديم السينما العراقية بصورة مختلفة، في ظلّ وجود عدد كبير من صنّاع الأفلام في العراق والمنطقة. ورغم حاجة العراقيين إلى خدمات إنسانية عديدة، فهم يحتاجون أيضًا إلى إبراز ثقافتهم وتقديمها إلى العالم».
ما هي مشاريعك القادمة
- لديّ مشروع فيلم روائي كبير عن الحرب العراقية ـ الإيرانية أعتزم تصويره في صحراء الأردن، يتناول آثارها السلبية، فهي حرب على الإنسان. كما أعمل على مشروع فيلم طويل بعنوان (بابيلون)، هو أهم بالنسبة إليّ، ويتحدّث عن رحلة شاب عراقي من الجيل الثاني المولود في المهجر. رحلة عودة إلى العراق بحثًا عن سرّ أو أصول تعرّف عليها عبر والده».