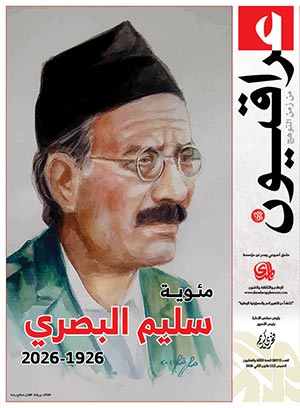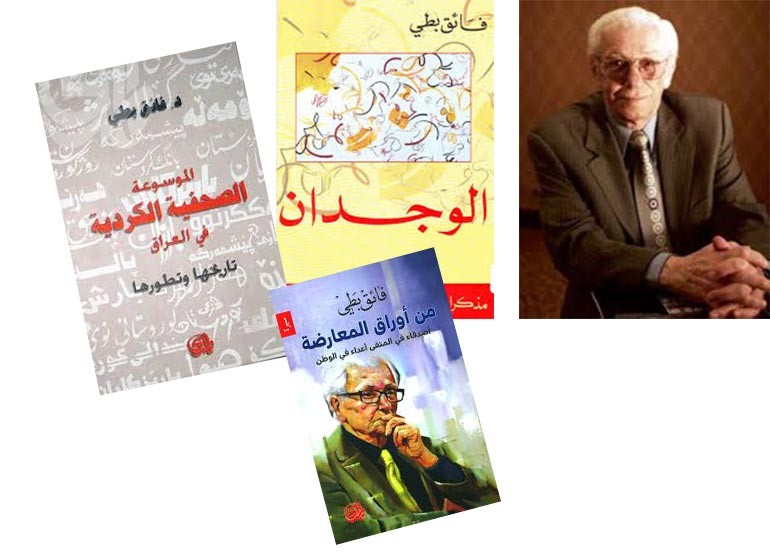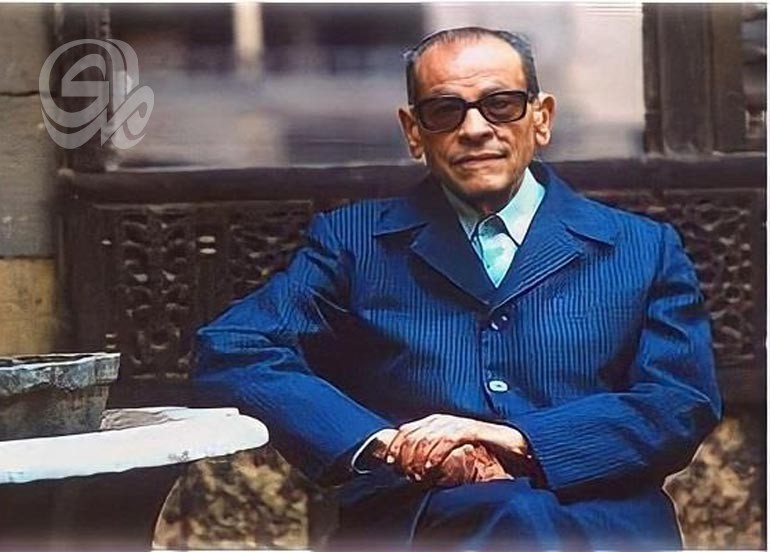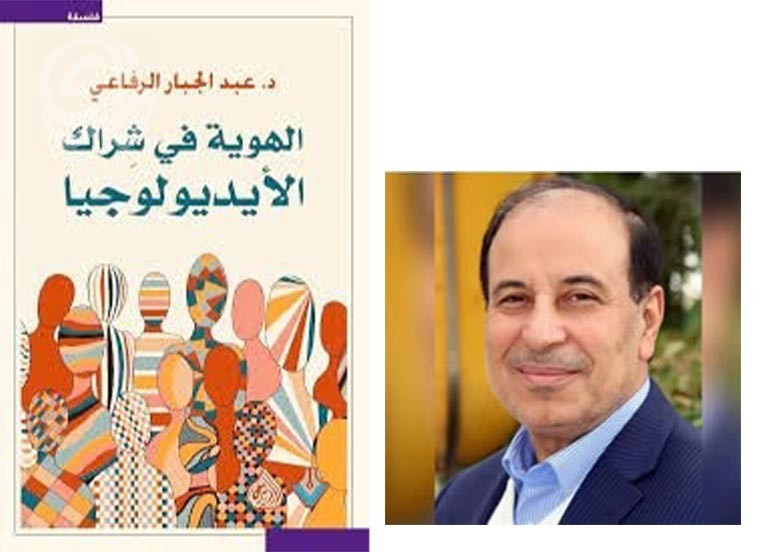علاء المفرجي
الطفولة والمكان هي المفاتيح السحرية، لأبواب الموهبة والابداع، ورسم ملامح المستقبل.. فمنهما يستمد كل من اصبح موهوبا في المعرفة خطواته التي تقوده الى المنابع الصافية للكتابة أو الرسم أو الموسيقى..
مراجع ومصادر كثيرة ومؤثرة تحفل بها الطفولة، وينعم بها المكان، هي التي تسهم في صياغة المبدع وترسم هويته الإبداعية، وكما يقول باشلار: «البيت ركننا في العالم، إنه وكما قيل مرارا، كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى» .
فهناك علاقة غريبة التي تربط المبدع بالمكان، ما مدى تاثير هذا المكان في صياغته مبدعا، وما هي المراجع والمصادر التي قادته الى الابداع منذ الطفولة؟ أوكما يقول الشاعر إبراهيم البهرزي «وانت تسعى الى الشعر عليك الا تاخذ معك دليلا.. فهو ما تتلمّسه لا ما يدلّك عليه احد» .
عدد من مبدعينا تحدثو عن الطفولة والمكان في صياغة حياتهم.
محمد خضير
تختلف طفولتي قليلاً في بيئتها وتأويلها اجتماعياً وسيكولوجياً. عشتُ في كنف أبوين حتى سنّ متقدمة، وعمّرت أمّي اثنين وتسعين عاماً. لكن أيّاً من هذين الحدّين العائليين لم يكن فاعلاً ثقافياً في نشأتي، فقد كان كلاهما أميّاّ. كما لم تُتح لي فرصة الكتابة عن الوالدة في حياتها، بعد وفاة الأب عن واحد وستين عاماً. كتبتُ نصّين مختصرين عن هاتين الركيزتين (في كتاب: ما يُمسَك وما لا يُمسَك) ولكن بعد سنوات من وفاتهما. لم أكتب عن أصدقاء الطفولة صفحة واحدة تستحق الاحتفاء ما عدا قصة أو قصتين. لكن شذرات من حياة البيت الذي ولِدتُ فيه، وكان واقعاً قرب النهر (شط العرب) ظهرتْ في كتاب (بصرياثا) بينما لم تحظ سنوات المدرسة الابتدائية بقسط وافر من الكتابة. كنت كما يبدو طفلا انعزاليا، أو شقيّاً. وما عدا هذه الصفحات المتفرقة لا أتذكر شيئاً مثالياً من طفولتي، ولا عن طموح الكتابة المستقبلي، فقد كنت أطمح لأن أكون معلّماً. وأعتقد اليوم أن ما نقيّده بالكتابة وحده ما يسترعي الانتباه والاعتبار. وما تلا من سنوات النشأة الأدبية كان أكثر اختفاء والتواء، حتى أن كتابة سيرة ذاتية «حرفية» كان غير ممكن على الاطلاق. أنا أعجب كيف تهيأت لزملائي الكتّاب ذاكرة واضحة المعالم كي يعودوا بها للوراء. إنّ تذكّر الماضي وإعادة كتابته ليس متطابقاً تماماً، خاصة لمن اعتاد تحريف الحوادث لتخدم أغراضه السردية.
البصرة في قصصي ليست مكاناً جغرافياً وحسب، إنما ارتساماً زمنياً لصيرورة شخصية، وحيّزاً للتخييل والحلم بمدينة أخرى. لكن أيّ مرتسَم آخر مفتعل لها كان سيتطابق ونسخة سابقة قامت قبلها، فهي تستمر بالتناسخ الى ما لا نهاية. هذا ما حاولت قوله (أحلام باصورا) الحلقة الثانية من (بصرياثا). ثم تأتي الحلقة الثالثة (العشّار) لتبحث عن أسماء أخرى، وطوبولوجيات قصصية لرواة مجهولين، ينوب عنهم السارد الأخير في تخييل حياتهم ومِهنهم وألعابهم. إنها بهذه الحلقات المتواشجة، مدينة ذكرى، لا تظهر إلا لمن يتخيلها، ولن تستقر على حال حتى تستنفد شعاعها الأنثروبولوجي والتاريخي. والحقيقة إن قصص (بصرياثا) بحلقاتها الثلاث أنثربولوجيا سردية متحوّلة أكثر منها خطاباً تاريخياً متوارثاً في الكتب والروايات. ذكرى أكثر منها حقيقة، أو بالأحرى سيرة مخطِّط مدنٍ قديم (مسافر فقير، مترحِّل بين المدن)، وستتوالى في أذهان المخطِّطين المتعاقبين وتسافر معهم. إنها ليست نقطة على خارطة، بل مُخطَّط قابل للتشكيل والتغير الطبيعي والمناخي والإنساني. وما كتبتُه عنها (وأظنني اكتفيت وانتهيت من رسمها) يقترب من تلك الصورة التناسخية. أما صور المدينة في قصصي الأخرى فهي تخطيطات مرتجلة لصورة أصلية من بصرياثا القديمة.
يحيى الشيخ
ذات يوم وجدت نفسي طفلاً في قرية «اللطلاطة» على خاصرة دجلة جنوب العمارة، شمال قلعة صالح، قرية دخلت جغرافيا العراق لمئتي عام بقوة التاريخ، وخرجت منها بقوةً المستقبل. قرية تكرست للصابئة المندائيين وحدهم، عمرانها يتكون من اربعة وعشرين بيتاً طينياً بنيت على شارعين ترابيين بين النهر والمقبرة، بين برزخين متصالبين متلاحمين. اهلها كهنة شيوخ بلحى تبارك النهر كل صباح وتشطف وجهه، وصاغة مهاجرون تناثروا في البلدان بحثاً عن الرزق، وحدادون ذوو اكف عريضة خشنة متفحمة، نجارون تعلق بثيابهم نشارة خشب تفوح منه رائحة الراتنج، وفقراء، وابناء متخلفون خَلقياً، وأرامل، ونساء حانيات على ارحامهن. كل هذا وسط طبيعة باذخة بخضرتها، ومائها، وحيواناتها الأليفة، والبرية، والخرافات. في الجهة الاخرى من النهر، وسط أشجار الغَرب، في الاكمات الكثيفة تعيش خنازير وحشية مهولة، ولصوص خطرين.
عشت في البراري، وكنت برياً بكل ما تمنحه البرية من صفات خام، ولم يكن باب البيت الواسع، مخلوع المفاصل، غير مدخل للنهر والحشيش والريح. كانت القبور المتاخمة للقرية تخفي أمواتاً يفوق عددهم عدد الأحياء، جدود واعمام وأقران، تآلفت معهم ولعبت بين قبورهم، فتحصنت طفولتي ضد الموت والخوف. في ذاك المكان نشأة وورثتُ الطبيعة البكر، التي ما فتئ ملمس ترابها وريحها بين اصابعي.
عرّفتني اختي ليلى، على الكتب في العاشرة من عمري، وكانت تقرأ لي عن موسيقيين ورسامين وفلاسفة، وكان جبران خليل جبران ربان السفينة التي ابحرت بي ولم ترس حتى اليوم. كتب مليئة بالحكايات الغريبة، والرسوم والاساطير وأنا بين دفتيها صبي مليء بالوحدة والضجر في مدينة حرمتني من بساتيني وأعشاشي وضفافي، فما أجمل ساعات القراءة، والرسم ونسيان الواجبات المدرسية!، حتى انتهى بي الحال عام 62 إلى اقل معدل لنجاح لا يجيز بدخول الجامعات العراقية. انذاك كانت ابواب اكاديمية الفنون الجميلة التي تأسست مستقلة عن الجامعة وخارج شروطها، مشرّعة لمن يجتاز امتحان الرسم، على غرار مدرسة الفنون الجميلة في باريس «بوزار»، فكانت ملاذي ومعبدي الاول الذي تكرست فيه نزعتي التجريبية، وعتبة مغامرات لم تنته حتى اليوم.
حسين الهنداوي
- الصدفة وحدها وحسن الحظ ايضا. ولدت في أسرة غدت مع مرور الوقت شبه معدمة. توفي أبي شابا وانا دون العاشرة وثاني خمسة اخوة اولهم بنت تكبرني بعامين. ترك غياب ابي وحشة وفقراً هائلين. فتولت والدتي في ظروف قاسية للغاية مسؤولية حراستنا وتربيتنا أفضل ما استطاعت. كانت تعيلنا من القليل الذي تكسبه من العمل البيتي كخياطة ثياب للصغار وقد تحملت شظف العيش بصمت مطلق اذ كانت أبية النفس ومتقدمة في وعيها على محيطها. كانت كادحة بكل معنى الكلمة رغم انها «ابنة خير» في الأصل، وقديسة. بدأت خطواتي الأولى في تعلم القراءة معها. كما أصرت على ان أكمل تعليمي من عرق جبينها فتفوقت في الابتدائية. وفي صيف 1961 انتقلنا من مدينة الهندية الى بغداد دون عودة، وفيها بدأت اشتغل عامل نجارة في البدء قبل ان امتهن خياطة الكتب في مطبعة الهلال لصاحبها هارون شاشا ومطابع أخرى في شارع المتنبي لم يعد لها وجود اليوم، فيما واصلت اكمال الدراسة المتوسطة مساء.
خلال تلك الفترة بدأ الوعي الادبي والسياسي يتبلور تدريجيا واذكر انني شاهدت بعض عمال المطابع يتعرضون الى الضرب والاعتقال من قبل ميليشيا الحرس القومي بعيد انقلاب 8 شباط 1963. وبالطبع فان عملي في المطابع أسس علاقة لي مع الكتاب، الا ان انطلاقتي الفعلية الأولى في الكتابة كانت بعد انتقالي الى «ثانوية الشعب» في الكاظمية ببغداد في خريف 1964، وكان لمدرس العربية الأستاذ مظفر بشير فضل في ذلك. كما نسجت أولى علاقاتي الأدبية وتبادلت بعض الكتب مع أصدقاء في المدرسة وفي مدينة الحرية وبعضهم صار معروفا بعد حين في الحياة الثقافية العراقية، كما صرت مولعا باقتناء دواوين الشعر والمؤلفات الأدبية الاخرى. في تلك الفترة كنت احفظ الكثير من الشعر، وكانت لي محاولات في الشعر العمودي يافعا وقد نشرت لي بعض القصائد البسيطة في تلك المرحلة اولها في بريد قراء جريدة «البلد» البغدادية، كما طلبت من أستاذ مصري كان يعمل في مدرستنا ان يوصل قصيدة لي، اعجبته كما قال، الى السيدة ام كلثوم لعلها تغنيها، والقصيدة تستلهم «الاطلال» للراحل إبراهيم ناجي. وكان الطلب ساذجا بلا ريب..
د. لاهاي عبد الحسين
- قد تكون الطفولة مبكرة جداً ولكني أتذكر أنّ وعيي الثقافي بدأ بالتشكل بوضوح منذ دخولي مرحلة الدراسة المتوسطة حيث استلهمت سلوك بعض الصحافيات العربيات والعراقيات. ظهرت هؤلاء في نشرات الأخبار، يدخلن مكاتب المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين بأناقتهن العملية والبسيطة. وكنّ يحظين بدعم المجتمع كونهن يدخلن ميداناً جديداً غير تقليدي بالمقارنة لتوجهات الغالبية العظمى من النساء آنذاك ممن قصدن التعليم الابتدائي وفي أحسن الأحوال التعليم الثانوي للعمل كمعلمات أو مدرسات. كان ذلك في ستينيات القرن الماضي. بدا العمل بالصحافة بالنسبة لي مغرياً. ولكني سرعان ما شعرت بالحاجة إلى عمق فكري بقضايا المجتمع فكان أنْ بدأت أحلم بعلم الاجتماع لتوفيره ركيزة فكرية عملية بالمقارنة إلى الفلسفة التي بدت بالنسبة لي آنذاك كطائر يحلق بعيداً عن أرض الواقع المباشر الذي كنت أتعجل فهمه ومحاولة وضع الحلول لمشكلاته وارهاصاته العملية المباشرة. الخلاصة، أنني رغبت بالعمل كصحافية بخلفية فكرية سوسيولوجية لا تكتفي بملاحقة الحدث بل تتوجه إليه وفق تصور أولي يروم المزيد من الفهم والتعمق والتحليل. جاءت بعد ذلك المكتبة الوطنية التي كنا نؤمها في العطلة الصيفية لقتل وقت الفراغ الثقيل مما عانينا منه كفتيات لا يسمح لنا بغيره، كونه من الأماكن الآمنة. هناك طلبت كتباً اجتماعية فتعرفت على كتاب «ثورة على القيم» للدكتور متعب مناف السامرائي الذي أصبح فيما بعد أستاذي وبعد التخرج والتعيين في القسم، زميلي. تطورت النزعة لدي للتعرف على الاجتماعيين العراقيين فكان أنْ قرأت كتاب الوردي، «دراسة في طبيعة المجتمع العراقي»، الذي بدا جاذباً ومطمئناً للغاية وهو يشرح ويرسم ويصور ما نحن فيه كمجتمع. وعندما عانيت من الخلط بين الصحافة كميدان عمل وعلم الاجتماع توصلت إلى قرار أنّ الصحافة تتطلب مؤهلات فنية يمكن اكتسابها بالخبرة والتجربة أما علم الاجتماع فيتطلب تفرغاً لدراسته والتمكن منه نظرياً وفكرياً. وهذا ما دفع بي إلى التخصص في علم الاجتماع.
فليحة حسن
- يعود تعلقي بالأدب الى ما بذرته بداخلي حكايات الأجداد عن الجان ومغامرات السندباد التي كنتُ استمع إليها متى ما كان باستطاعتهم قصّها لي كهدية مسائية، بعدها صرتُ كلما صحوتُ من نومي وجدتُ الى جانب وسادتي قلماً وورقة مدوّن عليها بعض الجمل التي يمكنني الآن أن اسميها جملاً شعرية ، وربما أيضاً يعود السبب في ذلك الى الهدية التي حصلتُ عليها من أبي كمكافأة لتفوقي ونجاحي الى المرحلة المتوسطة والتي كانت مجموعة نزار قباني الشعرية (قالتْ لي السمراء)، وحينها ولدتْ أول قصائدي أمنية: (كان بودي أن آتيكَ، لكن شوارعنا حمراء، وأنا لا أملكُ إلا ثوبي الأبيض ؛)
من طبيعتي حين الكتابة إنني ومهما اجتهدتُ في المحاولة لا أستطيع أن أكتب شيئاً مالم أكن قد خبرته حياتياً، كوني بالكتابة وحدها أشفى، لذا فإن مفردات الغربة والحنين الى الوطن والوحدة، هي المفردات التي لما تزل تطغى على قاموسي الشعري كنتيجة لما عشته من تجربة الاغتراب عن الوطن، فأنا لا أستطيع الشروع بالكتابة عن أيما موضوع إلا وتنزُّ تلك الكلمات من ذاكرتي وتتناثر على وجه قصيدتي الصافي كالنمش على خدّ الحسناء، (أبداً لم يسألنا الربُّ حين ألقى بذاره فيها وقال: كونوا / فكنّا، أطفالاً نلّثغ بهمس البيوت الغافية، نركض صوب المدارس محاطين بأدعية الأمهات خشية كلَّ شيء !، غير إن مديرة المدرسة اختصرتْ حيواتنا جميعاً بجملتها الخانقة: « سنعود بعد أن تنتهي الحرب.....بعد عشرة أيام فقط «، قالتها «نازنين» بلكنتها الكردية، وظلّلنا نحن الطلاب المجتمعين في ساحة الاصطفاف، فاغري الروح دهشة وخوفاً، استطالتْ الأيام وصارتْ سنيناً، تفرقنا......البنين الى ساحة الثرم، والبنات الى دكة الانتظار، لم يعودوا أبداً أصدقائي،جمعتْ بقاياهُم صناديق خشب مزينة بثقوب الفراق !)
كريم سعدون
لازالت ذاكرتي تختزن مراحل من العمر مررت بها ومنها محطات عالقة لانها الاكثر اهمية فيها كما تتراءى لي الان فقد ولدت في بغداد في عائلة اهتم الاب بتعليم ابناءه وحثهم على ذلك وكان يهتم بادوات الكتابة ويوفر ماهو مختلف من الاقلام والورق ، كان يسحرني الخط الذي اسحبه على الورق بقلم القوبيا وارشه بالماء فكانت تجربة تلوين اول باقلام الخشب المائية التي رافقتني الى الان ، فقد بدأت الرسم مبكرا لانني وجدت فيه متعة كبيرة تدفعني للاستمرار فضلا عن الجو الذي تتحقق حينها في المدرسة الابتدائية بوجود جميل روفائيل مدرسا للرسم الذي اصبح فيما بعد مراسلا لمونت كارلو في مقدونيا ، وروفائيل اغنى مرسم المدرسة بنشاط غير مسبوق كان لكل منا دفتر رسم خاص وعلبة الوان مائية وفرت لي فرص جيدة لاكون في صلب تجربة الرسم والتدرب على انتاج الفن وبعد روفائيل كانت لنا تجربة مع المعلم الذي خلفه والذي ترك لنا حرية اختيار الموضوعة التي نعبر بها عن القصة التي يسردها لنا فمنه تعلمت كيف اكون حرا في التمتع بالرسم وكيفية الاختزال في التكوين والرسم معا . وفي المتوسطة التي تعلمت في مرسمها كيفية الرسم والتعامل مع مواد الفن من الوان وقماش بشكل اكثر احترافا ففيها فتحت عيوني على انواع جديدة من مواد الرسم من الزيت وقماش الكانفاس وكيفية تحضيرها وشدها على الحامل الخاص بها وبحجوم لم اعهدها سابقا وافتح عيني على كيفية تنظيم معرض فني، كان مدرس الرسم فنانا حروفيا ناشطا هو خالد ناجي، شجع المواهب واقام لنا معارض كبيرة وعمل منافسة رائعة بين الرسامين من الطلبة وفيها اشتركنا بتجربة نحتية حقيقية حيث عمل مدرس المادة الفنان النحات عدنان أسود على انجاز تمثالا في ساحة المدرسة كان مثار اعجابنا ودهشتنا الأولى في التعرف على كيفية صنع تمثال بمراحله المختلفة ، واشركنا معه في عمله فتعرفنا على الكيفية التي يتم فيها انجاز تمثال مدور بدء من الطين الى عمل قالب له وصبه وتصميم مكان عرضه. وفي الاعدادية تمكنت من رسم اعمالا بقياسات كبيرة وموضوعات مختلفة حيث وفر لنا مدرس المادة الاستاذ عباس خضير العيساوي الذي اصبح بعدها استاذا في كلية الفنون الجميلة التقيته فيها اثناء دراستي الاكاديمية، الفرصة والحرية وموادا جديدة للعمل ، ولابد ان اتذكر كيف كانت القراءة المبكرة الاساس في تنظيم وعيي الاول وتوجيه قرءاتي حيث اهتم الاخوان في البيت بتوفير الكتب وتنمية مكتبة كبيرة كانت ولازالت قائمة فيه، ولعل هناك فرصتان مهمتان في حياتي توفرتا لي، الاولى وهي الفرصة التي اتاحها لي اخي عجمي السعدون وصديقه غازي الفهد في رسم اغلفة مجله مكتوبة باليد وبخمس نسخ كانت من الاهمية الكبيرة لي حيث عززت عندي الثقة بالقدرة على انجاز شئ يحظى بالتقدير ، وهذه البداية المبكرة تركت لدي رصيدا من المحبة للرسم واندماجا به فبعد سنوات قليلة