يرى أن الثقافة ليست تعبيراً عن ضمير جمعي، بل بالأحرى تأنيب ضمير متواصل
أجرى الحوار/ علاء المفرجي
ولد الشاعر أحمد عبد الحسين في بغداد عام 1966. درس في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية في جامعة بغداد نشر أول نص له عام 1983 في مجلة الطليعة الأدبية.
كان من ضمن الشعراء الذين أصدروا كتاب «الموجة الجديدة في الشعر العراقي» عام 1986. هرب الى كردستان أواخر 1989 ثم الى ايران عام 1990. درس في ايران العلوم الاسلامية وبخاصة العرفان الاسلامي. سافر الى سوريا عام 1991. عمل في كثير من الصحف العراقية والعربية في سوريا ولبنان.. أصدر «عقائد موجعة» (1999 عن دار ألواح في أسبانيا)، و بالاشتراك مع ناطق عزيز «عمدني بنبيذ الأمواج» (اتحاد الكتاب العرب في دمشق وهو ترجمة عن الفارسية للشاعرة فروغ فرخ زاد). عضو منتدى الأدباء العراقيين في دمشق. عمل في هيئة تحرير مجلة المسلة في لندن. له ثلاثة كتب شعرية وكتاب نصوص مسرحية معدّة للطباعة.
حدثنا عن المراجع والمصادر التي مارست تأثيرها في احمد عبد الحسين في النشأة الأولى، وقادت خطاه الى الشعر؟
- نشأت في بيت يمنح الكتاب توقيراً كبيراً، مكتبة ليست كبيرة ورثها أبي عن أبيه رجل الدين المعمم، ولهذا كانتْ دينية وإنْ لم تخلُ من دواوين الشعراء كالمعلقات وديوان المتنبي والجواهري، كبرتْ المكتبة لاحقاً على يد أخوتي الأكبر سناً لكن ظلت الغلبة لكتب الدين من مدونات فقهية وحديثية. لكنّ احتراماً «مبالغاً فيه أحياناً» للكتاب كان يدهشني وأظنه أسهم في حبي للكتب. أذكر مثلاً أن خصاماً نشب بيني أبي وعمي الذي يسكن الكوت، الأمر الذي جعل عمي يطالب بحصته من كتب أبيه فأخذ قسماً من هذه الكتب معه إلى الكوت، كان ذلك يوم مناحة في بيتنا، وظل أبي إلى آخر حياته يتذكر خسارته للكتب التي أخذها عمي للمناكفة.
حبّ الكتاب إذن كان ذا أثر على تكويني، ثمّ يحضر ذلك الباعث العميق على جعل كل شيء تراجيدياً، كان أبي قارئاً حسينياً يتلو المقتل في المجالس وكنت أحياناً أرافقه وأظلّ مشدوهاً لهذا السحر الذي يمارسه جاعلاً الرجال الأشداء ينتحبون كالأطفال. هذه التراجيديا كوّنتني. حفرت في وجداني ما لا يمكن أن يمحى في ما بعد. وحين تلتقي التراجيديا بعاطفة مشبوبة لصبيّ يحبّ الكتب سيولد شاعر لا محالة.
الشعر حتميّ في مدينة كمدينتي الثورة «مدينة الصدر الآن» لأن الشعر هو الفنّ الوحيد المتاح لنا نحن الفقراء. فهذه البيوت التي يفتح الأطفال عيونهم فيها ولا يجدون آلة موسيقية ولا تتوفر لهم موادّ للرسم، لا بدّ أن يكثر فيها الشعراء الذين لا يحتاجون سوى إلى ورقة وقلم.
أسرني السياب مبكراً، ما أن قرأته حتى شعرتُ أني مخلوق لأقول كلاماً كهذا، كلاماً يشتمل على طاقة إنشادية عالية مع تفجّع يعيد عليّ تفجّع الأب وهو يقرأ المقتل، فقلّدتُ السياب. لأشهر وأنا أكتب على ضوء سراجٍ سيابيّ نصوصاً أعجبت أخوتي الكبار، فاستسلمتُ لمديحهم. ثم في لحظة عظيمة وأنا في الرابعة عشر من عمري اكتشفت محمود درويش الذي أنساني السياب وجعلني أسخر مما كتبت. لكني صرت حينها متلبساً بوهمي موقناً أن الشعر سيكون قدري، ثم توالت القراءات والإيغال في التيه إلى أرسلت نصاً لمجلة الطليعة الأدبية ـ بإشارة من صديقي وابن خالتي الشاعر الراحل خالد جابر يوسف ـ وكم كانت دهشتي حين رأيت النص منشوراً والشعراء يتحدثون في مقهى حسن عجمي عن ولادة شاعر، لا أنسى أن الشاعر زاهر الجيزاني امتدح النصّ أمام جمع من الشعراء ما تركني مزهواً لأيام، ثم اتسعت الدهشة وأنا أقرأ مقالاً للناقد فاضل ثامر يمتدح نصي الشعريّ بعبارات مؤثرة.
كانت مجلة الطليعة الأدبية هي الأبرز كما تعرف، والنشر فيها يعني جواز مرور إلى محفل الشعر في العراق، وقد استلمت جوازي مبكراً جداً. أذكر هنا موقفاً طريفاً: حين ذهبت للمجلة لأستلم مكافأتي عن القصيدة «كانت المكافأة ثلاثين ديناراً» لم يصدّق رئيس التحرير «خضير عبد الأمير» أنّ هذا الصبي الواقف أمامه هو الشاعر إلا بشهادة زاهر الجيزاني الذي أنقذني من الحرج.
بالعودة إلى سؤالك فأنا أظنّ أن مصادر شعري كانت التراجيديا الدينية التي تربط الشعر عندي بالغيب والتفجّع، وتجعل النصّ أشبه ما يكون بدعاء مرفوع من تحت إلى أعلى، من ذات مفتقرةٍ إلى مجهول ما، على الضدّ من شعرِ كثير من الشعراء الذين يتنزل عندهم الشعر من فوق، من أنا علوية أو صمدية. وكما أن الفقر كما أسلفت هو سبب رئيس للشعر فهو يسم الكتابة بميسمه، الشاعر مسكين وحياته وحياة نصه أيضاً أشبه بيدٍ مبسوطة للدعاء واستنطاق الغيب.
مثل باقي جيلك، جربت النفي بأقسى ما يكون، لكنك تنفرد عنهم في أنك، ما ان انفتح أمامك فضاء الحرية (التي لم نهنأ بها حتى الان) بعد 2003 ، انهيت هذا النفي بشكل لا رجعة فيه، هل خاب أملك من جراء ما حصل؟ ام أن لك رايا اخر؟
- كنت أول أبناء جيلي خروجاً من العراق، ربما لأني كنت في وضع أمني ونفسيّ أسوأ منهم، قبض على كثير من أصدقائي وأودعوا السجن وكان طبيعياً أن يصل الدور إليّ فآثرت الهرب، بمساعدة أصدقاء من البيشمركه، أوصلوني إلى منطقة قريبة من «ماوت» ووصفوا لي الطريق، مشيت ثلاثة أيامٍ في أرض كنت أعرف أنها مملوءة بالألغام. رجلة هروبي من العراق وحدها تصلح لأن تكون كتاباً. بقيت فترة في إيران ودرست هناك في الحوزة التي كنت قرأت معظم منهاجها قبلاً من منطق وأصول وعقائد ونحوٍ وفقه، لكنْ سرعان ما ضاقت بي إيران أو ضقت أنا بها فرجعت في ذات الطريق بعد انتفاضة 1991 إلى كردستان وعملتُ فترة في إعلام المعارضة «كنت من مؤسسي جريدة المؤتمر وأصبحت سكرتير تحريرها»، ثم غادرت إلى سوريا وبقيت عدة سنوات فيها إلى أن ذهبت إلى كندا.
حتى قبل ذهابي إلى كندا كنت أعرف أن تغيير نظام صدام يعني عودتي إلى العراق حتى لو كنت في جنة عدن. ليس هذا نشيداً وطنياً لكني حقاً لا أحسن العيش تماماً إلا هنا. كان على الدوام شيء ما ينقصني ولا أستطيع التعبير عنه. وبعودتي إلى وطني اكتمل كل ما يجعلني كائناً حياً. كثيرون يتحدثون عن الراحة التي توفرها دول اللجوء. اختبرت هذه الراحة طبعاً لكني وجدتها تماماً كراحة نزيل المستشفى، يوفرون له كل ما يبقيه مرتاحاً لكنه في آخر الأمر ليس في بيته. وبيتٌ بكل منغصاته أفضل من مستشفى.
وأنا في تورنتو بعد سقوط النظام أصبح لديّ لأول مرة جواز سفر عراقيّ. كانت لحظة عظيمة، بلادي التي خرجت منها هارباً في ليلة ظلماء ها أنا أعود لها بجواز سفر. وعدتُ إلى الأبد.
لم يخب أملي. كنت أعمل مع المعارضة آنذاك الذين تسلموا الحكم بعد 2003 وأعرفهم، أعرفهم فشلهم وفسادهم وتكالبهم على الصغائر وولاءهم لدول أخرى وكراهية كثير منهم لوطنهم، مجموعة تجارٍ جشعين وجدوا منجم ذهب لا حارس له. لكني ـ صدّقْ أو لا تصدّقْ ـ ما زلت مؤمناً بقيامة العراق، وأن ما يحدث فترة مؤقتة طارئة ستذهب باللصوص إلى الدرك الذي يستحقونه وسيولد الوطن الذي عاد إليه المنفيون من منفاهم، وهو ذات الوطن الذي أراده شباب تشرين.
ماركيز الذي استوفى كل شيء من الأدب بما في ذلك جائزة نوبل، ظل مهتما بالصحافة وبتدريب الصحافيين، ما الذي دفعك الى هذه المهنة؟
- لا أستطيع أن أقول إني اخترت مهنة الصحافة. كان الأمر أقرب إلى الاضطرار. أيام المعارضة كان المعارضون اثنين: إما سياسيّ أو صحفيّ. لست سياسياً طبعاً، فكان لا بدّ أن أستثمر قدرتي الكتابية لأعيش ولم يكن متاحاً إلا الصحافة.
لكن مهنتنا ليست سيئة! متعبة لكنها ممتعة أحياناً. وأنا على خلاف الرأي الذي يقول أن الصحافة والانغماس بها يؤثر على لغة الشاعر أو يعيق مشروعه الكتابيّ. أظنّ أن العكس هو الصحيح. أفادتني لغة الصحافة في كسر الطوق المتخيّل عما هو شعريّ وغير شعريّ وسمحت لي بتوسعة حدود لغتي الشعرية، إضافة إلى جعل الكتابة عملاً يومياً أشبه بالتمرين المفروض ما يدعو إلى القراءة باستمرار.
قلت مرة « أنا أكتب و أريد لكتابتي أن تكون تأنيب ضمير لمن يقرأها..هناك خطأ علينا تصحيحه دائما ً , ليس المثقف ضمير شعبه او قومه إنه تأنيب ضمير.» هو راي مغاير للمتعارف عليه. ما الذي كنت تعنية بالضبط؟
- في منتصف الثمانينيات اعتلى وزير ثقافة صدام «لطيف نصيف جاسم» منبر مهرجان المربد متحدثاً للشعراء العرب عن الثقافة فقال ما نصه: المثقف أنبوب «بوري» إذا أجريت فيه ماء نظيفاً فسيخرج الماء نظيفاً وإن أجريت فيه ماء قذراً فسيخرج من الطرف الآخر من البوري ماء قذر. كانت هذه العبارة نكتتنا اليومية آنذاك: «المثقف بوري».
هذا الوزير العبقري، ومثله أولئك الذين يقولون إن المثقف ضمير شعبه والمعبّر عن أمته ولسان حال مجتمعه، يستقيان من منبع واحد ويصدران عن ذات الفهم، كلاهما يرى بأن المثقف بوري، ووظيفته لا تعدو نقل ما يلقى فيه كما هو.
الحقيقة أن الثقافة إن لم تكن صادمة فلا تستحق اسمها. المثقف هو من يؤشر إلى اللطخة السوداء في ثوب الملاك. هو من يشعر الجميع بأن الأمر ليس على ما يرام. فحين تريد السلطة والحزب ورجل الدين وشيخ العشيرة إقناعك بأنْ ليس في الإمكان أفضل مما هو كائن، تكون حاجتك أكيدة إلى مثقف يريك الثغرات.
الثقافة ليست تعبيراً عن ضمير جمعي، هي بالأحرى تأنيب ضمير متواصل لأن جبهة الرفض يجب أن يشغلها أحد، إن بقيت شاغرة فنحن نخاطر بجعل سلطان الظلم والشرّ مقبولاً من الجميع.
انت بحق متفرد في الشعر ولك حضور فاعل في الشعرية العراقية، لكنك بصراحة في الصحافة ليس أكثر من صحفي.. لماذا رضيت بذلك؟ هل منحتك الصحافة ما عجز عنه الشعر؟
- الصحافة مهنة. وهي تمنح ما تمنحه المهنة لصاحبها. قدرة على توفير أسباب العيش، وربما روتينا يومياً تنتظم فيه حياتك، لكن الصحافة تمتاز عن مهن أخرى لأنها توفّر لك فرصة لقول كلمتك في القضايا العامة. وهذا ما يجعلني أرضى في أن أكون مكبلاً بقيودها.
الشعر شغف يُصرف العمر كله في استيفائه وهو يمثل حياتي باطناً وظاهراً، انشغال عابر لليوميّ والعامّ ومتجاوز للشرط السياسي والاجتماعيّ. إنه بتعبير بيرس تاريخ للروح.
كنت محررا ثقافياً في مطبوع بارز وغادرته بسبب محاولة البعض في هذا المطبوع ممارسة العسف معك في التعبير عن رأيك.. انت على رأس هذه المطبوع كيف تتعامل مع هذا الأمر؟
- أيام كنت سكرتير التحرير الثقافي في الصحيفة، حاولت أنا وبعض الزملاء أن أجعل الصفحات الثقافية والملحق الثقافي آنذاك علامتين فارقتين في المشهد الثقافي. فتحنا الأبواب مشرعة لكتّاب ذوي جرأة فائقة، وأنجزنا ملفات عن مواضيع محرمة دينياً وسياسياً. أظن أن جرأتنا آنذاك لم تكن معهودة، وكانت أحزاب السلطة تنظر إلينا من طرف خفي وتراقبنا وتتحين الفرص لإنهاء عملنا. وحدث ذلك بالفعل. فصلت من عملي مراراً، مرة بسبب مقال عن سرقة شهيرة لمصرف، وأخرى بسبب وقوفي مع مشروع ميناء الفاو الذي كانت دولة مجاورة تريد إيقافه بأي ثمن واقتطاع أرض عراقية لضمها، وكان رئيس التحرير آنذاك مناصراً لموقف الدولة الجارة ضد وطنه! وكان ثمن موقفه هذا فصلي من عملي، وفصلت مرة ثالثة لأني رفضت توقيع تعهد بعدم نقد الحكومة في مواقع التواصل. لستُ سعيداً لهذا الاضطراب المعيشيّ لكني أرحب به كل الترحيب إذا كان ثمناً لمواقف وطنية أو نتاج ضمير مثقل بالواجب.
اليوم أنا رئيس تحرير الصحيفة، وهذه علامة على أن المواقع والمناصب متحركة وزائلة ولا تستحق أن يسفح المرء من اجلها ضميره ويبدد مبادئه.
للثقافة في عملي الصحفي أهمية مضاعفة، فكوني شاعراً ومحرراً ثقافياً منذ ثلاثين سنة يجعلني أمام اختبار حقيقيّ في إنجاز صفحات ثقافية مختلفة. هذا ما احاوله. ومن يقرأ الصحيفة يشعر أن هناك تغييراً ملحوظاً. سقف الحرية أعلى وحصة الثقافة أوسع. هذا ما يتحدث به كثيرون وأرجو أن يكون حديثهم صادقاً.
أرى أن الثمانينين قد خذلهم النقد، رغم انهم ولدوا في مناخات بروز وترجمة الحركات النقدية في العراق؟ وهنا اذكر لك ما قلته في كتابك ( لا العطش ينتهي و لا الينبوع ): «الناقد العربي كسول و تنبل لا يتناول الا ما يقع صدفة بين يديه».. هل كان الكسل وحده في أن ينأى بعض النقاد عن تجربتكم؟
- ليس لدينا نقاد ذوو مشاريع كبيرة. ينشغل الناقد عندنا بالنصوص التي هو قادر عليها ويستبعد النصوص التي تضع عدّته النقدية في اختبار حقيقيّ. يبحث عن الأسهل. ينجزون كتباً ويقيمون نداوت لكنهم لا يتناولون إلا ما يألفون من نصوص وما اعتادوا على تجريب عددهم النقدية «المستوردة غالباً» عليها. ولهذا لا نرى دراسات نقدية تضيء تجربة شاعر إلى الحد الذي تجبرنا فيه على إعادة قراءته وفقاً لكشوف نقدية مبتكرة.
هم كسولون بهذا المعنى. لا يريدون مغادرة منطقة الراحة التي توفرها لهم نصوص «مسيطر عليها» من قبلهم ولا تقلق مسلّماتهم النقدية التي كرروها حد الملل. بالمقابل هناك شعراء عرفوا بالسليقة ما يريده الناقد بالضبط فكيّفوا نصوصهم وفقاً لعدّة الناقد المستريح.
النقد لم يظلم الثمانينيين وحدهم، بل ظلم الشعر العراقي بعامة. حتى السياب الذي أشبع قراءات لم يقل أحد فيه قولاً خارج هذه المساحة المريحة التي يتمدد فيه الناقد الكسول.
والثمانينيون ظلموا أنفسهم أيضاً، أو ظلم بعضهم بعضاً. بعضهم كتب عن أبناء جيله وكان كتابته مخزية ملطخة بأوهامه عن ذاته وأمراضه ومحاولة إعلاء اسمه على حساب أسماء زملائه. حدث هذا عند الستينيين وعند السبعينيين وهو تقليد عراقي أحبه الثمانينيون ونسجوا على منواله وسيحدث مع أجيال أخرى. هذه الأمراض تنتقل بين الأجيال بتلقائية مضحكة.
في كتابك الأخير «طفل لاعب باللاهوت».. الذي كتبت فيه سيرتك الشعرية، هل ترى مقاربة الشعر للسيرة الذاتية ممكنة؟
ليست ممكنة وحسب بل هي طبيعية. الشاعر في كل ما يفعل ينسج أسطورته مهما بدتْ صغيرة وتتشابك حياته وانشغالاته بنصوصه اشتباكاً لا سبيل إلى فضّه. في كتابي «طفل لاعب باللاهوت» فتحت هذه النافذة التي يطلّ منها النص على مرجعياته الحياتية. أنا أكثر قرّاء هذا الكتاب اندهاشاً من قدرة المعيش على تلوين النص بمعاريض وإشارات قد تبدو بعيدة لكنها دالة دلالة واضحة على رسوخ الشعر في ما يرى ويسمع ويعاش. اكتشفت تطابقاً تاماً بين التدوين والتكوين أو بين تراجيديا الحياة وتراجيديا اللغة، وجدت أن حادثاً ما في طفولتي قد يكون عابراً أو هامشياً سينتهي به الأمر إلى أن يغدو قصيدة.
أحد كتبي عنوانه «على ما أرى واسمع». في الحقيقة وبالمعنى العميق فإن الشعر كله نكتبه على ضوء ما نرى ونسمع. السيرة جذر القصيدة وكلنا يدرك أن للشجرة جذراً حتى لو كان مدفوناً تحت التراب.
هل ترى أن الشعر تخلى عن صولجانه لصالح الرواية، وخاصة في العراق الذي شهد في العقدين الأخيرين سيادة تكون مطلقة على غيرها من الاجناس الأدبية، ما رأيك. وإن كان هذا الانطباع صحيحا ما السبب في رأيك؟
- ليس للشعر صولجان. هناك مفارقة وهي أن الشعر يزدهر تداوله حين يمرض، حين يكون منشغلاً بغرض سياسي أو اجتماعي، أو لنقل حين يكون ذا نفع «بالمعنى الهيدغري». كان الشعر عند الجواهري مثلاً مرتبطاً بقضايا عامة وهذا سبب تداوله، ولا يمكننا اليوم الحديث عن انحسار الشعر بإطلاق. ألاحظ أن الشعر الشعبيّ وبدرجة أقل الشعر العمودي مزدهر مطلوب متداول وتتناقله الشفاه ومواقع التواصل، لأنه شعر متجذر في الغرضية. الذي ينحسر هو الشعر المصفى من كدورة الغرض كقصيدة النثر مثلاً، وهذا النوع من الشعر قليل القراء دائماً وأبداً. يدور في أبهاء دائرة مغلقة من الشعراء أو من في حكمهم من القراء المنشغلين به.
الرواية تتقدم لكن ليس على حساب الشعر. وهذا نبأ مفرح. نحن بحاجة إلى الرواية، بمعنى عميق نحن بحاجة إلى هذه الانتقالة من رواية الحدث كتاريخ أو كخبر صحفي إلى روايته كفنّ. شيوع هذه الممارسة سيغير وجه الثقافة. لدينا فيض أحداث لا نعرف ما نصنع بها، ولدينا فائض مشاعر بعون من الشعر، حاجتنا لمن يقص علينا حكايتنا لا كتاريخ ولا كخبر صحفي عاجل بل أن يقدم لنا حياتنا كقطعة فنية مشغولة بعناية.
كان لك حضور بارز في انتفاضة تشرين، بشكل قدمتم فيه انت وعدد من المثقفين صورة جديدة للمثقف العراقي لم نعتدها. ما الذي يجب ان يقوم به المثقف العراقي من دور في الظرف العراقي الملتبس؟
- أؤمن أن الرفض البدّ اللازم للثقافة. لا ثقافة من دون هذا الجذر الرافض. منذ 2008 شاركت في كل الاحتجاجات التي حدثت وكنت فاعلاً في كثير منها. وانتفاضة تشرين تتويج لمسيرة احتجاجية كبرى لكنها الأبرز والأنقى لأنها صنيعة جيل جديد ضاق ذرعاً بالنظام وبمعارضيه على السواء. تشرين ثورة شابة، ونحن الشيوخ كنا ضيوفاً عليها وفي هامشها، مساندين ومؤازرين لكنها كانت حراك الجيل الجديد وحده. تخلقت بأخلاقهم وأعرافهم وطبعوها بطابعهم الخاص. شخصياً كنت أتعلّم منهم ولم أعلمهم شيئاً، وكنت أكتشف المستقبل بفضلهم.
أجزم أن كل المثقفين كانوا في درس كبير ألقاه علينا شباب تشرين. لم يكن لنا دور مميز سوى أن نسند هؤلاء الشباب بكلمة. تشرين أهم حدث عراقي منذ تأسيس الدولة العراقية.





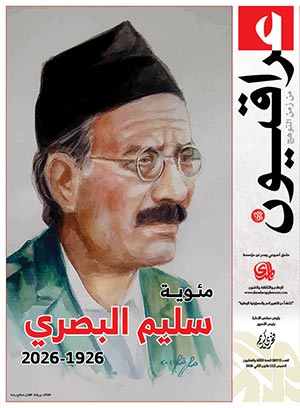
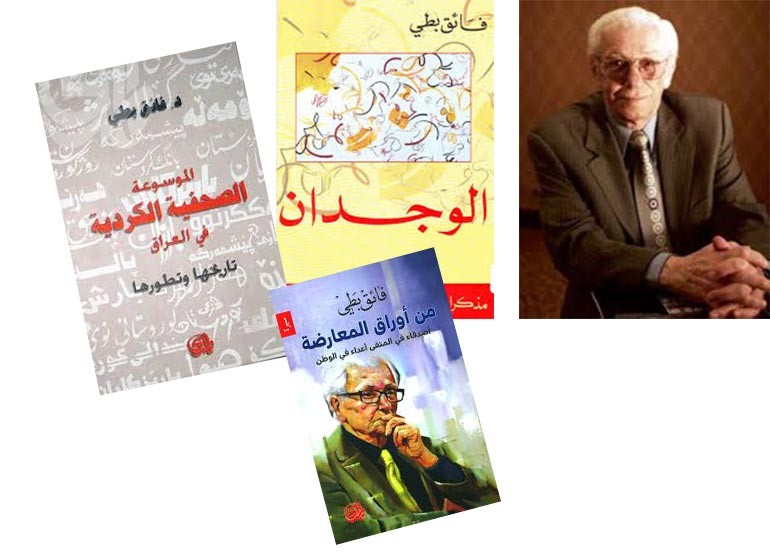

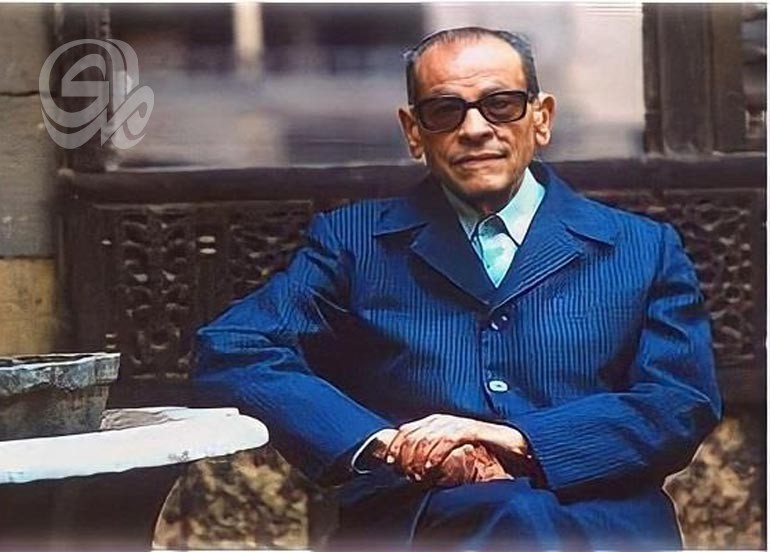
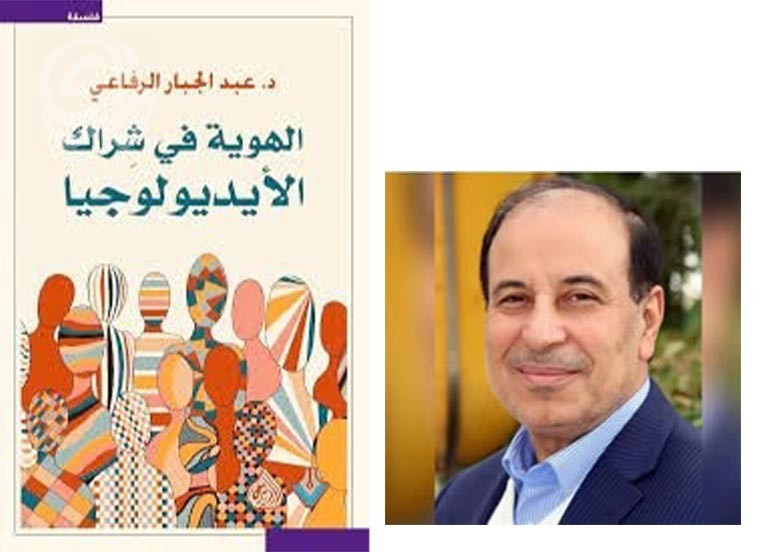

جميع التعليقات 1
عقيل محسن
استاذ أحمد هو ومن معه هم من يخملون راية الثقافة العراقية في هذا العصر ونتوسم بهم خيرآ