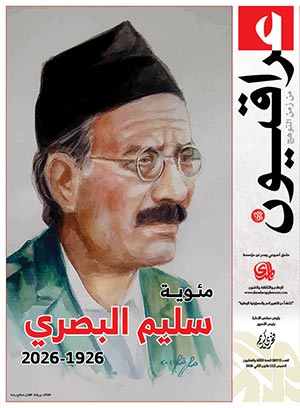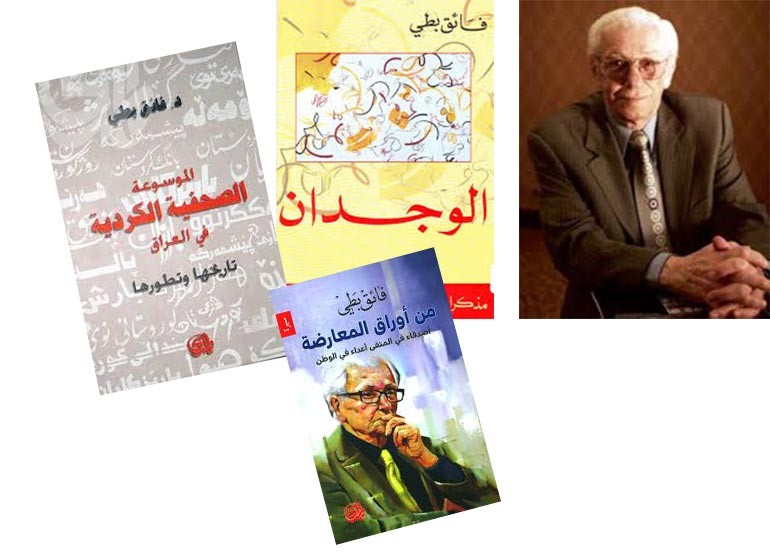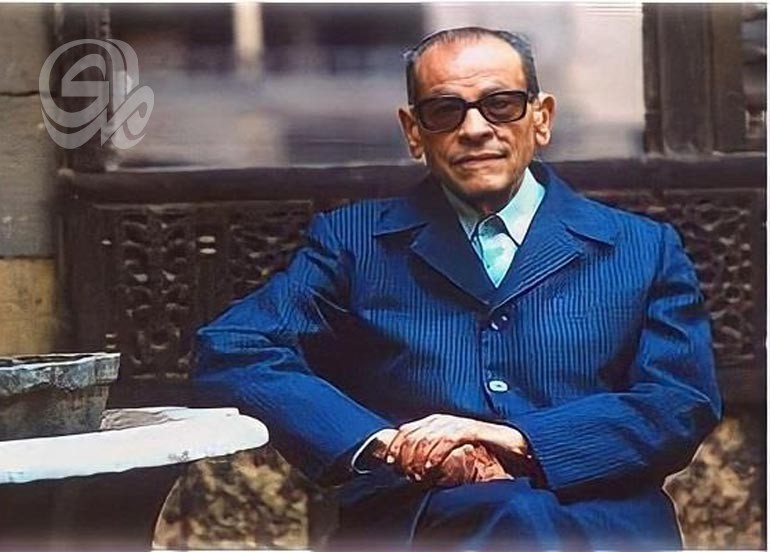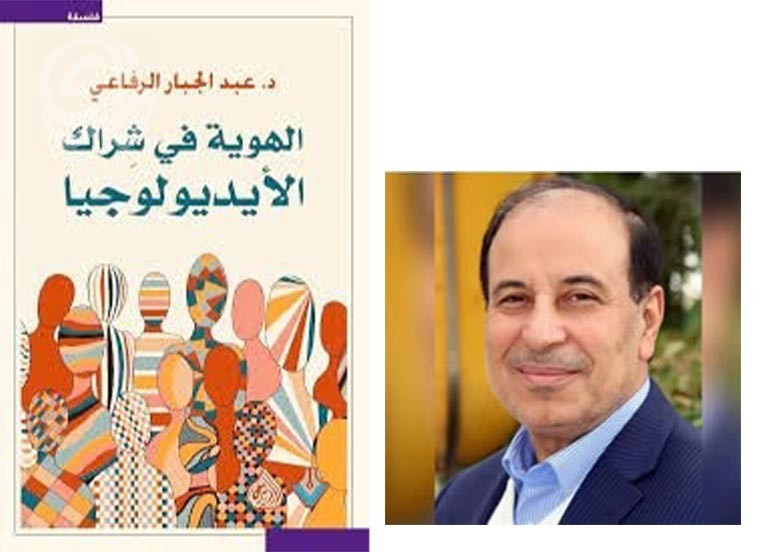يرى أن المناطق تشبع تلهفه للمعرفة والاطلاع على التنوع اللغوي والعقائدي والبيئي، وهو مهووس بهذا الثلاثي
حاوره: علاء المفرجي
- 1 -
شاعر وكاتب أدب رحلات ومهتم بالهُوية والتنوع الثقافي لإيمانه أن التنوع ثراء، وأنه روافد مهمة في نهر الثقافة العربية والإنسانية،
وفهم هذا التنوع ودراسته تعيننا كثيرًا على مدّ جسورِ المحبةِ والألفةِ والتعارف بين شعوب المنطقة كافة بل وشعوب العالم أجمع.
يلتزم بمبدأ في القراءة والبحث والكتابة مَبنيٍّ على أن يكون المبدع نفسه ولا يستعير حنجرة الآخرين في شعره وكتاباته بل وحتى قراءاته، وهو التزام تبناه منذ بداياته المبكرة في الكتابة.
ولد عام 1967، في كربلاء، • يكتب الشعر منذ الصبا، واتّضح اهتمامه بالشعر قبل سنّ العاشرة، ثم بدأ نشر قصائده في الصحف والدوريات العراقية، بدءًا بجريدة «العراق» عام 1987. توفي أبوه وهو صغير، في عام 1969، دفاعًا عن جارته، فانتقل إلى حضانة جدته، وعمل منذ صباه الباكر، خبازًا، ثم عمل في صناعة التحف النحاسية، ثم عمل بالتصوير الفوتوغرافي؛ وهي المهنة التي احترفها بعد ذلك. ترك مقاعد الدراسة عام 1988، فتم تجنيده بالخدمة العسكرية الإلزامية لمدة أربع سنوات.
وفي الثالث والعشرين من شهر نيسان من عام 1993 غادر العراق إلى الأردن، ثم تقدَّم بطلب للجوء السياسي عام 1996، وانتقل إلى نيوزيلندا عام 1997، وأطال الإقامة فيها، وشارك في كثير من اللقاءات الثقافية والندوات الشعرية، ونشر قصائده في معظم مجلاتها الأدبية، وتمَّت استضافته في الإذاعة الوطنية النيوزيلاندية مرات عدة، للحديث عن تجربته الشعرية وتجارب الآخرين.
انتقل العام 2005 إلى هيروشيما. ثم انتقل العام ( 2008 ) إلى جمهورية لاوس، وانتقل العام ( 2011) إلى الإكوادور، ثم إلى الخرطوم (السودان) العام 2014.
صدرت له ثلاثة عشر مجموعة شعرية، منها أشدّ الهديل، خريف المآذن،أنا ثانيةً. وثمانية كتب في أدب الرحلات، وصدر له في ألسيرة : (دموع الكتابة .. مقالات في السيرة والتجربة)، وفي مجال الدراسات صدر له (أغتيال الهوية). وصدرت عنه خمسة كتب لنقاد ودارسين عراقيين.
حاورته المدى للوقوف عند أهم ما في تجربته.
حدثنا عن المصادر والمراجع في طفولتك التي قادت خطاك إلى حيث امتهان الشعر والرحلات؟
- أرى أن اليتم المبكر هو واحد من مصادر تجربتي الشعرية، واليتم أقسى ما فيه، أنك لا يمكنك أن تشعر بالأمان الذي يمنحك القدرة على المطالبة بما تريد، فالطفل يملك الشجاعة تلقائيًّا بأن يطلب ما يبغيه من أبويه، حتى لو تعرّض للضرب مرارًا، فإنه يعاود السؤال، يسأل عن ما يؤمن به بوعيه ولا وعيه، فهي من حقوقه، في الطعام والملبس وغيرهما. إن الأبَـوَين جناحان للطفل، وإن طفلًا بلا أبوين مثل طير بلا جناحين.
يبقى أن الذي لا يعيش في كنف أبويه، يُعقَد لسانه، يخشى إن سأل أن يتلقى تقريعًا، وربما ضربًا حتى لو كان ضربًا رقيقًا على الكفين، فيكبر الشعور بالحرمان، والشعور بالفقد، والحذر الشديد الذي يولّده هذا الشعور، فتكبر حساسية الطفل ولا تغادره، وحين يكبر لن يكون أمامه سوى خيارين، خيار العنف، أو خيار الاستكانة فيتعرض للاستغلال في العمل، وفي عموم مناحي الحياة.
اليتم والعمل الشاق الـمبكّر، وجدة عجوز اختزنت آلام ثُلثَي قَرن من التنقل بين غروب إمبراطوريات، ونهوض دول واستقلالها كانت تئن تحت هيمنة الغزاة والعراق واحد من تلك الدول، ثم ثورة واحتجاجات وتأسيس حكم وطني في ذلك العراق اتفق المؤرخون والبلدانيون تاريخيًّا على أن حدوده من تخوم الموصل شمالًا إلى بلاد عبادان على ساحل البحر جنوبًا، ومن حُلوان (ديالى والسليمانية اليوم)، جدة تنقّلت بين كربلاء مدينة آبائها وأجدادها، إلى البصرة ثم عبادان لأكثر من سنة حتى تم الضمّ القسري في سنة 1925 ميلادية، وبعد عشرين سنة من العودة إلى مدينة الولادة والأسلاف.
ترملت وليس معها سوى ابنة في السادسة أو السابعة من عمرها وطفل أتم عامه الأول للتوّ، لِيُقتل هذا الطفل بعد أربع وعشرين سنة في المدينة نفسها، مخلّفًا هو الآخر ابنًا في الثانية من عمره وطفلة في يومها الثلاثين، وأرملة حين استشهاده كانت في السادسة عشرة وتسعة أشهر وخمس وعشرين يومًا. والفرق بين الجد والابن أن الأول مات على فراشه بعد أن خاض غمار حروب مع الحياة استسلم لها بعد أن وهن العظم منه، بينما الابن – وأعني أبي – قادته شجاعته ونخوته وجوده أن يجود بروحه ليحمي جارة وحيدة من مسدس مجرم من سقط المتاع، فكان حفظ كرامته وشرفها وحياتها ثمنه طلقة استقرت في خاصرة أبي، وحملتني وزر اليتم بكامل جبروته.
أنا ابن اليتم العميق الذي يراكم الألم والدموع والحسرات لتكون جسرًا يمتد على طول الحياة.
كما أن مدينة كربلاء بحد ذاتها تعدّ مصدرًا مهمًّا من مصادر طفولتي وانبثاقاتها، فمن حيث اللغة، فإن كربلاء مدينة تكثر فيها تلاوة القرآن والأدعية المنسوبة لنبي الإسلام وأهل بيته، والمجالس الدينية، وهذه مناهل مهمة لتقويم اللغة، وضخ المعرفة المضمخة بالتاريخ المحكي بما يُنمّي الخيال، وما تبعث عليه السياحة الدينية، جعلتني هذه المعالم أشعر أنني في مركز العالم، والناس تأتيني من كل حدب وصوب، فكانت للسحنات وللأزياء واللغات أثرها في نمو الرغبة عند الطفل الذي يكبر في داخلي لمعرفة الثقافات الأخرى. علمًا أن كربلاء نفسها مثلها مثل معظم المدن النابضة بالـمَدَنية والحياة والتاريخ، تحوي تنوعًا قوميًّا وإثنيًّا ترك بصمته بأسماء أسواق وأمكنة مثل سوق التجار العرب، وسوق التجار العجم، وسوق الهنود، وميدان أو دوار البلوش، بل حتى محلة “المخيّم” وهي من المحلات السبع التي كانت تتكون منها كربلاء القديمة.
كانت لغة الحياة اليومية واللغة الثقافية في كربلاء هي اللغة العربية، وقد أخبرتني عمتي وهي امرأة في منتصف ثمانينها الآن “أمدّ الله في عمرها” أن معظم صديقاتها كن من الإيرانيات والهنديات ولكنها لم تتعلم منهن لا الفارسية ولا الهندية، وذلك لأن لغة التخاطب حتى بين الأطفال كانت اللغة العربية، ومع ذلك “متهمة” كربلاء عند سلطة نظام صدام حسين وعند بعض معارضيه وضحاياه بأنها مدينة يغلب عليها الطابع الفارسي، وهذا افتراء عقيم.
بدأ من الشعر، تقول في حوار صحفي لك « صراع التفرد في داخلي انتصر، إذ لا أحب التقليد في الكتابة والقراءة والسلوك»، هل تجلى ذلك فيما (كتبته) من شعر فيما بعد؟
- أزعم أنني حاولت منذ طفولتي وأنا قدمت إلى الشعر طفلًا بكامل شغفه، أن لا أقلّد حتى نفسي، كان التأثر بالآخرين يقلقني، فما أقسى أن تتحول إلى مجرد صدى، وربما أعزو «صراع التفرد في داخلي» إلى طفولتي القاسية، فقد كنت وأنا الطفل الوحيد الذي شاءت الأقدار أن يكون الوحيد بين مجموعة كبيرة من التلاميذ في صفه «الأول الابتدائي» لم يجد أسرة متعلمة أو في الأقل أن يكون أحد أفرادها في مرحلة دراسية أعلى من مرحلته بمرحلة، وهذا تسبب لي بأزمة نفسية حين ضربني المعلم، فلم أجد مَن أستجير به سوى جدتي العجوز، التي أوضحت له ظروفي، ولكن بعد أسبوعين نبهني بشدة، فتأثرت، وصرت أحرص على تطوير إمكانياتي البسيطة بالكتابة والقراءة، وأرجوه أن يزيد عدد الصفحات التي يُنقّط سطرها الأول بكلمتي «دار، ودور» حتى تمكنت في شهر شباط، أي في عطلة نصف السنة للعام الدراسي الأول، أن أقرأ كتابًا للصف السادس الأدبي، حيث كنت في زيارة لأمي وكان الكتاب لجارتهم التي استغربت من انهماكي بقراءة كتابها ولا علاقة لي بما يجري حولي، فسألتْ والدتي: «في أي صف دراسي أنا»، وأبدت دهشة حين قرأت لهم بصوت مسموع وبلا تردد، وأنني في الصف الأول الابتدائي.
ربما هذه مرجعية لا بأس بها، لمعرفة شغفي بتقوية شخصيتي، فالشخصية القوية ليست التي تملك لسانًا سليطًا وقدرة كبيرة على الهجوم، بل هي التي تبني نفسها بنفسها وتكون مرآة لنفسها وليست مرآة للآخرين، أن تحترم تجارب الجميع، بلا تقليد وهوس، بناء الشخصية يتم عبر بناء ذاتها بعيدًا عن المباهاة والتقليد، وإنما عبر خط طريق متفرد حتى يصبح هذا الطريق بصمة واضحة لا تُنسب لسواها.
هذا ما دأبت عليه، قراءة وكتابة وسلوكًا، فقرأت المنجز الشعري بخاصة والثقافي بعامة منذ البدايات وحتى يومنا هذا، ثم واصلت قراءة ما تيسر لي من الأدب غير العربي، إن كان مترجمًا للعربية أو بالإنجليزية أو مترجمًا لها، وهذا ما انعكس على تجربتي الشعرية، ويمكن للقارئ والمتابع أن يلاحظ هذه المؤثرات واضحة في تجربتي الشعرية، ولا سيما منذ ديواني الرابع، حيث أتت تلك القراءات أُكلها.
بدأت شاعرا، ما الذي جعلك تُغرم بالرحلات، وما جدواها وهل أسهمت في(( منحك شعريا))، بمعنى هل أسهمت في تطوير خزينك الشعري؟.
- «حين ودَّعْتُ الطفولةَ، حَالِـمًا بالسَّفَرِ والترحال، لم أجرؤ على البوحِ لأحد»؛ هذا ما صدَّرتُ به كتابي «الحلم البوليفاري» وهو الكتاب الثاني في سلسلة أدب الرحلات التي بلغت مع كتابي «زول في بلاد السماحة» الذي صدر مؤخرًا عن دار الشؤون الثقافية العامة، ثمانية كتب، وبانتظار أن أجد الفرصة لنشر تجاربي في أماكن أُخرى؛ قراءاتي لسيرِ الشعراء ونتاجهم الإبداعي، زرعت في أعماقي رغبة السفر والترحال، وعملت جاهدًا لأحقق حلمي هذا، وأستطيع القول إنني نجحت في تحقيق جزء لا بأس به من حلمي هذا الذي أتمنى أن أحققه كاملًا.
لم أكن يومًا مسافرًا، لأن قصدية المسافر هي المتعة والتسوق والاستجمام، بينما هوسي هو في المعرفة، وللأمانة التاريخية أقول: إن جلوسي في مقهى “علي الدواس” على قناة “نهر الحسينية” وأنا مراهق صغير، بل كنت أصغر مرتاد لهذه المقهى، وكان معظم جلاسها ممن يكبرونني بأكثر من ربع قَرن وثلث قَرن، وكان أغلبهم من ذوي التجارب الكبيرة في الحياة والقراءات والسفر، ومنهم تعلمت أن زيارة المكان الجديد تعني معرفته جيدًا، جغرافية وتاريخًا وثقافة، أي بعبارة أخرى، معرفة المكان إناسِيًّا “إنثروبولوجيًّا”، فكانت أحاديثهم تلهب رغبة الفتى الغض في داخلي لأن أنحو منحاهم ولكن بخصوصيتي التي لن أتنازل عنها في القراءة والكتابة والسلوك.
وفعلًا حققت خصوصيتي، حيث إن مدن الأضواء مثل لندن وباريس وبرلين وكوبنهاغن وأمستردام وغيرها لا تثيرني، أقول لا تثيرني لأنها حتى اللحظة غير مدرجة ضمن اهتماماتي، وما زيارتي لإنجلترا واسكتلندا، إلّا بدعوة عائلية لم تكلفني ماليًّا، وأقصرتها على زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والمكتبات وجامعة كمبردج وغيرها، وكان جدولي حافلًا لدرجة الاعياء، فكنت قاسيًا على نفسي أخرج من الصباح المبكر ولا أعود إلّا بعد منتصف الليل.
إن الهوامش والأطراف من دول وجزر ومدن ومجتمعات ولغات وعقائد، تثيرني معرفيًّا، بي شوق عارم لأن ألامس الروح الإنسانية في كل تجلياتها الروحية والمادية، من لغات وعقائد وعادات وتقاليد، والترحال ثقافة وخزين معرفي، إذ إن الشاعر بحاجة للقراءة، وقراءاته تنعكس على شعره إذا كانت تجربته صادقة، فإذا علمنا أن قراءة الإبداع لا تخلق مثقفًا، على عكس القراءة المعرفية متمثلةً بالفلسفة والفكر أي في حفريات المعرفة التاريخية، أي معرفة اللغات وتطورها والعقائد والثقافات بعامة، ومنها المكان، وهجرات المجموعات اللغوية، وتأثيراتها التي تجلبها من المكان الأول، وتضفيها على المكان الجديد، وهذه القراءات هي التي قادتني إلى نتائج أظنها جديدة، فيما يخص معرفة مدى مطابقة السرديات اللغوية “القومية والإثنية” والعقائدية للتاريخ الثقافي للمكان، وأزعم أنني نجحت في أمرين.
الأمر الأول: لغة قصيدتي وأجواؤها تشهد لي بأن الترحال والتنقل لسنوات ما بين العراق والأردن (أربع سنوات ونيف) وزي الجديدة “نيوزلندا” (ثماني سنوات وعشرة أسابيع) وهيروشـيمـا (ثلاثة أعوام) وجمهورية لاوس الديمقراطية (ثلاثة أعوام) والإكوادور (ثلاثة أعوام) والسودان (ستة أعوام) ثم العودة الاضطرارية لزي الجديدة منذ حوالي ثلاث سنوات، وزيارة ما يقارب من أربعين بلدًا من ضمنها البلدان المذكورة في أعلاه، أجواء هذه الدول وتاريخها وثقافاتها وجغرافيتها انعكست على قصيدتي، ومجموعاتي الشعرية ابتداء من مجموعتي الرابعة “بلوغ النهر” وحتى مجموعتي العاشرة والأخيرة الفائزة بالمركز الأول لجائزة حلمي سالم التي يمنحها منتدى الشعر المصري، تتضح فيها ملامح ومؤثرات الترحال، والانغماس بثقافات الشعوب التي أرى تنوعها اللغوي والعقائدي والعمراني والثقافي بعامة متحفًا إنسانيًّا يجب الحفاظ عليه.
الأمر الثاني: هو أنني قرأت تاريخ التنوع اللغوي والعقائدي في العراق والمنطقة والعالم، ونتج عنه كتابي “اغتيال الهوية” الذي يبرهن أن الترحال والانغماس في روح الثقافات الأخرى يمنحك أفقًا معرفيًّا عاليًا ووعيًا عميقًا ومتفردًا بالعالم، وأظن أن مجموعتي العاشرة “مرح في الأساطير” تتضح ملامح ما ذكرت بصورة جلية.
شعريا انت مولع بالمكان .. الى ما تحيل ذلك؟
- المكان هو البوتقة التي تنصهر فيه الثقافات، ويطبعها بطابعه الخاص، المكان لا يعني أرضًا جغرافية فقط، إنما الجدوى في عبقه التاريخي والثقافي والاجتماعي، المكان هو الجذر، والكتابة عن المكان وفاء مثلما الحنين وفاء أيضًا، المكان موطن المرجعيات الثقافية للمجتمعات والأفراد، فمَن أراد أن يعرف نسبة المكان لغويًّا (قوميًّا أو إثنيًّا) أو عقائديًّا فما عليه سوى أن ينظر في التاريخ الثقافي للمكان، فاللغة والعقيدة فاضحتان.
شغفي بدراسة المكان ثقافيًّا وإناسيًّا “إنثروبولوجيًّا”، سببه أولًا شغفي المعرفي، وثانيًا ما رأيته من صراعات سياسية تحت مظلات الإثنيات والقوميات والعقائد، وإيماني أن من واجبات المثقف وهي كثيرة، أن يقف مع الحق وليس مع ما يمليه عليه مسؤوله الحزبيّ، أو تعصبه القومي، أو العقائدي، أو يردد ما هو شائع وليس كل شائع صواب، وهذا ما رأيته واضحًا في معظم آراء “مثقفينا”، وفي خضم هذا التناقض أخذت قراءاتي منحنين منحنى داخليًّا تمثل في قراءة المكان العراقي وتتبع الهجرات والمنجز الثقافي لكل مجموعة لغوية وعقائدية فيه أي في عموم العراق، ومنحنى خارجيًّا تمثل بالأمكنة التي أقمت فيها وزرتها وتجولت في أعماق تاريخها ومجتمعاتها.
وهل (ادمانك) على الرحلات ، هو تكريس هذا الحضور في شعرك؟
- أعتقد، أن الترحال حافز قوي ومؤثر في تجربتي الشعرية، الترحال قد يكون واحدًا من أهم مصادر «الإلهام» في تجربتي الشعرية والكتابية على السواء، لأن مقاصد رحلاتي هي المعرفة وليس الاستجمام، والمعرفة مصدر ثر في أية تجربة إبداعية، وإلّا نحت المادة الإبداعية نحو التسطّح. إن الترحال معرفة، فلا ترحال بلا قراءات موسعة عن المكان ثقافيًّا وتاريخيًّا وجغرافيًّا واجتماعيًّا وإناسيًّا «إنثروبولوجيًّا» وشخصيًّا، وبعد عودتي من البلد الذي قمت بزيارته، أقرأ عنه كثيرًا، وأبحث في تنوعه اللغوي والعقائدي والاجتماعي، وهذه القراءة عادة ما رأيتها تتسلل لنصوصي بلا وعي أحيانًا، وهذا دليل على أنني هضمت ما قرأت ومن ثم أنتجته نصًّا شعريًّا.
وانا أطّلع على المدن والبلاد التي زرتها، (و)التي قاربت الخمسين بلدا ومدينة، وأكثرها بلدان هامشية اذا ما قيست بالبلدان الاخرى مثل باريس ولندن وفينا وغيرها .. ما تعليلك لذلك؟
- مشكلتنا تخلقها ثقافة «الإشاعة»، وتبهرني أضواء المدن الكبرى، فنسينا أن شعوبًا كثيرة تملك خزينًا ثقافيًّا هائلًا، بسبب تكاسلنا وتجاهلنا له أصبح بِكرًا، ولأني أنفر من التقليد الأعمى والمحاكاة، وجدتني أنفر من المراكز الـمُكرّسَة، وأميل إلى الأطراف والهوامش، فكان ترحالي ما بين زي الجديدة وهيروشيما (اليابان) ولاوس وميانمار (بورما) وكمبوديا وتايلند من بانكوك وحتى أقصى نقطة في الشمال ثم العودة مع الحدود إلى أن عبرت نهر ميكون (ميكونغ) في نقطة قريبة من المثلث الذهبي وفيه يصبح نهر ميكون محاذيَا لميانمار وتايلند ولاوس وفيتنام وماليزيا وسنغافورة ومناطق تقع جنوب الهند وليس المدن الكبرى، كذلك فعلت مع الصين حيث لم أزر بكين والمدن الكبرى إنما زرت أطراف الصين، والأمر ينطبق على أمريكا الجنوبية، ودول إفريقية.
هذه المناطق تشبع تلهفي للمعرفة والاطلاع على التنوع اللغوي والعقائدي والبيئي، وأنا مهووس بهذا الثلاثي، فقد شاهدت خمسًا وأربعين نوعًا من النمل، ومئات الأنواع من الطيور، ومثلها من الحشرات، وأطعمتُ فِـيَـلَـةً، وضمّدت جراح حيوانات وطيور، وتنقلت بين غابات وجبال وأودية حتى تعرضت مرارًا للخطر واقتربت أكثر من مرة من الموت وكانت واحدة مؤكدة لولا إصراري على الحياة، لكن الأهم أنني أستطيع أن أقول وبكل ثقة أن تجربتي مع مئات المجموعات اللغوية (الإثنيات والقوميات) في العالم وممارستي لطقوس أديان شتى من أجل الدراسة والمعرفة، وانغماسي اجتماعيًّا وثقافيًّا مع هذه الشعوب، كل هذا جعل تجربتي الحياتية والثقافية والشعرية لها نكهة خاصة لا تُشبه سواها، كما قال عنها الآخرون، راجيًا أن لا يكون فيما أسمع وأقرأ مجاملة على حساب الحقيقة.
أحيانًا أسأل نفسي: أأنا محظوظ أن وعيي للاختلاف وعدم التقليد كان مبكرًا ولم أمر بمرحلة التقليد؟ وأن اختياراتي وهوسي بالخصوصية قادتني إلى اكتشاف عوالم الشرق البعيد المهمل في ثقافتنا العربية مع الأسف، وكذلك عوالم إمريكا الجنوبية وإفريقية التي لم نعرف عنها لولا الروائيين، أما الأخيرة فهي متحف متكامل بيئي ولغوي وعقائدي، بينما معظمنا معلوماته عنها لا تزيد عما تبثه وكالات الأنباء عن المجاعات والانقلابات؟
في صفحتك الخاصة على الفيسبوك تكتب شذرات من زيارتك ورحلاتك، (و)التي نراها فيما بعد باسهاب اكثر في كتبك.. هل هي وسيلة لاستدراج القارئ؟ ام تراها كتبت للتذكير فيما سيليها؟
- أقولها وبكل صدق، إن سبب كتابتي على حسابي في موقع التواجه «الفيسبوك» هو جهلي بعوالم الحاسوب، فحين بدأت التدوين كنت في قرى وأرياف وأمازون الإكوادور، والأماكن التي كنت ارتادها لكتابة يومياتي، كانت تُغلق مبكرًا، أو يكون أمامي نصف ساعة فقط، ولأني لم أكن حينها أجيد فتح ملف جديد، وتدوين يومياتي فيه، ومن ثم إرساله على عنواني الرقمي «الإيميل» وبعد ذلك أقوم بحذف الملف، بل كنت أجهل تمامًا طريقة حذف الملف، فكانت الكتابة المباشرة على حسابي في موقع التواجه، خير معين لي، هذا كل ما في الأمر، لكنني وجدتها طريقة ممتازة للتفاعل، وحين بدأت أقرأ تعليقات الشعراء والأدباء والنقاد أو رسائلهم على «الخاص» فيما أنشر، استمتعت بهذه الطريقة.
لكن الأكثر إغراءً لي على المواصلة هو ما تلقيته من عروض للكتابة في صحف ومجلات، وبذلك وجدت دخلًا ماليًّا يُسهم ولو قليلًا بتغطية نفقات الترحال بحدها الأدنى، لكن الإغراء الأكبر حين راسلني الشاعر نوري الجراح مدير عام مؤسسة ارتياد الآفاق التي اطلقت للثقافة العربية جائزة ابن بطوطة، ودعاني للمشاركة في المسابقة، ومن ثم فوزي بجائزة ابن بطوطة، ورأيت كتاباتي التي جمعتها من منشوراتي على موقع التواجه وأعدت تحريرها، تتحول إلى كتاب ورقي، شعرت أنني أملك شَغَفًا آخر يُضاف إلى شغفي الأول والرئيس ألا وهو شغفي بالشعر الذي كرّستُ حياتي له.
لكنني وأنا اليوم أنهي عشر سنوات من التدوين الذي نتج عنه ثمانية كتب، أعترف أن في نشري تسللت الرغبة باستدراج القارئ، والتذكير بأنني عاكف على مشروعي في كتابة أدب الرحلات بالقوة نفسها التي أعكف فيها على مشروعي الشعري، وأن الجوائز الكبرى التي حصلت عليها زادتني شعورًا بالمسؤولية، وحفزتني للتجديد والتجاوز والتنوع لإثراء مشروعي في أدب الرحلات، الذي أراه خزينًا معرفيًّا وتجربة ثرة حفزت القصيدة عندي على الاغتراف من معين الترحال، وصبغت قصيدتي بخاصيتين متكافأئتين، وأعني بهما المعرفة والتجربة، أي تحولت قصيدتي إلى قصيدة معرفية – حياتية بنسبة متعادلة تقريبًا.