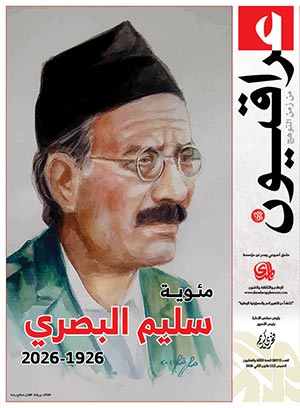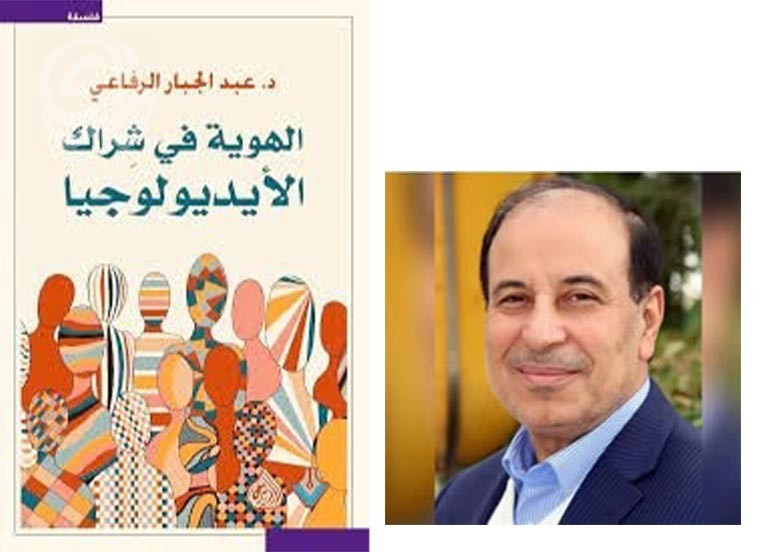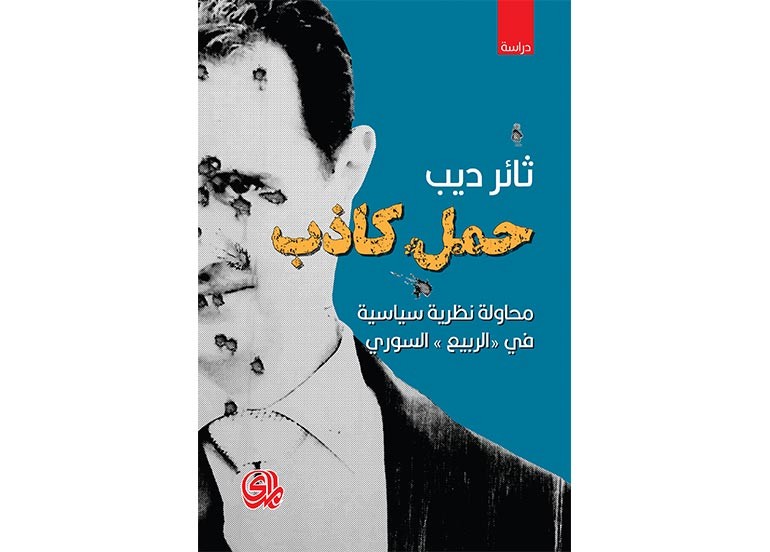بلقيس شرارة
سأكتب ذكرياتي عن الشاعرة نازك والعلاقة الفكرية التي كانت تربط عائلتّي محمد شرارة وصادق الملائكة. تعرفتُ على نازك عندما شاهدتها جالسة في الحديقة المطلة على نهر دجلة في الرستمية، في دارنا عام 1946،
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. إذ كان والدي مدرساً في دار المعلمين الريفية، وقد دعى عائلة صادق الملائكة إلى دارنا في الرستمية. وذكرت حياة: " كانت الرستمية ناحية معمورة بالبساتين واشجار النخيل والدفلى والتكي، وكانت السكينة الريفية تعمر جنباتها... واعجبت نازك بهذه الطبيعة الهادئة البعيدة عن ضوضاء المدينة وتجولت في ارجائها". (صفحات من حياة نازك الملائكة، حياة شرارة، ص-129(
عاشت نازك ألاحداث العامة من انتصارات وهزائم الدول في الحرب العالمية الثانية، كما كان هنالك تطلع وحماس في الحصول على الاستقلال وجلاء الجيوش البريطانية عن البلاد، إذ كانوا ينتظرون ميلاد عالم جديد بعد الحرب، رغم معاناة الناس من الغلاء والتموين والتقنين في المصروفات. كانت نازك تعيش الاحداث ويأخذها الحماس تارة والقنوط تارة أخرى.
في عام 1947 انتقلت دار المعلمين الريفية إلى حي سبع قصور في الكرادة الشرقية، واصبحت الزيارا ت متبادلة بين العائلتين.
كنتُ آنذاك في الصف الثاني المتوسط، وكنا كلنا آذان صاغية لما يدور من حديث، وشعرنا باهتمام نازك بنا، إذ كنا في سن المراهقة، وقد علمّتنا على سماع الموسيقى الكلاسيكية، إذ لم نتعرض في السابق في دار والدي إلا إلى سماع الاغاني المصرية وخاصة عبد الوهاب، كان والدي من المعجبين به.
كنا نجلس في غرفة الضيوف المطلة على الشارع في شارع أبو قلام، وكانت نازك تضع الاسطوانة في كرمفون كبير، الذي كان جزء منه راديو، ونصغي إلى القطعة الموسيقية، بعد أن تطفئ ضوء الغرفة. وأول مرة سمعت السمفونية السادسة للموسيقار الروسي شايكوفسكي هو في تلك الغرفة المظلمة، بعد ان شرحت لنا السمفونية، وهي آخر ما ألفه الموسيقار الروسي قبل موته، وتعتبر من روائع اعماله الموسيقية. فالموسيقى حزينة جداً وعاطفية في نفس الوقت. ثم استمعنا إلى جميع سمفونياته، ولكن ظلت السمفونية السادسة المفضّلة بالنسبة لي. ثم بدأت تعيرنا بعض السمفونيات، لعدد من الموسيقيين الألمان والروس والفرنسيين، وكنا نصغي اليها في الدار عشرات المرات حتى حفضنا قسماً منها. كان لنازك في الحقيقة الدور الرئيس في تذوقنا الموسيقى الغربية، وسماعها من قبل جميع أفراد العائلة.
كانت نازك قصيرة القامة، مملؤة الجسد، بسيطة المظهر، قليلة الكلام، وإن تكلمت فبصوت هادئ لا ترفعه إلا عندما تقرأ إحدى قصائدها. كما كانت واسعة الاطلاع، ذات ثقافة أدبية عميقة، تتقن عدة لغات. ولم يقتصر اطلاعها على قراءة الكتب وانما شمل التتبع في الموسيقى والسينما. إضافة إلى ذلك، فإنها كانت تعزف على آلة العود، وتغني اغاني عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم من المغنين. كانت تفضل أن تقرأ الرواية قبل ان تشاهد الفلم، مثل رواية "دكتور جيكل ومستر هايد، أو "لمن تقرع الأجراس" للكاتب همنغواي، وغيرها من الأفلام الغربية، لكنها كانت تشاهد أيضاً الأفلام المصرية مثل "رصاصة في القلب" لتوفيق الحكيم.
وذكرتْ عنها شقيقتي حياة، ان موقف نازك من الجنس والزواج كان كرد فعل للتقاليد الاجتماعية الصارمة بحق المرأة. فكانت ضد الزواج لدرجة انها شكّلت في النصف الثاني من الاربعينيات جمعية ضد الزواج ولكن الجمعية تصّدعت بزواج القاصة ديزي الأمير عندما تزوجت عام 1948.
كانت نظرتها للحياة نظرة مأساوية، متشاءمة، وكان الحزن يغلب حتى على محياها. انعكست تلك النظرة في قصائدها. فقد صدر لها في تلك المدة ديوان (عاشقة الليل)، وقد أثار تسائلات عن سر الحزن والكآبة اللذين يخيمان على القصائد في الديوان.
يا ظلام الليل يا طاويَ أحزانِ القلوبِ
أنظُرِ الآن فهذا شبحٌ بادي الشُحوب
جاء يسعى، تحت أستاركَ، كالطيف الغريب
حاملاً في كفَّه العودَ يُغني للغُيوبِ
ليس يَعنيهِ سُكون الليلِ في الوادي الكئيبِ
***
فارجِعي لا تَسألي البَرق فما يدري الوميضُ
عجباً، شاعرة الحَيرة، ما سرُّ الذهول؟
ما الذي ساقكِ طيفاً حالماً تحت النخيلِ؟
مُسندَ الرأس إلى الكفين في الظّل الضليلِ
مُغرقاً في الفكر والأحزانِ والصمتِ الطويلِ
ذاهلاً عن فتنةِ الظُلمةِ في الحقل الجميلِ
***
وقد حاول والدي محمد شرارة ان يتلمس تلك الأسباب، أسباب الحزن، فكتب مقال بعنوان: "عاشقة الليل، وهل في الليل ما يعشق؟" وتساءل :" ما هي بواعث هذا الأنين المتصل واللوعة المستمرة؟... فربما كانت وراء هذه اللوعة بواعث متصلة بالمجتمع من حيث الأوضاع والعنعنات البالية، ومن حيث الحكم واساليبه الراجعة إلى اسخف عهود الإقطاع... وربما كانت متصلة بعاطفة ذاتية خاصة". (عاشقة الليل وهل في الليل مل يعشق؟، مجلة العرفان اللبنانية، كانون الثاني 1948).
كانت نازك تحضر أما بصحبة والدها صادق الملائكة أو بصحبة شقيقها نزار، الندوة الشعرية في دارنا، وفي احد الأيام اصطحب والدي الشاعر بدر شاكر السياب ليتعرف على عائلة الملائكة. وقد قرأتْ نازك في تلك الأمسية قصيدتها بعنوان: (الكوليرا)، إذ انتشرت الكوليرا في مصر عام 1947، وكانت الأذاعة تذكر عدد الموتى يومياً، الذي كانوا يموتون بالمئات، خاصة بين الطبقة الفقيرة. وعندما وصل الرقم الى الألف، هيمن على نازك في ذلك اليوم حزن عميق، ونظمت قصيدة (كوليرا).
وكانت في تلك القصيدة رائدة الشعر الحر أو شعر التفعيلة، و انتقالها في تركيبها من الشكل الكلاسيكي الذي ساد الأدب العربي إلى الشكل المعروف بالشعر الحر. ولاقت انتقاداً في البداية حتى من قبل عائلتها عندما بدأت تنظم الشعر الحر بدل الشعر الكلاسيكي. إذ خرجت بذلك عن الشعر الموزن بقافية. لكن لاقت القصيدة استحساناً بعد ذلك، وكانت القصيدة حدث مهم في حياة نازك الشعرية، وتقول:
"ومنذ ذلك التاريخ انطلقتُ في نظم الشعر الحر، وإن كنت لم أتطرف إلى درجة نبذ شعر الشطرين نبذاً تاماً، أو مهاجمته، كما فعل كثير من الزملاء المندفعين الذين أحبوا الشعر الحر واستعملوه بعد جيلنا".
سكن الليلُ
اصغِ الى وَقْع صدى الأنَّاتْ
في عمق الظلمة، تحتَ الصمتِ، على
الأموات
***
في كل فؤادٍ غليانُ
في الكوخِ الساكن أحزان
في كل مكانٍ روحٌ تصرخ في
الظلمات
***
ثم تنهي القصيدة:
الموتُ، الموت، الموتُ
يا مصرُ شعوري مزَّقه ما فعل الموت
***
وبعدها بعامين صدر لها ديوان (شظايا ورماد) وهي انطلاقتها الأولى في الشعر الحر. وذكرت في مقدمة الديوان عن جمود الشعر العربي:
"وقد يرى كثيرون معي أن الشعر العربي لم يقف بعد على قدميه بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على صدره القرون المنصرمة الماضية. فنحن عموماً ما زلنا أسرى، تسّيرنا القواعد التي وضعها اسلافنا في الجاهلية وصدر الإسلام. ما زلنا نلهث في قصائدنا ونجّر عواطفنا المقيدة بسلاسل الأوزان القديمة، وقرقعة الألفاظ الميتة، وسدى يحاول أفراد منا أن يخالفوا: فإذ ذاك يتصدى لهم ألف غيور على اللغة، وألف حريص على التقاليد الشعرية التي ابتكرها واحد قديم أدرك ما يناسب زمانه، فجمدنا نحن ما ابتكر واتخذناه سنة. كأن سلامة اللغة لا تتم إلا إن هي جمدت على ما كانت عليه منذ ألف عام، وكان الشعر لا يستطيع أن يكون شعراً إن خرجت تفعيلاته على طريقة الخليل".
تركت المقدمة اثرها الطيب في لفت النظر إلى طبيعة الشعر الحر.
هذا مقطع من قصيدة (جدران وظلال):
وهناك في الأعماق شيء جامد
حجزت بلادته المساء عن النهار
شيء رهيب بارد
خلف الستار
يدعى جدار
اواه لو هدم الجدار
***
كانت نازك عندما نزورها أو تزورنا تقرأ آخر ما نظمت من القصائد، كان الصمت يهيمن على الحاضرين، و يستمر الصمت أحياناً حتى بعد ان أن تنتهي من قراءة القصيدة، واتذكر ذلك عندما قرأت قصيدها بعنوان: (الخيط المشدود في شجرة السرو)، والقصيدة حزينة فهي عن الفقدان والموت، عن شاب ماتت حبيبته:
في سواد الشارع المظلم والصمت الأصم
حيث لا لون سوى لون الدياجي المدلهّم
حيث يرخي شجر الدفلى أساه
فوق وجه الأرض ظلاّ
***
وكان هنالك تنافس واضح بينها وبين بدر السياب، فكل منهما كان يدّعي انه هو الأسبق في نظم الشعر الحر، وذكرت نازك عن بداية حركة الشعر الحر انه كان في عام 1947 ومن بغداد، ثم امتدت الحركة حتى غمرت العالم العربي كله. ولكنها استدركت بعد ذلك، ان الشعر الحّر قد بدأ في العالم العربي قبل العراق.
ولكن لم تكن لها الجرأة الكافية لمواجهة المجتمع وتقاليده، فعندما نظمت ديوان (شظايا ورماد) بشخص كانت تحبه ويحبها، لم يذكر أحد عن ذلك الحب، فهو محّرم في مجتمعنا. وظلت فترات من حياتها مجهولة، وكتبت حياة في مقدمة الكتاب: "واجهتني مشكلة كبيرة وهي حساسية وضع المرأة في مجتمعنا وكثرة القيود التي تثقل كاهلها. إن تناول الحياة الخصوصية للمرأة بكل تفاصيلها أمر لا يتقبله الفرد ولا المجتمع عندنا... صارت كلمة عيب تدق رأسي كالمطرقة وتكاد تأتي على كل جهودي وتحطمها. عيب أن تحب، أو تغني أو تُظهر عواطفها... ووجدت الأصفاد الاجتماعية ترن بكل ثقلها في مسمعي وأنا أنقل خطواتي بينها بحذر وخوف". (صفحات من حياة نازك الملائكة، حياة شرارة، الطبعة الثانية، دار المدى 2011).
هذا الموقف هو بعكس موقف الشاعرة لميعة عباس عمارة، فقد صّرحت بحبها لبدر وكان كل منهما يقرأ القصائد المتبادلة بينهما في الندوة الشعرية في دارنا، أما نازك فكانت تقرأ بعض قصائدها غير المتعلقة بالحب.
بعد أن القي القبض على والدي وحكم عليه بالسجن لمدة عام، انقطعت العلاقة بين عائلتينا، وعندما خرج والدي من السجن عام 1954، ترك العراق وسافر إلى لبنان.
مرّت الأيام والاشهر والسنين، وعلمتُ ان نازك متعبة صحياً، وقضت السنين الأخيرة من حياتها في القاهرة، حيث توفيت في عام 2007. ومن المؤلم ان عدد من مفكري تلك الفترة لم يدفنوا في بلدهم العراق، والذين كان لهم دور مهم في تجديد الشعر مثل الشاعر بلند الحيدري ولميعة عباس عمارة، وغيرهم من الذين كان لهم دور مهم في الحركة الفنية والأدبية في العراق.