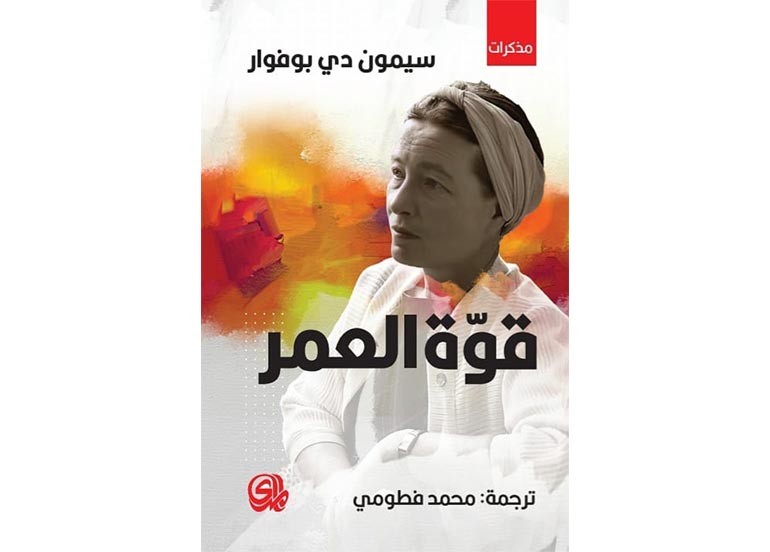قرأتُ قبل أيام مقارنات لأحد المثقفين العراقيين، يقارن فيها بين مثقف الأمس ومثقف اليوم، وهو يرى من وجهة نظره تطابقا بين جوهر المثقف السابق واللاحق، إذ يبدو أن الوجوه والعناوين تغيرت، لكن تبعية المثقف (للسلطة/ المال/ المنفعة) لا تزال قائمة، وهو مؤشر ودليل لا يقبل الريب، على عدم قيام المثقف الراهن بدوره الطليعي في المجتمع، وهو ما حصل أيضا إبان الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على حكم العراق، والتي وضعت المثقف غالبا، في خانة الرأي الحكومي وحاولت ونجحت في تجييره لصالحها.
مثقف اليوم يقع في الخانة نفسها، بعد أن وجد نفسه وجها لوجه أما السلطة، ليس الحكومية وحدها، بل جميع البؤر السلطوية التي انتشرت في عموم العراق، فقد تشظّت السلطة، ولم تعد تابعة للحكومة وحدها، بوجود الكتل السياسية والأحزاب والتيارات، وحتى الشخصيات السياسية المستقلة، لذا فإن مثقف اليوم يجد نفسه أمام سلطة مركزية حكومية وسلطات أخرى تتفرع منها، أو سلطات كتل وأحزاب وشخصيات سياسية.
في ظل هذا الواقع المربك، يجد المثقف نفسه أسيرا لفوضى السلطة، وعليه أن يوازن بين حاجاته اليومية وضمان العيش المقبول لعائلته، وبين الحفاظ على دوره الريادي كمثقف ينبغي عليه القيام بدور متميز، يختلف عن أدوار الآخرين في بناء المجتمع، هذه الموازنة تجعل المثقف الراهن في حيرة من أمره، فإذا كان تابعا للسلطة السياسية (يعمل في إحدى دوائرها ومؤسساتها الثقافية والإعلامية)، عليه أن لا يتقرب من نقد السلطة كما يريد أو كما يرغب، وإلا فالنتائج واضحة، حيث المستقبل المجهول له ولعائلته، ولدينا هنا في العراق أمثلة لا تقبل الدحض وفي دول عربية أخرى، وإذا كان المثقف يعمل لتحصيل رزقه اليومي في مؤسسة إعلامية أو ثقافية تابعة لكتلة أو حزب أو تيار أو حتى شخصية سياسية، فعليه أن يلتزم حرفيا بما يُملى عليه، حتى لو كان غير مؤمن ولا مقتنع بما يُملى عليه!.
هذه الإشكالية التي يعانيها المثقفون اليوم، حاضرة وشاخصة بقوة في الواقع العملي، وهي انعكاس للتشظي السياسي الحادث في العراق منذ 2003، وقد يبدو الخلاص منها أمرا مستحيلا، أو هو غاية في الصعوبة، في حالة كهذه كيف يمكن للمثقف أن يقوم بدوره المطلوب في قيادة الوعي المجتمعي وترصينه وترقيته إلى درجات أعلى؟
من الواضح هنا أهمية بل حتمية الحصول على عنصر تمويل بديل للمثقفين، فإذا ضمن المثقف إيرادا ماليا له ولعائلته، هنا يمكنه القيام بدوره الصحيح من دون إملاءات من السلطة أو سواها، لذا غالبا ما يضمن القطاع الأهلي والمنظمات الخيرية وسواها، حياة المثقف وذويه في المجتمعات المتطورة، الأمر الذي يبعده عن سطوة السلطة بأنواعها كافة، وإملاءاتها.
تُرى هل تحقق لمثقف اليوم ما كان يفتقده مثقف الأمس؟
إن الإجابة الصحيحة والصريحة عن هذا السؤال، هي التي تمكن المعنيين من وضع الحلول الإجرائية الدقيقة لمعالجة إشكالية دور المثقف في الواقع الراهن، وما يعانيه من ارتباك وفوضى، نتيجة لتشظي السلطة وتعدد فروعها وتنوع إملاءاتها أيضا، ولا نعني بمعالجة هذا الارتباك الواقعي إعطاء الذرائع للمثقفين كي يلهثوا وراء فوائدهم (المادية خاصة)، وينسوا مبادئهم ورسالتهم التثقيفية الإنسانية التي لامناص من الالتزام بها.
لذا فالمثقف في كل الأحوال عليه وحده تقع مسؤولية الالتزام بجهده الرسالي في خدمة المجتمع، من ناحية رفع الوعي الشعبي إلى درجات تمكن الشعب من العيش بطريقة تليق بكرامة الإنسان، لكن يجب أن يعرف أثرياء البلد دورهم الأساس في حماية المثقف من ضغط السلطة بكل فروعها وأنواعها، بل لابد للسلطة نفسها أن تصل إلى قناعة، بأن المثقف يجب أن يبقى في منأى عن إملاءاتها، لأن حرية المثقف تضمن حرية الرأي، والأخير يضمن استقرارا وتطورا للديمقراطية، وللعملية السياسية، والاقتراب سريعا من دولة المؤسسات المدنية.
إن مثقف اليوم لا يختلف عن مثقف الأمس إذا تركناه تحت سطوة السلطة بأنواعها، وتحت ضغط أفكارها التي لا تتسم في كل الأحوال بسعة الآفاق وتعدد الرؤى والانفتاح الفكري الذي يقود إلى مجتمع التعايش، والتسامح، والتعددية، حيث يندمج فيه الجميع تحت خيمة الوطن الواحد. لذا على المعنيين جميعا، إنقاذ المثقف من ضغوط السلطة بكل أشكالها وأنواعها.