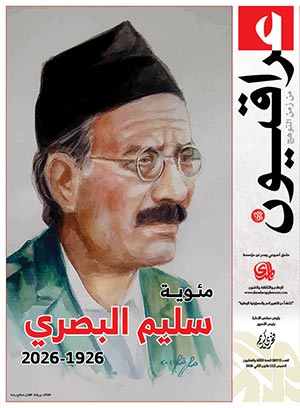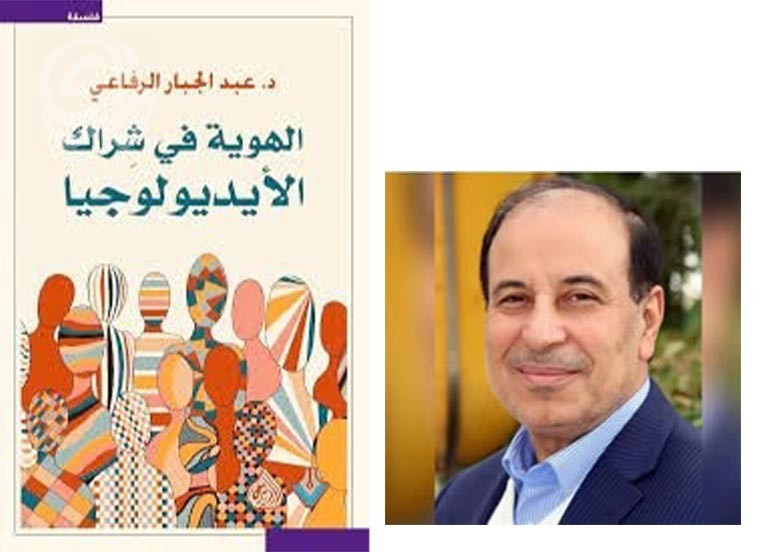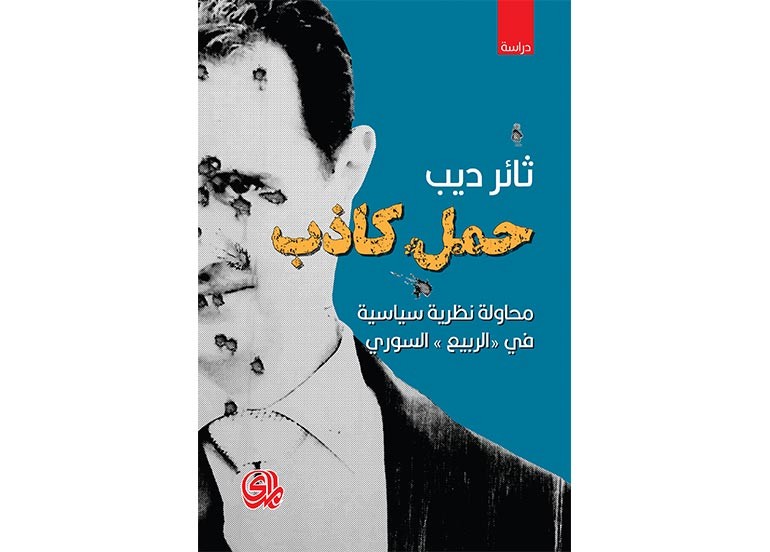د. بسّام البزّاز
لطالما قلنا إنّ الترجمة لغة وثقافة وأسلوب.
على هذا الأساس يجب أن ننظر إليها،
وعلى هذا الأساس يجب أن نتعامل معها، مترجمين وقرّاءا.
وعلى هذا الأساس يجب أن نترك جدلا عقيما يأخذ منّا مجهودا ووقتا حول الانتقال بالنص المترجم إلى عوالم اللغة الهدف فنعرّق ونمصّر ونلبنن، بدلا من أن نجعل من الترجمة مركبة وواسطة تنقلنا إلى العوالم التي يمثلها النصّ أو يوثقها، سواء أكانت تتصل بلغته أم بأسلوبه أم بمادته التاريخية أو الاجتماعية.
يكفي أن نستعرض مسارح بعض الروايات لندرك كم أثّرت قراءتُها في ثقافتنا.
ويكفي أن نتذكر كم ساحت بنا تلك الأعمال وطافت حتى قادتنا إلى التعمّق في جوانبها وعناصرها ومكونات حبكتها وشخوص أحداثها:
خذوا أيّة رواية عالميّة: مترجمة أم غير مترجمة، وستجدون أنّها ليست قصّة تُحكى، بل عالما يمرّ من أمامنا وسياحة تحملنا بين دفتي كتاب، وموسوعة يضمّها مجلّد واحد.
حكى لي صديق عن صديق قرأ رواية "الرجل الذي كان يحبّ الكلاب"، التي تروي وقائع اغتيال الزعيم البلشفي تروتسكي، فإذا به يجمع المصادر والمراجع ويستعد لدراسة تروتسكي والثورة الروسية وتاريخ روسيا كلّه.
رواية تقود إلى دراسة التاريخ وإلى البحث فيه واكتشاف المزيد من جوانبه وأسراره.
وأخرى تحملك على دراسة مجتمع من المجتمعات
أو ظاهرة من الظواهر
أو حركة من الحركات السياسية أو الفكرية أو الفنيّة.
فالترجمة، بكلمة واحدة، مفتاحُ باب نطلّ منه على عالم كامل، بعد أن فتحت الرواية أعيننا على فرجة منه.
أكتبُ مقدمة ترجمة لرواية من تلك المعروفة برواية الدكتاتور. فأبحث في سيرة الدكتاتور ثمّ أبحث في عشرات الأسماء والأحداث والأحزاب والمحطات الفاصلة في تاريخ باراغواي الذي لا يلبث أن يمتد ليشمل تاريخ المنطقة برمتها، بل تاريخ أمريكا الجنوبية وأوربا وأسبانيا. فالكل متّصل بالكل: مصيرُ باراغواي المرهون بسعي الجارين العملاقين، الأرجنتين والبرازيل، إلى ابتلاعها. وبالإنكليز الذين يغيرون من حين لحين على هذه المقاطعة أو تلك. وبالإسبان الذين بدأ نفوذهم ينحسر من على تلك الديار بعد طول سيطرة واستعمار.
وسيقرأ القرّاءُ، حين نشر الترجمة، ما قرأتُ وما كتبتُ، فتتسع هكذا دائرة المعرفة، وتتحوّل الترجمة إلى مصدر للمعرفة والثقافة، نستشهد بمضمونها أو ببعضه كما نستشهد بأيّ كتاب أو وثيقة أو معلومة.
حجرٌ يحرّكُ أمواجا من الأحداث والسير والمعلومات، تتغلغل في وعي القارئ حتّى تشكل جزءا من معارفه وثقافته.
ولا خير من السينما شاهدا يقرّب لنا الفكرة التي نحن بصددها:
من منّا لا يلمس دور السينما المصريّة والدراما المصريّة في تعريفنا، حدّ الإشباع والتماهي، بكلّ ما يتّصل بمصر وتاريخها ومجتمعها ولهجتها وتقاليدها ولغتها وأمثالها؟
وهل كان لأعرق الجامعات ولا أنبه الأساتذة والعلماء أن يعلمونا عن مصر ما علمنتا إيّاه عنها روايات محفوظ والسباعي وعبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس أو الأفلام التي اتخذت من أعمال هؤلاء وسواهم مادة لهم؟
وهكذا يفعل المسرح
وهكذا تفعل الفنون التشكيليّة
وهكذا يفعل كلّ تفسير وأداء إبداعي مبني على نصّ إبداعي آخر.
القصّة قصّة
لكنّ وراءها وفي طياتها وتفاصيلها ثقافة وعوالم ومعلومات.
نلتقط صورة لصديق أو مجموعة أصدقاء
وجوه الأصدقاء مهمّة
وذكراهم مهمّة
لكنّنا نصوّر، في الوقت نفسه، ومن حيث لا ندري ولا نبالي، خلفيّة توثيقيّة لا تقلّ أهميّة عن الوجوه والأفراد.
فحديقة غنّاء كانت هنا
وجدول ماء كان يجري متدفقا هناك.
صورة وإطار
نصّ وتوثيق
تلك هي الترجمة: نصّ ننقله، وننقل معه، وبين طياته، الكثير الكثير من المعارف والعوالم.