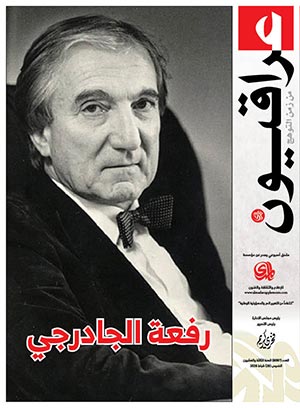في 30 مارس/آذار 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري الثاني منذ توليه إدارة شؤون البلاد في 11 فبراير/شباط 2011 «الإعلان الأول في 13 فبراير 2011» نتيجة ثورة 25 يناير وإجبار رئيس الجمهورية «حسني مبارك» على الرحيل والتخلي عن منصبه، ونصت المادة الستون (مواد الإعلان 62 مادة) من الإعلان الدستوري على عقد الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اجتماعا مشتركا لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من 100 عضو.
عقب انتخاب مجلسي الشعب والشورى عقد هذا الاجتماع المشترك وانتهى في 17 مارس 2012 بتشكيل الجمعية التأسيسية ومن بين أعضائها أعضاء في مجلسي الشعب والشورى بنسبة 50% وبأغلبية كبيرة من أعضاء أحزاب «الحرية والعدالة» و«النور» وأحزاب تيار الإسلام السياسي الأخرى.
وكان النص الذي أورده الإعلان الدستوري (إعلان 30 مارس 2011) الخاص بمسؤولية الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى عن تشكيل الجمعية التأسيسية يمثل انتهاكا سافرا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في 17 ديسمبر/كانون الأول 1994 في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية يقضي بأن «الوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة، وتنفصل وتستقل عنها.. وأن الدستور هو وثيقة السيادة المطلقة على كل سلطات الدولة، فلا يجوز لواحدة من السلطات أن تضعه وإلا كان الأدنى مسؤولا عن الأعلى.. وإلا نسبنا الأب للابن»، وقد أوقعت جماعة «الإخوان المسلمين» – المتحالفة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الحين – ومعهما مستشاروها القانونيون المنتمون للجماعة أو القريبون منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الخطأ الفادح.
وزاد الطين بلة أن الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ضرب عرض الحائط بكل القواعد المستقرة في الفقه الدستوري، فقام بتشكيل الجمعية التأسيسية من أغلبية تنتمي للسلطة التشريعية وتنتمي لتيار الإسلام السياسي كاشفا بذلك عن نيته صياغة الدستور بمنطق الأغلبية والأقلية وليس بمنطق التوافق، وهو الشرط الضروري لصياغة الدساتير في العالم كله، فالأغلبية متغيرة والدستور دائم.
واتخذ حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الموقف الصحيح عندما قاطع هذه الجمعية التأسيسية منفردا.
وتأكد صحة موقفه عندما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 10 أبريل/نيسان 2012 بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية «الأولى» وبطلانه.
وعندما اتضح أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور اللذين يهيمنان على الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى يتجهان إلى تشكيل «الجمعية التأسيسية» الثانية بنفس المنطق وأنها ستحمل نفس العوار الذي كان سببا في إبطال تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، قرر حزب التجمع مقاطعتها ومقاطعة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى المخصص لتشكيل الجمعية التأسيسية، وغاب نوابه حتى لا يشاركوا في هذه الخطيئة.
ودعا حزب التجمع الأحزاب الأخرى لمقاطعة الاجتماع والنأي بنفسها عن المشاركة في الجمعية الإخوانية السلفية، ولم تستجب الأحزاب المدنية والديمقراطية لهذه الدعوة ليصبح «التجمع» وحيدا في مقاطعة الاجتماع، وعندما «وقع الفأس في الرأس» كما يقولون وتبين صحة موقف التجمع، أعلنت أحزاب: المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الوطنية والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي وأحزاب أخرى الانسحاب من الجمعية التأسيسية الثانية، كما انسحب عدد من ممثلي حزب الوفد من الجمعية بالمخالفة لقرار رئيس الحزب بينما استمر آخرون، وبعد فترة عاد ممثلو بعض الأحزاب المنسحبة مثل المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي للجنة!
ومع بدء الجمعية التأسيسية عملها وافتضاح منهج النور والحرية والعدالة عمليا في فرض دستور «إخواني سلفي» على مصر بما يهدد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ناضل الشعب المصري لتأسيسها منذ ما يزيد على قرنين، ويعيد إنتاج الاستبداد الذي عانته مصر طوال العقود الأربعة الماضية توالت الانسحابات من «الجمعية التأسيسية».
وجاءت الاستقالة الأولى من الجمعية التأسيسية التي كشفت الكثير مما يجري داخلها من الناشطة السياسية «منال الطيبي».
وتلاها بيان اللجنة الوطنية لحرية التعبير التي يرأسها الكاتب الكبير بهاء طاهر ومنسقها محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب ليلقي المزيد من الضوء على عمل الجمعية وعلى كارثة الدستور الذي تعده.
وأصدر تحالف الوطنية المصرية بياناً دعا لمقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية.
وقررت محكمة القضاء الإداري في 23 أكتوبر الماضي وقف نظر 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني أصدر 30 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية بيانا هددوا فيه بالانسحاب من الجمعية، ثم أعلنوا في 13 نوفمبر تجميد عضويتهم وتقدموا بخمسة مطالب يتم الانسحاب من الجمعية إذ لم تتم الاستجابة لها، وأعلنت الكنائس المصرية الثلاث سحب ممثليها في الجمعية وقدمت د. سعاد كامل أستاذة الجامعة والعضوة السابقة بمجلس الشورى استقالتها من الجمعية، بينما واصلت الأغلبية المهيمنة جهودها للإسراع بصياغة دستورها قبل 12 ديسمبر.
صياغة الدستور بالمقلوب!
توقع كثيرون على ضوء تشكيل هذه الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وهيمنة التحالف الإخواني السلفي عليها وإصرارهم على الانتهاء من صياغة الدستور بسرعة والاستفتاء عليه قبل أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الطعن على الجمعية التأسيسية، أن يأتي مشروع الدستور مرتبكا وممثلا لوجهة نظر التحالف الإخواني السلفي وبعيدا عن التوافق السياسي والمجتمعي.
ولكن المسودة الثالثة التي نشرت يوم 5 نوفمبر 2012 – وهي المسودة الأخيرة حتى الآن – فاقت كل التوقعات، وحملت كل أمراض وعيوب ونواقص المسودة الأولى في 14 أكتوبر/تشرين الأول والثانية في 24 أكتوبر.
ونقطة الضعف الرئيسية في مسودة الدستور تتمثل في المنهج الذي اتبعته الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فبدلا من أن يتم في البداية اتفاق الجمعية وتوافق أعضائها على المبادئ العامة التي تحكم الدستور مثل شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات والعلاقة بين السلطة والحرية والالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية من عدمه.. إلخ، بدأت اللجنة عملها بتقسيم أعضائها إلى لجان فرعية تتولى كل لجنة صياغة أحد الأبواب المقترحة للدستور ووضع تفاصيل المواد دون ناظم أو رابط أو رؤية متفق عليها.
ونقطة الضعف الثانية نتجت عن ضعف واضح في الشخصيات الرئيسية التي تولت قيادات الجمعية ولجانها الفرعية وتصدت لكتابة مواد المسودات المختلفة، فصياغة مواد مسودة الدستور تكشف عن افتقار كاتبها للصنعة والجهل باللغة العربية عامة وبالصياغات القانونية والدستورية خاصة، فالعديد من المواد كتبت بصياغات عامة وعبارات فضفاضة تحتمل أكثر من معنى وتفسير وبعبارات إنشائية، لا معنى لها وغير منضبطة وفي صياغات ركيكة، دفعت د. محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بجامعة الزقازيق إلى المطالبة «بتأنيب من صاغوها على سوء صناعتهم» وسانده في ذلك عديد من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية على اختلاف انتماءاتهم السياسية.
ونقطة الضعف الثالثة تتعلق بالإحالة في كثير من مواد الدستور للقانون، وبصفة خاصة في المواد المتعلقة بالمبادئ العامة والحقوق والحريات العامة، بما يحمله ذلك من خطر أن ينتقص القانون من أصل الحق الدستوري، وقد أحالت مسودة الدستور للسلطة التشريعية تنظيم هذه الحقوق عن طريق إصدار قوانين 14 مرة في المواد (4 و10 و18 و21 و24 و25 و37 و38 و39 و47 و57 و58 و73 و76).
دولة دينية
وإذا انتقلنا من الملاحظات العامة إلى الملاحظات التفصيلية حول مواد مسودة 5 نوفمبر (232 مادة) فسنفاجأ بأن الذين وصفوا مشروع الدستور الحالي بأنه أسوأ دستور منذ عرفت مصر الحياة الدستورية لم يخطئوا.
وتتعلق الملاحظة الأولى بالمواد المتعلقة بتحديد هوية المجتمع والدولة وهي المواد 2 و3 و4 و220 و9 و10 و11، والتي تتناول الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع والهوية الثقافية.
وتعد المادة الثانية هي نقطة الارتكاز في هذه القضية وتنص هذه المادة على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وقد تم إقحام هذه المادة على الفقه الدستوري المصري في دستور 1971 من قبل الرئيس الأسبق «أنور السادات»، بعد أن رفض مشروع الدستور الذي صاغته اللجنة التي شكلها، وطرح للاستفتاء مشروع دستور آخر متضمنا المادة الثانية المشار إليها، وصدر الدستور الجديد في 11 سبتمبر/أيلول 1971.
والنص على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» موجود في دستور 1923 الذي صدر نتيجة لثورة 1919 التي طالبت بالاستقلال والملكية الدستورية في (المادة 149)، وكذلك في دساتير ما بعد ثورة 1952 بدءا بمشروع دستور 1954 (مادة 195) ودستور 1956 (مادة 3) ودستور 1964 (مادة 5).
وبصرف النظر عن أن الدولة «كائن معنوي» لا يمكن أن تكون مؤمنة أو كافرة، فقد وصف الفقهاء النص على أن دين الدولة الإسلام في دستور 1923 بأنه «مجاملة» من لجنة صياغة الدستور لدين أغلبية السكان ليس إلا.
ولكن النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية «مصدر رئيسي للتشريع» طبقا لنص المادة عند صدور دستور 1971، ثم «المصدر الرئيسي للتشريع» في الاستفتاء على تعديل الدستور عام 1980، فهي إضافة فرضها السادات كمناورة سياسية في المرتين، فخلال صراعه – بعد رحيل جمال عبدالناصر في 28 سبتمبر 1970 وتوليه رئاسة الجمهورية – مع شركائه في الحكم من رجال جمال عبدالناصر ومعاونيه «علي صبري وشعراوي جمعة ومحمد فائق والفريق محمد فوزي.. إلخ» ومع اليسار الشيوعي والناصري والقوى الديمقراطية التي عارضت انقلاب القصر الذي قاده السادات في 13 مايو/أيار 1971 وأسماه «ثورة 15 مايو»، وتمسكت بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للطبقة الوسطى والطبقات الشعبية.. لجأ السادات إلى التقارب والتحالف مع الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية واستغلال المشاعر الدينية للمصريين، فأطلق على نفسه لقب «الرئيس المؤمن» وأبرز في مقدمة اسمه اسم محمد ليصبح «محمد أنور السادات»، ودس هذه الفقرة في المادة الثانية من الدستور، وفي استفتاء 1980 عدل المادة لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية «المصدر» بدلا من «مصدر» ليمرر تعديل المادة الخاصة بمدد رئيس الجمهورية (المادة 77) ليطلق المدد بعد أن كانت محددة بمدتين فقط تمهيدا ليرشح السادات نفسه لمدة ثالثة، لكن القدر لم يمهله ليكمل مدته الثانية وتم اغتياله في 6 أكتوبر 1981.
وتتمثل خطورة هذا النص في إسقاطه شعار ثورة 1919 العظيم «الدين لله والوطن للجميع» وإدخاله الدين في السياسة والسياسة في الدين بما يضر بالاثنين معا، وهدم أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ناضل الشعب المصري من أجلها ما يزيد على قرنين من الزمان.
كما أدى هذا النص للتمييز ضد أقباط مصر وغير المسلمين عامة، وتقديم السند لصعود الأحزاب الدينية وقوى الإسلام السياسي ودعوتها لإقامة «دولة إسلامية» أي دولة دينية، وأن «تكون الشريعة الإسلامية مرجعا أعلى من الدستور»، وأن يتم عرض القوانين قبل صدورها على هيئة من كبار العلماء لترى مدى اتفاقها مع الشريعة الإسلامية.
ولم تكن مصادفة بدء أحداث الفتنة الطائفية بعد أشهر قليلة من صدور دستور 1971 حاملا هذه المادة، بوقوع فتنة «الخانكة» عام 1972.
ولا تكتفي مسودة الدستور «الإخواني السلفي» بنقل المادة الثانية كما هي، بل تضيف إليها المادة (220) التي تقول إن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة»، وتنصب هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعية إلزامية في تفسير الشريعة الإسلامية (المادة 4).. لتتحول مصر بذلك إلى دولة دينية بامتياز، ويحذر د. محمد نور فرحات من النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل «.. المصادر المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، قائلا إن «تعبير أهل السنة والجماعة لم يظهر على ساحة الفقه الإسلامي إلا في العصر العباسي المتأخر عندما اشتد الخلاف بين الفرق الإسلامية، فظهر هؤلاء بزعم أنهم يمثلون الفرقة الناجية ويأخذون بكل ما وردت به مصادر الشريعة قطعية أو ظنية الثبوت والدلالة ويعملون عمل أهل السلف، بل يأخذون بالأحاديث الضعيفة وأحاديث الآحاد، والمطلوب منا وفقاً لهذه المادة أن ننسف اليقين القانوني نسفاً وتدخل النظام القانوني المصري في سراديب التاريخ القديم باعتبارها سراديب مقدسة لا يمكن الحيدة عنها»، ويتساءل «من الذي سيفسر المقصود بأحكام الشريعة ومن الذي سيختار بينها، هل هم المجددون أم المقلدون؟ هل هم فقهاء القانون أم أتباع السلف الصالح؟»
ويضيف د. إبراهيم العيسوي أن تعريف مبادئ الشريعة الوارد في المادة 220 يتعارض مع حقيقة أن في الإسلام تعددية في المذاهب والفرق والشيع، وأنه يستتبع هذه التعددية بالضرورة تعدد في الأحكام والاجتهادات بشأن أمور شتى «وهذا ما دعا د. السنهوري «عبدالرازق السنهوري» والمحكمة الدستورية إلى تعريف مبادئ الشريعة بأنها المبادئ الكلية التي لا تختلف من مذهب فقهي إلى آخر والتي تتصف بأنها قطعية الثبوت والدلالة وبأنها لا تتصادم مع روح العصر»، لينتهي إلى أن المواد المقترحة تقدم «تعريف ضيق وإقصائي» لمبادئ الشريعة الإسلامية، وأن اعتماد الأزهر كمرجعية إلزامية يثير شبهة «ولاية الفقيه» على التشريع.
ويزداد الأمر خطورة عندما تفرض مسودة الدستور في المواد 9 و10 و11 نوعا من الأحادية الثقافية، وهو ما دفع عمرو موسى وعدداً من ممثلي التيار المدني في الجمعية التأسيسية للقول في مذكرتهم للجمعية «إن هذه المواد مجتمعة تثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم، إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه».
ويصل د. محمد نور فرحات إلى نتيجة مهمة وحاسمة، وهي عدم جواز النص في الدستور كوثيقة قانونية كبرى تحكم الحاضر والمستقبل البعيد على الهوية بما يؤدي لإكساب الدستور طابعا عقائديا دينيا كان أو دنيويا.. «إن النص الدستوري على الهوية أمر غير لازم وغير مطلوب في الدساتير الرشيدة.. فالهوية تمارس ولا تفرض بسيف القانون والدستور.. إن الطابع العقائدي للدستور، أي تبني الدستور أيديولوجية مهيمنة أيا كان مضمونها من شأنه تحقيق نتائج تتنافى مع فكرة العمران الاجتماعي في الصميم: أولها إقصاء أصحاب العقائد الأخرى من الحماية الدستورية، وثانيا تقييد الحريات العامة بحيث لا تتعارض مع التفسيرات العقائدية لأهل الحكم، وثالثا الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون بين أصحاب العقائد المختلفة، ورابعا فتح الباب واسعا أمام الاستبداد وتجنب نقد الحكام ومعارضتهم باعتباره نقدا ومعارضة للعقيدة التي تبناها الدستور، وتلك هي النتائج العملية التي أسفرت عنها فعلا جميع تطبيقات الدساتير العقائدية».
ويشير د. نور إلى أن دساتير الدول الديمقراطية مثل الهند والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا تخلو من أية نصوص عن «هوية الدولة» و«مقومات المجتمع».
بينما دساتير البلاد غير الديمقراطية سواء كانت دولا شمولية مدنية أو دولا شمولية دينية، تتحمل نصوصا تجبر المجتمع قسرا على اعتناق نسق فكري رسمي واحد لا يسمح بالخروج عليه، لا فرق في ذلك بين دستور الاتحاد السوفيتي «السابق» حيث نصت مادته السادسة على قيادة الحزب الشيوعي وهيمنة الماركسية اللينينية، ودستور سوريا في المادة الثامنة التي تتحدث عن قيادة حزب البعث وفقا لأهداف الاشتراكية العربية ودستور العراق «في عهد صدام» والكتاب الأخضر في ليبيا، ودستور إيران الذي ينص في المادة الثانية على أن نظام الجمهورية يستند إلى الإيمان بالإله الواحد وسيادته وحقه في التشريع وضرورة الخضوع لتعاليمه وإلى الآيات المقدسة وإلى الرجوع إلى الله في الآخرة، ودستور المملكة العربية السعودية حيث تنص المادة السابعة على أن يستمد الحكم سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وتنص المادة السادسة على أن يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، والمادة 23 التي تنص على أن تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
* كاتب وسياسي مصري