حاوره/ علاء المفرجي
الروائي والكاتب الصحفي العراقي، جمال حسين علي، ولد في العراق - مدينة البصرة. وحصل على دكتوراه في الفيزياء والرياضيات من جامعة موسكو (1993). له أربع روايات منشورة أحدثها (مقاصب الحياة) التي صدرت أخيرا عن المدى، كما أصدر ثلاث مجموعات قصصية وكتباً مؤلفة ومترجمة في الأدب والريبورتاج الصحفي والسياسة. عمل في العديد من الصحف العالمية والعربية. حصل على جوائز في القصة والمسرح والصحافة.
صدرت الرواية الأولى لجمال حسين علي صيف في الجنوب عام 1983، وأتبعها - في فترة الثمانينات- بنشر روايتين هما الفنارات و التوأم، وفي عام 2018 تم إعادة نشر الروايات الثلاث عن دار السلاسل في الكويت تحت عنوان الذاكرة العراقية (ثلاثية روائية). ولجمال حسين علي أيضا ثلاث مجموعات للقصص القصيرة هي: ظل متبخر و الضريح الحي و التويجات.
صدر لجمال حسين علي في الأدب الوثائقي اعتماد على عمله كمراسل حربي، مجموعة من الكتب هي: قمحة النار-نساء في ليالي الحروب، افتتاح ثقب الإبرة عن تجربته في تغطية حرب أفغانستان، و نهوض الجحيم عن تجربته في تغطية حرب الشيشان، و مذبح الأزهار عن تجربته في تغطية حرب كردستان، و شبابيك الأئمة عن تجربته في تغطية حرب العراق، و عنفوان المجرة عن تجربته في الأهوار. يعمل جمال حسين علي حاليا في صحيفة القبس الكويتية. وقد عمل قبلها في مؤسسات إعلامية عربية ودولية منها موسكو تايمز، جريدة البيان الإماراتية، ونشرت ريبورتاجاته الحربية في جريدة الخليج الإماراتية والزمان اللندية وبعض الصحف الروسية، كما عمل محللا للشؤون الروسية في قناة الجزيرة الإخبارية، ومحللا للشؤون العراقية في قناة أوربيت.
اصدر ما يقرب من خمسة وعشرين كتابا، واربع روايات منها: حبة بغداد، رسائل أمارجي، وأموات بغداد، الذاكرة العراقية، كما اصدر: التويجات (قصص قصيرة)، الضريح الحيّ (قصص قصيرة)، ظل متبخّر (قصص قصيرة)وفي مجال الترجمة اصدر: الكرملين وأزمة الكويت - الكسندر بيلونوغوف، والصحوة الإسلامية في روسيا المعاصرة - ألكسي ملاشينكو، والقادة السبعة - ديمتري فولكاغونوف.
حدثنا عن البدايات في الطفولة والنشأة الأولى، ما هي المصادر والمراجع (المكان، والحيوات) التي نمت لديك حرفة الأدب وانت بهذا التخصص العلمي الكبير؟
- أدركت منذ الصِبا أن حياتي تغيّرت مع ارتباطي بالأدب. ومنذ سنواتي المبكرة، اعتبرته رحلة استكشافية إلى العالم. بينما بدأت حياتي الأدبية، عندما لا زلت صغيرًا جدًا لفهمها. فالطفولة كانت سعادة وعفوية، والمراهقة كانت حبّ، والباقي أدب… لكن متى حدث الأدب؟
لا يمكن العثور على الإجابة، فقد تراكمت عدة حقائق غير محسوسة حددها التغيير الجذري. ربما بعض الحقائق الواضحة جدًا التي لم أحسب نطاقها، لكنها لا تجد الإجابة على "متى"، على وجه التحديد. ففي تلك الأوقات المبكرة من عمر المرء، مجرد معرفتك لموهبتك، موهبة بحدّ ذاتها.
في البداية كتبت، ليس لكي أقول أشياء كبيرة أو جيدة، بل لأشغل نفسي وأرى أحلامي مكتوبة، ولم يكن طموحي في ذلك الوقت أن أكون كاتبًا، بل كانت طريقة أجيدها لكي أبقى وحيدًا قدر الإمكان.
لن أسرد قصتي، بل سأتحدث عن تجاربها وقِيَمها، فهي كقصة ليست ممتعة، على الرغم من تناغمها مثل العديد من القصص المختلَقَة؛ لها طعم المغامرة والجسارة والحماقة والحيرة، وبالطبع الجنون والحلم، بدأت الأدب والعلم في البحث، كطريقة أساسية للتعلّم، لذلك كوّنت فكرتي عن الناس والكون والفضاء والتاريخ بشقّ النفس وبشكل ذاتي. استمتعت بالكتب والقراءة والدراسة، ومن هذه الناحية، قد لا تكون قصتي مشوقة أو مُخترَعة، بل هي وليدة طموحات طفل وأحلام شاب وأمنيات رجل ربما لم يحقق انتصارات ملحوظة، غير إنه تجنّب هزائم حتمية.. لأن من الصعوبة هزيمة شخص اختار الصعود دائمًا.
لا أحب الإجازة، ولا أحتاج إلى عطلة. منذ أن كنت تلميذًا، أقرأ في العطلة أكثر. وأعتقد لو أتقاعد سأعمل أكثر أيضًا. ليس هناك ما هو أخطر من الملل والفراغ. لقد وجدت منذ طفولتي شيئًا أكرّس له وقتي وقلبي وروحي، وهو ما يلهمني ويعطي لحياتي معنى، وهذا مصدر ثرائي الذي لا تعادله أموال الدنيا.
منذ البداية، كانت الكلمات أكثر واقعية بالنسبة لي من الحياة الواقعية، وبالتأكيد أكثر إثارة للاهتمام.. ونظرًا لظروفنا الصعبة في الصِبا، فكلّ واحد له طريقته في الخروج من العالم السفلي. ففعلت ذلك عن طريق الكتابة.
قبل ان تغادر العراق للدراسة في موسكو في بداية الثمانينيات، كانت لك حصيلة من الابداع بثلاثة روايات وثلاثة مجاميع قصصية، انخرطت بعدها بالدراسة الصعبة (هل كانت خيارك من البدء) وبعدها تضاءل نشاطك الادبي.. هل أدخرت سنوات الانقطاع النسبي عن الأدب، للانطلاق بقوة فيما بعد الى عالمه؟ - في مرحلة الدراسات العليا والمتقدمة وخاصة في كلية الفيزياء في جامعة موسكو، التي كان فيها ما لا يقل عن 17 أستاذًا مرشحين لنوبل في الفيزياء، وكما قال لي رئيس قسمي البروفيسور ألكسي براندت: حينما تعود إلى أهلك، أخبرهم أنك درست في كلية قدّمت 20% من الفيزياء للبشرية.
كان هذا التحدي الكبير الذي واجهته. وبالرغم من أني الأول على دفعتي ومن المتفوقين في جامعة البصرة، ودرّست فيها فيما بعد، إلا أني شعرت منذ المحاضرة الأولى في كلية الفيزياء بجامعة موسكو، إن الأستاذ قال كلّ الفيزياء التي تعلمتها بثلاثين سنة في غضون ثلاثين دقيقة. وهنا كان عليّ البدء من الصفر. وهذه البدايات تتطلّب الحفر والاكتشاف وسهر الليالي والوقت والمناخ الصعب في موسكو والمعيشة المرهقة في السكن الطلابي التي تشبه معسكرات الاتحاد السوفيتي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حيث كان البلد في حالة جمود وعلى حافة المجاعة تقريبًا، في السنوات الأخيرة من البيريسترويكا، وهذه الظروف مجتمعة، زادت من صعوبة الحياة على شخص انتقل بالكامل إلى أجواء وثقافة أخرى.
تاليًا كنت أتعلّم وأتدرب وأعمل نحو 17 ساعة في اليوم، لأكثر من أربع سنوات متتالية، لغاية ما بدأت التقط الأنفاس أثناء كتابة أطروحتي. وبالتوازي مع الفيزياء قرأت الأدب الروسي بلغته الأم لكبار الكتاب الذين أحبهم، وتعرفت على تشيخوف وديستويفسكي وتولستوي ونيكولاي غوغول وليرمنتوف وتورغينيف بلغتهم، وكم كان الفارق كبيرًا، وبالأخص بالنسبة للغة تشيخوف وديستويفسكي التي سحرتني بالروسية. وبالاضافة إليهم كنت أتابع الأدب المعاصر وما ينشر يوميًا واشتركت مع كل المجلات والصحف الأدبية الروسية التي كانت قوية للغاية في الحقل الأدبي والفني والثقافي عمومًا.
ماذا علّمتك الحياة الأكاديمية في كلية عريقة كالفيزياء في موسكو؟ - علّمتني الحياة الأكاديمية أن الذكاء وحده لا يكفي في العلوم، ما لم يصاحبه التركيز على حقل معين والقفزات الكبرى لا تحققها كثرة القراءة، بل التفكير خارج المألوف وتطوير الخيال والقليل من المغامرة.
مع بواكير دخول الكمبيوتر إلى الجامعات، (بالمناسبة الكمبيوترات التي تساعدنا في التجارب، كنا نصنعها بأنفسنا).. لم يكن على مكتب أستاذنا سيرغي كابيتسا غير الكتب والأوراق والدوريات.
قال لنا مرة: "الكمبيوتر لن يجلب لكم العِلم".. وأوضح: "الإفراط في المعلومات يؤدي إلى إفقار روحكم البحثية"، هذه الجملة قالها عالم أبن عالم وقد يحتاج أن يتأملها أيّ طالب عِلم.
قال لي مرة: ستتعلم في كل الأحوال، فلا تنشغل بأمور بائسة، مثل محاسبة الضمير في كل خطوة! وأن أكون أستاذك لا يعني أعلّمك أو أعيقك عن التعلّم.
بعد يوم فهمت.. أستاذك تعني: أعمل وأتعلّم معك.
أتذكّر في تلك الأوقات وفي السنة الأولى للماجستير عشت في غرفة مساحتها 8 أمتار مربعة.. ومع ذلك، كانت لديّ مكتبة جيّدة.
وباستثناء مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) التي اعتمدت فيها على نفسي بالكامل بالتعليم والتدريب، لا أتذكر أن النظام التعليمي (في المدرسة والجامعة) أفادني بشيء أو نقلني من مستوى إلى أعلى. ولم أترك له المجال ليدمّرني كما فعل مع البعض. لأني آمنت دائمًا بالتعليم الذاتي.
تقول الروائية لطفية الدليمي انك دخلت الأدب من بوابة الفيزياء، وأقول أنا: أنك دخلته من باب الصحافة، بوصفها وسيطا اقرب من الفيزياء الرياضيات الى الأدب… ماذا ترى أنت؟ - يقولون أني متعدد الاهتمامات، من الفيزياء شرقًا إلى الأدب غربًا ومن الصحافة شمالاً إلى الفنّ جنوبًا، هذا صحيح.. إلا أنه قليل أيضًا، فمن وجهة نظري، أن على المرء أن يهتم بكلّ شيء في الحياة. وسيبقى موطني العلم، ومسقط رأسي مدينة الأدب، فأنا معجون من الآداب والفنون والعلوم وبعض الخمائر والتوابل الأخرى. في عملية البحث الوجودية الأزلية، أعتقد أن الآداب والفنون، اقتربت لفهم "معنى الحياة"، أسرع وأعمق من زميلاتها: الفلسفة وعلم النفس وباقي العلوم المتعلقة بالإنسان.
ليس لدي اهتمامات أدبية فحسب؛ بل أنا مخلوق من الأدب. حتى عندما كتبت أطروحة الدكتوراه في الفيزياء، كان أفضل ما فيها الصفحات الـ 120 الأولى، وهي "الاستعراض" الأدبي - الفلسفي للموضوع. ولهذا السبب كتبت كلّ الأنواع الأدبية ليس لأني أحبّ الأدب بل لأني لا شيء آخر ولا أستطيع أن أكون أيّ شيء آخر.
لقد كنت وما زلت طالبًا، لكني لم أعد استجوب النجوم والكتب؛ فقد بدأت في الاستماع إلى وساوس دمي. ومع كلّ ما زجّته الفيزياء من شكوك في دماغي، إلا إنها لم تؤثر على رغبتي في استلطاف الحياة.
كنت وفيًا للفيزياء كدراسة وعمل، ولكني اخترت الأدب كمكان صالح للعيش لقضاء الحياة التي أعيشها جماليًا، مستغلاً كلّ لحظة. ولعلّ علاقتي مع الأدب، هي الأكثر إخلاصًا، فلم يكن لدي طموح في أن أصبح كاتبًا، بل طريقة في أن أكون وحدي.
عندما كنت أراقب أشعة الشمس وهي تخترق نافذتنا المظللّة بسعف النخيل، أتابع ذرات الغبار وهي تسبح في الضوء، وأعيد رسمها في خيالي صورةً مكثفة للكون. كانت هذه علاقتي الأولى بالفيزياء والأدب، الضوء المار عبر النافذة، وهو ما حاولت إنشاءه في كلّ كتبي اللاحقة.
لماذا إذا تعرّف نفسك كفيزياوي وروائيّ؟ - هو تعريف إجرائي للعلم بالشيء، ولكنه ليس نهائيًا. فقد لا أكون لا هذا ولا ذاك، لقد اشتغلت بهذه المجالات فحسب. ولعلّ معرفتي المبكرة في الفيزياء، صَمَدت مثل نبات بريّ، وقاسمتني قطرة المطر مع الأيام. وبذلك حرصت على أن أنمو معتمدًا على نفسي، لغاية ما أبصر النور وأتذوق طعم الحياة وأرى الوجه المزهر من الزمن. ومع مرور الأيام وتعطّل الكثير من خلايا الذاكرة وانتعاش عجلات النسيان شيئًا فشيئًا، استطعت خلق ذاكرة رصينة وعميقة وربما حكيمة بعض الشيء، لنفسي لكي أقضي بها ما تبقّى لي من أيام.
لماذا لا تثق بالتصنيف؟ - لأنه: غير دقيق، يضعك في منظومة ويحدّدك داخل إطار فيما الموهبة بلا حدود. ربما لأني أشعر بالحاجة إلى أن أكون "حقيقيًا، لم أستطع تحمّل الجو الأكاديمي لفترة طويلة، كما حملت الأدب معي طوال حياتي. وأعتقد أن الأديب يفضلّ تعلّم الأشياء، بينما الفيزيائي، يجرّبها.
أصدرت للآن ثمان روايات منذ روايتك الأولى الصادرة عام 1983 والتي وضعت خطواتك الأولى في مسرة الرواية. وخلال إصدار هذه الروايات اصدرت العديد من الكتب المتنوعة، لتسلط الضوء على الوجه الآخر في اهتماماتك عدا السرد، لتكشف باعا طويلا فى الثقافة والعمل الصحفي، من خلال ثقافة موسوعية، وكأنك تضعها في خدمة المتلقي الذي ينشد الثقافة. مارأيك؟ - نظرتي إلى الأدب شمولية، ولم أحصرها بنمط واحد. لذلك كتبت في الأدب الوثائقي وأصدرت كتابي "قمحة النار" و نصوص عالمية مترجمة مثل "بريد العظماء"، ونصوص خاصة مثل "كتاب الناس والعالم" و "فالق الآلام" وغيرها وقد بلغت اصداراتي أكثر من 40 كتابًا معظمها تأليف وبعضها مترجم. لا أسميها "ثقافة موسوعية"، بقدر ما هي اهتمامات متنوعة. وفي اليوم الذي أنجز فيه كتاب، أبدأ فورًا بالكتاب الجديد ولا أفكر أبدًا في الأشياء التي فعلتها؛ أفكر فقط بالأشياء التي أريد أن أفعلها وتلك التي لم أفعلها بعد.
البعض ينصحوني بالراحة أو النوم، حينما يروني أكتب بأوقات يرتاح فيها الناس. من اللطف منهم مراعاة صحتي.. وخشيتهم أن الكتابة تتعبني. ولكن لماذا استبعدوا أن وضعي سيء أصلاً والكتابة تجعلني أتحسّن؟ لقد عشت لأقرأ وأكتب، فلا يمكن أن أنقضّ على المشاعر الشديدة إلا عن طريق الكتابة، وهي التي تجعل روحي حرّة.
اذا سلمنا بوجود الكره، فلماذا يكره المثقفون بعضهم، برأيك؟ او لنقل ما الدرس توصلت اليه او أردت أن تقوله في هذا الكتاب؟ - هذا السؤال يحيلنا أكثر إلى علم الاجتماع. وطرح أسئلة على شاكلة: لماذا انتشرت "ثقافة الإقصاء" على نطاق واسع بين المثقفين، حتى في غضون مناقشة قضايا بسيطة؟ كيف سيضع الاجتماعيون الجدد نظرياتهم لبناء العلاقات الاجتماعية، وكيف ولماذا استُبْعِدت مجموعات وأفراد معينين من تفاعلات ومساحات اجتماعية معينة؟ ولماذا ساهم المثقفون أنفسهم في نشر "ثقافة الإقصاء"، بدلًا من المساعدة في تعزيز التّواصل ما بين الأسرة البشريّة والمجتمع الكوني؟
المثقفون لا يحبّون الذي في مستواهم والأعلى منهم. وقد يتغاضون عن الأدنى منهم. وهُم سادة "ذر الرماد في العيون"، وأستاذة التّظاهر بالمساعدة، و"الشّللية" والانتقاء و"المعايير المزدوجة"، ويملكون حصريًا ابتكار "عبادة الفرد" قبل السّاسة… هُم أول من صنع الأصنام التي يأكلونها.
ما يسمون بـ "المثقفين"، لا يرحمون خصومهم بأيّة زلّة أو خدش للديمقراطية، لكن عيونهم تعمى إزاء الجرائم الكبرى التي يرتكبها أنصارهم العقائديون وحتى الطائفيون، سيكون المجرم اليساري والبروليتاري والقومي والمذهبي والقبلي… على حقّ، بل جرائمه مقدّسة، ما دامت تنسجم مع أهواء "المثقف" وميوله.
المثقفون ليس فقط لا يرحمون خصومهم، بل لا يقبلوا حتى بهدنة في حروبهم. فالتاريخ اثبت أن حروبهم استمرت لغاية وفاتهم، حتى مع أصدقاء لطفاء مثل سارتر وكامو وتولستوي وتورغينيف وماركيز و يوسا وفان كوخ وغوغان وهمنغواي وباسوس ومن ثم مع صديقه سكوت فيتزجيرالد، وخصومة همنغواي وفوكنر وعشرات، إن لم نقل مئات غيرهم.
ما سبب كل ذلك برأيك؟ - يحبّ هذا النوع من المثقفين أن يبقون مركزًا لاهتمام الناس، أكثر مما يهتمون بتطوير مواهبهم الطبيعية والفطرية، وترك المواهب النقية هي التي تؤثر على الناس تلقائيًا، وليس أساليب الدعاية وباقي المواقف التي يتميز بها الأشخاص ذوي السمات السيكوباتية الواضحة، الذين يفقدون السيطرة على أنفسهم حينما يرون أحدهم تقدم عليهم في نسبة المبيعات أو فاز بجائزة، فسرعان ما يكون ردّ فعلهم سيئًا وسريعًا وعدوانيًا مباشرًا، خال من الكياسة والوقار في الكثير من الأحيان.
وهناك أيضًا بعض العلامات السلوكية التي تميز "الثالوث المظلم" والذي يميز شخصية هؤلاء بثلاث سمات: النرجسية، والميكافيلية، والاعتلال النفسي. ومعظم المثقفين واقعون في هذا الثالوث. وبسبب هذا الثالوث المريع يميل هؤلاء إلى الكذب والتلاعب والخيانة المتكررة وزيادة مستوى الغيرة الوقائية عندما تكون السلطة بأيديهم يمنعون المنافسين الاتصال بالآخرين. مثلاً، إذا أصبحوا مسؤولين عن قطاع الثقافة، يهملون منافسيهم ولا يدعونهم إلى النشاطات.. وفي حالة إشرافهم على مطبوعات أو دور نشر، لا ينشرون لمن يغارون منهم أو ينظرون إليهم كمنافسين بمستوى أعلى منهم، بل يدعون وينشرون للأدنى منهم فقط، بحجة احتضان المواهب الصاعدة، وهذا الشيء يشبه إلى حدّ كبير غسيل الأموال القذرة بالتبرع في مشاريع خيرية لذرّ الرماد في العيون. فالمثقف النرجسي مستحيل يحتضن مواهب كبيرة تنافسه، هو يفعلها مع الأدنى منه والأقلّ موهبة فقط.
هل توضح لنا ماذا تقصد بسادة "ذر الرماد في العيون"، وأستاذة التّظاهر بالمساعدة، و"الشّللية" والانتقاء و"المعايير المزدوجة"؟ - المثقفون المصلحيون لديهم مهارة كافية في الكذب من أجل مصلحتهم الخاصة. ويبررون الكذب بمعاذير واهية، وفي الحقيقة كذبهم يعبّر عن خوفهم من الآخرين الأفضل وأكثر رصانة وموهبة منهم، مثل هذه الحقائق تسبب لهم الكثير من الألم وخاصة الذين يعانون من سمات سيكوباتية ميئوس منها، لذلك تراهم يكذبون ويدّعون حتى عندما لا يوجد سبب على الإطلاق لذلك.
لذلك العلاقة مع هؤلاء سواء كانت زمالة أو صداقة، وحتى زواج، تكون علاقة سامّة. تنخفض فيها مستويات التعاطف لديهم لغاية فقدان الأحاسيس السويّة، لذلك تراهم يجنحون للسلوك العدواني والتنمّر والسخرية من الآخرين سواء على شبكة الإنترنت أو في الحياة الحقيقية.
وماذا عن المثقف الآخر الذي لا يحمل هذه الصفات؟ - إنهم نادرون للأسف، وتعرضوا للاقصاء والتهميش مع كلّ الأنظمة. وما أن يبدأ المثقفون الشرفاء في التعبير عن آرائهم، سيواجههم مثقفون مثلهم في الممارسات الاقصائية التي تصل إلى تصفيتهم الجسدية أو الثقافية. لذلك يضطر غالبية المثقفين إلى عدم الانخراط في نشاطات وحركات يعتبرها النظام معادية. إن أفعال المسؤولين عن الثقافة في الدول غير الديمقراطية، تشعرنا بالخجل، وخاصة تخاذلهم من نصرة زملائهم المثقفين المعتقلين من دون توجيه تهمة، لأن اعتقالهم بلا سبب أصلاً، لمجرد عدم طاعتهم وخضوعهم. وعلاوة على ذلك يقومون بالمرحلة التالية بتشويه سمعتهم وتلفيق التهم الباطلة اليهم.
وهكذا سيغوص المثقفون وأشباههم في المنظومة التي تتحكّم في كلّ شيء، ولا يستطيعون الفكاك منها، وسيكونون نجوم المهرجانات والمعارض والمناسبات والمواسم وكل ما يخطر على بال صنّاع السيرك الكبير.
سيستمر هذا العار لسنوات طويلة وعقود، وسيتعين على المرء أن يتساءل كيف عملت المنظومة على افتراس هؤلاء المثقفون والأكاديميون والاعلاميون والفنانون وكيف تمكنوا من خنق ثقافة التساؤل والمعارضة في بلدانهم؟ وفي الوقت نفسه، فإن المثقفين النقديين القلائل الذين يعبرون عن مخاوفهم لا يظهرون أبدًا في وسائل الإعلام المهيمنة، في حين تقدّم السلطة أشباه المثقفين، كمثقفيها الأبطال. وسيتم مسح المثقفين البارزين من وسائل الإعلام ويحذفون من المناهج الدراسية. هكذا يتم افتراس المثقفون الحقيقيون ويتم تحويلهم إلى فئة ثانوية وعاجزة عن العمل الفكري والإبداعي، ويترتب انسحابهم من المجتمع، وعدم السعي لقول الحقيقة من أحد.
تقول عن كتابك (بريد العظماء): "إنها ليست مقتطفات، ولا هي اقتباسات، إنها نتاج انصهار تام وهارمونيا تلقفتها من أولئك الذين جعلوا حياتنا أفضل وأجمل".. باعتبار الكتاب يجمع مختارات وفيرة وطائفة ضخمة من الأقوال والعبارات والفقرات الأدبية من نصوص عالمية لأشهر الكتاب والروائيين والقصاصين في العالم… ما الذي تراه يختلف عن كتب كثيرة من هذا النوع؟ - هذا النوع من الأدب اشتهر لدى العرب القدماء، مثل "الأغاني" للأصفهاني و"مجمع الأمثال" للمدياني ومجالس "الأمالي" للقالي و " كنز الدرر وجامع الغرر" للدواداري و"الكشكول" للعاملي الهمذاني و " المستطرف في كل فن مستظرف" للأبشيهي.. وعشرات من الكتب التي جمعها العرب القدامى، ولا تزال تحافظ على أهميتها، لتبويبها وتصنيفها وتوثيقها الرصين والدقيق. ففي العودة إلى الآخرين، قد نستشهد بتعبير أفضل مما نستطيعه، ونعيد إنتاج المقاطع التي حفظها الزمن ومنحنا حصتنا منها، ما يجعل الأدب يتنفس عبر العصور عن طريق الترجمات المختلفة والبارعة. فهي ليست مجرد اقوال أو أمثال أو حكم ومواعظ، بل طريقة جديدة لفهم الحياة من أناس عبّروا عن الأمر أفضل منا.
رواياتك هي سير أمكنة فضلا عن كونها سيرا سردية لأشخاص.. كيف تتعامل مع مثل هذه العناصر في أعمالك؟ - كلما أكتب رواية جديدة، اعتبرها مسقط رأسي الحقيقي، وأماكنها هي الأمكنة التي أراها للمرة الأولى ونحاول أن نتعرّف على بعضنا بطريقة مهذبة ومفيدة، لكي نتآلف مع بعضنا بذكاء. لقد كانت رواياتي أوطاني البديلة.
وعندما أحلّق، أرى سنوات الحرب التي أخذت شبابنا تظهر عيني في المرآة. كيف يريدوننا أن نكتب عن أيّ شيء آخر؟ وكنت أفضّل كتابة النصوص التي تتطرق إلى المواضيع التي تجاهلها الجميع. فمن واجب المبدع أن يسمو ويتعالى ليفكر خارج حدود الفكر المسموح. ومن ثم يتجرأ ليقول أشياء لا يستطيع قولها الآخرون. وليس من واجب المبدع كتابة ما يريد الناس سماعه أو قراءته أو ما يتوقّعونه منه، مع الرغم أنه متشابك مع الحياة أيضًا، فهناك العديد من الواقعيين والمنطقيين ما يكفي، لكن المتلقيّ الجيّد يدرك الفارق ما بين الحقيقي والمُصطنع.
لم أبحث عن الصور وأركّب الأحداث وأمضي في صناعة الشخصيات، وبالرغم من أن هذه العناصر أساسية في البناء الروائي، إلا أني كنت أبحث عن شيء آخر، وهو دمج أكبر قدر ممكن من الآمال والآلام الإنسانية في رواياتي.





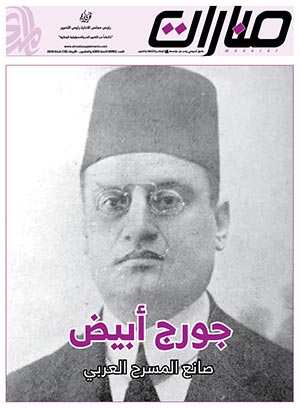
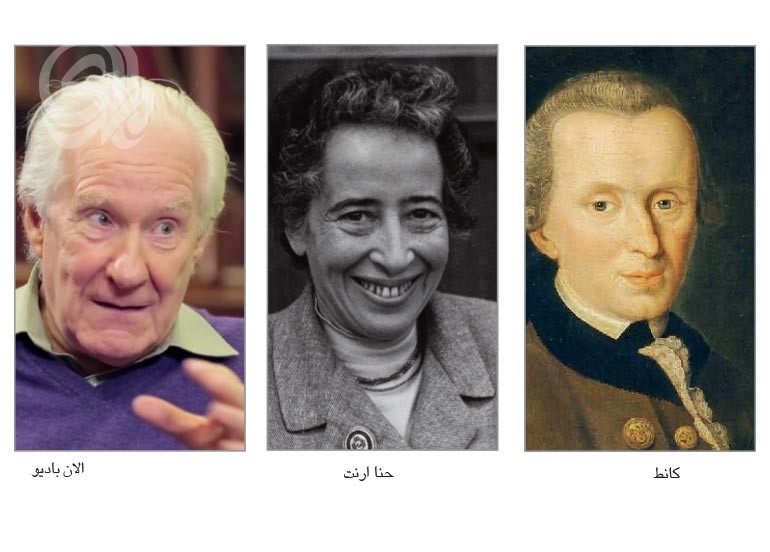
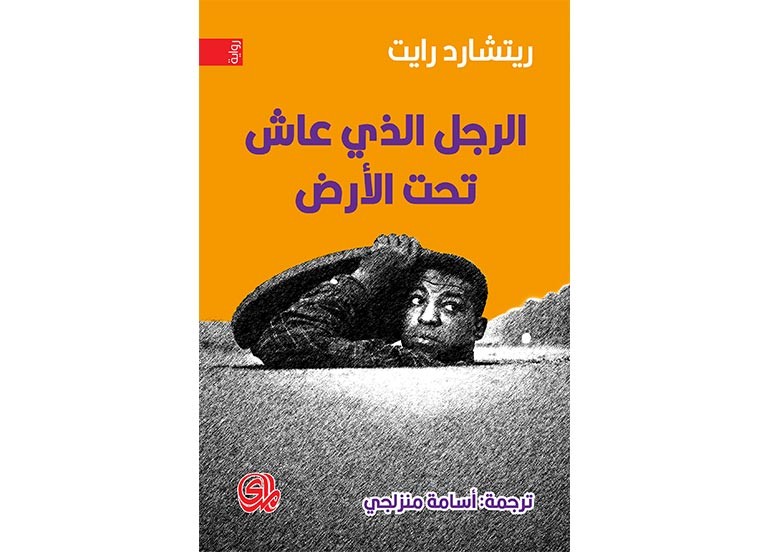
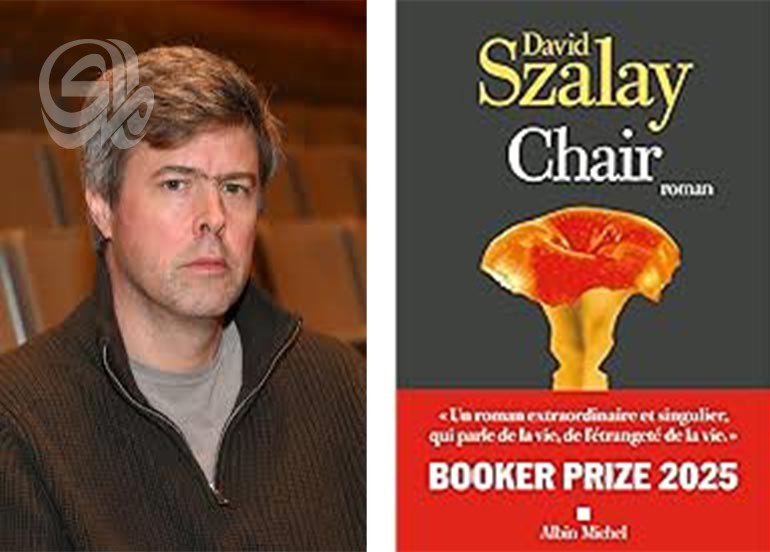


جميع التعليقات 1
سناء الخالدي
منذ 12 شهور
مهتمة