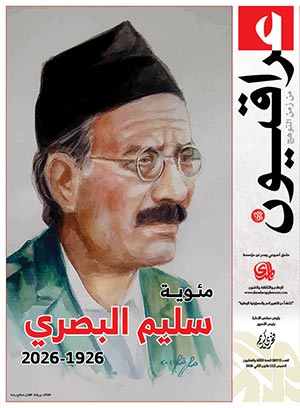علي المدن
سأتخطى النقاشات التقليدية التي يُبتدأ بها هذا الموضوع، فهي في تقديري لم تعد مجدية.
إن موضوع النقاش اليوم ليس عن مرونة الفقه وكفاءة الفقيه في عملية الجمع بين الأدلة والاستنباط منها، هذا تصور قديم لمفهوم الفقاهة. موضوع النقاش اليوم هو حول كشف (ما هو تاريخي) في (ما هو ديني)، أي بيان ما هو (تطبيقي زمني) من الإسلام كدين، وهذا هو معنى الفقاهة.
يبدأ التحدي من فهم أن جميع الأفكار في العالم، وعلى مر التاريخ، وفي جميع الفلسفات، الدينية وغير الدينية، هي عبارة عن استجابة لحاجات الإنسان في تنظيم حياته، الفردية والاجتماعية. وإن تلك الحاجات الإنسانية في تطور مستمر، سواء أكان هذا التطور بسبب تفكيره المستقل في ذاته البشرية، وما لها من حقوق أو ما عليها من واجبات، أو بسبب تطور حياته المادية التي تخلق أوضاعا جديدة تفرض عليه إعادة ترسيم هذه الحقوق والواجبات في علاقاته الاجتماعية مع الآخرين.
هذا التحدي يواجه الأديان أيضا، لذا يكون معنى فقه الدين، أي فهمه، بغض النظر عن رأينا بصدق الدين وعدمه، أو صحة “الوحي” من عدمها، هو التحقق من أهليته الزمنية وكفاءته المعاصرة. والسؤال لا يكون عن ثبات صلاحية الأديان وعدم ثباتها اليوم، بل عن نفاد الصلاحية وعدهما، بمعنى أن السؤال يكون دائما ليس عن قابلية التحقق بل عن قابلية النفي. وبتعبير آخر: يجب أن لا نسأل عن الحكم الديني هل ما زال نافذ الصلاحية أو لا ؟ فيكون من السهل إدعاء نفاذ الصلاحية وصحة بقاء هذا الحكم، بل يجب أن نسأل هل انتهت صلاحيته أو لا؟ هل هو غير مرتبط بزمنه أو لا ؟ حتى إذا كان الجواب بالايجاب، وادعينا أنه نافذ الصلاحية وعابر لزمنه نكون مطالبين بالبرهنة على هذا الدعوى.
إن هذا التحدي هو ما شعر به الأذكياء من أمثال محمد باقر الصدر، وهذا هو الذي يبرر اهتمامي بتراث هذا الرجل، فإنني أعتقد أن جميع من تأخر عليه من الباحثين الإسلاميين، من داخل المعاهد الديني أو خارجها، قد تأثر باجابته على التحدي المذكور. ولقد كانت مقدمات محمد باقر الصدر واضحة: انطلق من افتراض وجود خالق لهذا العالم، ثم قال إن الصلة بهذا الخالق تعيد ترسيم فهمنا للواقع، سواء البشري والمادي منه. ثم جمع المبررات التاريخية على أن ظهور الدين وما فيه من أفكار كان أكبر من أن يُفسر كمنتج لهذا الواقع الذي ظهر فيه، وإذا كان هو أكبر من واقعه فهذا يعني أنه رباني، وهذا معنى الوحي عند محمد باقر الصدر. وأخيرا دخل في عملية “تكييف” ما ورثه عن هذا الدين من مفاهيم وأفكار وتشريعات مع واقع حاجات الإنسان المعاصر. ولكنه، وبالرغم من حماسه المنقطع النظير، وصدقه الذي لا يشوبه ذرة شك بهذا الدين، واجه حقيقة (التاريخانية، الزمانية) في هذا الدين، فخفّض من اندفاعه، إذ هو ليس كأي فقيه سطحي ركن عقله خارج التاريخ والمعرفة الحديثة يتلذذ بوثوقيته التي لا يكدر صفوها شيء، وأخذ يتحدث عن “الفهم الاجتماعي” للنص والعودة للارتكازات العقلائية، خداع الواقع التطبيقي للإسلام، ندرة الأحكام الفقهية القطعية، غياب اللغة التقنينية للقران، اختلاف مضامين النص القراني وخلوها من الاتساق، اندثار القرائن المضيئة لمعنى النص وضياعها، فقدان النصوص المكملة لفهم الحكم الديني بنحو موثوق، عدم القدرة على الانفلات من الزمن الحاضر واستيعاب النصوص في زمن صدورها … إلى غير ذلك من المشاكل المستعصية على الحل. واخيرا اعترف قائلا: إن الاجتهاد (عملية معقدة، تواجه الشكوك من كل جانب). وكان من نتائج اعترافه الأخير أن بدأ يتحدث عن أحكام دينية ثابتة محدودة بنسبة لا تتجاوز الخمسة في المئة من مجموع الأحكام الفقهية مع “منطقة فراغ” مرنة تمثل الجانب المتطور والمتحول من الأحكام الفقهية تدار من خلال مجموعة من “المؤشرات الإسلامية العامة».
تلك كانت نهاية أكبر المتحمسين لفكرة أن “الإسلام منهج حياة”. وهي نهاية متوقعة من شخص ذكي، وواقعي، مثل محمد باقر الصدر. ولكنها بالتأكيد لن تكون النهاية الوحيدة، فالباب بقي مفتوحا أمام محاولات أخرى ترسم نهايات مختلفة لقصة وعينا بالزمن في تحليل تجربة الإسلام. وهذا هو تحديدا معنى أن يكون الشخص فقيها في عصرنا الحاضر.
لهذا أعيد ما قلته سابقا: الفقاهة اليوم هي كشف (ما هو تاريخي) في (ما هو ديني)، كشف (الزمني) في (ما هو إسلامي).