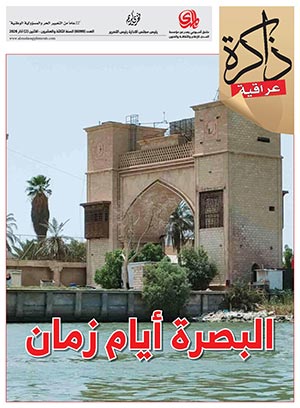إياد العنبر
انتهت أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب في العراق، بعد فراغ في المنصب لأكثر من 10 أشهر، بوصول الدكتور محمود المشهداني إلى كرسي رئاسة البرلمان، والذي بقي مصرا على الحضور بين الشخصيات المتنافسة منذ بداية الدورة الانتخابية الحالية، ولكن كما يقول المثل العربي "من صبر ظفر". وها هو المشهداني يعود رئيسا لمجلس النواب بعد أن قدم استقالة منه في عام 2009، والتي بررها في ذلك الوقت بأنها "للصالح العام"، رغم أن أسبابها كانت بدعوى "توجيه إهانات لأعضاء مجلس النواب".
المشهداني، الحاصل على شهادة البكالوريوس في الطب، ويحسب على تيار الإسلام السياسي، يعد من الجيل الأول، أو هو آخر من تبقى من الرعيل الأول للسياسيين السنّة بعد 2003. ولذلك هو يحسب على "الآباء المؤسسين" لنظام الحكم والدستور العراقي الحالي. وعودته إلى المشهد السياسي بعنوان "رئيس مجلس النواب" ربما يؤشر على بقاء ونفوذ هذا الجيل السياسي في منظومة الحكم، وأيضا رمزية هذا المنصب في العملية السياسية بصورة عامة، وعلى مشهد صراع النفوذ بين القوى السياسية السنية بصورة خاصة.
مفارقة مهمة تجتمع في خطابات الجيل السياسي التقليدي، والذي ينتمي إليه السيد المشهداني، إذ يتفقون على أنهم ساهموا في الخراب والفوضى التي تراكمت على مدى عشرين عاما. فالمشهداني قبل إعادته لمنصب رئيس البرلمان، يصف السياسيين الذين كانوا في المعارضة واستلموا الحكم بعد 2003 بأنهم "مقاولو تفليش". وكذلك السيد نوري المالكي رئيس "ائتلاف دولة القانون"، عندما كان نائب رئيس الجمهورية (2014-2018) يقول: "أنا أعتقد أن هذه الطبقة السياسية، وأنا منها، ينبغي أن لا يكون لها دورٌ في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنها فشلت فشلا ذريعا..". وهادي العامري رئيس كتلة "الفتح" في مؤتمر انتخابي عام 2018 اعترف بالتقصير والعجز بقوله: "إننا قصّرنا بحق شعبنا وعجزنا أن نقدّم له الخدمات المطلوبة والحياة الكريمة… التهينا بالصراعات الداخلية وتركنا شعبنا يتلوع من الجوع والفقر، ولذلك لا بد أن نعترف بذلك، وأنا أول من أعترف بذلك، وأعتذر للشعب عن كل قصور وتقصير..".
وعلى الرغم من هذه الاعترافات الصريحة، التي يتفق عليها سياسيو الجيل التقليدي، فإنهم لا يزالون متمسكين بحضورهم السياسي، ويديرون الصفقات السياسية في تقاسم المناصب العليا في الدولة، ويتحدثون عن نقد الحكومات، رغم مشاركتهم الفاعلة فيها!
من الطبيعي أن تبقى النخب السياسية الحاكمة تقاتل في سبيل البقاء في السلطة! وتبرير ذلك بغياب ركنين أساسيين في العملية السياسية: الأول غياب تام للمحاسبة والمساءلة عن الفساد والخراب والفشل الذي تقرّ وتعترف به قيادات الأحزاب صراحة بمسؤوليتهم ومشاركتهم في وجود كل مظاهر الفوضى التي خلفتها إدارتها للحكم. والثاني غياب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يفترض أن تكون حاضرة بعد مرحلة الاعتراف بالفشل، إذ ماذا يعني اعترافهم بالفشل والتقصير من دون أن يترتب موقف سياسي وأخلاقي عن ذلك الاعتراف!
هكذا هي لعبة السياسة في العراق، سياسة من دون التزامات أخلاقية ولا سياسية، مجرد ثرثرة عجائز وجملة من التناقضات في التصريحات. حيث يرفض الفاعلون في العملية السياسية الاحتكام إلى القوانين والأعراف التي تنظم العلاقة بين السلطة والمجتمع، فرغم خيباتهم وفشلهم يصرون على أنهم يمثلون المكون الطائفي أو القومي! ويعتقدون أن "شرعية" عملهم السياسية لا ترتبط بكيف ينظر إليهم المواطن، أو ما يقدمونه من منجز اقتصادي أو خدمي يخدم المجتمع. إنما ترتبط بنضالهم ومناصبهم و"جهادهم" في معارضة الدكتاتورية، أو رمزيتهم العائلية والدينية. ومن ثم تولّدت لديهم قناعة بأن تصديهم السياسي هو "تكليف شرعي" كما يصرّ على ذلك الإسلاميون، وهي التي تعطيهم الحق في أن يتعالوا على المحاسبة والمساءلة حتى وإن استولوا على المال العام وتعاملوا مع اقتصاد الدولة كغنيمة!
وحتى على مستوى أحزابهم، يبقى الزعيم أو القائد في سدة رئاسة الحزب، من دون أن يُساءل عن إنجازاته في قيادة الحزب ومسؤوليته عن الاخفاقات التي ترافق مسيرته في الانتخابات أو العمل السياسي. ومن مفارقات العمل السياسي في العراق أنّ من يفشل في قيادة الحكومة يتحوّل إلى قائد أو زعيم سياسي! وربما ينشقّ من الحزب الذي رشحه ويشكل تحالفا سياسيا يدخل الانتخابات بقيادته! ويريد أن يعود إلى منصب رئيس الحكومة!
تحالفات متناقضة
خارطة التحالف السياسية في العراق، تشبه كثيرا ظاهرة الكثبان الرملية في الصحراء. إذ تجدها في هذا الجانب، وفي اليوم التالي تجدها في الجانب الآخر، وهكذا هي تحالفات النخب السياسية القديمة والجديدة. فالمشهداني ليس زعيما لتكتل سياسي داخل البرلمان، وإنما ساهم بوصوله إلى منصب رئيس مجلس النواب لهذه الدورة، التحالف بين نوري المالكي زعيم "دولة القانون" ومحمد الحلبوسي رئيس حزب "تقدم"، صاحب الأغلبية داخل القوى السياسية السنية، وتدعم هذا التحالف قوى أخرى داخل "الإطار التنسيقي".
كثيرة هي تناقضات التحالف بين المالكي المحسوب على الجيل السياسي القديم، والحلبوسي الذي يحسب على الجيل السياسي الجديد، والذي شاركت في تقويته أطراف تنتمي إلى الزعامات السياسية الصاعدة مثل الشيخ قيس الخزعلي وبافل طالباني. ومن ثم جاء هذا التحالف الذي يمثل أغلبية الوجوه السياسية الصاعدة بقيادة سياسي ينتمي إلى النخب التقليدية، وهو المالكي!
والمشكلة في هذا التحالف، أنه يأتي في مواجهة تحالف للجيل السياسي الصاعد، والذي يمثله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والنائب سالم العيساوي، وبدعم من الشيخ خميس الخنجر رئيس "تحالف السيادة". إذ كان السوداني يدعم بقوة ترشيح النائب سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب، كخطوة تمهيدية لتحالفات قادمة في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تُجرى في نهاية 2025. والعيساوي كان يمكن أن يكون رقما صعبا في التنافس السياسي السني، في حال تسنمه منصب رئيس مجلس النواب، الذي يعد البوابة نحو الزعامة السياسية السنية.
لذلك، فإن وصول محمود المشهداني إلى كرسي رئاسة البرلمان، يعد نصرا للجيل السياسي التقليدي، الذي استفاد كثيرا من تناقضات النخب السياسية الصاعدة، واستعجالها في فرض نفوذها على العملية السياسية، وتخطيطها لتحالفات مستقبلية. ومن ثم، هذا النصر ليس بفضل تخطيط وخبرة الجيل القديم، وإنما بفضل التناقضات والتقاطعات المصلحية لقيادات القوى السياسية الصاعدة.
المراهقة السياسية
ربما تكون نقطة الالتقاء بين القوى السياسية التقليدية والقوى السياسية الجديدة، هي المراهقة السياسية. إذ إن كلتيهما لا تزال تستخدم الخطابات نفسها التي ترفض مغادرة نظرية المؤامرة، والتخندقات المصلحية التي تقف عند حدود الصفقات وتحقيق المكاسب المؤقتة، من دون أن تتحول إلى رؤية ومشروع موحد يستفيد من حضورهم في السلطة لتوسيع دائرة النفوذ داخل المجتمع.
إذن، تجاهل التحديات وغضّ الطرف عن مطالب الجمهور، هو تعبير عن البقاء ضمن دائرة المراهقة السياسية التي تعتقد أن الزمن لا يتغير، ويمكن مواجهة التحديات بخطابات الاستذكاء والمرور البارد على آلام الناس ومعاناتهم وتقديم الوعود الفارغة. المواطن العراقي يتطلع إلى مواقف سياسية تعطيه الأمل في أنّ الريع النفطي يتم توظيفه في قطاع الخدمات ومعالجة البطالة، وليس لخدمة المافيات السياسية.
المراهقة السياسيّة تتجلى في عدم الثقة والتآمر والرهان على حماسة الخطابات والتعالي على الدولة، وتقزيمها أمام قوى اللادولة. وانعدام معايير عملية يمكن من خلالها تقدير قيمة الإنجاز من عدمه، كفاءة الأداء من فشله، فتلك التي تبدو تفاصيل تقنية صغيرة هي مصدر آلام ومعاناة الكثير من العراقيين، أكثر من تلك التي تبدو قضايا كبرى مصيرية في تفكير الزعامات السياسية وحاشيتها: مثل الحصول على رئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس النواب لاستعادة أمجاد المنصب وتصفية أو إخضاع الخصوم والشركاء لسطوته. أو قضية الحصول على وزارات لتنمية الموارد المالية للحزب أو التكتل السياسي، أو الحصول على رئاسة الجمهورية لكسر إرادة حلفاء الأمس وخصوم اليوم.
العراقي يريد حياة آمنة ومستقرة، ولا يريد أن يدخل في رهانات تعبّر عن مراهقة سياسية تحاول الانتقال من الصفقات والتوافقات في تقاسم مغانم السلطة، إلى فرض ثنائية السلاح والسياسة بهدف السيطرة على الدولة وثروات البلد. أما محاولة ترويض المواطن بعنوان الحفاظ على حق المكون، أو استحقاقه في المناصب العليا في الدولة والسيطرة على مؤسساتها واقتصادها وتحويلها إلى إقطاعيات حزبية وعائلية وعشائرية، فهي تعبر عن فجوة كبيرة بين ما يريده الجمهور وما تسعى إليه زعامات الطبقة السياسية، سواء كانت تقليدية أو جديدة.
العراق بحاجة إلى مشروع سياسي تقوده طبقة سياسية ناضجة، تبدأ أولا بالشروع في نقاش جديد لا يقوم على استغفال الناس ومداعبة غرائزهم الوجدانية، نقاش يتواضع فيه السياسيون الذين يحاولون تقديم أنفسهم باعتبارهم أوصياء على الطائفة أو المكون القومي. وأن يبتعدوا عن المتاجرة بالقضايا الكبرى التي يقدمون أنفسهم مدافعين عنها ومتصدين لمشاريع المؤامرة التي تقف ضدها.