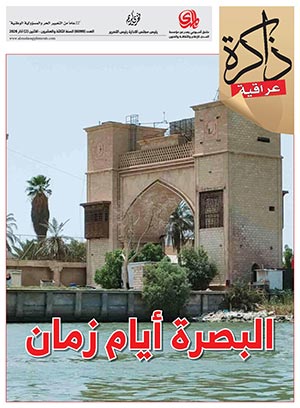زهير الجزائري
أبدأ بالمخيم من حرش الصنوبر، حيث مربط الخيول التي تهيج مع القصف وتدور بين الحرش، الذي تأتي من خلفه رصاصات القنص والقذائف المنثارية، وبين باب الإسطبل الخشبي الذي يحركه القصف. تهيم الخيول مع الناس في أزقة المخيم وهي تضرب الجدران بحوافرها. هنا في هذه البناية التي كانت يتيمة في المخيم ووراء ذاك الباب الذي طلي بالأحمر ولد ابني نصير. تغيّر سياق أيامنا أنا و زوجتي سعاد بعد مولده. صرنا نسهر الليل مع صراخه نبحث عن مواقع الألم في جسده البضّ، وننام معه في النهار. أبحث عن الحارس الصغير الذي أخرج في ليالي الأرق لأشرب الشاي وأدخن معه. ذات يوم دخل علي قاطعاً شريان يده بشفرة حادة بعد حكاية حب فاشلة. ما من أحد يعرفه: هناك عشرات المقاتلين من عمره يحملون هذا الاسم (أبو عرب) … أتابع البيوت التي تنقلت بينها حسب اتجاهات القصف وتغيّر الأعداء: في هذا الزقاق الضيق أعطتني الأرملة (الحاجة) بيتها الذي لا يطاله الرصاص والقذائف، واشترطت علي شرطين: أن لا أرفع عن الجدار صورة زوجها الشهيد. عاش معنا بصورته فترة القصف العشوائي غير آبه بدوي القذائف محدقاً بعيني ذئب في الباب متوقعا عدواً لا يراه. له شاربان امتدّا خارج وجهه النحيل المشدود، بل خارج إطار الصورة.
شرطها الثاني ان لا أمسّ درفة مقفلة من دولاب فيه ملابسه. ستأتينا كل جمعة بعد الصلاة وزيارة المقبرة لتفتح الدولاب و تتشمم ملابسه، و تغادرنا بهدوء بعد أن تودع صورته على الجدار.
بيت آخر سكنته مع طبيب عراقي مشكوك بشهادته أصبح مكتباً عسكرياً، وآخر تحول الى وكالة أنباء.. الأمكنة تعصر قلبي بإنكارها.
الجدران تنزّ دماً وهي تحمل صور الشهداء. تضيق بهم الحيطان فتستبدلهم بصور شهداء جدد. غاب الجدّ الحازم عن وجوه القدامى وصعدت خفّة الروح إلى وجوه الجدد الأصغر عمراً والأقل اعتقاداً. أبحث بينهم عن وجوه أعرفها. أغلبهم من الجيل الثالث الذي رأيته سابقا في أزقة المخيم يتزاحم أمام كامرتي وهو يهش الذباب عن عينيه. زوجتي سعاد تقارن وجهي، بلحيتي الحديثة ووجوههم، وتقول لي بين الفزع والمزاح: -أنت تشبههم!
خارطة المخيم تغيرت أمامي أنا الباحث عن ذلك الشارع الوحيد الذي كانت تروده السيارات. الامتداد الأفقي للبيوت المتقاربة اخترقته عمارات مزدحمة بالمحال والمكاتب التجارية. المخيم توسع أفقياً نحو الأحياء المجاورة. هناك سكنت الطبقة الجديدة التي تريد أن تغادر المخيم وتحتمي به في الوقت نفسه.
لا تزال الأسواق مزدحمة بدكاكين الصفيح والعربات التي تبيع الخضار وتغذي المدينة الشرهة. ولكن في وسطها قفزت فجأة محلات ملابس وعطور وادوات كهربائية وسجاد لا تتناسب مع فقر المخيم المفترض، هي من نثار الوسط التجاري البيروتي الذي أحترق ونهب خلال الحرب الأهلية. معالم لبنان المرفهة اخترقت المخيم: محلات الفليبر والعصير وأغاني فرقة البوني إم إلى جانب مارسيل خليفة وفرقة الميادين. الناس أيضا تغيروا فاستطالت شعور الشبان وضاقت سراويلهم وطريقة مشيتهم، وانعكست صور أبطال الأفلام، خاصة رامبو، على ملابسهم وتسريحة شعرهم وطريقة مشيتهم المتمهلة المتمايلة.
الجيل الثالث
بين المخيم ومقرات المنظمة جيش مبعثر من مقاتلي الجيل الثالث، يحملون الرشاشات المتوسطة وقاذفات الصواريخ قبل أن يشبعوا من لعب الطفولة. هذه اللعبة الدميمة تبدو كأنها خلقت معهم ذراعا للقتل والدفاع. ضاقت بهم جبهة المواجهة في الجنوب، وما عادت تتسع لهم، فازدحموا في هذه الثكنة الضيقة، وأدمنوا حياة المدن والعطالة المستتبة بعد توقف الحرب الأهلية. الحرب أعطتهم المعاني واضحة. في العالم المضطرب يوجد اثنان، أنا وعدوي وجها لوجه، بيننا هذا الخط الذي نريد اجتيازه، والأمر واضح في ذهني، الحق والخير معي، وهناك يتركز الشر والنذالة. وهذا يعطيني الحق في أن أقتل.
مثل سابقه دخل ابن هذا الجيل الحرب طواعية، ولم يكن وحيداً، انما يقاتل ضمن جماعة جاءت طوعاً وانتمت مثله طوعاً لهذه الجماعة التي حلت محل القبيلةً. والحرب بالنسبة لها خيار حياة أو موت، وكل الدمار والآلام التي ترافقها ضرورةً لابد منها، بدونها تصبح الحياة بلا معنى. الحيوية التي تمتلك روح وجسد هذا المقاتل غنية بالمعاني التي تفوق آلام القتال ومصائبه. الجسد نفسه ينسى ذاته وهو يقفز فوق خطوط التماس وينقضّ على العدو. كل يوم أرى الطائرات الإسرائيلية تخطّ سماءنا، وأرى الشبان يقفزون دون تردد إلى كراسي المضادات فترتجّ أجسامهم مع الطلقات، يدورون على كراسيها وأعينهم تتابع لمعة الطائرة… أراهم وهم بعدتهم الكاملة وقد تحفزت كل أجزاء أجسادهم للهجوم و الإنقضاض. الأسلحة بأيديهم تستدعي الفعالية وتستدعي توتر روح أدمنت القتال ولا تعرف عملاً غيره، بل لا تعرف أفقا للسعادة والمستقبل، بعد أن نأت الآمال وأصبحت الأهداف غامضة.
يترقبون أي قتال حتى ولو مع منظمة أخرى، ويذهبون إليه بسرعة تشبه الغياب. هناك مجال موهبتهم الوحيد، حيث الواحد إما قاتل أو قتيل. لا يريدون أن يتساءلوا أو يسألوا عن السبب والجدوى، لأن القتال أصبح هدفاً لذاته ما دام العدو بعيداً عنهم. وقد كنت شاهد قتال عنيف اندلع فجأة بعد زخة رصاص عند أحد الحواجز. لم ينتظر المتقاتلون إيعازا ولا نتيجة لحوار بين القادة، إنما ذهبوا إليه بكل عنفهم المخزون، وبكل ما لديهم من أسلحة متوسطة وثقيلة في مساحة قتال لا تتجاوز الثلاثة كيلومترات مربعة بين بضع بنايات. لم أستطع الهدوء وأنا أتخيل أناساً، بينهم شيوخ وأطفال لم يأكلوا تفاحة الخطيئة مثلنا، يموتون في هذه اللحظة. من الشرفة أرى مزيدا من السيارات المسلحة تحمل صبيانا مدججين بالهاونات والبي سفنات ذاهبة بسرعة إلى ساحة القتال الضيقة لتزيد الجحيم جحيما. مجموعة منهم صعدت بنايتنا لتنصب دوشكا على السطح لتتسلط منه على مكتب المنظمة الثانية. كل تكتيكات قتال الفنادق في الحرب الأهلية استخدمت هنا في هذه الرقعة الضيقة لتطويق مكتب والاستيلاء عليه، فلا بد لواحدة من القبيلتين أن تذلّ الأخرى وتجبرها على التسليم. الخوذ الحديدية الثقيلة مسدلة على وجوه لم تنبت شواربها بعد، والصدور مدججة بالرصاص وعلى الظهر قاذفات الصواريخ. مع هذه الهيئات من الصعب تلمس مصادر رقتهم وإنسانيتهم التي توارت خلف هذا العنف الذي تحول إلى غريزة وإدمان. فالتوتر والقسوة شدّا أعصابهم حتى النهاية، وألقيا عليهم غلالة كهولة مبكرة. أفتش عن أطفال كنت أناديهم من النافذة كي يجلبوا لنا الخبز من الدكان القريب، أو أطفال كانوا ينغصون قيلولتي بلعبهم الصاخب. من المؤكد إنهم كبروا الآن وأصبحوا جيل المقاومة الجديد، وبينهم هذا الذي أوقفني قبل أيام وطلب مني ابراز هويتي. الأسلحة مجمدة بين أيديهم مع أن وجودها يستدعي الفعالية. ثمة عضلة مشدودة ومرتجة تمتد من رأس الصبي الملول إلى الإصبع المعقوف على زناد البندقية. وأنا أمشي في الشارع العاري بين صفين من حراس المقرات تداهمني فجأة فكرة منحوسة: ما الذي يمنع هذا الصبي الملول من أن يضغط على الزناد ليقتلني انا الماشي وحيدا في الشارع مكبلاً بكدس من الكتب والأوراق. كدت أنسى فيهم همة الصبيان وهم يستقبلون الأطفال العائدين من روضتهم و يداعبونهم ويشترون لهم الحلوى، أو يحملون قناني الغاز ليوصلوها لنا نحن سكان الطابق السادس دون أن ينتظروا كلمة شكر، كأنهم يفعلون ذلك لأمهاتهم البعيدات. كدت أنسى ذلك الجوهر الذي تبدى فيهم خلال غارة الطيران الإسرائيلي: فقد هرعوا إلينا نحن السكان المدنيين يدفعوننا وأطفالنا نحو الملاجئ، وينيرون طريقنا ببطارياتهم اليدوية وبعد أن أوصلوا العجوز الأخيرة خرجوا إلى الشارع المكشوف دون حماية منذورين للموت. ببدلاتهم هذه بدوا كأنهم لا يجيدون لغة غير العنف فتتحرك العضلات حين يتأتى اللسان عاجزا عن التعبير. لا تزال المدينة بأسواقها المنتشرة وسلعها القريبة والمستحيلة في الوقت نفسه تراود هذا المراهق المسلح وتستطيع القوة أن تأخذ مكان المال في خيال الصبية الفقراء الذين يرون الأمور من فوهة بندقيتهم. وعندما أبديت لأحد القادة تخوفي على جيل المقاتلين الذي نشأ بعد الحرب اللبنانية، قال لي بأن تحت هذا المكتب سجن مليء بصبيان بمثل هذا العمر… "ومع ذلك لا نستطيع أن نضغط عليهم أكثر اذا ضبطناهم بيطفشوا".
لاجئون عند اللاجئين
في هذه الثكنةً تكدّس (اللاجئون الجدد). أكثر من ألف عراقي أغلبهم من اليسار هربوا من القمع العراقي إلى غابة السلاح هنا. تدريجياً اتعرف على حياة العراقيين في هذه الثكنة الغريبة. ففي بيوت يسمونها هنا (محطات)، تتكدس العوائل العراقية في خليط عجيب. (محطات) تعني أماكن مؤقتة، مع ذلك تدق المسامير في الحيطان لتعليق الملابس، وتوضع صور الغائبين قريبا من السرير. عوائل كانت مرفهة في العراق، تسوّر بيوتها الحدائق، تعيش هنا في غرف مزدحمة، وفي الطوابق العليا من عمارات تعطلت مصاعدها. بنات شابات تسللن من العراق بأوراق مزورة وتركن عوائلهن هناك، وشبان تركوا حبيباتهم وزوجاتهم وأطفالهم، ولا يحملون في جيوبهم غير الصور. عندما وصلت الى هنا فوجئت بهذا الحضور العراقي الغريب.. ما من مهنة الا ولها "اسطة بارع" حدادون، محاسبون، تجار، صحفيون، رسامون، معلمو اطفال.. من هذا الخليط يتكون اللاجئون الجدد. عندما وصلت تذكرت انني كنت ذات يوم وحيداً مع زوجتي في هذه المنطقة، وكل الناس يستغربون حماقتي لأنني اخترت هذه الساحة. الآن الجميع هنا، سبقوني اليها وعرفوا خفاياها. قرأ لي الشاعر عواد ناصر قصيدة عن "مسطر اللاجئين الجدد": في زاوية محدودة من شارع الفاكهاني يتكدس العراقيون، وبالذات العزّاب منهم، ينتظرون شيئاً، وربما لا يعرفونه. عمل او اتصال جزئي، او ترحيل الى المعسكر، او رسالة من الوطن او من يسلفهم لتناول وجبة طعام. لحاهم كثة، وجفونهم زرق من السهر. هنا تجد آخر اخبار العراق، وأجمل النكات، وقد أصبح وجودهم في هذا المكان ظاهرة مألوفة. هنا يتبادلون السكائر والرسائل ويتقاسمون مصاريفهم وهمومهم و يفتّتون ضيقهم ومرارة وضعهم باعتبارهم لاجئين عند اللاجئين.
من شققهم المزدحمة الى هذا الشارع الأكثر ازدحاماً، وفي كل لحظة يأتي رفيق جديد ينتظم في صف المنتظرين، يلقي التحية ويطرح سؤالين ويسكت. ليست هناك أحاديث كثيرة، فقط ما ينشر في الصحف وما يتسرب مع القادمين، وكلما وصلت الى الشام أم أو عائلة احد الرفاق ينتشر الخبر بين الجميع، فالأمر لا يخص واحداً. كل أم تأتي لرؤية ابنها ستحمل معها الكثير من خير العراق، مصاريف ستقتسم وملابس، وشاي عراقي وعمبة، واخبار عن العراق ورسائل. اذن من حق الجميع ان يحتفوا بها ويلتفوا حولها ويتنافسوا على حمل حقائبها إلى البيت الذي تريد. من الضجر والانتظار سيكتب البعض قصائد رصيدها الجزع وحرقة القلب.
طال البقاء في هذه المحطة- الثكنة، لذلك تزوج بعضهم هنا، وولد لهم اطفال، وكبر اطفال صغار ماعادوا يتذكرون العراق. بدأب لا مفر منه يتوالف العراقيون هنا مع منفاهم، مع هذه الحياة الاستثنائية القاسية، ولكنهم هنا يصنعون افراحهم بذلك الحرص الشديد على الاحتفال بأية مناسبة. لقد نظّموا حياتهم هنا بصعوبة. في كل شقة مسؤول عن تنظيم الحياة والإدارة ، وفي كل شقة صندوق تبرعات، وقد نقل الشبان العراقيون معهم هذا الدأب على قراءة الكتب وحضور أية ندوة ثقافية أو سياسية. جاءوا هنا في فترة ركود وتداع وأعطوا حيوية وخبرة لهذه الساحة الصعبة المليئة بالمزايدين.. البعض هنا يعيب علينا أننا متعصبون لعراقيتنا. نحن نحب الشاي العراقي، والبامية العراقية ونعلق في غرفنا بطاقات عراقية ونسمع أغنيات عراقية. حقاً نحن لاجئون جدد لم ننس طعم الاشياء العراقية. ونعلل أنفسنا كلما حدثت اضطرابات بأن عودتنا قريبة جداً. نحن لم نهجر سابقاً وما كنا من مدمني السفر، لذلك نخلق مناخاً من الوهم العراقي حولنا، ويصعب علينا الحياة بدون هذا التماثل مع حياتنا السابقة.
يتندر اللاجئون الجدد بالمفارقات التي تصادف العراقيين خاصة الريفيون وسكان الجنوب. في هذه المدينة التي بقي فيها الكثير من ملامح مدنية حضارية، هناك رفاق لم يدخلوا في حياتهم مصعداً كهربائياً، وما رأوا البحر، ولا يعرفون استعمال الشوكة أو الملعقة. كل هذه الادوات تشاكسهم وتجعلهم موضوعاً للتنكيت، ولا حدود للنكت الآتية من مفارقات اللغة. اعرف رفاقاً يخلطون بين "البندورة" و"البلكونة"وبين "المازوت" و" الكازوز" وتقفز الكلمات الريفية الجنوبية وسط الجمل اللبنانية في نشاز مضحك…
…
بين آونة واخرى نودع وجبة جديدة إلى كردستان، نودعها بدموع الفرح والحسد، والرجال الذين بقوا يحسّون بعار خفيف، فلن يبقى في هذه الساحة غير الأطفال والنساء، ولذلك يمايزون أنفسهم بالرجال الذين ذهبوا.. ما الذي يعوزهم إذن؟! في بيروت تتكون البروليتاريا الشيوعية التي افترق عنها الحزب طوال فترة الجبهة. بروليتاريا لا تريد الزمالات ولا المكاسب. فقط تريد ان تقاتل وتسهم في تحرير العراق من الفاشية، وعما قريب سيكون هناك، ويا للاسف، نوعان من الشيوعيين: العائدون من الزمالات حاملو شهادات الدكتوراه في نظريات الجمال العتيقة، او في نظريات التطور الرأسمالي. يقابلهم شيوعيو المخيمات والخنادق المجبولون على الخطر والموت، المستعدون للقتال والموت.
نحن هنا نكبر سياسياً ونزداد خبرة بالاختلاط مع حيوية السياسة وتفاعلاتها هنا ونستوعب مأساتنا ونفسرها، واحياناً يبدو لنا أن المأساة اكبر منا، واننا لسنا جديرين بها، وكأن كل ما حدث لنا هو مجرد نزوة اردناها نحن، ونتلاءم معها كما يحب المراهقون الرحلات الصعبة، وليس كارثة حقيقية كنستنا كزلزال. ثم نتذكر انها كارثة شعب كامل، وما من احد غيرنا يستطيع انقاذ شعبنا من هذه الكارثة، ولذلك علينا ان نترفع على الهموم الصغيرة والمنافسات والحسد والبحث عن الصغائر.