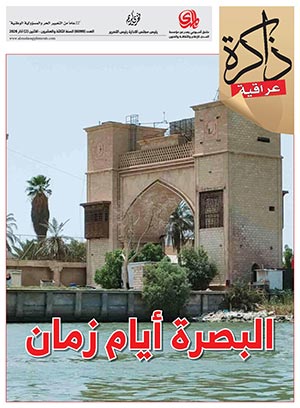علاء المفرجي
وجدت الأفلام الوثائقية، في بداية الثورة السورية، طريقها إلى التشكّل عنصراً مهمّاً في توثيقها منذ بدايتها. ساعَد على ذلك التطوّرُ التقني الذي لمع في سنوات الثورة. لم تعرف أماكن ساحات الاعتصام والتجمّعات الاحتجاجية وجود من لديه الوعي بضرورة توثيق سَير هذه الثورة، باستثناء محاولات بعض المتظاهرين، خاصة الشباب منهم، باستعمال الهواتف المحمولة والكومبيوترات الشخصية، للنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أو لإرسالها مباشرة إلى الفضائيات المتعاطفة مع الثورة.
من هنا، تشكّلت أهمية الفيلم الوثائقي في سرد سيرة الثورة. وربما كان فيلم "تهريب 23 دقيقة ثورة"، الذي عرف نجاحاً في مهرجانات سينمائية عالمية، كـ"مهرجان برلين"، يُصوِّر دخول صانعيه مع الكاميرا إلى مدينة حماة، في ظروف صعبة، لتوثيق قصة الثورة.
توالت وثائقيات الثورة، التي بدأت بتظاهرات سلمية، قبل تحوّلها، مع قسوة مواجهة النظام لها، وابتكار أساليب جهنمية لردعها، إلى ثورة مسلّحة. من الأفلام التي تناولت الثورة، "عن الآباء والأبناء" (2017) لطلال ديركي، الذي أثار سجالات بين مُنتقدٍ له ومُبارك صنعته. وذلك لأنّ الفيلم ـ الذي حقّق لسورية إنجازاً كبيراً بترشيحه لجائزة "أوسكار"، وهذا أكبر تتويج سينمائي له، ثم فوزه بأفضل فيلم وثائقي في "مهرجان صندانس" ـ لا يبحث في مسبّبات الثورة، قدر الذهاب إلى تداعياتها المهيمنة على المشهد في عشر سنوات.
استمدّ الفيلم مغايرته بهيمنة موضوعات شتّى بين ثناياه: الإرهاب ـ الجهاد، تأثير الحرب على الأسرة، الأطفال والنساء. والأهمّ: أسلوب تنفيذه، الذي جعله مُربكاً، فديركي جزءٌ من الحدث، وإنْ لم يكن له دور بالمعنى المتعارف عليه في السينما. لكنّه، في الوقت نفسه، يستنطق الشخصيات الرئيسية: الأب أبو أسامة وأولاده، إذ دخل في هذه العائلة متخفّياً كأحد الجهاديين، فباتت حياته مُهدّدة بالخطر، إذا كُشفت هويته الحقيقية.
يمنح طلال ديركي كاميرته حرية الحركة من دون تدخل، إذ لا توجد مَشاهد مُعدّة سابقاً. كُلّ الحوارات عفوية أمام الكاميرا، من دون حاجة إلى توجيه الشخصيات، أطفالاً وكباراً، فلا بطل ولا حدث، باستثناء عائلة وأطفال، وآباء يساهمون بقتلهم مع أعدائهم، رغم أنّهم يحبّونهم ويحنّون عليهم. لكنْ، لا مفرّ من إلقائهم في الحرب.
يرى بعضهم أنّ ديركي وثّق حياة عائلةِ متطرّفٍ وإرهابي. بينما رأى هو أنّ الفيلم "يُلقي الضوء على الطفل الذي يتربّى على العنف، ويستنشق رائحة الدم، ما يُحدّد اختياره الوحيد في أنْ يكون مُتطرّفاً". هو هنا يؤكّد الجانب التربوي في البيت السوري، وعن كيفية انتقال العنف من جيل إلى آخر.
الفيلم عن تجلّيات الثورة السورية وتداعياتها، التي أفرزت مجموعات وأنماطاً عدّة، تنظر إلى الأوضاع في سورية نظرة خاصة. بالتالي، فإنّها تعالج الوضع بمنظورها، والمنظّمات المتطرّفة وجدت في الغليان العام سبيلاً إلى تحقيق مآربها.
ربما يؤخذ على هذا الوثائقي تماهيه مع رؤية نظام بشّار الأسد للثورة، ووجهة نظر الطاغية المستبدّ، واتّهامه الثورة بالعنف والإرهاب. فديركي ـ الذي أنجز في بداية الثورة أوّل وثائقي له بعنوان "العودة إلى حمص" (2013) موثّقاً فيه الاحتجاجات المناهضة للنظام في حمص عام 2011 ـ ابن جيل حمل الكاميرا ليُصوّر فظائع النظام، لكنّه اصطدم بتحوّل جانب من الثورة إلى العنف، فكان عليه التركيز على الجناة الحقيقيين الذين انحرفوا بالثورة، عكس ما تمنّى لها، مُسجلاً ما تفعله الحروب بالآباء على أطفال لا تتعدّى مُتعهم ألعاباً بريئة. إنّه يجعلنا نتلمّس، بعين الحقيقة، جريمة إشراك الأطفال مع الكبار في لعبة العنف.