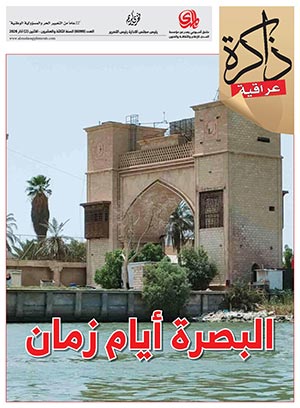طالب عبد العزيز
في مجلس أسريّ سألني أحدُ أبناء العم ما إذا كنت قد انتفعتُ من كتابة الشعر، وإصدار الكتب بشيءٍ أم لا؟ لم أخفِّ شعوري بالخزيّ والحرج من السؤال، الذي لا أجدُ إجابتي عنه مجزيةً، لفتىً في عمر أحدِ أبنائي! يفهم الحياة بوصفها رحلة قوامها المال والجاه والمنزل والسيارة والرصيد في المصرف، لذا، أستأذنته بأنَّ إجابتي ستكون خارج ذلك كله، وأنَّ الشعر والكتابة وإصدار الكتب قضيةٌ شخصيةً، لا يدخل المالُ نفسَ صاحبها -في شرقنا العربيّ بوجه خاص- بل هو ينفق من ماله عليها، دون التفكير بقضية الربح والخسارة!! فهالته الإجابة.
ولكي لا يراني بعقل مختلٍّ حاولت تبسيط الامر عليه، فقلتُ: أترى ثمة فائدة في الظلام؟ فقال لا، الفائدة في الشمس والضوء. قلت وماذا عن الماء واليابسة؟ أيمكننا القول بأفضلية هذا على ذاك؟ فكاني يجيبني بحسب وعيه الأحادي، ومثل هذه قلت في الامتلاء والفراغ، وفي الحلو والمر، وفي الملح وعدمه، وفي القرب والبعد، وفي الحضور والغياب، وسألته: ماذا لو أنَّ الشمس ظلت تشرقُ دون غياب، أتكون الحياة معها ممكنةً؟ فقال: لا. ثم أنني سألته ماذا لو أننا بقينا في مجلسنا هذا الى ما لا نهاية، هل لبقائنا هذا معنى؟ أم سنحتاج الى المغادرة؟ ولكي أقترب من فهمه سألته: ألا ترى في كتب الأنبياء وكتب الفلسفة والأديان والنحو والفلسفة والرسم وسواهم نفعاً وفائدةً فأجاب: بلى، قلت أيمكنك أنْ تدلني على معنى انتفاعك منها، وكم وضعت في جيبك منها؟ فتبسمَ قائلاً: الآن، عرفت.
ثم أنني أردت تبيان القضية أكثر له فسألته عن الحائط الأبيض الذي أمامنا حيث نجلس أهو جميل؟ فقال: أجل، هو أبيض وجميل. فقلت ماذا لو جئنا برسام عبقري ورسم عليه شيئاً، مما في الطبيعة، سماءً زرقاء، طائراً، نهراً، حديقةً بورود وفراشات... الخ ألا تراه سيكون أجمل؟ وفي كلِّ مرةٍ كان يقترب مني أكثر، وتطيب نفسه، وتحلو الإجابات له. أكتب هذه لأننا محاطون بمثل الفتى هذا، وهناك من يسخر من حياتنا التي نضيعها في الكتب والاقلام والمماحي، ولأننا مفلسون وأبناء خيبات وحمقى من وجهة نظر الكثيرين، ولا نجد بين أصحاب الشأن من واضعي المناهج المدرسية وأصحاب الرأي والفكر من يدافع عنا أو يقول كلمة في معنى خيباتنا وخلو جيوبنا من المال فسنظل هكذا من وجهة نظر مجتمعاتنا، وستتسع الهوة بين صانع الحياة ومستعملها.أردتُ أنْ أقول له بأنَّ الشاعر والرسام والموسيقي وسواهم يصنعون الحياة، أما أنت وغيرك فهم يستعملونها حسب، لكنني خشيت عليه من قولة ثقيلة كهذه.
تقول الكاتبة الأميركية أودري لورد:" الشِّعرُ أكثر طرقنا الحقيقية نحو المعرفة" وهو يساعدنا في منح اسم لما لا يمكن تسميته" "وحين تصبح آمالنا ومخاوفنا مقبولة تقودنا مشاعرُنا الى أكثر الأفكار جموحا وجرأةً". الغريب أنَّ لا أحدَ يسأل عن ثمن القشعريرة التي يحدثها الشعر أو الموسيقى أو الأغنية أو اللوحة أو الجملة الشعرية العابرة حتى؟ السؤال الذي سيقود الى أهمية وجود الشاعر والموسيقي والمغني والكاتب وسواهم بيننا، وماذا سيصبح شكل الكون إنْ فقدوا! هذا الوجود غير المعاين، هذا الوجود الذي لا يسمى ويزهد به كثيرون هو قوام الحياة هذه، وهؤلاء وحدهم من يعرفونها، التعريف الذي تستحقه. يسهبُ كبيرُ أطباء القلب في شرح فسلجة ووظائف القلب لكنه يعجز عن فهم بيت الشريف الرضي:" وتلفتتْ عيني، فمذ خفيتْ عنّي الطلول تلفتَّ القلب" الشاعرُ وحده الذي يعرف كيف يتلفت القلب! وإن سأله الطبيب: أيتلفت القلبُ سيقول بلى، وبيقين ثابت، بأنه يتلفت، وقد يخرج عن مداره، لكنْ لا يشعر به إلا من كان مسكوناً بالمشاعر، إلا من كابد وتحسس وعانى ومكّنته لغته من التعبير. كنتُ جاهدتُ في إيصال جملة الإجابات للفتى ذاك، لكنَّ حدود الفهم التي تفصل بيننا كانت شاسعةً، هناك ما لا يُستخلص بالسؤال والاجابة. هل سيضطرني الى القول بأنَّ الحزن الحقيقي خير من الفرح الزائف، وأنَّ "اختيار الحقيقة خير من البقاء في حدود الطمانينة"؟ كما يقول اندريه كونت سبونفيل.