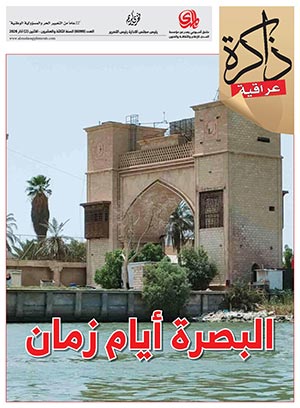د. عدي حسن مزعل
في الدول المتقدمة، وفي الدول الساعية إلى النهوض والتقدم، تحظى الجامعات باهتمام كبير. ولا غرابة في ذلك، فرصانة المؤسسات التعليمية في بلد ما، وعلو منزلتها لدى صانع القرار، مؤشر على قوة البلد وازدهاره، إذ لا توجد دولة متقدمة من غير جامعات متقدمة، والعكس صحيح أيضاً.
وهكذا، فماهية المؤسسات التعليمية، تقدمها أو تأخرها، تكشف عن قوة الدول أو ضعفها، وهو أمر يتجلى داخلياً، في هذا المجتمع أو ذاك، على صعيد التنمية والتقدم، كما يتجلى خارجياً، على صعيد التأثير والحضور في مجريات الساحة الدولية. وذلك هو ما يفسر قول الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما: (إن مصدر قوة الولايات المتحدة جامعاتها).
غير أن واقع الجامعة وتأثيرها في المجتمع، لا يختصر في تلقينها للعلوم والمعارف، ولا في تمكينها الدول أسباب القوة والهيمنة، أقصد أنها ليست آلة تنشر معارف يأخذ بها متلقيها وكأنهم روبوتات تستجيب لأوامر وإشعارات، ولا هي مؤسسة وظيفتها منح شهادات لخريجيها وحسب، كما هو التعريف المتداول للجامعة، وإنما هي فضاء يزدهر فيه الرأي والرأي الآخر، كما يشهد حوارات وسجالات والأهم، يحضر فيه، بهذا القدر أو ذاك، قضايا المجتمع والسياسة. ومن زاوية تاريخية، فإن المعنى الأخير شهدته العديد من الدول الغربية التي عرفت جامعاتها احتجاجات طلابية إزاء قضايا داخلية وخارجية. وقد اتسع هذا النشاط مع بدايات القرن العشرين في الجامعات الأمريكية، وفي الجامعات الأوروبية، خصوصاً مع الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت عام ١٩٦٨ في فرنسا ثم انتشرت في بقية بلدان العالم.
ويهمني في هذا السياق تسليط الضوء على دور الجامعة في مجتمعاتنا ومقارنته بدور الجامعة في الغرب. ذلك أن الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية، وخاصة الجامعة، في تشكيل الثقافة وبثها في المجتمع، يجعلها في مقدمة المؤسسات الفاعلة في الشأن الثقافي. وإذا كان هذا هو ما ينبغي أن يكون، فإن ما هو كائن خلاف ذلك. أقصد أن الجامعة ودورها التنويري المفترض في مجتمعنا، أبعد ما يكون عن التأثير في عموم طبقاته، وأحياناً لا يكون له تأثير في الطالب ذاته، هذا إذا ما تخرج هذا الأخير، وهو يحمل كماً هائلاً من النقمة والسخط على الجامعة، ولا يبقى في ذاكرته سوى علاقات عابرة وانطباعات متفرقة عن هذا الدرس أو ذاك. ولهذا تبدو الجامعة غير مؤثرة ولا فاعلة، لا في طلبتها ولا في المجتمع.
لا شك أن الجامعة في العراق قد أنجبت أسماء لامعة وكفاءات فذة، خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، وهؤلاء بدورهم كان لهم بصمة وأثر واضح في البعض من تلامذتهم، لكن خارج أسوار الجامعة الأمر غير ذلك. وتفسير ذلك يعود إلى الحكومات وسياساتها في إغراء وتدجين النخب لصالحها تارة، وفي تغييب وإقصاء كل صوت معارض تارة أخرى، الأمر الذي يؤكد حقيقة أن الجامعة بقيت حبيسة قيود النظم السياسية الحاكمة. وهذا الأمر بدوره أوقف عملية النمو التدريجي لحرية البحث والقول. وعندما تغيب الحرية عن الجامعة، وبعبارة أدق عن المثقف، فلا تفسير لذلك سوى: إن النظام التربوي والتعليمي كسلطة في المجتمع غير مستقل عن السلطة السياسية وقوانينها التي تحدد ما يسمح به ولا يسمح به، ما ينبغي أن يُدرس ويُعلم وما لا ينبغي أن يُدرس ويُعلم، وبعبارة موجزة: (ما ينبغي قوله وما لا ينبغي قول).
لقد لعبت الجامعة في الغرب دوراً رئيسياً في عملية التغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي، أكان ذلك زمن الأزمات الكبرى أم زمن الاستقرار، تمثل ذلك بنشر العلوم الإنسانية الحديثة، وفي تقليص نسبة الجهل، وتصحيح الكثير من التصورات الظلامية والأسطورية للحياة والكون، كما ساهمت في نشر ثقافة حقوق الإنسان خارج أسوارها، وكانت عامل ضغط كبير على قوى ومؤسسات الدولة، يشهد على ذلك الاحتجاجات الطلابية التي جرت في الجامعات الغربية، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تنديداً بالإبادة الجماعية في غزة، والتي تقوم بها أكثر الدول تحالفاً وقرباً للغرب (الكيان الصهيوني).
وهذا ما لم تحققه جامعاتنا، لا زمن الأزمات حين تمد يدها للمشاركة في الشأن العام بغية إيجاد الحلول ومعالجة المعضلات لصالح المجتمع، ولا زمن الاستقرار النسبي الذي يفترض فيه أن تتقدم الجامعة على سواها من المؤسسات، رغم أن هذا الأخير (أقصد الاستقرار النسبي) نادراً ما حظي به المجتمع العراقي منذ تأسيس دولته الحديثة وإلى اليوم. وربما كان أقصى ما تقدمه الجامعة في مجتمعنا هو تخريج عدد قليل من الطلبة الجيدين، من الذين حظوا بتعليم لا أبالغ إذا قلت: إن القسط الأعظم منه هو نتاج جهد ذاتي لا علاقة للجامعة به، إضافة إلى تقديم خبرتها واستشاراتها إلى مؤسسات الدولة. ويبقى أن دورها محصور داخل أروقتها، وهو دور أبعد ما يكون عن التأثير في الشأن العام، أو التأثير في الواقع السياسي والاجتماعي، فضلاً عن الثقافي نفسه.
نخلص من ذلك إلى أن مؤسساتنا التعليمية تتبع السلطة السياسية وتدور في فلك سياساتها. ويبدو أن الأنظمة السياسية في مجتمعنا، وفي كثير من المجتمعات المتأخرة، لا زالت تهتدي بهدي رؤى أفلاطون، حيث التربية لدى هذا الأخير حقل تتحكم به السلطة السياسية وتديره. لكن الفرق بين التصور الأفلاطوني للدولة وبين ما آلت إليه شؤون السياسة في مجتمعاتنا، هو أن الأول أراد جعل رأس الدولة في مدينته الفاضلة هو (الفيلسوف)، بوصفه الأجدر في تدبير شؤون الدولة، في حين أن مجتمعنا وغيره، انتهى إلى جعل أنصاف المتعلمين، وأحياناً الجهلة على رأس الدولة.
وهكذا لم تكن الجامعة، لا ماضياً ولا حاضراً، أكثر من أداة بيد النظم السياسية تطوعها وتدجنها وفق مقتضيات (مصلحة النظام السياسي الحاكم)، أي وفق الأيديولوجيا التي يرتئي هذا النظام أو ذاك بثها في المجتمع، وليس وفق ما ينتظره المجتمع من هذه المؤسسة باعتبارها صرحاً تنويرياً. ولذا، فإن الدكتاتورية وعوامل أخرى مثل: الطائفية السياسية، النزعة القبلية، التأخر المعرفي وسيادة الجهل، فضلاً عن أسوأ نسخ الأصولية الدينية التي لا زالت حاضرة في مجتمعنا، لعبت دوراً في أن لا تأخذ الجامعة دورها التنويري المفترض إزاء المجتمع وقضاياه.