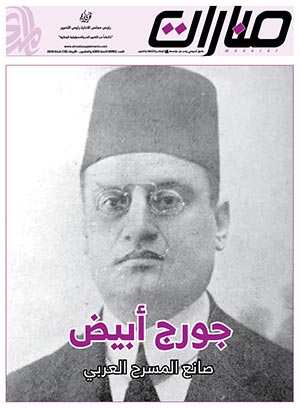لطفية الدليمي
هل صدّقتم العنوان؟ لا تصدّقوه. هو بعضُ نزوات ترامب الذي يقول كثيراً من المبالغات والأباطيل والأكاذيب التي يغلّفها بتوصيفاته البرّاقة. هل ثمّة ما هو أكثر رقاعة من توصيفه لحزمة تشريعه المالي الأخير بأنّه اللائحة الجميلة الكبيرة The Big Beautiful Bill؟ وهي لائحة قد تكون كبيرة؛ لكنّها ليست جميلة بالتأكيد. كلام مرصوف فحسب.
كتبتُ في مقالة سابقة أنْ ليس أشقّ عليّ من أن يكون رئيسٌ أمريكيٌّ عنصراً في ما أكتب؛ لكنّما الرغبات لا تتحقق دوماً. أمريكا إمبراطورية لها فعلها المؤثر في صناعة العالم وتشكيله على كافّة المستويات، ولن نستطيع تغيير هذه المعادلة الحاكمة في السنوات القليلة القادمة على أقلّ تقدير. لذا قد نجد أنفسنا مدفوعين دفعاً إلى تناول الشأن الأمريكي وبخاصة عندما تكون مفاعيله أبعد من حدود الجغرافيا الأمريكية، وفي الغالب هذا ما يحدث. حربُ التعرفات التجارية أحد أكبر الأمثلة.
يبدو ترامب وكأنّه يخوضُ حرباً من حروب القرون الوسطى الدينية بالضد من جامعات النخبة الأمريكية. الغريب أنّ جامعة هارفرد نالت النصيب الأوفر من كلماته القاسية وقراراته التنفيذية الممهورة بتوقيعه الغريب مثل شخصيته.
من المؤكّد أنّ خرّيجي هارفرد يعرفون العدّ، ولهم مهارات كبيرة تؤهلهم لوظائف مميزة في سوق الوظائف الأمريكية. أظنّ من يسعى للمزيد من معرفة تاريخ الجامعات الأمريكية يمكنه الإستعانة بالكتاب الممتاز الذي كتبه جوناثان كول Jonathan Cole وعنوانه The Great American University (توجد ترجمة عربية له). لماذا يناصبُ ترامب العداء لجامعات النخبة في بلده وبخاصة هارفرد التي هي من أوائل الجامعات الامريكية التي تأسّست في القرن السابع عشر؟ لا عاقل من الأمريكيين يفعل هذا؛ فلماذا يفعل من هو رئيسٌ لأمريكا؟ الجواب البسيط والسريع هو أنّ ترامب شخصية غير متوازنة، يقول شيئاً ثم يقول نقيضه بعد ساعة أو أقلّ من ساعة. كتلةٌ من المتناقضات والتصريحات المتضادة التي تربك المستمعين وصُنّاع السياسة العالمية. لكنّها ليست كلّ أفاعيل ترامب وسياساته هي ممّا يمكن تسويغه بنظرية الرجل المجنون الذي لا تُـعْرَفُ نواياه. هذه المقاربة التبسيطية سيئة ولا تنفع في محاولة فهم السياسة الأمريكية الحالية.
ترامب أكبر من صورته الشائعة بكونه رجل صفقات لا يرى العالم سوى بأنّه شركة كبيرة يمكن أن يتعامل معها مثلما يفعل مع شركاته العقارية. هناك جانب آيديولوجي خطير في السياسة الترامبية، وهو جانب يرقى لأن يكون مساراً جديداً في السياسة والإقتصاد والتقنية يتجاوز العالم الرأسمالي الحالي حتى في أكثر أشكاله تطوّراً: النيوليبرالية. ترامب يمثّلُ (بروفة) تمهيدية لعالم مابعد الرأسمالية والنيوليبرالية. يمكن وصف هذا المسار الجديد بأنّه اليمين الجديد: اليمين التقني الشمولي (التوتاليتاري) المدعوم بالذكاء الإصطناعي الفائق. هذا اليمين الجديد يرى في كبريات شركات التقنية الرقمية أماكن حصرية لصناعة المعرفة الحقيقية التي ما عادت في حاجة إلى خدمات الجامعات التقليدية حتى لو كانت من طراز هارفرد وأخواتها. هذا هو السبب الذي يجعل ترامب - الجاهل في أبسط الأساسيات التقنية حدّ أنّه لم يعرف أنّ ستار لينك هي منظومة مزوّدة للإنترنت الفضائي- يؤكّد على الأهمية الحاسمة للذكاء الإصطناعي في التعليم الأمريكي وبخاصة في المراحل الأولية منه.
هذا في الجانب التقني حيث ستنشأ سياسة إستقطابية تمييزية صارمة بين المتمكّنين تقنياً والمفتقدين للقدرات التقنية التنافسية. أما في الجانب الآيديولوجي فلطالما عُدّت الجامعات بحكم سياسات عملها خواصر ليّنة غير صادّة للأفكار والسياسات والآيديولوجيات، وتتعاظم معالم هذا اللين في الجامعات الأمريكية التي صارت نهباً لشتى الأفكار المندثرة في حواضنها الأولى. كيف نفهم مثلاً شيوع الأفكار الماركسية في قلب هارفرد في وقت ما عادت الماركسية تّذكرُ في موسكو؟ يمكن ببساطة توظيف هذه الحواضن الجامعية لتدعيم سياسات محدّدة وخلق لوبيات (جماعات ضغط) بين الأساتذة الجامعيين الذين كثيراً ما يعملون إستشاريين لدى المؤسسات الأمريكية العريقة والمؤثرة بما فيها البنتاغون والكونغرس. هل يقبل الصينيون أو الروس بمثل هذه الخواصر اللينة في جامعاتهم؟ الخواصر اللينة لا تقتصر على الحواضن الجامعية بل تمتدّ لتشمل صناعة السينما والصحافة ووسائل الإعلام ودور النشر. كثيراً ما كان يُنظرُ إلى مرونة التعليم الجامعي الأمريكي وليبراليته العالية وسيلة لإجتذاب أفضل العقول العالمية وترغيبها للعمل في قطاعات قيادية في الإقتصاد الأمريكي، وقد حقّق الصينيون والهنود مآثر شاخصة في هذا الشأن، ويبدو أنّ اليمين الأمريكي الجديد بات يرى أنّ السياسة الفضلى هي ردع هذه الرخاوة الليبرالية بصرف النظر عن كلّ ما يترتّب عليها من خسارة الجاذبية الأمريكية لأفضل العقول والمهارات العالمية.
أما العنصر التوتاليتاري (الشمولي) في سياسات اليمين الجديد فليس أدلّ عليه من قلب المشهد السائد في المكتب البيضاوي: يجلس ترامب وكأنّه ملك متوّج بينما الآخرون متوزّعون وقوفاً وراءه فيما يشبه سيميائية (القائد وأتباعه الآيديولوجيين الخلّص)، ولا فكاك من الدوران في فلك القائد. بالأمس القريب كان (ايلون ماسك) اللورد التقني الذي سينقذ المؤسسات الأمريكية من ترهلها وتناقص معايير كفاءتها، واليوم صار ماسك المستفيد غير الشرعي من مليارات الدعم الحكومي لصالح سيارته الكهربائية (تسلا)، وبات سلاح الطرد خارج أمريكا مشرعاً كسيف ديموقليس على رقبته.
يبدو أنّ اليمين الأمريكي الجديد سعى من حيث لا يحتسب لأن يعيد بعث الروح في عصبية (إبن خلدون). يصرّح هذا اليمين: لقد ضاقت صدورنا بالسياسات الليبرالية المتراخية للحزب الديمقراطي والحياة السياسية الأمريكية في ممارساتها الديمقراطية الشائعة. نريد حصان طروادة يتسلل إلى قلب الحياة النابض للسياسة الأمريكية لكي يزيح عنها ميوعتها التي جعلت أمريكا أمّة من المسرنمين الذين يدورون في متاهة لانهائية. ترامب ليس سوى حصان طروادة لليمين الجديد.
ما أتوقّعه من سياسات قادمة لليمين الجديد هو المزيد من إعلاء شأن الأصوليات المغيّبة في جبهتيْن: الدين والجيش. أنت لن تستطيع مواجهة الأصولية بسياسات ليبرالية تبدو (مخنّثة) ولن تحقق شيئاً سوى ترغيب المقابل في التمادي بأصوليته. كل أصولية لا بدّ من أصولية مقابلة تواجهها. هذا هو القانون الفاعل في الأصوليات المتضادة.
سنكون من كبار الساذجين لو تصوّرنا أنّ إمبراطورية فوق العظمى Super Power يمكنُ أن تسلّم قيادتها لرئيس مثل ترامب من غير حساب دقيق لمآلات المستقبل، وسنكون أكثر بكثير من ساذجين كبار لو أقنَعْنا أنفسنا أنّ مستقبل تلك الإمبراطورية رهينٌ بأوامر تنفيذية موقّعة من ترامب. نحن إزاء عالم جديد يتشكل وآخر يتلاشى، عالم ديستوبي حكى عنه ألدوس هكسلي ومارغريت أتوود وآخرون من الروائيين العالميين، وليس ترامب بأكثر من اللسان التبشيري والتنفيذي الصاخب في المشهد العالمي الجديد؛ أما الصانعون الحقيقيون لمستقبل العالم فهُمْ قابعون بهدوء في جوف حصان طروادة اللامرئي والمركون في زاوية مهملة من زوايا البيت الأبيض.