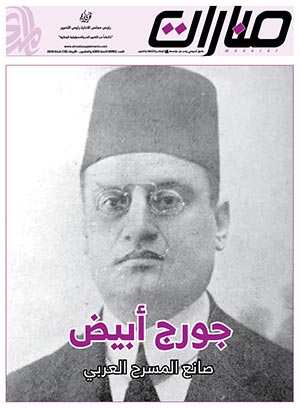د. سهام يوسف علي
في العلاقات الدولية، لا تُقاس القوة بما تملكه الدول من ثروات، بل بما تملكه من إرادة إدارة هذه الثروات. وفي الاقتصاد، لا تنفع الأرقام إذا كانت مفاتيح القرار مرهونة للآخرين. هذه هي مأساة العراق الحديثة، بلد غني بالموارد، فقير بالسيادة، برغم ما يملكه من ثروات نفطية وزراعية وبشرية، لا يزال نموذجًا صارخًا لدولة غنية الموارد، فقيرة القرار، مُعلّقة الإرادة، وهكذا، حين تُفتَقد السيادة، يصبح الاقتصاد أول الضحايا.
في العراق، لا تتعثر خطط النهوض لغياب المال فقط، بل لأن الدولة فقدت منذ زمن طويل حقّها في أن تقرّر، وحين تفقد الدولة هذا الحق، لا تعود قادرة على التفكير في مستقبلها الاقتصادي، بل تُجبر على الاستجابة لأوامر اللحظة، لما يُملى عليها من الخارج، أو لما يُصاغ من قِبل دول الجوار، أو ما يُحاك في غرف المؤسسات الدولية.
العراق اليوم لا يُفكّر اقتصادياً، بل يخضع اقتصاديًا. ليس لأنه فقير، بل لأنه مُقيّد الإرادة. بلدٌ ينتج النفط ولا يتحكم به، يملك أكبر نهرين في المنطقة، لكنه يعاني من الجفاف والعطش، يحتفظ باحتياطي نقدي ضخم، لكنّه ممنوع من التصرف به دون استشارة، ويمتلك آلاف العقول الاقتصادية، لكن القرار بيد السياسة، والسياسة مرهونة لرغبات من فوق.
منذ عام 2003، وُضِع العراق في معادلة هشّة: سلطة سياسية ضعيفة، واقتصاد ريعي معطوب، وهيمنة خارجية متعددة الاتجاهات. ورغم الطفرة النفطية، لم تتحوّل الثروة إلى نفوذ، بل إلى أداة ابتزاز. لم يكن النفط مظلة سيادة، بل عبئًا يُدار خارج إرادة الدولة.
الولايات المتحدة التي تفرض العقوبات على إيران، تغض الطرف عن صادراتها النفطية إلى الصين، لكنها تضيق الخناق على العراق إن فكر باستيراد الكهرباء من ايران، أو تفاوض خارج إشرافها المباشر، و تُمعن في تقييد السياسة النقدية العراقية، وتفرض رقابة على نافذة بيع الدولار، وتقيّد الحوالات الخارجية، وتحاسب البنك المركزي كما لو كان فرعًا من وزارة الخزانة الأميركية.
هنا، لا نتحدث عن مجرد حماية للنظام المالي من الفساد، بل عن وصاية مقنّعة، تمنع العراق من استخدام أدواته النقدية بحرية. فالدولار، الذي يفترض أن يكون وسيلة تداول، تحوّل إلى أداة ضبط سياسي. تُستخدم قوائم سوداء، وتُجمّد حسابات، ويُعاقب التجار، دون أن تُعاقب المنظومة التي سمحت بهذا الارتهان، لماذا؟ لأن الصين دولة قوية، تدافع عن مصالحها. أما العراق، فدولة تُدار من الخارج، وتُخترق من الداخل.
الكهرباء مثالًا آخر، حين قررت الحكومات السابقة ربط شبكة الطاقة الوطنية بمصدر غاز خارجي – وتحديدًا إيراني – لم يكن القرار تقنيًا بقدر ما كان سياسيًا، جرى شراء محطات تعمل بالغاز دون تطوير موازٍ لصناعة الغاز المحلية، وبذلك، أصبحت الكهرباء، وهي أساس الحياة الاقتصادية، رهينة في يد الجوار. إن انقطاع التيار ليس عارضًا، بل نتيجة هندسة قرار لا يريد للعراق أن يستقل.
ثم تأتي تركيا، التي تلعب بورقة المياه والنفط بلا حرج. تقطع أو تقلل من حصة العراق المائية متى شاءت، وتحتل أراضٍ بلا مقاومة تُذكر، وتوقِف ضخ النفط عبر ميناء جيهان، وتفاوض على استئنافه بشروطها الخاصة. لا حرج في منطق المصالح عند أنقرة، لكن الحرج كل الحرج في صمت بغداد.
كل هذه التدخلات ما كانت لتنجح لولا بيئة داخلية ساهمت في تعميق التبعية، فالحكومات العراقية المتعاقبة، بدلاً من بناء مشروع اقتصادي وطني مستقل، توزع المناصب والثروات على أساس حزبي وطائفي، وتتعامل مع الدولة كغنيمة لا ككيان سيادي.
والنتيجة: اقتصاد بلا إنتاج، واستيراد بلا بدائل، وتبعية بلا خجل.
السيادة هنا ليست شعارًا، بل سياسة. فالدول لا تُحترم لأنها تطلب، بل لأنها تفرض. والعراق، في صورته الحالية، لا يفاوض كدولة ذات سيادة اقتصادية، بل ككيان يعتمد على الخارج في أساسيات معيشته: كهرباؤه من إيران، ماؤه من تركيا، ودولاره من واشنطن.
كتب المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي ذات مرة: "الأزمة تولد حين يموت القديم ولم يُولد الجديد بعد." وربما هذا هو وصف المرحلة العراقية بدقة. فالدولة القديمة سقطت، ولكن الدولة الحديثة لم تُبْنَ بعد. وفي هذا الفراغ، تتسلل القوى الخارجية، وتتقاسم القرار الوطني كما تتقاسم عقود الإعمار والامتيازات.
العراق لا يفتقر إلى الموارد، بل إلى منظومة حكم تحرر قراره من الولاءات الخارجية والمصالح الضيقة، فكما يقول الاقتصادي الأميركي "غالبرث": "الاقتصاد امتداد للسياسة، لا بمعناها الأخلاقي، بل بوصفها نظامًا للسيطرة "، وحين تكون السياسة مرتهنة، يكون الاقتصاد مرهونًا، وتكون الدولة كلها على الهامش، مهما علت أسعار نفطها أو تضخمت موازناتها.
ما لم يُسترد القرار، فلن تُبنى الدولة، وما لم تُحمَ السيادة، فلن يخرج العراق من عباءة الخضوع الاقتصادي، ولا من نفق الأزمات المتوالدة.