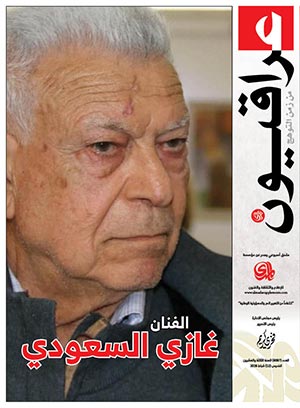يوسف المحمداويلم تمنعنا حزمة الخيبات التي عشناها ونعيشها من السلوى بأمور قد تكون حلاوتها لا تساوي شيئاً أمام مرارة نتاج تلك الحزمة، بل يدفعنا ما نحن فيه أحيانا إلى ذكريات ماض متخلف كما تظنها عقلية جيل لم يشهده، ولكن بنى تصوره وللأسف على ما يعيشه العالم من تحضر، مقارنة بما يري من صور "التقدم الورائي" التي تعج بها البلاد.
وأجزم لو أنه تذوق حلاوة بعض البعض من عسل ذلك الماضي، لشمر سواعد انتقامه على صاغة واقعه، اللاهثين به وبنا وبالوطن صوب المجهول، غازلتني ولطالما ما تغازلني شذرات ذلك الماضي بدافع من انكسار يسورني، وخيبة لا أطيقها على أرصفة حقيقتي.في ستينيات القرن الماضي مازلت طفلا في السادسة أو السابعة من عمري، لا فرق، المهم أتذكرها ولم تستطع غسلها الجرعة الكيمياوية التي حقنوني بها غفلة أطباء (الحوسمة)!، لأنها أصبحت جزءا من الدم وكرياته، وليس بالإمكان نسيانها، كنا حينها نسكن في مدينة العمارة وبالتحديد محلة الجديدة، ولكونها تقع في مركز المحافظة تجدها منجبة للكثير من الأسماء الأدبية والفنية اللامعة، واذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، الفنان والناقد التشكيلي شوكت الربيعي والروائيين نجم والي وجمعة اللامي والفنان حسن حسني، وقارئ القرآن المرحوم عبد الزهرة العماري والقاص عبد الخالق كيطان، ومنها خرجت أول مصورة في تأريخ العراق المناضلة سميرة مزعل وشقيقي الفنان التشكيلي الراحل ياسين المحمداوي، وغيرهم من شعراء ومطربين ولاعبي كرة، وعذرا للذين لم أذكرهم لكثرتهم ومحدودية المقال.كنا وأخي ياسين الذي يكبرني بثلاثة أعوام نذهب سوية نغسل براءتنا ونلون ملامحنا بطين دجلة، التي يقع على شارعها أكثر من صالة عرض للسينما، وكنا نقصدها ونتمتع حتى بالبكاء، ونحن نشاهد الأفلام الهندية وهي السائدة والمفضلة آنذاك، ونحفظ أغاني "شامي كابور" و"فيجنتي مالا" و "آشاباريخ"، فضلا عن أفلام الكابوي التي نشاهدها في سينما الخيام أو الرافدين و النصر وغرناطة وأطلس وغيرها، وتقام أغلب الحفلات والعروض المسرحية آنذاك في المتنزهات التي تمتد على طول كورنيش دجلة.ولا تفارقني ما حييت صورة العربة (الربل) بجمالية صناعتها وطاعة حصانها لسائسها، وهي تقف صباحا قبالة بابنا لتقل شقيقاتي إلى مدارسهن، شارعنا المعبد أو جادتنا كما نسميها سابقا، التي يسكنها الصابئي أبوماجدة، والكردي مزعل البزاز، والمسيحي بيجان وغيرهم من أبناء الوطن الذين جمعهم ملح الطين لا المحاصصة.وأتذكر جيدا مدرستي المختلطة"الكوثر" ومعلمتي السامرائية الست إخلاص وهي توزع علينا الكسوة الشتائية أو الصيفية، وكيف توزع علينا التغذية و و و، وكلها تذكرتها و أتذكرها.وأذكر بها حتى يتذكر جميع القائمين اليوم على قيادة البلد، بأني من عائلة متواضعة الدخل ومع ذلك كنت أشاهد سينما ومسرح في ستينيات القرن الماضي وفي مدينة العمارة، ودارنا ملك صرف، وشوارعنا معبدة، ومدارسنا من الطابوق وليست من الطين.محافظة العمارة وليست العاصمة بغداد يا كامل الزيدي ويا صلاح عبد الرزاق وفي ستينيات القرن الماضي على قاعاتها تصدح أغاني مسعود العمارتلي، وعبادي العماري وسيد محمد ،ومن على مسارحها تخرج فاضل خليل وعبد الرحمن المرشدي وأنعام الربيعي وغيرهم.فكم من رياض احمد يريد الآن أن يغني في بغداد، وكم من قبانجي يريد أن يطرب بالفرح عاصمته، وكم من زينب و ناهدة والسعدي يريدون أن يعتلوا المسرح، وكم وكم، ولكن بغداد الآن بلا صالات للعرض السينمائي!، بلا قاعات للغناء!، بلا نواد اجتماعية!، بلا مسارح!. بغداد التي كانت مزارا وقبلة للعالم، اليوم عبارة عن مدينة خربة قطعت أوصالها الحواجز الكونكريتية، وكتم أنفاسها حظر التجوال، ملونة بالسواد، والسؤال الأبدي ما هو حال المحافظات وعاصمتهن ترفل بهذا العز!؟.يقول أحد المفكرين الذي رفض ذكر أسمه: بالأمس حلمت بالمرحوم داخل حسن واقفا على باب محافظة بغداد يغني.. (عاين يدكتور... باوع يدكتور... فانوسنه مابيه نفط..... كافي يعمي من اللفط...لا عدل بس جور.... عاين يدكتور..عاين)، والدكتور المحافظ ورئيسه من على شرفة البناية يضحكان ويتمايلان طرباً.
كلام آخر: أين يغني داخل حسن؟

نشر في: 8 مارس, 2011: 05:25 م